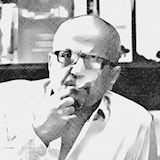الواقع السياسي الفلسطيني في الداخل: ما بعد السابع من أكتوبر وسقوط الأوهام

الواقع السياسي الفلسطيني في الداخل: ما بعد السابع من أكتوبر وسقوط الأوهام
صحيح قانون القومية عام 2018 مهّد لهذا الانكشاف، وكشف بوضوح الوجه الإثنوقراطي للنظام الإسرائيلي، لكنه يبقى حدثًا تأسيسيًا في الماضي، بينما السابع من أكتوبر هو لحظة سياسية راهنة ومؤسِسة لوجه جديد قديم للسياسة الإسرائيلية..
لم تكن لحظة السابع من أكتوبر 2023 مجرد حدث عابر في تقلبات السياسة الإسرائيلية أو الجغرافيا الفلسطينية، بل كانت اللحظة التي عرّت بنية النظام الإسرائيلي بالكامل. الدولة التي طالما ادّعت ديمقراطيتها، وأسست منظومة قانونية لتجميل هيمنتها القومية، سقطت فجأة من كل أقنعتها، وأعادت تعريف الفلسطيني، لا كمواطن، بل كخطر وتهديد وجودي.
في تلك اللحظة، لم يسقط فقط خطاب الاندماج والمساواة، بل سقطت عقود من الأوهام التي غذّت العلاقة بين الدولة ومواطنيها الفلسطينيين. لقد تحطمت البنية الرمزية لـ”المواطنة”، وانهار معها خطاب الأقلية، وخطاب الحقوق، وحتى خطابات المعارضة القومية التي ظنت أن التعايش ممكن داخل دولة تعرّف نفسها كدولة اليهود.
صحيح أن قانون القومية عام 2018 مهّد لهذا الانكشاف، وكشف بوضوح الوجه الإثنوقراطي للنظام الإسرائيلي، لكنه يبقى حدثًا تأسيسيًا في الماضي، بينما السابع من أكتوبر هو لحظة سياسية راهنة ومؤسِسة لوجه جديد قديم للسياسة الإسرائيلية، تنتمي إلى الحاضر وتفرض شروطها على المستقبل. من هنا، يبدأ هذا المقال: من لحظة التعرية الكاملة، لا من لحظة التلميح. من زمن يُحاكم كل ما سبقه، ويطلب من الفلسطيني في الداخل أن يُعيد صياغة موقعه، خطابه، ومعركته.
أولًا: من المواطنة المشروطة إلى الإقصاء القانوني
طوال عقود، اتبعت إسرائيل سياسة المراوغة بين منح الحقوق الفردية وإنكار الحقوق الجماعية. لكن مع قانون القومية، سقطت ورقة التوت الأخيرة، وأعلنت إسرائيل سيادة يهودية حصرية، وصار الفلسطيني في الداخل “مواطنًا من الدرجة الوظيفية”، لا من الدرجة السياسية أو القومية. وبهذا، لم تعد الهوية الفلسطينية تواجه القمع الأمني فقط، بل تواجه الإقصاء القانوني المنهجي.
ونقصد بـ”مواطن من الدرجة الوظيفية” أن الوجود الفلسطيني في الداخل بات مقبولًا فقط بقدر أدائه لوظائف محددة تخدم استقرار النظام؛ والتي تتمثل بوظيفة اقتصادية تضمن الإنتاج والاستهلاك، ووظيفة سياسية تشرعن صورة “الديمقراطية الإسرائيلية” دون المساس بالهوية اليهودية للدولة، ووظيفة أمنية تقوم على ضبط السلوك والانتماء. هذه المواطنة ليست حقًا أصيلًا مستندًا إلى الشراكة، بل امتيازًا مشروطًا بالأداء الوظيفي، يُسحب أو يُقيد فور التشكيك بولاء الفلسطيني أو إظهاره لأي انتماء وطني مغاير. هذا المفهوم أو المصطلح، يتقاطع مع تحليلات نقدية لمكانة الفلسطينيين في إسرائيل باعتبار “مواطنتهم مشروطة” ضمن منظومة إثنوقراطية، لكنه هنا يتبلور بوضوح كآلية تحكم وظيفي لا اعتراف سياسي.
ثانيًا: أزمة علاقة الأحزاب العربية مع الدولة
بنت بعض الأحزاب السياسية العربية داخل إسرائيل جزءًا كبيرًا من خطابها السياسي على المطالبة بالمساواة ضمن المواطنة، لكنها وجدت نفسها في مأزق وجودي وسياسي بعد 2018، في حين كانت إسرائيل تعيد موضعة نفسها كدولة إثنية حصرية، بقيت معظم أحزابنا تراهن على خطاب الحقوق المدنية كوسيلة للاندماج السياسي أو النضال السياسي.
وهنا تتكشف المفارقة القاتلة: بينما حسمت إسرائيل هويتها وموقعها القانوني، استمر خطاب أحزابنا السياسية الداخلي في مطالبة دولة يهودية صريحة أن تتعامل مع “مواطنيها” الفلسطينيين كمتساوين. وكأن الزمن السياسي توقف عند بعض نخبنا، بينما النظام تحرك إلى موقع أكثر تطرفًا ووضوحًا. إن الإصرار على خطاب المساواة المدنية في واقع ما بعد قانون القومية وما بعد السابع من أكتوبر أصبح عبئًا سياسيًا، بل وهمًا استراتيجيًا، إذ يُغفل أن المعركة الحقيقية لم تعد معركة خدمات بل معركة اعتراف قومي وسيادي.
الأحزاب العربية تجد نفسها اليوم مطالبة إما بإعادة صياغة مشروعها الوطني بما يتلاءم مع طبيعة النظام الجديد، أو بالاستمرار في استنزاف قوتها في معركة خاسرة، تنتهي بتهميشها التدريجي.
ثالثًا: جدلية الخطاب المدني وسقوط أوهام الانتماء المتساوي
الخطاب المدني الذي ساد بين فلسطينيي الداخل لعقود، والقائم على فكرة أن تحقيق العدالة يتم عبر المساواة القانونية الفردية داخل الدولة، والذي ساد وما زال منذ اتفاقيات أوسلو، واجه أكبر اختبار له بعد السابع من أكتوبر 2023. ففي أعقاب تلك الأحداث، انفجر الخطاب الأمني ضد الفلسطينيين في الداخل بشكل غير مسبوق، مثل حملة اعتقالات موسعة تحت ذرائع واهية وتجريم أي تعبير عن الهوية الفلسطينية، وترسيخ صورة “العربي العدو الداخلي” في الخطاب العام الإسرائيلي. هكذا كشفت أحداث السابع من أكتوبر أن المواطنة الشكلية التي يصطدم فيها الانتماء القومي بالولاء السياسي للدولة، تصبح المواطنة أول ضحاياها.
انكشف الخطاب المدني للأحزاب العربية التي طالبت من خلاله بالمساواة على حقيقته: حقوق مشروطة بقدر التخلي عن الرواية والهوية الفلسطينية والقبول الكلي بالهوية الصهيونية للدولة. بالتالي، لم يعد بالإمكان اليوم الحديث عن “مواطنة متساوية” دون التعامل مع معضلة الانتماء القومي والسياسي الذي لا تقبله إسرائيل حتى ولو التزم القانون.
رابعًا: الحاجة إلى مشروع سياسي بديل
كل هذه التحولات تفرض بناء مشروع سياسي جديد يقوم على عدة أسس استراتيجية منها: الاعتراف بأن إسرائيل قانونيًا وثقافيًا حسمت طبيعة نظامها القومي الأحادي، والانتقال من خطاب الحقوق الفردية إلى خطاب الحقوق القومية الجماعية، المستند إلى شرعية الانتماء الفلسطيني، وربط نضال فلسطينيي الداخل بنضال شعبهم الفلسطيني الأوسع، ورفض الفصل بين قضيتهم وقضية التحرر الوطني الشامل.
لم تعد المطالب بالخدمات والتمثيل السياسي المحدود كافية. إن المطلوب الآن إعادة صياغة مشروع يستند إلى تثبيت الهوية، والمطالبة بالاعتراف بالحقوق القومية الكاملة، بما في ذلك حق تقرير المصير الثقافي والمدني.
خامسًا: هل تجاوزنا حتى خطاب التجمع؟
ومع أن هذا المقال يتقاطع جوهريًا مع الطرح الذي قدمه حزب التجمع الوطني الديمقراطي منذ نشأته، إلا أن لحظة ما بعد السابع من أكتوبر تفرض مساءلة حتى لهذا الخطاب القومي ذاته. فبينما شكّل التجمع لعقود حاضنة فكرية مركزية لخطاب “دولة لجميع مواطنيها” و”الحقوق القومية الجماعية”، إلا أن هذا الخطاب نفسه بات بحاجة لإعادة تموضع، ليس لأنه فشل من حيث المبدأ، بل لأنه لم يتطوّر تنظيميًا وسياسيًا ليواكب لحظة الانكشاف الكامل بعد السابع من أكتوبر.
فالتجمع، رغم وضوح شعاراته وتماسك أطروحاته النظرية، ظل هذا الخطاب حبيس النخب الثقافية والسياسية، ولم ينجح في إنتاج أدوات جماهيرية أو مؤسساتية مستقلة تُجسّد مشروعه خارج الكنيست. ولم يُجرؤ بعد على طرح أسئلة مفصلية حول جدوى الاستمرار في العمل البرلماني ضمن منظومة باتت تعرّف الفلسطيني كتهديد قومي. ولذا فإن استدعاء خطاب التجمع، دون مساءلته وتطويره، يُبقي المشروع السياسي الجديد في دائرة التكرار لا القطيعة.
ما بعد السابع من أكتوبر لا يتطلب فقط موقفًا جذريًا من خطاب الاندماج، بل مراجعة نقدية حتى لخطابات المعارضة القومية، وفحص مدى صلاحيتها وقدرتها على الفعل في واقع تحوّل فيه الفلسطيني في الداخل من مواطن من الدرجة الوظيفية إلى خطر سيادي في نظر الدولة. هذه لحظة تستوجب التجاوز لا الاكتفاء بالاستعادة.
ختامًا، بعد سبع سنوات على قانون القومية وما بعد السابع من أكتوبر، كشفتا القشرة الرقيقة التي غطت على عمق الصراع. لم نعد أمام دولة تسعى إلى دمجنا، بل أمام دولة تسعى إلى “تحييدنا”، وأمام خطاب داخلي يجب أن يتحرر من أوهام الاندماج الزائف.
المستقبل لا يُصنع بالرهان على نوايا نظام أعلن أنه لا يرانا شركاء ولا بشر، بل بالرهان على مشروع وطني يعرف موقعه بدقة، ويتعامل مع ذاته كشعب أصيل صاحب حقوق جماعية، لا مجرد مجموعة خدماتية تطالب بنصيب أكبر في دولة لا تعتبرها أصلًا جزءًا من معادلتها القومية. إن إعادة تعريف المعركة باتت ضرورة وجودية، لا خيارًا تكتيكيًا. بين من يواصل المطالبة بما أُغلق بابه، ومن يصوغ خطابًا يرتكز إلى وعي سياسي وهوية غير قابلة للتفاوض، سيتحدد موقعنا في قادم السنوات.