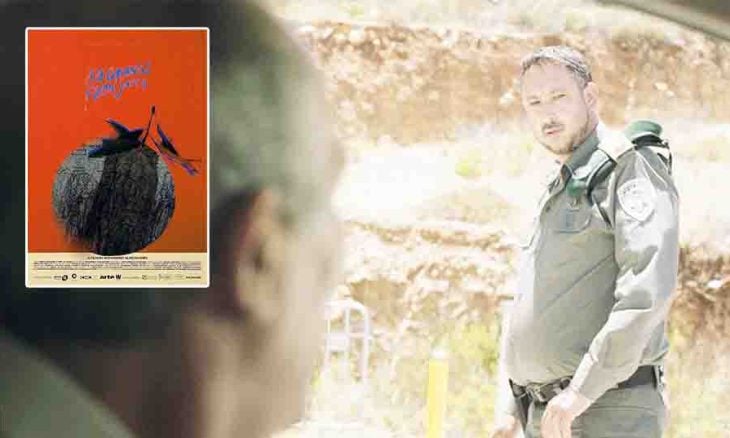في حضرة الضمير: حين وقفت طالبة في وجه العالم!

مريم مشتاوي
في إحدى قاعات التخرج المزينة بالابتسامات والعباءات الأكاديمية، وفي لحظة كان يفترض أن تكون احتفاء بالنهاية وبداية جديدة، وقفت فتاة شابة، نحيلة الصوت، عظيمة الموقف. لم ترفع يدها للسلام، ولا لتلقي التهاني، وإنما رفعتها لتقول الحقيقة.
لم تكن سيسيليا كولفر، خريجة جامعة جورج واشنطن، بحاجة إلى أن تصرخ لتسمع، فقد نطقت كلماتها بصوت القلب، َوبصوت الضمير. «أشعر بالخجل من معرفة أن رسوم دراستي تستخدم لتمويل إبادة جماعية». لم يكن ذلك مجرد رأي سياسي، أو تعبيراً غاضباً من طالبة متمردة، وإنما شهادة إنسانية في زمن تخمد فيه الأصوات، وتحرق فيه الكتب، وتدفن فيه الحقيقة تحت ركام المصالح والإعلام المسيّس.
كانت تلك الكلمات بمثابة زلزال تحت قبة الصمت. كأنها أخذت بيد كل من جلس في القاعة، ووضعتهم أمام مرآة ضخمة، عاكسة لما ينفقونه، يدعمونه، ويصمتون حياله. فحين يتحوّل التعليم إلى تجارة، وحين تستخدم الجامعات كقنوات لتمويل الحرب، يصبح الخريج، من حيث لا يدري، شريكاً في جريمة لم يختر أن يكون جزءاً منها.
قالت الطالبة الشابة ما عجز عنه كثيرون من أساتذة، وكتاب، ومفكرين. قالت إنها تخجل من كونها تنتمي لمؤسسة تنسج علاقاتها مع دولة تمارس الاحتلال، وتبارك الإبادة، وتدفن الطفولة في تراب غزة دون أن يرمش لها جفن. رفضت الصمت، وهي تعلم أن الصوت في هذه اللحظة هو مقاومة. والسكوت تواطؤ.
ما الذي يجعل طالبة في مقتبل عمرها تتجرأ على قول ما لا يقال، في لحظة قد تكلّف فيها الحقيقة ثمناً باهظاً؟
الإجابة لا تكمن فقط في جرأتها، بل في حجم الألم الذي وصل إلى الضمائر الصاحية من تحت أنقاض المجازر. هي لم تكن فلسطينية الدم، لكنها كانت فلسطينية الإحساس. لم تكن عربية اللسان، لكنها نطقت بلسان العدل. وهذا ما لا يفهمه المستفيدون من الصمت… أن القضية لم تعد جغرافيا، إنما ضمير.
بدت تلك الفتاة، وسط الزي الأكاديمي الأزرق، وكأنها ترتدي عباءة الحقيقة.
وفي عالم تعود على المجاملة، كانت صراحتها فضيحة للجميع: للجامعة، للنظام الإمبريالي، وللطلبة الجالسين خلفها الذين كانوا يهتفون بعبارات مؤيدة.
قالت: «لن يتحرر أحد منا حتى نرفض نحن هذه الجرائم» .
وكانت بذلك تعلن أن الحرية لا تتجزأ، وأن الدم إذا سفك هناك، فإن الإنسان يموت هنا. كان خطابها درساً في الأخلاق قبل أن يكون موقفاً سياسياً.
في زمن يتم فيه طرد الطلبة لفكرة، ومعاقبتهم لصوت، وتخوينهم لحلم، جاءت سيسيليا لتقول: لست خائفة من الفصل، إنما من الصمت. ولست نادمة على خسارة فرصة، وإنما على خسارة المبادئ.
«أشعر بالخجل»
عبارة قالتها وهي ترتجف. لكن تلك الرجفة لم تكن نتيجة خوف، وإنما من ثقل الحقيقة. كأنها كانت تعتذر نيابة عن جيل كامل، ساهم من حيث لا يدري في استمرار المجازر. وكأنها تنطق باسم طفل قتل وهو يردد الحروف الأولى من اسمه. أو طبيب انتُزع من تحت الأنقاض وهو يحتضن سماعته، أو أم حملت بقايا طفلتها في كيس، لأن لا شيء آخر بقي. في كلمتها، لم تكن تطلب تعاطفاً، وإنما صحوة ضمير.
قالت: «علينا أن نعيد النظر في تهاوننا».
نعم، فالكارثة لا تبدأ بالصواريخ، بل بتهاون الضمائر. ولا تقصف المدن فقط من الجو، بل من الغفلة، من السكوت، من التبرير، من خلط المفاهيم حتى تغدو الضحية متهمة، والمجرم شريكاً في الحوار.
كانت خطيبتنا تحمل ورقة، لكنها كانت تقرأ من قلبها. وحين قالت: «نحن مَن يدفع ثمن هذه الفظائع» لم تكن تقصد الدولار، بل الصمت، والعار، والمستقبل الذي يبنى على أشلاء الأبرياء.
أرادت أن تقول: لا نريد شهادات ممهورة بالدم. ولا نريد وظائف تنمو فوق المقابر. نريد علماً ينقذ، لا يشرّع القتل. نريد جامعات تنتمي للإنسان، لا للممول.
ذلك اليوم لم يكن يوم تخرج، بل يوم ولادة ضمير. وفي مشهدها، بدا الحفل الجنائزي لحضارة تخلت عن معناها، حين تصبح الشهادات بلا شرف، والتميز بلا قيم. لم يكن ما فعلته سيسيليا بطولة، إنما كانت الإنسانية في أبسط صورها.
أن تقول «لا» في زمن الـ «نعم» المعلبة.
أن ترفض ما اعتاد عليه الجميع، لأنها تعرف أنه خطأ.
ستنسى الكاميرات أسماء كثير من المتخرجين، لكن سيسيليا ستظل علامة.
علامة في زمن اختلطت فيه الحقائق، وصار من يفضح الإبادة يدان، ومن يبررها يكافأ. لكن التاريخ لا يرحم.
لغة الضمير، وإن تأخرت، ستنتصر.
ففي ختام المشهد، لم تكن تلك الفتاة وحدها على المنصة. كانت فلسطين معها.
كانت غزة تنطق على لسانها. وكانت الإنسانية كلها تصفق لها، لا بحرارة، بل بدموع. وسيبقى صوتها، في زمن الجدران، نافذة.
وفي زمن العتمة، شمعة.
وفي زمن الغياب، ذاكرة… لا تنطفئ.
صرخة أم من ليبيا لا يسمعها أحد
التراب ظل دافئاً، والجسد الذي غادره قبل قليل ترك أثره في كل ذرة.
الأم انحنت فوق الرماد، لم تفتش عن أثر، بل حاولت أن تعيد بناء الذاكرة من بقايا الجسد الذي غاب عن العين وبقي حاضراً في القلب.
صرختها لم تتجه إلى السماء، بل وجهتها إلى الأرض وهي تقول:
«بنتي… يا حبيبي… خلولي قبرها نزورها.»
في طرابلس، خطفت مجموعة مسلحة الفتاة رؤية الأجنف، ابنة الستة عشر عاماً. الأم طالبت بالحقيقة، ولكن الذين يقفون خلف الخطف قدموا الرماد بدل الإجابة.
الجناة أحرقوا الجسد. البراءة اختفت وسط النار، وتركت العائلة تواجه الرائحة الثقيلة وحدها، دون جسد، دون ملامح، دون وداع. الأم جلست إلى الرماد، الذي خلفته النار في حضنها. احتضنته كما تحتضن الأمهات أبناءهن في الأعياد، لكن العيد غاب، والحياة توقفت في اللحظة نفسها. ما حدث لم يدمّر حياة عائلة فقط. أخلاق كثيرة سقطت. الدولة غابت، والسلاح استعرض قوته، والناس التزموا الصمت. أشخاص كثر وقفوا أمام الجريمة واستخدموا هواتفهم لتصوير المشهد.
لم يتحرك أحد، ولم يوقف أحد النار، بل انتشر الفيديو مثل مشهد في فيلم.
قالت الأم بصوت هادئ وغاضب:
«يعطوني جثتها… وهما يقتلو فيها، وعاطيينها للأسود» .
الكلمات خرجت منها وكأنها تلقّت الطعنة من جديد.
رؤية لم تتحول إلى جثة فقط، بل أصبحت عنواناً في شاشة هاتف:
مفقودة، محروقة، مدفونة.
رؤية جاءت من جيل نشأ وسط الخوف والانهيار. حلمت بصورة لها على هاتف والدتها، حلمت بعيد ميلاد بسيط، حلمت بحب صغير. لكن الواقع خطف كل ذلك. البلاد لا تمنح الفتيات فرصة الحلم، فالحلم يتوقف عند أول رصاصة، وتتحول كل بنت إلى اسم في خبر عاجل. الأم وقفت على ما تبقى من تراب، طلبت قبراً فقط.
لم تطلب قانوناً، ولم تنتظر محكمة. قالت وهي تجهش في البكاء:
«ما تحرمونيش باهي من قبرها» .
طلبت مكاناً للبكاء، لا مكاناً للثأر. انكسر فيها كل شيء، ولم يبق إلا صوتها.
من يعيد لها صوت ضحكتها؟ من يعيد لها المساء الذي تأخر فيه العشاء؟ من يعيد لها رائحة شعر ابنتها بعد الاستحمام؟ من يعيد لها الحياة؟ ومن يعيد لنا معنى أن نكون بشرًا؟
أشخاص أعلنوا أن الجاني اسمه أبو القاسم ابن غنيوة. قالوا إن التحقيقات انتهت.
لكن لا شيء بدأ. العدالة لا تنحصر في اسم، ولا تكتمل بإغلاق ملف. العدالة تعني ألا تضطر أم إلى جمع رماد ابنتها في كيس. الصور التي انتشرت أظهرت وجه الأم، لم يطلب الشفقة، بل فضح الواقع كله. الناس شاهدوا الجريمة، لم يتحرك كثيرون، وبعضهم نشر المشهد وكأن شيئًا لم يحدث. رؤية لم تغيبها النار فقط، بل غابت معها أمة كاملة. البنات يذبحن أمام الأهل، والحياة تمضي، والمجتمع لا يتحرك. الأم جلست على الأرض، تمسكت ببقايا الحضور، خاطبت غائبة تعرف أنها لن تعود.
هتفت: «خلّولي قبرها… نزورها.» كررتها مثل دعاء أخير في ليل طويل. أمسكت بالكلمات القليلة التي بقيت، وناجت بها ابنتها. لا أحد وقف بجانبها، ولا أحد خفف عنها. العدالة غابت، والقاتل ظل حراً. التراب بقي الشاهد الوحيد، والأم حملت الذاكرة، وواجهت العالم وحدها.
رحم الله رؤية.
ورحمنا من هذا الصمت.
كاتبة لبنانيّة