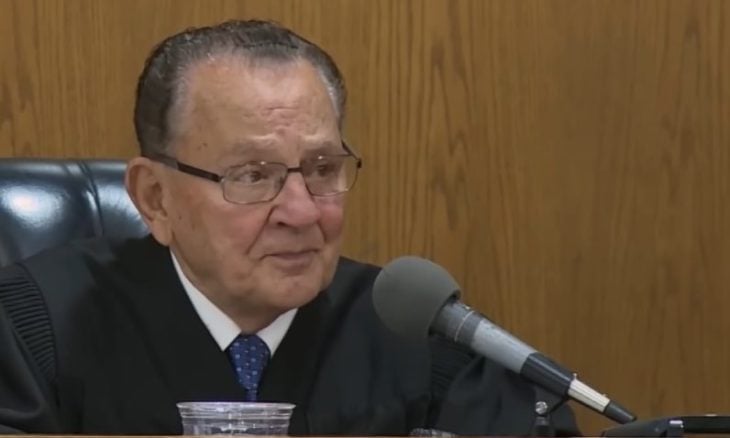حين يتحول الجمال إلى خبز.. والدم إلى لوحة!

مريم مشتاوي
في بيت صغير تضيق جدرانه بالهموم، جلس الفنان التشكيلي، وهو يحاول استخراج القوة من ضعف خساراته. خساراته كثيرة جدا.. ملونة جداً تسكنها أرواح طيبة، ولكنها اليوم صامتة تنتظر نهايتها.
عيناه مثقلتان بتجاعيد السنوات، ويداه اللتان اعتادتا أن ترسما الجمال ترتجفان أمام قرار صعب للغاية يكاد أن يكون أصعب قرارات حياته.
هناك أمامه تتكدس لوحات أنفق عليها أكثر من عشرين عاماً من العمر. كل خط فيها امتداد لروحه، وكل بقعة لون توقيع من قلبه. لم تكن مجرد ألواح خشب وألوان زيتية، كانت ذاكرة كاملة: طفولة غابت في الأزقة، مدن مرّت ولم يعشها، وجوه أحبها وافترق عنها، وأحلام أراد أن يورثها لأولاده كأيقونات من صبر وحرية.
الجوع لا يفهم لغة الفن. والبرد لا يرحم قلب أب يرى أطفاله يرتجفون تحت أغطية رقيقة. في تلك اللحظة صار السؤال حاداً كحد السكين: أيهما أحق بالبقاء؟ اللوحة التي تحمل من روحه الكثير، أم ابن قلبه الذي يحتاج دفئاً ورغيفاً؟
اقترب من كومة اللوحات. قلب إحداها بيده، تذكر كيف سهر الليل ليصنع من خطوطها حكاية عن حصار مدينته. لمس أطرافها، فارتعشت أصابعه كأنها تودع صديقاً عزيزاً. ثم مدّها نحو النار. اشتعل الخشب بسرعة، وتعالت ألسنة اللهيب، واختلطت رائحة الزيت المحترق بدخان كثيف. كان يسمع الألوان وهي تتقشر وتتحول إلى رماد. كان يسمع صراخ سنواته وهي تتبخر أمامه. ومع ذلك ظل ثابتاً، كمن يعرف أن التضحية قدر لا مفر منه.
لم يكن يحرق الفن، كان يحرس حياة صغيرة تتنفس حوله. كان يحمي نوم أطفاله من قسوة الشتاء ومن معدة فارغة لا تعرف سوى وجع الانتظار. النار التي التهمت اللوحة صنعت دفئاً في الغرفة. اللهيب الذي أذاب الألوان أشعل شعلة حياة قصيرة لكنها كافية لليلة أخرى.
جلس ينظر إلى أطفاله وهم يقتربون من الموقد، تتورد وجوههم قليلاً، ويبتسمون للحظة. شعر أنّ اللوحة لم تحترق، إنما تحولت إلى شكل آخر من الحياة. المعرض لم يفتح في قاعة أنيقة، إنما في عيون صغيرة لمعت بالدفء. اللوحة لم تعلَّق على جدار، لكنها ارتسمت على وجوه أبنائه الذين ناموا أخيراً بلا ارتجاف.
سأل نفسه: هل هذه أكبر لوحة رسمتها؟ لوحة غير مرئية، ألوانها من دموعه، وخطوطها من قسوته على نفسه حين قدَّم أبناءه على أحلامه.
في تلك اللحظة أدرك أنّ الفن ليس ترفاً كما يظن البعض. الفن خلاص، لكن الخلاص أحياناً يغيّر وجهه. الفن قد يتحول إلى نار تطهو حساء هزيلاً، أو إلى رماد يدفن في الموقد، لكنه يظل فناً لأن المعنى لا يحترق.
الفنان التشكيلي في النهاية إنسان يواجه ما يواجهه شعبه. لم يعد يميز بين حياته الخاصة وحياة شعبه. فكما يحاصر وطنه بين الجوع والحرمان، يحاصر هو بين الفن والرغيف. كما تحرق الأحلام على أبواب المخيمات، تحرق لوحاته في مطبخه الصغير.
اللوحات التي حلم أن تسافر إلى أوروبا لتقف في صالات كبرى وتقدّم بلغات أخرى، لم تتجاوز جدران بيته. لكنها صارت شهادة أكبر من أي معرض: شهادة على زمن اختصر القيم العليا في رماد يومي، وحوّل الجمال إلى وسيلة طهو.
تذكر أول مرة أمسك فيها فرشاة. كان طفلاً حين أعطاه أستاذه في المدرسة علبة ألوان صغيرة. رسم شجرة، فصفق له أصدقاؤه. يومها شعر أن الفن خلاص من الضيق، وأن اللون أقوى من أي قيد. كبر الحلم معه، وصار الفنان الذي يعرفه الجميع في الحي. أقام معارض صغيرة، وعلّق لوحاته في المقاهي والبيوت. كان يحلم أن يعلّقها يوماً في باريس أو برلين. لكن الحياة خبأت له امتحاناً آخر: أن يحرق بنفسه ما أحب.
لم يندم، لكنه نزف من الداخل. قال لنفسه: «لوحاتي تعود إليّ رماداً، لتصير طعاماً ودفئاً لأطفالي. هذه دورتها الأخيرة، وهذا هو قدرها».
ورغم ذلك، كان يعرف أن المعنى لم يختف. اللوحات التي احترقت صارت حديث الناس، وصورته وهو يبكي أمام النار تحولت إلى لوحة أعمق من كل ما رسم. الفن الذي ظنه انتهى، استحال صرخة عالمية: فنان فلسطيني يضطر إلى حرق لوحاته كي يطهو لأطفاله. أي مأساة أبلغ من هذه؟
سيأتي يوم يعرف فيه أولاده الحكاية. سيجلسون ويتذكرون أنّ أباهم قدّمهم على نفسه، وفضّل دفئهم على أحلامه. سيفهمون أنّه صنع من لوحاته جسراً يعبرون عليه نحو حياة أقل قسوة. سيتعلمون أن اللون لا يموت، إنما يتنقل بين أشكال مختلفة: بين نار ورغيف، بين دخان وحلم، بين لوحة احترقت وصورة لن تغيب عن ذاكرة الناس.
الفن حين يحرق لا ينتهي. يتجسد من جديد في كلماتنا، في صورته الباكية، في ضمير كل إنسان يشاهد قصته. ربما لم يدخل قاعات العرض الكبرى، ولم تصفق له الصالات المزدحمة، لكنه دخل قاعة الوجدان الإنساني، حيث اللوحات لا تحتاج جدراناً ولا أضواء، تحتاج صدقاً يختصر معنى الوجود.
هكذا كتب لفناني غزة أن يحرقوا لوحاتهم كي يدفئوا أولادهم…أما فنهم فسينهض من رماده ليحيا فينا جميعاً.
الطفل الصامت
يجلس الطفل على الأرض في خيمة يضربها الهواء، وملابسه ملطخة بدمه الطري. وجهه الصغير غطّته حمرة الجرح، كأن الحياة نزفت منه قبل أن تكتمل ملامح الطفولة. ومع ذلك، يجلس في صمت عجيب، صمت لا يشبه الأطفال، إنما حكمة العجائز حين يختبرون قسوة القدر.
عيناه نصف مغمضتين، كأنهما نافذتان على غيب بعيد. لا يصرخ، لا يطلب شيئاً. يعرف أن صوته لن يوقف القصف، وأن الدموع لن تعيد البيت المهدوم. يجلس في هدوء مهيب، فيما دماؤه ترسم لوحة على الأرض، لوحة تفوق كل ما يمكن للفن أن يبتكره، لأنها مرسومة بلحم حي ووجعٍ نازف.
ذلك الطفل لم يخلق ليحمل هذا الألم، غير أنّه ولد في زمن جعل الطفولة ساحة حرب. اختصر بجسده الصغير حكاية غزة كلها: أرض تتلقى الطعنات وتبقى ساكنة، جسدها ينزف وصوتها يغيب في ضجيج الصمت.
الطفل لا يعرف معنى الكلمات الكبيرة: سياسة، مفاوضات، هدنة. يعرف فقط أن جسده الصغير تحوّل إلى ساحة صراع. كل جرح في رأسه حكاية عن صاروخ سقط، وكل نقطة دم تسيل من وجهه توقيع على وثيقة غياب العالم.
كان يمكن له أن يصرخ حتى يملأ المكان، أن يعلو صوته بالأنين، غير أن الألم أكبر من أن تترجمه الكلمات. الصمت تحوّل إلى سلاح خفي، احتجاج أعمق من أي عويل.
كأنه يقول بعينيه: خذوا خطاباتكم وأسلحتكم، واتركوا لي صمتي. ففي هذا الصمت تسكن الحقيقة.
جلس الطفل ثابتاً كحجر في وجه العاصفة. لم يتحرك كثيراً، لم يتشبث بيد أحد، لم يسقط مغشياً عليه. بقي جالساً، جسده الصغير يرفض أن يستسلم حتى للجرح النازف.
من يراه يدرك أن غزة لم تعد تحتاج إلى الكلام. أطفالها يتكلمون بصمتهم، بملامحهم النازفة، بدمائهم التي صارت لغة يفهمها الجميع وإن تظاهروا بعدم السماع.
كاتبة لبنانية