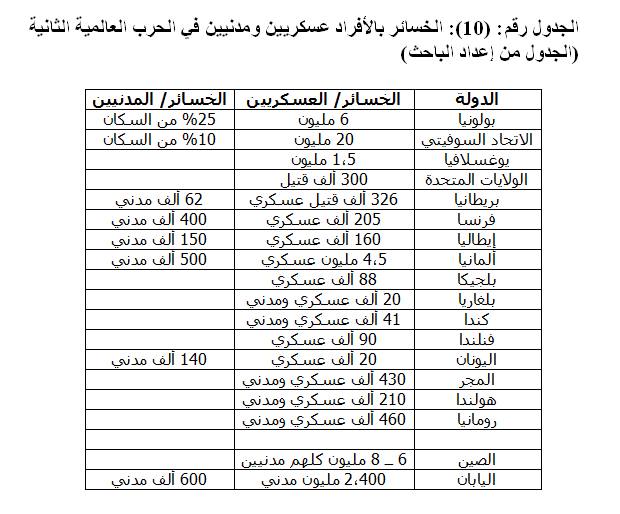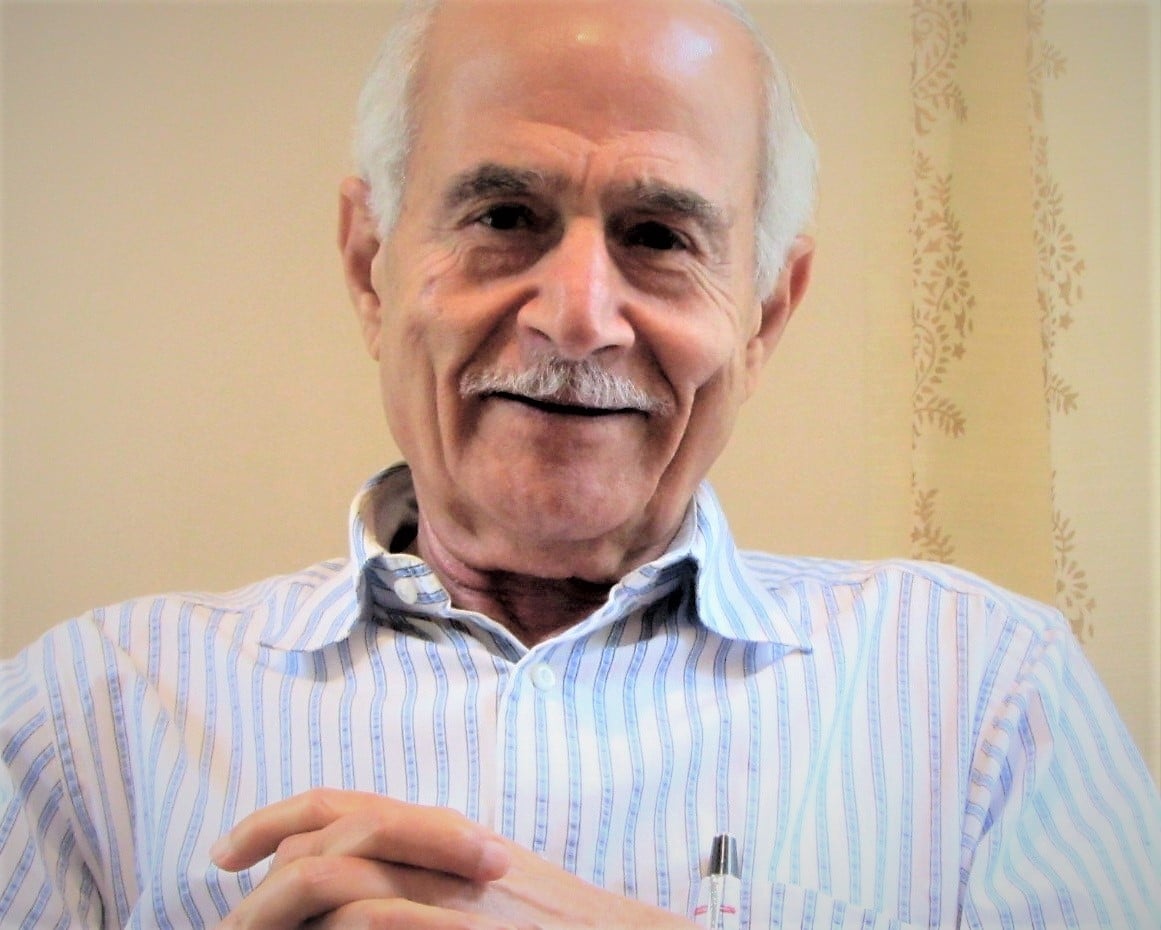ثقافية للولاءات في البنى القرابية العربية بقلم الدكتور عزالدين دياب
بقلم الدكتور عزالدين دياب

قراءة أنثروبولوجية ثقافية للولاءات
في البنى القرابية العربية
د.عز الدين دياب
تشي المقدمة بأنَّ سلامة ما ستقوله بشأن قراءة الولاءات في البنى القرابية العربية، يُمَكِّنها من سلامة النتائج التي يراد الوصول إليها.
كما تشي أيضاً بأنَّ قراءتها ستنهض على أربعة مفاهيم، يأتي ذكرها لاحقاً، انطلاقاً من يقينها المنهجي، بأهمية المفاهيم في التفسير الأنثروبولوجي للظواهر البنائية المتعينة داخل البناء الاجتماعي، والمتعايشة فيه، وفق قانون التأثير المتبادل بينها، وبحكم الوظائف التي تمارسها داخل هذا البناء، ومالها من صور، وتجليات، وممارسات، وردود أفعال في الحياة الاجتماعية اليومية.
وتنفتح المقدمة على سؤال فرضي يقول: هل مازالت للقربى وظائفها ودلالاتها في البنى القرابية العربية الراهنة التي تراها القراءة تشكل سكناً شرعياً للقربى، على اختلاف مضامينها ومكوناتها، وما يتعايش حولها من عصبيات تبدأ بقربى النسب «الدم»، وتنتهي بقربى العقائد. والانتماءات السياسية، بعد أن تمر بقربى الجهة والحي، والدين، والمذهب والمهنة، والحزب، النادي الرياضي.. الخ([1])..
وتجد المقدمة لزاماً عليها أن تُؤكد بأنَّها لا تريد أن تقيم مقاربة مع النظريات/ المدارس الأنثروبولوجية التي قالت قولاً متبايناً بشأن المفاهيم، كما لا تريد أن تَحْشُرَ القراءة في شرح مفَصل للمفاهيم، قوامه النَّزعة الأكاديمية. وإنما ستكتفي بما قلَّ ودلَّ عن مستويات التساند الوظيفي بين المفاهيم التي قالت بها تلك النظريات، اعتماداً على ما بينها من مشتركات، ومحددات ثقافية اجتماعية، تمارس وظائفها في تنشئة الشخصية الاجتماعية العربية المتعينة في الواقع العربي الراهن، المحكوم إلى مستويات من التباين الاقتصادي /الاجتماعي بين أقطاره.
والمقدمة بإشارتها إلى التساند الوظيفي بين مضامين المفاهيم، تريد أن تؤكد أنَّ المحددات الثقافية /الاجتماعية الموجودة في النسق الثقافي العربي في أبعاده المحلية، والوطنية، والقومية، تشكل المشترك في تنشئة الشخصية العربية، مستلهمة قول العلامة العربي ابن خلدون في مقدمته: الإنسان ابن عوائده([2]).
في المفاهيم
تعني المفاهيم في الأنثروبولوجيا بأنَّها حُزْمة من الرموز والأحداث التي تملك خصائص مشتركة فتجعلها متقاربة، يمكن الدلالة عليها باسم محدد، ورمز معين، ويُعَرِّفها معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية بأنها([3]): «…. الماهية المجردة عن المادة الشخصية، وعن الأعراض الملازمة للمادة كالمقدار، واللَّون، والصَّوت، والرَّائحة، والطَّعم، والحرارة، والبرودة»…
إذاً، المفهوم مصطلح تجريدي يشير إلى مجموعة من الحقائق والأفكار المتقاربة.. إنَّه صورة ذهنية عن موضوع مُعَيَّن يستطيع الإنسان تصوره. هو أشبه بخارطة للقضايا والأحداث التي يكوِّنها ويعيشها الناس في حياتهم اليومية. ولذلك يشكل وحدة تحليل لإدراك ومعرفة حقائق الظاهرة البنائية، التي يشكلها الباحث الأنثروبولوجي اعتماداً على حواسه الخمس، ثم يعيد وضعها كفرضيات وأسس لتفكيره، وتمحيصه ، وتحليله للظاهرة البنائية التي يدرسها، تمهيداً لتفسيرها ووضع المعاني السليمة لها، التي تشكل خطوة منهجية إلى الأمام في وضع الحلول لها.
1 ـ العائلة: سنحرص أن يأتي مضمون مفهوم العائلة متطابقاً مع ما يقوله الناس في القرية، والخيام، والأحياء الشعبية (الحارات) في المدن، وفي البلدات الصغيرة، وما يضعون له من معانٍ تعكس مكوناته الاجتماعية، وتظهر روابط القربى، وتسلسلها بين هذه المكونات، ومايماشيها ويتضافر معها من عصبيات تشير، على نحو وآخر إلى الولاءات، وما تحكمها وتقودها من قيم وأعراف كبرى، وما جرى عليه الناس في حياتهم اليومية..
فالعائلة لازالت في كثير من البنى الاجتماعية تشكل الوحدة الرئيسة، وخاصة في الريف، والبلدات الصغيرة، والأحياء الشعبية في المدن العربية، وإذا كبر حجم العائلة، تتحول إلى «بيت» أو «دار» أو «فخذ وبطن»..
ومن العائلات مايعيش أفرادها في دار «حوش» واحد، أو مساكن متجاورة، ويشتركون في كثير من المناسبات الاجتماعية والدينية، ولهم مضافتهم التي يأتي إليها الرجال لقضاء الوقت، والتشاور حول أمورهم اليومية، وشرب القهوة المرة، والشاي، ومزاولة بعض الألعاب، مثل «المنقلة». وتنقسم العائلة إلى أسر زوجية، وأسرة مركبة، من الزوج والزوجة والأولاد المتزوجين وغير المتزوجين.
2 ـ القربى:
ويقصد بها صلة النسب، وقربى الدم التي تتكون من جانبين: العضوي/ البيولوجي، والاجتماعي، وهذا الأخير ينمو وتتسع دائرته، وعلاقاته، وروابطه بناء على تعامله مع الجانب العضوي، الذي يؤسس لنظام اجتماعي ينسق العلاقات الاجتماعية بين مستويات القربى، بحيث يعيشون في بقعة معينة من الأرض، إما داخل قرية، أو حي، وتسمى باسم العائلة التي ينتسب أفرادها حكماً إلى الجد المؤسس، وتؤلف مكوناتها البنائية القرابية بناءً اجتماعياً تراتبياً حسب مستوى القربى، التي يحددها الاقتراب والابتعاد عن الجد المؤسس([4]) «فنظام القرابة إذن نظام متسق من العلاقات يرتبط فيه الأفراد بعضهم ببعض بشبكة من الروابط والصلات، وعن طريق هذه العلاقات والروابط ذاتها، وليس عن طريق النظام نفسه تظهر الجماعات القرابية: الأسرة، والأسرة المركبة والعائلة»
وبناء على مستويات القربى تتكفل الأسرة، والأسرة المركبة، والعائلة، بحاجات أفرادها وفق جدلية الالتحام والانقسام في الولاءات بين تلك المستويات. التكافل الذي تقوم به عادة المؤسسات في المجتمع المدني.
وتظهر دلالات التكافل والتضامن القرابي في أكثر من نشاط وفاعلية اجتماعية بسيطة ومعقدة، مثل التعاون في مجال الفلاحة، والزراعة، وجني الموسم، وبناء البيوت وترميمها، والمشاركة في تكاليف الأعراس، وفي الدفاع عن أمن العائلة وهيبتها، والأخذ بالثأر، وحماية العائلة من غدرات الزَّمان، وفض المنازعات التي تقع بين مستويات القربى وتلزم القربى الجماعات القرابية القيام بالأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمليها حياتهم اليومية. وتعايشهم مع أسر وعائلات، وبيوت، وبطون أخرى..
وفي سياق التحليل الأنثروبولوجي للولاءات، فَإِنَّ من أهم الأنشطة التي تمارسها العائلة: التنشئة الاجتماعية لأفرادها، حيث تلقنهم، بل قل تثقفهم من صغرهم على الولاء للأقارب، ومناصرتهم في السراء والضراء، والذود عن اسم العائلة وشرفها، وهيبتها، وقيم الرجولة والبطولة، والشجاعة، وإطاعة الصغير للكبير في إطار مصلحة العائلة، وغرس قيم النصرة والتعصب لها، حيث تعد هذه القيمة من القيم الكبرى في ثقافة العائلة، وما ينتسب لها من مستويات قربى. الأمر الذي يؤسس في العائلة وامتداداتها التراتبية إلى وجود عقلية التعصب للعائلة والاستجابة الطوعية/ العائلية لقيم المناصرة، وفق الفهم الشائع والمتداول: أنصر أخاك ظالماً أومظلوماً، الذي تحوَّل إلى قيمة رئيسه لها طابعها العائلي وذروته التعصب للرمز / الجد المؤسس في سياق تسلسل مستويات القربى وعصبياتها.
وتجب الإشارة إلى أنَّ القيم الكبرى التي تُشَكِّل محددات ثقافية للتنشئة الاجتماعية في العائلة العربية تعرَّضت لتغيرات بنيوية وقيمية كثيرة رافقت وزاملت التغيرات التي حدثت في القاعدة المادية، وتغيَّرت أولوياتها داخل اهتمامات الشخصية الاجتماعية العربية.
ومع ذلك فمن الملاحظ أَنَّ المناصرة بوصفها قيمة كبرى، ظلَّت تمارس وظائفها داخل البنى الاجتماعية العربية، وإن جاءت تحت عناوين مختلفة، وتأثيراً متبايناً في المدن، والبلدات الصغيرة، والقرى، حتى إنها سحبت نفسها إلى منظمات المجتمع المدني مثل الأحزاب، والنقابات، والمنظمات الاجتماعية، والنوادي والجمعيات الخيرية والمذهبية، وبقيت تَشْغلُ دورها ومهامها في هذه البنى الجديدة انطلاقاً من أن وظائف عصبية القربى، أياً كان مضمونها، تمارس دورها في المحافظة على بنية القربى، واستمرارها، والمواءمة بين سلوك الفرد في هذه البنية وأنماط السلوك الثقافية المقررة اجتماعياً، وهذا معناه أنَّ دور تلك العصبيات، لا ينكر في المحافظة على كيان البنى القرابية، كما نلاحظه في حوادث الثأر والتضامن بين ذوي القربى، وفي المواءمة بين دور الفرد في المجتمع، ودوره في البنى القرابية، حيث إنَّ هذه المواءمة تصل إلى هذا المستوى بفعل قوة التفاعل المباشر بين أبناء البنى القرابية، وتشابك العلاقات الشخصية.
وقد دلتنا معايشة البنى القرابية والملاحظة المباشرة لحياتها وعلاقاتها الاجتماعية اليومية أن قيم القربى أخذت تعيد إنتاج نفسها في كثير من بقاع الوطن العربي بلبوس جديد في البنى القرابية العائلية، والعشائرية، والجهوية، والحزبية… الخ.
3 ـ الولاءات:
القول في الولاءات يبدأ من خلال تعريفها في المعجم الوجيز([5]) (الولاء) القرابة، والنصرة والمحبة (الولاية) القرابة. و (الخطة والإمارة) و ـ السلطان. و(البلاد التي يتسلط عليها الوالي) (الوَليُّ) كلُّ من وَلِيَ أمراً أو قام به.
و ـ النّصيرِ. و ـ : المحب. و ـ: الصَّديقُ. و ـ : المُطيع. يقال: المُوَْمن. وليَّ الله (ج) أولياء.
والولاء من وجهة نظر الانثروبولوجيا الثقافية لا يبتعد عن معناه ودلالاته في اللغة. فهو يعني التآزر والتناصر بين أعضاء الوحدة القرابية والقائم على الاعتماد المتبادل في الأنشطة والواجبات، كما تمليه قيم القربى وأعرافها وأهدافها المشتركة.
ويمارس الولاء، منقاداً ومُوَجَّهاً بقيم القربى التي تحكمه تربية أفراد الأسرة، وكافة مستوياتها القرابية على مناصرة ذوي القربى، والتضامن معهم، والدفاع عنهم إذا لزم الأمر، والاستجابة لكافة مستحقات الولاء.
ويُعْرَفُ الولاء بقدرته على تنمية وازع القربى، وتهذيب ما يقرره من انتماءات، واستجابة أفراد الدائرة القرابية حسب تسلسل مستوياتها، ووضع إمكاناتهم وقواهم في إطار أمنها وهيبتها، وقُوَّة شوكتها.
والحقُّ أنَّ الولاءات لا تُفهمَ كحقائق في سياق الحقوق والواجبات والالتحام والانقسام إلاَّ إذا أخذناها في نسق روابط القربى، وتسلسل مستوياتها الذي يقرر بدوره تسلسل مستويات العصبية وولاءاتها في الالتحام والانقسام، الذي يجسده المثل القائل: أنا وأخي على ابن عمي، وأنا وابن عمي على الغريب، وما يُساكِنُهُ من التزام وإلزام وواجب بالولاء لذوي القربى.
إذاً؛ فالولاء يقوم بدوره ووظائفه في المناصرة بين الأخ وأخيه، وبين الأخوة وأبناء العمومة، ومن ثم بين أعضاء وأفراد الوحدة القرابية ضد القريب.
وَثَمَّةَ تجليات لولاءات المُناصرة والمفاخرة والتضامن تظهر في كثير من المناسبات الاجتماعية خلال الأنشطة التي تقوم بها وتمارسها الوحدة القرابية في حياتها اليومية، سواء أكان ذلك في نشاطها الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو السياسي، حتى إن الزواج الداخلي بين أبناء وبنات العم والأقارب يعد أحد أشكال التعبير عن دور وظائف الولاءات، والاستجابة لها.
حسبنا في هذا الإطار أن نشير إلى أنَّ الولاء يتحول إلى أدوات تحليل للعلاقات الاجتماعية، وما يتضايف معها من سلوك اجتماعي.
ولذلك، إذا أردنا فهم الجدل الاجتماعي في الحياة الاجتماعية للمجتمعات الأهلية القرابية، وما تقرره من وازع في الالتحام والانقسام، وفي المناصرة، والمؤازرة، وما يتأتى عنها من ولاءات لابد أن نقرأ نظام للقربى وآلياته في الضبط الاجتماعي، وتجلياته داخل البناء الاجتماعي، وما يقرره من روابط وواجبات قربى، تتوازعها مستويات القربى المحكومة أصلاً إلى قيم وضوابط تحدد طابع ومضمون وظيفة الولاء في سلوك الأفراد والدائرة القرابية الأولى التي يبدأ منها، والدائرة التي ينتهي بها.
إذاً، الولاءات في البنى القرابية مالكة لوظائف وأدوار تتماهى مع مستويات القربى، وفق المثل السالف الذكر، وحصيلته في وحدة وانقسام البنى القرابية، ومن ثم تَعُّينهِا في البناء الاجتماعي القرابي، بوصفها وحدات بنائية قرابية التحامية مرَّةً، وانقسامية مرَّةً أخرى، حسب وازع القربى منها.
وحسبنا أن نشير إلى أنَّ المجتمع القرابي له آلياته في ضبط الولاءات وتوجيهها، والمواءمة بين مستوياتها، حسب تسلسل مستويات القربى وعصبياتها، حتى لا يغلب فيها وازع الانقسام على وازع الالتحام، وأهم هذه الآليات القيم الكبرى في المناصرة والمؤازرة، وعناصر الضبط الاجتماعي مثل الحقوق، والواجبات، والالتزامات، والتواؤم… الخ.
وعلى ضوء ما تقدم نسأل هل يمكن تعميم الأفكار السابقة على كل البنى الاجتماعية العربية؛ وهل البنى الاجتماعية الحضرية تتساوى وتتقابل مع البنى الاجتماعية القروية، في الوظائف التي تمارسها عصبية القربى؟ وهل ردود الأفعال على الولاءات واحدة في كل البنى الاجتماعية العربية؟.. للإجابة على هذه الأسئلة، لا بد أن نعرج نحو قصة اختلاف مستويات التطور التاريخي بين الأقطار العربية، وصراع الولاءات وانقسامها. قضية الاختلاف في مستويات التطور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي بين الأقطار العربية حقيقة قائمة في الحياة العربية بحكم تأثير الظروف الداخلية والخارجية التي مرَّت بها هذه الأقطار
ولاشكَّ أنَّ هذا الاختلاف يعود ليصبح سبباً في تنوع الشَّخصيات الاجتماعية الوطنية/ القطرية التي كرَّست التجزئة بعض معالمه.
غير أن هذا التَّنوع بإيجابياته وسلبياته لازال حاضراً جنباً إلى جنب مع كثرة من المشتركات في تكوين وتشكيل معالم الشَّخصية الاجتماعية العربية، وخاصة في الثقافة العربية التي نعنى بها العادات والتقاليد، والقيم، والأعراف والنتاج المادي والروحي والحضاري.
سنفترض أن التنوع والقواسم المشتركة في معالم الشخصية الاجتماعية العربية يعود إلى بنية اجتماعية لازالت رهينة للقيم الكبرى للقربى وعصبياتها، بمعنى آخر لازالت تنتج، وإن بدرجات مختلفة البنى البدوية، والفلاحية والحضرية، المسكونة جميعاً بعصبية القربى، المختلفة في المضامين، والقيم الكبرى، كما أسلفنا، فإنَّ هذا معناه أنها لازالت تنتج الولاءات المحكومة إلى العصبيات المتنوعة.
صراع الولاءات وانقسامها…
خلصنا إلى نتيجة مفادها أنَّ اختلاف درجات التطور التاريخي بين الأقطار العربية، يؤدي إلى تباين وتشابه يتمثل في المحددات الثقافية التي تنتج الولاءات المختلفة والمتشابهة في مضامينها وعصبياتها، والتي تشكل بدورها القاعدة القيمية للتنشئة الاجتماعية، التي تتم داخل الأسر والعائلات والبيوت والبطون العربية… الخ…
وهذا يجاريه من طرف آخر تشابه وتنوع في نزعة استقلال الفرد نسبياً عن محيطه القرابي.. والذي يرافقه في الوقت نفسه تدني في الوحدة البنائية المتجانسة القائمة على عصبية الدم، والجهة، والمذهب، والحزب… الخ، وضعف في وظائف الأعراف، والجزاءات الأخلاقية، حيث تحل محلها علاقات اجتماعية جديدة قائمة على المصلحة الاقتصادية التي تضعف فيها العلاقات الشخصية المباشرة.
ونفترض أن بنية المجتمع العربي في مستوياته المحلية، والوطنية، رغم تدني الوحدة البنائية المتجانسة وصعود النزعة الاستقلالية.. فإنَّها لازالت تنتج وتتعايش مع العصبيات السالفة الذكر. وهذا مفاده أنَّ للثقافة العربية نهجها في عملية التخلي عن عناصر ثقافية قديمة، واكتسابها عناصر ثقافية جديدة. ولنقل كنتيجة خلصنا إليها أنَّ الثقافة العربية تشكل المأوى لكثرة من العناصر الثقافية القديمة مثل العادات، والقيم والأعراف جنباً إلى جنب مع عناصر ثقافية جديدة.
ولاشك أن هذا النهج يجعل الثقافة العربية تتميز بخاصية المحافظة على العناصر الثقافية التي تَمُتُّ بصلات وثيقة للقربة بوصفها خط الدفاع الأول عن البنى القرابية.
ولاشك أيضاً أن الثقافة في حالتها هذه تتحول إلى مركب ثقافي، يقوم على أساس الاعتماد الوظيفي المتبادل بين العناصر الثقافية «القيم» القديمة والجديدة ([6]) «… وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإنَّ الثقافة العربية تحتوي على قيمة الولاء الذي تتعدد مضامينه، ونواهيه، وأوامره، وواجباته، وتختلف محرضاته. فهناك الولاء للأسرة، والأسرة للعائلة، والعائلة للفخذ والبطن والعشيرة، ثم الولاء للوطن، علماً أن وظائف هذه الولاءات مختلفة، إلاَّ أنها تتبادل وظائف مختلفة في كنف صراع المعايير».
وإذا أخذ نا برأي العلم الأنثروبولوجي الثقافي بأنَّ المعايير تشكل قواعد وأنماط وأعراف تحكم السلوك الاجتماعي للفرد، وتقوده بالاتجاه الذي تريده وظائفها، فهي إذاً صاحبة الشأن في أن تحرم وتحلل، وتجيز وتقرر هذا الولاء، أو تردعه وتلغيه الخ… وتطلب من الفرد القيام بأفعال معينة، أو تحرضه وتوحي له القيام بها.
وإذا أخذنا أيضاً برأي علماء الأنثروبولوجيا الثقافية والنفسية من أَنَّ المكان أو المجال الحقيقي لصراع المعايير هو شخصيات الأفراد الاجتماعية، أو قل الشخصيات الاجتماعية المحلية، والوطنية، والقومية، ومن فيها من البشر، فإنَّ صراع المعايير في الثقافة العربية يتجلى في عدة مستويات، أهمها الصراع بين معايير الأسرة والعائلة، والأسرة والعائلة والفخذ… وهؤلاء والعشيرة، وهكذا دواليك إلى صراع المعايير الدينية، والمذهبية، والسياسية، والعقائدية، والجهوية، وأنَّ المكان الحقيقي لهذه الصراعات شخصيات الأفراد والجماعات([7]).
وإذا أخذنا بصحة وسلامة صراع المعايير واعتبرناه سبباً لصراع الولاءات داخل البناء الاجتماعي العربي، على اختلاف مستوياته، فإنَّ الولاءات تتصارع وتنقسم باعتبارها خط الدفاع الأول للأنا الفردية والمجتمعية، وتذهب وفق قيم المناصرة، حيث يأخذ وازع الالتحام والانقسام وجهة صراع الولاءات وانتماءاتها على النحو الآتي:
أنا ابن أسرتي ß ومن ثم ابن عائلتي ß وابن عائلتي ثم ابن فخذي ß ثم ابن فخذي وابن عشيرتي ß وابن عشيرتي ثم ابن قبيلتي ß وابن قبيلتي ثم ابن وطني ß وابن وطني ثم ابن أُمَّتي. ß ابن مذهبي وطائفتي ß ثم ابن ديني ß وابن حارتي ß ثم ابن قريتيß وابن جهتي ß ثم ابن مدينتيß وابن مدينتي ß ثم ابن وطني ß وابن وطني ß ثم ابن أمتي. وتتجسد هذه الولاءات، على سبيل المثال لا الحصر، في الصراع بين الولاء للأسرة أ م للعائلة، حيث يذهب ولاء الفرد لأسرته أولاً وليس لعائلته. وقل هذا في سائر الولاءات، ومالها من مستويات قربى في الحياة العربية.
والحق أنَّ خارطة الولاءات هذه تُوَضِّح أنَّ الانتماء للأحزاب، على سبيل المثال، يأتي من خلال الولاء للعائلة التي تنتمي إلى هذا الحزب أو ذاك، أو الولاء للجهة والمذهب.. الخ.
ونخلص إلى أنَّ هذا النمط من الولاءات في الحياة العربية، يتحول إلى عِلَّة… إلى مرض اجتماعي/ ثقافي لأنَّ الولاء/ العِلَّة في الأساس([8]) «… مايترتب عليه أمرٌ آخر بالاستقلال أو بواسطة انضمام غيره إليه، وهو علة لذلك الأمر، والأمر معلول له. ومن كل شيء سَبُبُ (ج) علات وعلل. ويقال قبل الأمر على عِلاَّته: على الحال التي هو عليها.»
وما دام الأمر كذلك، وهو كذلك، فإنَّ الولاءات العلل في نهاية الأمر ماهي إلاَّ ظواهر بنائية تحسب على خارطة المشكلات التي يعاني منها الوطن العربي.
إذاً؛ حسبنا أن نضع للولاء / المشكلة معناه البنائي ـ نسبة إلى البناء الاجتماعي ـ الذي يضعه حقيقة في سياق المشكلات البنائية الحقيقية المعاشة المتعينة في الحياة العربية اليومية المالكة لشروطها البنائية، باعتبارها أحد مفردات التنشئة الاجتماعية في الأسرة، والعائلة، والمدرسة، والحي… الخ.
ويلتقي معنى الولاء بوصفه أحد المشكلات البنائية الحقيقية مع الفرض السابق الذي احتسب الولاءات على البنى الاجتماعية العربية التقليدية التي لا تزال محكومة ومستندة في صراعاتها على عصبية القربى متنوعة المضامين العائلية، والعشائرية، والجهوية، والدينية، والمذهبية… الخ.
وهذه الولاءات بحكم طبيعتها الثقافية المركبة تحمل وظائف مزدوجة في معاييرها ومحدداتها الثقافية، ولذلك فهي متناقضة متصارعة في وظائف الانتماء: الفرد مرّةً ابن الأسرة والعائلة ß ومرّة ثانية ابن الأسرة ضد العائلة، وهكذا دواليك وصولاً إلى الأحزاب والجمعيات، والعقائد.
والولاء / العلة يبقى رهينة هذا الاشتباك حتى يخلي نفسه من انضمام غيره إليه، أي أن يكون الولاء للوطن يستند استناداً حقيقياً إلى مفهوم المواطنة التي تمثل القيمة العليا في التنشئة الاجتماعية، بحيث تكون هذه القيمة الحاكمة والمقررة لكافة الولاءات الأخرى التي تعرفها الحياة العربية، وأن يأتي هذه الولاء كتابع في كل وظائفه ل: الولاء للوطن بوصفه قيمة عليا تدور في فلكها كل القيم المالكة لحضورها في التنشئة الاجتماعية.
وحتى يملك الولاء للوطن استناداً إلى قيمة المواطنة شرعيته، ويتحول إلى أحد أهم أدوات وآليات الضبط الاجتماعي، فلابد له من نقاط استناد صلبة تنضم إليه، وتُحوله من الولاء/ المشكلة إلى الولاء الصحيح والسليم والمتمثل في الديمقراطية الحقة الخالية من أي إلحاقات، كما فعلت الأنظمة والأحزاب العربية عندما أصبحت على رأس السلطة، فَنَشَّطت هذه الإلحاقات المنضمة إلى الولاءات، ففعلت ما فعلت من انقسام وتشرذم في هذه الأحزاب وسلطها.
وخلال متابعتنا لصيرورة الولاءات، وتَعيُّن نتائجها في الحياة العربية، وما يتأتى منها من انقسامات تطول البنى العربية، وتحدث شرخاً بنائياً عميقاً في البناء الاجتماعي العربي، وتحوله بل تشرذمه إلى بناءات متصارعة. أقول قمنا مدفوعين بهاجسين: هاجس الولاء للأمة العربية بوصفه قيمة عليا تشكل المحدد الموضوعي للمواطنة، وهاجس المنهج الأنثروبولوجي الثقافي الذي يرينا الولاءات، كما هي في النسيج الاجتماعي العربي، وتعيناتها على هذا النحو هنا، وعلى ذلك النحو هناك. أقول([9]): قمنا بدراسة ميدانية / حقلية في إحدى المدن العربية برصد وظائف الولاءات، وهي تمارس وظائفها منقادة بعصبياتها المحكومة إلى وازعين، كما يقول ابن خلدون: وازع الالتحام، ووازع الانقسام حيث لاحظنا أنَّ وازع الالتحام في البنى الاجتماعية العربية محل الدرس يقوى عند حدوث تهديد أو عدوان خارجي فتنحسر التناقضات، وتقوى المشتركات بين الولاءات، والعكس هو الصحيح، حيث يقوى وازع الانقسام، ويقوى معه صراع الولاءات.
وتتجسد الانقسامات في انتماءات محسوبة إلى القيم الكبرى التي تحكم الولاءات والمتمثلة في المشهد الآتي.
لاحظنا أن صراع الولاءات يضعف، وتقل المشاهد الانقسامية في بنية الحزب الحاكم إذا شعر أعضاء هذا الحزب بتهديد من الأحزاب التي تُصارع حزبهم على السلطة. ويُقوى صراع الولاءات عندما يشتد التزاحم والمنافسة على المراكز السيادة في السلطة بين الفئات والقوى المُنَظَّمة داخل الحزب الحاكم، وتتجير صراع الولاءات إلى خلفيات مناطقية، ومذهبية، وأجيال، وخلفيات عقائدية… الخ..وخلصنا من دراسة صراع الولاءات في هذا الحزب إلى أَنَّ هذه الصراعات ترتد إلى خلفيات عائلية، وجهوية أحياناً، ومذهبية، وطبقية أحياناً أخرى.. وخاصة عندما يبدأ التنظيم، بل قواعد هذا الحزب، تدور في فلك الولاءات الفئوية المستندة إلى القوة العسكرية، وصاحبة القرار في توزيع المناصب. وما يتأتى عنها من جاه وكسب غير مشروع، وانفراد في الحكم.
وهذا معناه أنَّ الولاءات الفئوية تُغَيِّب الديمقراطية لصالح القوة والمحسوبية، وأن القيم الفئوية العليا هي القيم الحاكمة للولاءات وصراعاتها.
وفي هذا المشهد الفئوي تضعف قيمة المواطنة والوطنية، والديمقراطية أمام قيم الأنا الفردية كقوة دفاع عن الذات، وقيم الأنا الفئوية كقوة دفاع عن الفئة… الخ.
وقد دلتنا الدراسة ونحن نستشرف صيرورة الولاءات وتجلياتها في سلم الانتماءات أن كثرة من البنى الاجتماعية في الوطن العربي لا تنتج في أغلب حالاتها إلاَّ الولاءات العائلية، والعشائرية، والمذهبية، وهذه الولاءات متصارعة منقسمة بحكم جُبلَّتها العصبية التي تقودها وتوجهها، الأمر الذي يحيلها إلى علل في الحياة العربية يجعل وازع الانقسام له الغلبة على وازع الالتحام. وهذا معناه أنثروبولوجياً، أي في التحليل والتفسير الانثروبولوجي الثقافي لظاهرة صراع الولاءات وانقساماتها التي تشهدها الحياة العربية الراهنة، أنها انقسامات محكومة إلى المجتمع الأهلي، ومافيه من عصبيات دون الوطنية والمواطنة، مثل: العشائرية ـ المعنى القرابي الدموي ـ والجهوية، والمذهبية، التي تشكل بصورتها وطبيعتها البنائية عقبة في تجاوز الواقع الراهن، وفي تناقض موضوعي مع صيرورة تطور المجتمع التي توفر شروط انتقال المجتمع العربي إلى بنى اجتماعية أكثر تقدماً، يكون الولاء فيها للوطن قيمة كبرى.
وتؤذن المعطيات السابقة عن الولاءات وخلفياتها وحضورها في الحياة العربية اليومية كقوة دفاع عن الذات بصيغتها الفردية والمجتمعية، كما أسلفنا، يمكنها من إلزام الأفراد، والجماعات، والانصياع لأوامرها، لأنَّ الولاءات في حقائقها، وروابطها الاجتماعية ظاهرة بنائية بامتياز تطرح نفسها بسبب من خلفياتها ووظائفها والقيم القرابية التي تقودها كمشكلة بنائية تبحث عن حلول جذرية من أجل تتجاوز حالتها الراهنة/ الصراعية. وهذا يستدعي دراستها والإلمام بأسبابها المباشرة وغير المباشرة، دراسة حقلية متعددة الاختصاصات. الأنثروبولوجية، بحيث يتم تغطية أجزاء واسعة من البنى الاجتماعية العربية المسكونة بصراع الولاءات السائدة في النسق السياسي والاجتماعي والعقائدي([10]).
والحق أنَّ الأسباب التي أحالت الولاءات إلى علل بنائية متجسدة في مشكلات متعينة في الواقع العربي الراهن تستدعي رؤية جدلها الاجتماعي من خلال معرفة أسبابها المباشرة وغير المباشرة ـ وما بينها من مستويات من التأثير والاعتماد الوظيفي المتبادل. وهذا القول يشكل أحد شروط تجاوزها. فهل هذا الشرط مدعاة لأن تكون حاضرة في معاهد ومراكز أبحاث الجامعات العربية، وتحت إشراف القطاع الجدي من أبناء الوطن العربي. أساتذة جامعات، ومجموعات بحثية متدربة ومنخرطة في الأبحاث والدراسات الأنثروبولوجية الحقلية / التطبيقية مستندة إلى دليل عمل يتحول إلى مؤشرات تتقصد على وجه الدقة الولاءات، وما تعنيه داخل البناء الاجتماعي العربي من انتماءات في سياق معادلة مكونة من: أَنَّ المحلي جزء لا يتجزأ من الوطني، وإنَّ الوطني، جزء من الأمة. وكلَّ بعد من هذه الأبعاد يرى نفسه في الآخر، ويرى غناه كمحدد موضوعي لحل المشكلات العالقة في الوطن العربي، وتجاوزها نحو حياة عربية قائمة على المواطنة، ومالها من حقوق وواجبات، ومستندة إلى نظام ديمقراطي خال من العلل التي تنتجها ثقافة القربى الدموية، والبحث عن بديل ثقافي حضاري متقدم تجد فيه الديمقراطية سكنها المحروس بدولة القانون.. البديل الثقافي الذي يحقق قطيعة مع الثقافة البدوية.. ثقافة القوة الغاشمة… والاستبداد الذي طبع الأنظمة العربية الراهنة بطباعه. ثقافة بديلة تشكل واحة غناء للديمقراطية، والفكر المستنير.. والإنسان العربي الحر المالك لكرامته غير المنقوصة، قال مالك، عم عنتر، كر يا عنتر.. فأجابه.. عنتر: العبد لا يحسن الكر… قال العم.. كر يا عنتر فأنت حر. فَكَرَّ عنتر وأعاد السبايا، وحرر المواشي.. وأعاد الكرامة إلى عشيرته التي ضعفت ثم هُزمت بالفكر العبودي.
([1]) ـ العصبية عند ابن خلدون لا تعني عصبية الدم/ القربى، وإنما عصبية العمل، والسياسة، والدين، والمذاهب، والحزب والعقائد…الخ.
([2]) ـ يرجى الرجوع إلى مقدمة ابن خلدون ـ تحقيق عبد الواحد وافي ـ ج1 ـ مكتبة الأسرة ـ 2006: الكتاب الأول: في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من الملك والسلطان والكتب والمعاش والصنائع والعلوم وما لذلك من العلل والأسباب.
([3]) ـ د.أحمد زكي بدوي ـ معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية ـ مكتبة لبنان ـ بيروت ـ 1977 ـ ص 76.
([4]) ـ د.أحمد أبو زيد ـ البناء الاجتماعي ـ الأنساق ـ ط2 ـ ص 312 ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ مصر 1967.
([5]) ـ مجمع اللغة العربية: المعجم الوجيز ـ طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم ـ القاهرة ـ 1992 ـ ص 682.
([6]) ـ د.عز الدين دياب ـ التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسام السياسي في الوطن العربي ـ حزب البعث العربي أنموذجاً ـ مكتبة مدبولي ـ القاهرة ـ 1993 ـ ص 165
([7]) ـ المرجع السابق: ص 112- ص 163 ـ ص164.
([8]) ـ مجمع اللغة العربية ـ المعجم الوجيز ـ القاهرة ـ 1992 ـ ص 432.
([9]) ـ د. عز الدين دياب ـ التحليل الاجتماعي لظاهرة الانقسامات السياسية في الوطن العربي ـ المرجع السابق ـ ص 154.
([10]) ـ دعونا إلى هذا المستوى من الدراسات منذ عام، 1993 وسجلنا ذلك بكتابنا سالف الذكر تحت عنوان: دور الولاءات السائدة في الصراع السياسي في المجتمع العربي ـ دراسة استطلاعية ـ ص 152. سالف الذكر.