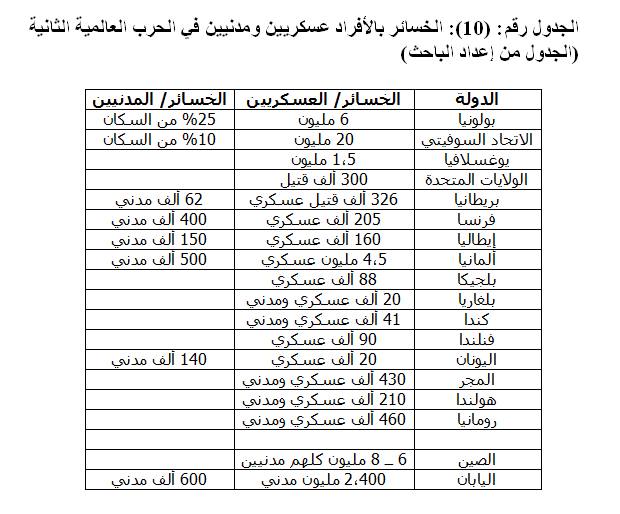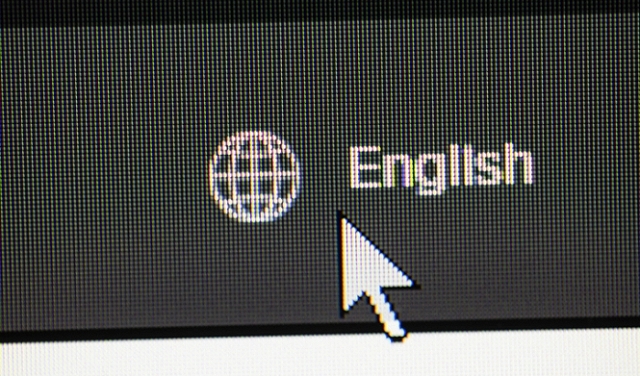دراسات
قوات الدعم السريع: هل هي قوات تحرير، مليشيا، أم مرتزقة؟ بقلم: أحمد محمود أحمد
بقلم: أحمد محمود أحمد

قوات الدعم السريع: هل هي قوات تحرير، مليشيا، أم مرتزقة؟
بقلم: أحمد محمود أحمد
تمهيد:
الدراسات البحثية حول قوات الدعم السريع غير متوفرة حيث أن التناول لطبيعة هذه القوات دوماً يكون سياسياً حاداً ويرتبط بالانحياز نحوها أو الوقوف ضدها، مما يؤدي إلى غياب المنظور المحايد الذي يحاول دراسة هذه القوات وطبيعة نشأتها وتطورها والنظر لمستقبلها في خارطة السودان، بالرغم من كون أن الحياد المطلق لا يوجد في التجربة البشرية، هذه الدراسة تجازف لتنحو منحىّ مختلفاً عن المنظور السائد تجاه هذه القوات، سواء كان مع أو ضد، وتؤسس لرؤية تقرأ بها هذه القوات على ثلاثة مستويات:
المستوى الأول يرتبط بطبيعة وتاريخية المنطقة التي نشأت فيها هذه القوات وهي دار فور، في حين يرتبط المستوى الثاني بالظروف التي نشأت فيها هذه القوات وطبيعة القوى التي ساعدت في إنشائها، أما المستوى الأخير فإنه يرتبط بماهية هذه القوات وطبيعتها ومستقبلها السياسي في السودان، للوصول لأهداف هذه الدراسة فإنها ستعتمد المنهج الوصفي التاريخي من جهة، ومن جهة أخرى ستعتمد على التحليل السياسي والاقتصادي استنادا للفرضيات التالية:
الفرضية الأولى:
بروز أي قوى سياسية أو عسكرية يأتي محكوماً بظروف نشأتها، مرتبطاً ذلك بالواقع الاقتصادي والسياسي.
الفرضية الثانية:
التحول نحو لعب دور سياسي يتطلب أكثر من نحت الشعارات، بل يتطلب وضوح الفكرة وتجلياتها في الواقع.
الفرضية الثالثة:
تجربة (الإسلاميين) في السودان ارتبطت بالعرق والدين كمجالات استغلال، وكل من أنتجته هذه التجربة لا يستطيع الانفكاك من نمطها ونسقها المعرفي.
مقدمة
الحرب الدائرة اليوم في السودان تعبر عن فشل الدولة السودانية منذ الاستقلال في عام 1956 وحتى اليوم، هذا الفشل قد ارتبط بدولة ما بعد الاستعمار والتي لم تستطع تطوير اَليات جديدة تستطيع من خلالها الحفر المختلف عن نهج الاستعمار والقائم على التقسيم ومصادرة الموارد، حيث أصبح الصراع حول هذه الموارد وعدم إدارتها مدخلاً لغالبية الصراعات التي شهدها السودان، الذي رتب لهذا الواقع يأتي مرتبطاً بعدم الاستقرار السياسي الذي شهده السودان حيث برز خطان أو اتجاهان في مسيرة هذه الدولة الرخوة و هما:
1- الاتجاه المدني الساعي لتثبيت أسس الدولة المدنية واستدامة الديمقراطية.
2- الاتجاه السلطوي ذو التفكير الأحادي والذي ارتبط بالمؤسسة العسكرية والتي هي وليدة الحقبة الاستعمارية من حيث التفكير والتوجه، هذا وبالرغم من قوة الحركة الجماهيرية السودانية وقواها المدنية، إلا أن من تسيد الموقف هو الاتجاه السلطوي نتيجة لتواطوء بعض القيادات الحزبية السودانية مع المؤسسة العسكرية ضمن توازنات السلطة والسيطرة على مقاليد الدولة، المثال الأبرز في هذه الحالة هو انقلاب (الإسلاميين) على النظام الديمقراطي عام 1989 من خلال دفع بعض أعضاء المؤسسة العسكرية المحسوبين ضمن قائمة (الإسلاميين) للانقلاب على النظام الديمقراطي حيث التقى العقل الديني هنا مع عقل السيطرة المعسكرة، أي التحام العمامة كرمز للشيخ الديني المراوغ مع الخوذة كرمز للحمائية الذاتية لدى العسكر وكلها حواجب للعقل المستنير، وهذا ما أدى إلى تطور الصراع نحو وجهة جديدة تحكْم فيها الشعار الديني من جهة، وعنف الدولة المحكومة بالبندقية من جهة أخرى، وهذا بالنتيجة أدى إلى عنف مقابل من قبل الحركات التي حملت السلاح، مما حول الدولة كلها إلى ساحة حرب وبالذات في إقليم دارفور وقبله جنوب السودان وغيرها من مناطق الحرب، وضمن هذا الواقع المأزوم، وحِدّة الصراع أُنشئت قوات الدعم السريع كتعبير عن سيادة البندقية في العمل السياسي، والأهم فإن إنشاء هذه القوات جاء كتعبير عن تحلل المؤسسة العسكرية وعدم قدرتها على مواجهة التمردات العديدة ضد النظام الإسلاموي الحاكم، لتتحول هذه القوات لاحقاً لمواجهة المؤسسة العسكرية نفسها والتي عملت معها لمواجهة القوى الحاملة للسلاح ضد الدولة الإسلاموية، وبهذا المعنى فإن قوات الدعم السريع هي نتاج العقلية الدينية والعسكرية، أي ما أطلقنا عليه تزاوج العمامة والخوذة والتي تحولت مؤخرا، أي قوات الدعم السريع، لتكون بالضد للإثنين معاً بالدرجة التي يمكن أن نطلق على هذه القوات اسم (البلدوزر أو الحفار) وقد دخلت هذه الأطراف سواء كان العسكر أوالحركة الإسلامية من جهة والدعم السريع من جهة أخرى في حرب 15 أبريل 2023 والتي أدت إلى ردة شاملة على الاتجاه الأول والمرتبط بالدولة المدنية والديمقراطية، وهذا الواقع تطلب دراسة هذه القوات من أجل معرفة طبيعة نشأتها والعوامل المتحكمة في تطورها وإذا ما كان هذا (البلدوزر) سيهدم الدار على ساكنيه، أم يسير عكسا للعمامة والخوذة ليشتغل نحو تأسيس نظام مدني ديمقراطي كما تقول شعاراته، هذا ما نحاول البحث عنه.
منطقة نشأة قوات الدعم السريع
تعود جذور قوات الدعم السريع إلى دارفور، هذا الإقليم المهم الذي تمتد جذوره إلى حقب موغلة في التاريخ، وبالرغم من شح الحفريات الأثرية في هذا الإقليم ، إلا أن هنالك بعض الدراسات التي تشير إلى أن هذا الإقليم كان معروفاً منذ زمن الحضارة النوبية في الشمال، وكذلك الدولة المصرية القديمة، وتذكر بعض المصادر أن القائد الفرعوني حركوف قد زارها ويقف درب الأربعين كشاهد على تاريخية هذا الإقليم (1) ولقد شهد هذا الإقليم ثلاثة ممالك أو سلطنات مهمة وبعد القرن الثاني عشر الميلادي وهي سلطنة الداجو وبعدها سلطنة التنجور ثم سلطنة الفور التي حمل الإقليم اسمها. وتتباين الرؤى تجاه أصل سلطنة الداجو وقد نسبهم البعض للفراعنة وذهب آخرون بالقول بأصولهم العربية (عباسيين أو هلاليين) (وقال آخرون بأصلهم المروي نسبة لمملكة مروي في الشمال(2)، أما فيما يتصل بالتنجور فيعتقد الكاتب بارت أن التنجور هم من النوبيين الذين هاجروا من دنقلا مدللا على أن اسم التنجور يعني القوس في لغة النوبيين وهو الاسم الذي عرفت به بلاد النوبة قديما (تاستي)، ومن جانب آخر يرى الكاتبان اركل وماكمياكل أن التنجور هم نتاج عن تصاهر قد تم بين عرب بني هلال والسكان المحليين (3)، ورغم أن الإسلام قد بدأ يشق طريقه إلى تلك البقاع منذ القرن الثاني عشر الميلادي أو قبله، إلا أنه لم يصبح الدين الرسمي إلا عام 1640 ميلادية إبان الحقبة التي حكم فيها سليمان سولونج وهو من الفور مجموعة الكنجارة والتي تقابلها مجموعات أخرى وهي التموركة والكرا كريت، وتذكر روايات أهل البلاد أن الكنجارة قد صاهروا عرب بني هلال واستطاع زعيمها سليمان سولونج تأسيس سلطنة دارفور وتعني كلمة سولونج في اللغة المحلية العربي (4) وعلى صعيد الجغرافيا فيعتبر هذا الإقليم متميزا حيث يتميز بثلاث مناخات تقريباً، وهي المناخ شبه الصحراوي في الشمال ومناخ شبه البحر المتوسط في منطقة جبل مرة والذي يصل ارتفاعه عشرة ألف قدم فوق سطح البحر وفي الجنوب والجنوب الغربي تنمو حشائش السافانا، وتبلغ مساحة دارفور 510888 كيلو متراً مربعاً ويسكن حوالي 75% من سكان دار فور في الريف و15% من الرعاة و10% في المدن وهذا التقسيم يعود إلى التسعينيات (5).
هذه المعلومات التاريخية والجغرافية تعكس أهمية هذا الإقليم، علاوة على تعدد مجموعاته السكانية وطبيعة التنوع فيه، والمستفاد من الجانب التاريخي في هذا الخصوص هو العلاقة التي نشأت بين العرب المهاجرين ومنذ زمن طويل والسكان الذين سكنوا تلك الأرض قبل العرب، حيث لم تقم هذه العلاقة عبر التصادم بقدر ما ارتبطت بالتداخل والتصاهر حيث ظهرت هذه السلطنات وهي تحمل هذه السمات العربية الإسلامية حيث كان يتطابق مفهوم العربي مع الإسلامي، مما يرجح أن قبول الإسلام نفسه قد تم عبر قبول العرب أنفسهم وسط السكان المحليين، ولم تبرز تلك المسميات التي باتت تظهر في وسائل الإعلام عبر العقود الأخيرة مثل عرب وزرقة أو عرب أو أفارقة حيث أن الحدود بين العروبة والأفريقانية في الحالة السودانية ليست بالقطعيات التي باتت تنمو بها في العقود الأخيرة، أي مسميات عرب- أفارقة حيث أن الإنتماء يجب أن يتحدد بالثقافة أكثر من العرق، وقد نتج كل ذلك نتيجة للممارسة السياسية الخاطئة التي استخدم فيها النظام الإسلاموي الحاكم العرق والدين من أجل تثبيت حكمه، والأهم أن المصادمات التي حدثت في العقود الأخيرة بين القبائل العربية ومقابلها القبائل الأفريقية وإذا ما قبلنا بهذا التوصيف، فإن هذه الصدامات لم تكن نهجاً تاريخياً يتأسس على عداوة متأصلة بين هذه التقسيمات، أنما هو وليد الفشل السياسي في مسار الدولة السودانية تاريخياً وعدم قدرتها على الانتقال بالمجتمع عموما من طور القبيلة والطائفة إلى المجتمع الوطني الذي يلتقي على أساس المواطنة وليس العرق أو الدين، هذا من ناحية، أما من ناحية أخرى وعلى مستوى هذا الواقع القبلي في دارفور، فإن الصدام الذي وقع بين القبائل العربية نفسها قد يفوق ما حدث بين هذه القبائل العربية ومقابلها القبائل الإفريقية، والمثال على ذلك الصدامات التي حدثت بين قبيلتي الرزيقات والمعاليا ومنذ الحقبة التي حكم فيها البريطانيون السودان ومرورا بعام 1968 وحتى الوقت الراهن وغيرها من المواجهات القبلية بين القبائل العربية. وهذا يدلل على أن هذا الإقليم لم يقم على ذلك الصراع المعنون بالعربي والأفريقي وعلى ذلك الفصل القبلي والعنصري الحاد (عرب/زرقة) والذي برز مؤخرا وبالذات من خلال حكم (الإسلاميين)، لقد برز وجود قوات الدعم السريع في هذا الإقليم بعد أن فشلت السياسة السودانية تاريخياً في تطوير كافة الأقاليم السودانية ومنها إقليم دارفور، وبدلا عن أن تتحول الموارد في دارفور لمصلحة أهل دار فور ولعموم السودان، تحولت إلى دائرة صراع وهذا الصراع أدى إلى الانقسام وضمن هذا الانقسام برزت قوات الدعم السريع، وفي هذه الجزئية فنحن نناقش الفرضية الأولى التي طرحناها في صدر هذه الدراسة والتي تربط نشوء أي قوى بالواقع السياسي والاقتصادي والذي تنشأ فيه، وبهذا التوصيف فإن قوات الدعم السريع قد نشأت في واقع اقتصادي لم يتحدد داخله واقع طبقي، لأنه قد ارتبط بالرعي من جهة، ومن جهة أخرى بالزراعة التقليدية التي وجدت في دارفور حينها والتي تفتقد الآلات والميكنة حيث تقوم طبيعة الصراع وفق هذه التشكلات والنشاطات على أساس قبلي محكوم بنمط الإنتاج في تلك المنطقة، وهذا الصراع كان محكوما بنفوذ الإدارات الأهلية من عمد ونظارات وقد استطاعت هذه الإدارات أن تبقي هذه الصراعات في حدها الأدنى عبر مبادرات الصلح والدية، وبدخول سياسة الدولة عبر حكم (الإسلاميين) تم تجيير هذا الصراع لمصلحة الدولة والتنظيم، وهي الحالة التي تم فيها ترفيع المجموعات البدوية وتدريبها لتصبح هي قوات الدعم السريع، وبالتالي فإن الانطلاقة الأولى لهذه القوات لم تكن ذاتية المنشأ بل جاءت مقترنة بالنظام السياسي وعلى خلفية الواقع الاقتصادي المتدهور أصلا والمحكوم بواقع البداوة والريف، إذا ما هي طبيعة هذه القوات وما هي طبيعةنشأتها؟
نشأة وطبيعة قوات الدعم السريع
يمكن العودة لطبيعة الصراع الذي أنتج هذه القوات إلى حقبة الثمانينيات من القرن الماضي حيث تأثر ذلك الإقليم بموجة الجفاف التي ضربت أجزاء من ذلك الإقليم مما دفع رعاة الماشية للبحث عن الكلأ والماء بالقرب من مزارع المزارعين، وقد تتجاوز الماشية وتدخل أحيانا إلى تلك المزارع مما رشح وأدى إلى صدامات بين المزارعين والرعاة، وكان يمكن معالجة تلك الأمور بتدخل الدولة ولكن لم يحدث ذلك، وقد سلحت الدولة وتحديدا في زمن حكومة الصادق المهدي بعد العام 1986 بعض القبائل الرعوية مما عمق ذلك من طبيعة الصراع والانقسام بين المكونات الاجتماعية، وبصعود تنظيم الإخوان المسلمين للسلطة في عام 1989 اتخد الصراع شكلا جديدا حيث تم استقطاب بعض أفراد القبائل العربية في ذلك الإقليم لتحارب مع النظام بعد ظهور الحركات المسلحة الدارفورية، ومن قبلها الحركة الشعبية لتحرير السودان – جنوبية المنشأ، وقد عرف الذين حاربوا مع النظام ومنذ البداية بالفرسان ثم “بالجنجويد” لاحقاً، ويمكن التأريخ لذلك منذ بداية تسعينيات القرن الماضي وتحديدا ضد الحركة الشعبية لجنوب السودان، والتي استقطبت بعض أبناء دارفور وعلى رأسهم القيادي الإسلامي داؤود بولاد الذي انشق عن النظام عندما شاهد أهله يقتلون وقال قولته المشهورة بأن (العرق أقوى من الدين) وقد انضم للحركة الشعبية وذهب للقتال في دارفور حتى تمت تصفيته من قبل النظام. ولقد تصاعدت الأحداث حتى العام 2003 وظهور الحركات المسلحة الدارفورية، وهنا اتخذت تلك المجموعات التي تحارب بجانب النظام مسمى “الجنجويد” كما أطلق عليها السكان المحليين ذلك، أي جن راكب جواد، وبدأ الصراع يتخذ أشكالا أكثر عنفا، وقد تم في العام 2013 الإعتراف الرسمي بقوات الدعم السريع الشكل المتطور “للجنجويد”، والتي تم تكوينها تحت إشراف جهاز المخابرات والأمن الوطني، ومن ثم استطاعت هذه القوات بسط نفوذها العسكري والاقتصادي في إقليم دارفور وتوسعت في أعمالها التجارية بما في ذلك التنقيب عن المعادن خاصة الذهب واليورانيوم (6)، وفي العام 2017 تم تقنين وجود وصلاحيات قوات الدعم السريع داخل المجلس الوطني (البرلمان) وتحديد علاقتها بالقوات المسلحة، واشتمل قانون الدعم السريع حينها على 25 مادة (أضيفت مادة أخرى في زمن البرهان) وحصر هذا القانون قيادة وإدارة هذه القوات في شخصين، وهما عمر حسن البشير رئيس الدولة حينها وأصبح القائد الأعلى لهذه القوات ومن بعده حميدتي كقائد لهذه القوات وتحت قيادة عمر البشير مباشرة حيث لا مكان ولا سلطة للقوات المسلحة على هذه القوات (7)، وكما يقول دكتور سليمان محمد احمد سليمان ( فإن المادة 5 من القانون قد تضمنت حالتين فقط لخضوع قوات الدعم السريع لأحكام القوات المسلحة وهما:
فإن المادة 5 من القانون قد تضمنت حالتين فقط لخضوع قوات الدعم السريع لأحكام القوات المسلحة وهما:
1-عند إعلان حالة الطوارئ أو عند الحرب بمناطق العمليات الحربية، تخضع قوات الدعم السريع لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007.
2- يجوز لرئيس الجمهورية في أي وقت أن يدمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقا للدستور والقانون وتخضع عندئذ لأحكام قانون القوات المسلحة لسنة 2007، وهذا وضع غريب يضع هذه القوات في التوازي مع القوات المسلحة ويسلبها دورها في قيادة المنظومة العسكرية مما خلق إزدواجية في المهام، إذ تبدو تبعية قوات الدعم السريع لرئيس الدولة مباشرة تمييزا لها عن القوات المسلحة وتجاوزا لسلطتها، وهذه النقطة هي التي أدت للأشكاليات اللاحقة حول قضية الدمج وتبعية هذه القوات للقوات المسلحة، والأخطر في جميع هذه المواد هي المادة 22 والتي تقول (لا يعتبر جريمة أي فعل يصدر من ضابط أو ضابط صف أو جندي بحسن نية أو بسبب أداء أعمال وظيفته أو القيام بأي واجب مفروض عليه أو عن فعل صادر منه بموجب أي سلطة مخولة أو ممنوحة له بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر ساري المفعول أو أي لائحة أو أوامر صادرة بموجب أي منها على أن يكون ذلك الفعل في حدود الأعمال أو الواجب المفروض عليه وفق السلطة المخولة له ولا يتعدى القدر المعقول من القوة لتنفيذ واجباته أو لتنفيذ القانون دون أي دافع آخر للقيام بذلك العمل (9)، ويعلق دكتور سليمان محمد احمد سليمان على هذه المادة قائلا (إن هذه المادة تعطي أفراد قوات الدعم السريع الحماية والحصانة الكاملة لأفعالهم بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور ولاحقا جريمة فض الاعتصام ، بل أن الجزء الثاني من المادة نفسها يذهب مسافة أبعد من هذا ويشير إلى أنه إذا نتج عن أنفاذ القانون أو أي أمر قانوني وفاة أو ضرر يستحق الدية أو التعويض فإن الدولة تتحمل دفع الدية أو التعويض نيابة عن الضابط أو ضابط الصف أو الجندي الذي يعمل بحسن نية وفقا لأحكام هذه المادة (10)، هذه القوانين والتي فصلها النظام السابق جعلت من هذه القوات مجرد تابع له وباعتبارها جزءا لا يتجزأ من تركيبة النظام وقبلت هذه القوات بهذه الوضعية حتى زمن سقوط النظام، إجمالا لهذا السرد فيمكن القول أن قوات الدعم السريع قد بدأت كمجموعات عسكرية أولا باسم الفرسان ثم “الجنجويد ” وينسب تأسيسها إلى موسى هلال زعيم عشيرة المحاميد التي تنحدر من قبيلة الرزيقات، وهو ابن عم محمد حمدان دقلو والذي انشق عام 2007 معلنا تمرده على الحكومة لعدم التزامها بتسديد مستحقات قواته وبدأ بقتال القوات النظامية، فما كان من نظام عمر البشير إلا تقديم عروض لمحمد حمدان دقلو تضمن عودته وكانت هذه العروض هي دفع الرواتب بأثر رجعي ومنح قيادات قواته رتب ضباط ومنحه هو رتبة عميد ( 11)، من جانب آخر تعُرف قوات الدعم السريع نفسها بكونها قوات عسكرية قومية التكوين وتعمل تحت إمرة القائد العام وتهدف لإعلاء قيم الولاء لله والوطن وتتقيد بالمبادىء العامة للقوات المسلحة (12)، وبهذا المعنى فإن قوات الدعم السريع تحدد ثلاثة مهام رئيسية لها وهي (13):
1- دعم ومعاونة الجيش والقوات النظامية الأخرى (الشرطة هنا) في مواجهة المهددات الداخلية والخارحية وأي مهام أخرى يكلفها بها القائد العام للقوات المسلحة (عمر البشير)
2- التصدي لحالات الطوارىء المحددة قانونا.
3- المشاركة في توطيد وحماية السلام والأمن الدوليين وتنفيذا للالتزامات الأخلاقية والمواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية، ونحن هنا أمام وضع غريب وشائك، فهذه القوات كانت جزءا من تركيبة نظام سياسي ولكنها في نفس الوقت تنزع لكي يكون لديها فرادتها ودورها المنفصل، وما رتب لكل هذا هو الدور الذي قامت به هذه القوات في إيقاف مد الحركات المسلحة الدارفورية، علاوة على علاقتها المباشرة برئيس الدولة وإحساسها بالتميز، إن هذه القوات قد نشأت في ظل نظام قد اعتمد على محورين لتثبيت سلطته، وهما محور الدين والعرق، حيث تم استغلال الدين وبشكل واسع في السياسة وفي الحروب وبالذات في حرب الجنوب، والتي أصبحت مقدسة في عرف ذلك النظام، وكذلك استخدم العرق في دارفور بتقسيم أهل المنطقة إلى (عرب وزرقة) وتصدير صورة زائفة لعرب دارفور بكونهم مستهدفون في وجودهم من أجل الوقوف معه في حربه ضد الحركات المسلحة، لقد اعتمد النظام في حرب الجنوب على ما عرف حينها بقوات الدفاع الشعبي وهي قوات ذات هوية دينية حاولت أن تحل مكان القوات المسلحة في الحرب وجعلتها حرب التقديس، وبذات الدرجة اعتمد النظام على قوات الدعم السريع وعلى أساس عرقي في دارفور لمحاربة الحركات المسلحة هناك، ولكن معها تمت محاربة أهل دارفور أنفسهم حيث تمت الإبادة والمعروفة ولدى الجميع، ووفقا لهذه القراءة السابقة فيمكن القول أن قوات الدعم السريع هي نتاج لثلاثة عوامل:
أولا : الصراع على الموارد والذي نتج عن الجفاف وعدم القدرة على إدارة هذه الموارد..
ثانيا: النهب المسلح الذي شهده إقليم دارفور منذ بداية التسعينيات مما استدعى بعض المجموعات لتأمين طرق التجارة وظهرت هنا بعض المجموعات المنتمية للقبائل العربية للقيام بذلك ومن ضمنهم حميدتي.
ثالثا: بروز الحركات المسلحة الدارفورية ومن قبلها الحركة الشعبية لتحرير السودان التابعة لجون قرنق، وهو العامل الذي دفع النظام الحاكم لاستخدام بعض أفراد القبائل العربية لتخوض حروب الوكالة في مواجهة الحركات المسلحة.
التعريف الممكن لقوات الدعم السريع
لقد طرحنا عبر عنوان هذه الدراسة سؤالا، وهو: هل قوات الدعم السريع هي قوات تحرير ، ميليشيا، أم مرتزقة؟ وللإجابة على هذا السؤال نقول، أنه عندما نتحدث عن قوات التحرير فإننا نتحدث عن مفهوم عميق يرتبط بالتحرير كفكرة، وحينها وعند تعميق مفهوم التحرير سنجد المعنى الذي يقودنا إلى الخلو من القيد، فالقيد قد يكون فكريا، اجتماعيا، نفسيا، تاريخيا، ايدولوجيا (14).
فالتحرير تصور قبل أن يكون استراتيجية، فهو كفكرة وفي جوهرها تعبر عن مكنون القوة لدى الشعب ولخدمة تحريره (15)، ووفق هذه السردية فإن التحرير مشروع كبير يعتمد على الأفكار والاستعداد لمواجهة العدو من أجل تحرير الشعب، وتصبح القوى أو القوات التي تقود هذا التحرير ذات سمات ترتبط بالمبادىء وقدرة عالية على التضحية ولديها أفكار وتصورات تسبق استراتيجية المواجهة.. والأهم أن لديها أهداف واضحة ومحددة ومنذ البداية تنطلق من خلالها وكذلك الرؤى التي تسير عليها هذه القوى أو القوات، والتحرير الذي تسعى إليه أي قوى قد يكون عادة من الاستعمار أو الديكتاوريات القابضة على مصائر الشعب وتتسم وتتقيد هذه القوى بالشرط الإنساني والأخلاقي في الصراع فلا تقتل المدنيين ولا تسرق وتخضع لمعايير دقيقة في تعاملها مع أعضاءها وتثقيفهم باتجاه القضية التي تسعى لتحقيقها، عند مقاربة تلك المنطلقات بقوات الدعم السريع فإنها لا تنطبق على هذه القوات والتي لم تنطلق من فكرة مرتبطة بقضية التحرير ضمن مفهومه الشامل، ولكنها وجدت ضمن فكرة تقف ضد كل شروط التحرير وهي الفكرة الدينية التي جسدها نظام (الإسلاميين) ضمن رؤيته المتخلفة للصراع، أما فيما يتصل بالمليشيا وإذا ما كانت قوات الدعم السريع مليشيا أم لا؟ فكلمة مليشيا (Militia) ووفقا لل (Wikipedia) تعود إلى روما القديمة وهي تعني جنود أو مقاتلين غير نظاميين ويعملون حسب الحوجة والطلب- أو هي جماعة مسلحة غير نظامية تعمل بأسلوب حرب العصابات وهي يمكن أن تكون:
1- قوات تابعة للجيش النظامي.
2-منظمات مسلحة تابعة لأحزاب أو حركات سياسية.
3- قوات دفاعية يقع تشكيلها من طرف مواطني منطقة سكنية أو جغرافية محددة في إطار جهوي أو ديني وقد تكون مدعومة من السلطات)، ويرى قاسم بلشان (16) إن المليشيا هي عبارة عن مجاميع مسلحة ومنظمة ومتدربة ومدعومة وموجهة تعبويا لتحقيق مصلحة حزبية معينة وخاضعة لسلطة مركزية وهي ذراعا عسكريا لفئة سياسية أو غير ذلك تخوض صراعا أي ما كان دافعه أو هدفه، وهنالك فريق يرى أن أهداف أعضاء المليشيا مادية بحتة، فالحرب عندها وسيلة عيش وكسب ولهذا تبحث عن المناطق المشتعلة التي تمثل مواردها المادية (17)، ونتيجة لالتباس هذه الكلمة فإن هنالك من يعمم مصطلح مليشيا على جميع الحركات ويعتبرها مقاومة أو وحدات تحرير وعلى الأقل مجموعات تابعة لدولة ديمقراطية، لهذا يذهب علاء اللامي (18) ليقول أن الدستور السويسري وفي المادة 58 يقول أن الجيش السويسري جيش منظم طبقا لنظام المليشيا، وكذلك قد نجد نفس الشيء في الدستور الأمريكي الذي يحتفي بدور المليشيات، ولكن الأهم في هذا الجانب هو العامل أو المنظور الذي تقوم عليه المليشيا أو لنقل التشكيلات العسكرية والمرتبط بالفكرة والهدف، وهي المنطقة التي تتحدد بها طبيعة المليشيات من حيث الدور الإيجابي أو السلبي وهي النقطة التي سنعود لمناقشتها لاحقا، فهل وبما تم طرحه هنا فهل تعتبر قوات الدعم السريع مليشيا؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من مناقشة وتعريف ماهية القوات المرتزقة أولا حتى يمكننا المقارنة ومن ثم إصدار الأحكام، القوات المرتزقة قد تختلف عن مفهوم المليشيات حيث يتسع مفهوم المليشيا ليقبل بالدور الإيجابي كما تم مناقشة ذلك سابقا، حيث أن هنالك بعض المليشيات لديها قضايا تدافع من أجلها وليس من أهدافها المال وبغض النظر عن الاتفاق أو الإختلاف حول هذه الميليشيات، فمثلا نجد حزب الله فهو ميليشيا ويتبع لإيران إلا أنه يصادم “إسرائيل ” أحيانا بالرغم من كونه يعتبر ممولا من قبل إيران، وبنفس الدرجة فإن الميليشيات التابعة لحماس تخوض اليوم حربا شرسة ضد الاحتلال “الإسرائيلي” وهي جميعها لا تعتبر جيوشا منظمة لكنها ينطبق عليها مفهوم المليشيات، وكذلك عبر التاريخ فقد ظهرت مليشيات مسلحة تابعة لأحزاب ثورية الأنظمة الدكتاتورية، كما أن هنالك مليشيات تنشأ للدفاع عن قضايا إقليمية تكتسب المشروعية عبر الإقليم الذي تدافع عنه، إذن وضمن المنظور العام لواقع المليشيات فإن الأمر الحاسم في تجسير تعريفها يرتبط بالأهداف والقضايا التي تسعي إليها المليشيا، وهي المنطقة التي تخرجها من مجال المليشيا وضمن مفهومها السلبي، نحو التحرير انطلاقا من التوجهات والأهداف، وفي المقابل يبقى الجانب السلبي للمليشيا كمفهوم عندما ترتبط بالسلطة الديكتاورية وكذلك بعلاقة هذه المليشيات بالمال، وهو ما ينقلنا لمفهوم القوات المرتزقة والتي هدفها الأساسي هو جمع المال، ويتضح هذا وعلى مستوى عالمي في حالتين وهما شركة Black Water الأمريكية المنشأ ومجموعة فاغنر الروسية، ويقول جيرمي اسكاهيل موضحا وهو يتحدث عن فكرة الأمن الخاص (Private Security) وهو المفهوم الذي يحيل للمرتزقة بأنها فكرة قد ارتبطت بالمحافظين الجدد في أمريكا من اجل توسيع دائرة الحرب والأهم إمكانية تفادي القوانين واللوائح التي تحكم القوات النظامية والمثال الأوضح هو شركة Black Water التي ارتكبت جرائم عديدة في العراق وفي أفغانستان (19)، وكذلك فعلت نفس الشىء مجموعة فاغنر الروسية والتي اقتحمت الكثير من البلدان والهدف الوحيد هو المال، وفقا لهذه القراءة السابقة لواقع المليشيات يمكن تحديد واقع قوات الدعم السريع وفق المحاور التالية:
أولا: لقد نشأت هذه القوات في ظل نظام استغل الجانب الديني والعرقي لتثبيت حكمه وأشاع لدى بعض القبائل العربية في دارفور بكونهم مهددون في وجودهم من قبل القبائل الإفريقية، ممثلا ذلك في الحركات الحاملة للسلاح ودعاهم للدفاع عن وجودهم.
ثانيا: هذه الدعوة كان من الممكن أن لا تنجح لو لا أنها قد ارتبطت بعامل آخر وهو دخول المال كعامل أساسي ومهم في تجميع هذه القوات حيث تحول المال ليحل محل فكرة الدفاع عن القبيلة وبالذات بعد أن اسهمت هذه القوات ومعها القوات النظامية في كسر شوكة الحركات المسلحة، حيث أصبح تطلعها أوسع للسيطرة على المصادر المالية، ونتيجة لحاجة نظام البشير لها ومن أجل حماية النظام، فإنه قد فتح لها المجال للسيطرة على بعض الموارد وكما أوضحنا ذلك سابقا والمتصلة بالذهب واليورانيوم، وتحولت هذه القوات وبهذا المعنى إلى إمبراطورية اقتصادية وأصبح هدفها الأساسي الحفاظ على مصالحها وبكافة الطرق الممكنة لأن الجانب الاقتصادي قد أصبح الرابط بين أعضائها والضامن لوجودها.
ثالثا: وفق هذا الجانب الاقتصادي والمذكور سابقا فقد تحولت هذه القوات إلى قوات عابرة للحدود حيث دخلت كطرف في حرب اليمن وبإرسال بعض جنودها ومن أجل المال وتعاقدت مع دول الاتحاد الأوربي ماليا من أجل محاربة ما يطلق عليه الهجرة غير الشرعية، وهكذا فقد خرجت هذه القوات خارج دائرة الدولة، وأصبح لديها تعاملات مع بعض الدول متجاوزة حدود دولتها وذلك من أجل جمع المال، والأخطر أن السعي للنفوذ والمال قد أدى إلى الصراع بين أبناء القبيلة الواحدة التي تنتمي إليها هذه القوات ممثلا ذلك في موسى هلال ومحمد حمدان دقلو، وبهذا المعنى فقد سقط حتى مفهوم الدفاع عن القبيلة الذي روج له خطاب (الإسلاميين) وأصبح الدفاع عن المال وتأمينه هو ضمن الأهداف الأساسية والتي ارتبطت بتاريخ هذه القوات، وفقا للتحليل السابق فكيف يمكن توصيف قوات الدعم السريع؟
قوات الدعم السريع وماهية التوصيف السياسي
قبل التوصيف السياسي لطبيعة هذه القوات، فإن كاتب هذه الدراسة يقف ضد كل الاتجاهات التي تحاول الإقلال من شأن هذه القوات ولقائدها وعبر الإساءة، وكذلك يقف ضد المحاولات التي تسعى إلى تغريبها ونفي سودانيتها. إن النقد لهذه القوات يجب أن يتم على أسس موضوعية ليس فيه تعدي ويجب أن يأتي مقرونا بالدلائل والوقائع وهذا ما نشتغل باتجاهه عبر هذه الدراسة، وإبتداءً نقول، لقد أتيحت الفرصة التاريخية لهذه القوات لكي تتحول إلى قوات تحرير وطني ضد الديكتاوريات وتكون ضمن القوى الوطنية عندما اتخذ قائدها موقفا عارض فيه قرار عمر البشير رئيس سلطة الإنقاذ في ضرب المتظاهرين إبان حراك ثورة ديسمبر 2018، ولكن لم يستطع قائد هذه القوات تطوير موقفا يجعله واقفا في صف الحركة الجماهيرية، إذ سرعان ما عاد ليكون جزءا من السلطة وعبر ما عرف حينها بالمجلس العسكري، ومشاركا في دورة العنف التي استهدفت ميدان اعتصام الجماهير إبان هذه الثورة، وقد حدثت مجزرة راح ضحيتها الكثير من الشباب والشابات وتعطلت نتيجة لذلك أهداف الثورة، وقد عاد قائد هذه القوات مرة أخرى ليخرج عن مجرى السلطة في معارضته لانقلاب البرهان الذي حدث في أكتوبر 2021 والذي كان شريكا أصيلا فيه ليذهب تجاه القوى المدنية ضمن ما عرف حينها بالاتفاق الإطاري، واستمر الحال حتى حدث الصدام بين الجيش وهذه القوات في حرب أبريل 2023، هذه الحالة من الصعود والهبوط في تفكير قائد هذه القوات والذي بدأ يتحدث عن الديمقراطية والدولة المدنية مؤخرا تنتج عن طبيعة تكوين هذه القوات والمعايير التي قامت عليها، فهي كانت محكومة بالواقع والظروف التي نشأت فيها من حيث وعي قيادتها ومحدودية دورها في العمل السياسي المباشر لأنها كانت محكومة بطبيعة النظام الذي نشأت في كنفه وبكافة أشكاله الديكتاتورية ونمطه الرأسمالي الطفيلي والتي أصبحت هذه القوات جزءا منه، ولهذا فهي وبكل القياسات الممكنة ليست قوات تحرير وطني بل هي مليشيا من حيث التنظيم العسكري وقد نشأت في واقع صراع قبلي ، وتحولت لاحقا وضمن نمط النظام الحاكم والمرتبط بالفساد لتكون قوات همها جمع المال، أي أنها أصبحت قوات مرتزقة ولهذا فإن المصطلح الصحيح لهذه القوات هو ميليشيا- أرزقية أي ميليشيا تعمل علي الإرتزاق وجمع المال ودون اعتبارات للواقع الوطني والذي تم تدميره أصلا عبر حكم (الإسلاميين). وقد كشفت هذه الحرب الدائرة اليوم في السودان عن ممارسات بعض أفراد هذه القوات والتي سعت إلى تجريد المواطنيين من ممتلكاتهم وطردهم من بيوتهم، وبالرغم من استنكار قائد هذه القوات لتلك الأفعال والتي قد لا تأتي منفصلة عن حالة وثقافة النهب الأكبر لموارد السودان منذ أن تشكلت هذه القوات. الدليل الأكبر على أن هذه القوات قد تأسست على قاعدة المال، هي هذه الحرب التي تخوضها هذه القوات و لأكثر من السبعة شهور بالرغم من تكلفتها العالية، وهذا يؤشر لحجم الأموال التي تملكها هذه القوات والتي توازي إمكانيات القوات المسلحة أو تفوقها، والتي قال حميدتي في إحدى خطبه أنه قد اشترى لها أي القوات المسلحة خمسة طائرات عندما كانت العلاقة طبيعية بينه وبينها، لقد تأتت اللحظة التاريخية لقوات الدعم السريع لتتحول لقوى وطنية تحررية عندما رفض قائدها ضرب المتظاهرين بعدما أمره عمر البشير بفعل ذلك كما أوضحنا ذلك سابقا، ولكنه وبعد أن سقط نظام عمر البشير فإنه ذهب مع السلطة التي قامت بفض الاعتصام أمام القيادة العامة، السؤال الذي يطرح نفسه جديا هنا هو: لماذا لم يعترض قائد الدعم السريع على فكرة فض الاعتصام إذا كان هو منحازا للحركة الجماهيرية ومنذ البداية؟ وإذا لم يكن يعلم بقرار فض الاعتصام كما يقول بعض أنصاره، فلماذا لم يتخذ موقفا يجعله واقفا ضد الذين قاموا بذلك وبعد أن حدثت جريمة فض الاعتصام ومن ثم قطع صلته بالمجلس العسكري ومن ثم الانحياز للحركة الجماهيرية؟ وإستنادا لحالة التردد هذه فإن قائد الدعم السريع يبدو وكأنه يتعامل في السياسة بمفهوم أقرب لحركة التاجر الذي يوزن الأمور ضمن منظور الربح والخسارة، وبهذا المعنى فهو لا يذهب مع الخاسر، ولهذا فقد ترك عمر البشير عندما تأكد أنه غير قابل للاستمرارية تحت ضغط الحركة الجماهيرية، وبنفس الدرجة وبعد أن شارك في انقلاب البرهان ورأى أن هذا الانقلاب كان فاشلا نتيجة لضغط الحركة الجماهيرية فقد انتقد نفسه ودوره في ذلك الانقلاب وذهب تجاه القوى المدنية عبر الاتفاق الإطاري، هذا التردد في الانحياز الكامل للحركة الجماهيرية يطرح أسئلة عديدة بدلا من أن يقدم أجوبة وهذا ما يجعلنا نناقش مستقبل هذه القوات على الخارطة السياسية السودانية مستقبلا.
المستقبل السياسي لهذه القوات
مستقبل أي حركة سياسية يرتبط بماضي هذه الحركة ولا يأتي منفصلا عنها، أي بمعنى آخر فإن طبيعة ونشأة أي حركة سياسية يرتبط بتطورها اللاحق ويحدد مساراتها، ولهذا فعند النظر إلى نشأة قوات الدعم السريع والظروف التي أنتجتها علاوة على الفئات المكونة لها وطبيعة الوعي الذي يحكم هذه الفئات، فإنها لا تخرج من كونها مجموعات غير متجانسة إلا من حيث الاعتبار القبلي والمناطقي، إذ تنعدم الرؤى والتصورات التي تجعل منها مجموعة تسير على نهج واحد وهذا يؤشر لعدم وجود مشروع يرتبط بمنطلقات تقود إلى تشكل حركة سياسية يمكن أن تقود المجتمع ككل نحو التغيير، ولهذا فيمكن قراءة هذه القوات ضمن منظور الثابت والمتحول، إذ الثابت النسبي في واقع هذه القوات وعلى الأقل عبر السنوات القادمة هو بقاء تفكير قاعدتها على طبيعة النشأة التي ارتبطت بهذه القوات لأن التحول في هذه القاعدة يحتاج إلى جهد غير عادي لوضعها في مهمة التغيير السياسي والاجتماعي، وهي مهمة صعبة إذ أن استرجاع وزرع الوعي لقوى وبعد أن تكونت على أسس غير صحيحة يبدو مهمة صعبة معقدة، أما المتحول والنسبي كذلك في مجرى هذه القوات هو وعي قياداتها والمتمثل في محمد حمدان دقلو والذي يتمتع بذكاء جعله يتحول من حواف البوادي إلى أخطر شخصية في السودان وأن يتقاطع مع عمر البشير ويرفض الصدام مع الجماهير وكذلك لموقفه ضد انقلاب البرهان وطرحه لشعارات الديمقراطية والدولة المدنية، وهنا يبرز سؤال إذا ما كانت هذه المواقف والشعارات تكتيكية أم ترتبط بالحفاظ على المصالح وحفظ مكانة هذه القوات وفي كل الظروف؟ أم هي تعبر عن تحول حقيقي لدى قيادة هذه القوات وتعد انسلاخا عن وعي القبيلة والرأسمالية الطفيلية التي تم وراثتها عن (الإسلاميين)؟ كلها أسئلة تظل مشروعة، لكن المهم في كل هذا هو علاقة هذه القوات بالحركة الجماهيرية وكذلك مشروعها السياسي والاقتصادي والاجتماعي مستقبلا ومدى قدرتها على اقناع الجماهير بأطروحاتها، والأهم من كل ذلك القدرة علي تبرير مواقفها وممارساتها التي أضرت بالجماهير سواء كان ذلك قبل هذه الحرب أو من خلالها أو من خلال علاقتها السابقة بالحركة الإسلاموية والتي قطعت الجماهير صلتها بها، وهنا تكمن القضية ومن ثم الماهية التي يمكن أن تكون عليها هذه القوات مستقبلا، حيث أن الشعارات التي يطرحها قائدها أثناء هذه الحرب وحدها لا تؤدي إلى لعب دور فاعل إذا لم ترتبط بفكرة تتجلى في الواقع وتحدث فيه متغيرات، حيث وضمن التجربة الواقعية فقد حكم (الإسلاميون) السودان بالشعار ولم يقدموا أي نقلة حضارية للسودان كما كانوا يطرحون شعار المشروع الحضاري، ولقد قلنا وضمن إحدى الفرضيات أن القوى التي تنشأ تحت إشراف هكذا نظام أي نظام (الإسلاميين) فهي بالضرورة تحمل نمطه ونسقه المعرفي، ولقد حملت قوات الدعم السريع نمط (الإسلاميين) المرتبط بالرأسمالية الطفيلية من جهة، ومن جهة أخرى تلبست نسقهم المعرفي المرتبط بالشعارات، وهذه الشعارات تكون أحيانا مرتبطة بالديمقراطية وأحيانا أخرى بالشورى كما صرح قائد هذه القوات في إحدى خطاباته، والفرق شاسع بين الشورى من جهة ومفهوم الدولة المدنية والديمقراطية من جهة أخرى، وهنا نحن أمام متناقضات جذرية نتجت عن طبيعة الوعي الذي حكم مسار هذه القوات والتي تم وضعها على حواف السلطة دون استعداد لدور قيادي في واقع معقد كالواقع السوداني، وضمن هذه الرؤية المرتبطة بالمستقبل السياسي لهذه القوات يدخل جانب جوهري ومهم وهو مدى قدرة هذه القوات على التماسك الداخلي بعد إنتهاء هذه الحرب. المعروف أن تكوين هذه القوات قد استند على قاعدة قبلية كما ذكرنا ذلك سابقا واحتوت على قبائل متعددة، بل يمكن القول أنها قد احتوت لاحقا علي تيارات مختلفة أثناء هذه الحرب، سواء كانت تيارات سياسية أو مجموعات تابعة للحركات المسلحة، وهذا وضع قابل للصراع والتشظي إذا ما انتهت هذه الحرب حيث أن ما فرضته هذه الحرب من وحدة ظاهرية بين هذه المكونات يبدو قابلا للصراع بعد إنتهائها، والأسباب الجوهرية في ذلك يمكن تلخيصها في الآتي:
1-العلاقة التي تجمع بين غالبية هذه المكونات لا تقوم على أساس عقائدي أو فكري إنما على أساس قبلي وجهوي كان محكوما بدور الدولة من جهة، ومن خلال دورة المكاسب والمال من جهة أخرى، وهذه المعادلة قابلة للتغيير بعد الحرب لأنه لن تكون هنالك رعاية مباشرة من الدولة لهذه القوات إلا إذا أصبحت هي الدولة، كما ان العامل المادي هو الآخر قابل للتغير والانحسار.
2- في حالة سيطرة هذه القوات على مستوى الأرض ومن ثم قيادتها للمشهد السياسي فإن هذه الحالة نفسها قابلة للصراع الداخلي علي أساس المكاسب والدور سواء كان على الأساس القبلي أو على أساس واقع التيارات المختلفة داخلها، وهذا يمكن أن يقود إلى صراع آخر ستكون أدواته هي السلاح مما يفتح المجال لدوامة عنف أخرى في السودان.
3- العاملان المذكوران سابقا يمكن تلافيهما إذا ما توفرت ظروف تحدي جديدة أمام هذه القوات مثل الدخول في حروب أخرى داخلية أو خارجية، لكن في حالة السلم فإن الصراع الداخلي سيستمر داخل هذه القوات على أساس سلطة المال والغنيمة مدعوما ذلك بالنزوع القبلي والمناطقي محكوم كل ذلك بالوعي الذي اكتسبته هذه القوات عبر مسيرتها والتي تحدثنا عنها سابقا، الجزئية الأخيرة في هذه الدراسة تتصل بجانبين، الجانب الأول يرتبط بالعلاقات الخارجية لقوات الدعم السريع، أما الجزء الثاني سيناقش مقولة حميدتي والتي قال فيها أنه لا يتطلع للحكم مستقبلا، فيما يتعلق بالجزء الأول والمتعلق بالعلاقات الخارجية فإن ارتباطات قوات الدعم السريع ببعض الدول تطرح أسئلة متعددة حول أجندة هذه القوات، على رأس هذه العلاقات هي علاقة قيادات هذه القوات بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث تتم على مستويين، مستوى اقتصادي يأتي مترابطا مع تهريب الذهب خارجيا ومستوى سياسي حيث تقود الإمارات العربية المتحدة حركة التطبيع مع الكيان الصuيوني في المنطقة وبالتالي فإن الارتباط مع الإمارات يقود وبالنتيجة للارتباط مع الكيان الصuيوني ومن حيث مبدأ التبعية، ويأتي كل هذا مترافقا مع مشروع التجزئة ضمن واقع المشروع الصuيوني- الأمريكي للمنطقة حيث تبدو هذه الحرب الدائرة في السودان اليوم إحدى تجليات هذا المشروع والذي تم فيه تغييب السودان وتراجع دوره للإسهام في الصراع العربي- “الاسرائيلي” وقضايا المنطقة الأخرى، ورأس الرمح في ذلك قوات الدعم السريع ومعهم الإسلاميين صناع التجزئة، يضاف إلى العلاقة المذكورة سابقا مع الإمارات توجد علاقات أخرى مع بعض الدول الإفريقية مثل مالي والنيجر وإفريقيا الوسطى وتشاد، وحتى مع روسيا عبر فاغنر، وهذه العلاقات تشير إلى وقوع قوات الدعم السريع في دائرة المحاور، وهي محاور لا تصب في مصلحة السودان مستقبلا، أما الجانب الثاني والمرتبط بمقولة حميدتي بكونه لا يسعى للحكم فإنه يثير السؤال التالي: هل يخوض حميدتي هذه الحرب والتي يفقد فيها الكثير من رجاله من أجل أن يسلم السلطة للأحزاب السياسية الأخرى ويتخذ دور المراقب؟ أم عدم السعي للحكم يشير إلى حالة تجرد ذاتي تتنامى عند حميدتي في السنوات الأخيرة؟ أم يشير الأمر كله لعدم وجود مشروع أو خط سياسي للحكم والذي يؤهل هذه القوات للحكم مستقبلا؟ كلها أسئلة تحتاج لإجابة، لكن الراجح وفي تجربة القوى أو الحركات السياسية في أنها تسعى للحكم لأنها وعبر الحكم يمكن أن تستطيع إنفاذ مشاريعها ويصبح هذا حقا مشروعا لها، ولكن ما يطرحه حميدتي حول مفهوم عدم تطلعه للحكم يمكن قراءته على المستويات والاحتمالات التالية:
1- ربما يشير الأمر إلى جانب موضوعي يرى فيه حميدتي أنه غير مؤهل لحكم السودان واضعا تاريخه وعلاقته مع النظام السابق في الاعتبار..
2- قد تكون دلالة لا أريد أن أحكم قد تشير إلى الحكم المباشر، لكنه ضمن الحكم غير المباشر فهو سيكون موجودا لتوجيه العملية السياسية حسب توجهاته ووفق القوة التي ستؤول إليه إذا ما حسم هذه الحرب لصالحه.
3- لقد طرحت هذه القوات وعبر مستشاريها مؤخرا قضية تفكيك دولة 56 متماهية مع خط الحركات المسلحة الدارفورية وقبلها الحركة الشعبية، أو تبني منظور دولة الهامش، وهذه مهمة ومع الإختلاف حول منطلقاتها صعبة ومعقدة، ولا يقوم بها إلا من يريد أن يفرض أجندته على الواقع وهذه النقطة وفي تقديري هي التي تنفي مقولة حميدتي التي تتحدث عن البعد عن الحكم، فالذي لا يريد أن يحكم لا يتبنى الأجندات الخطرة وهذا الأمر يجعل كل ما يقوله حميدتي يأتي مرتبطا بالتكتيك من جهة وبالشعار من جهة أخرى، دون أن تكون هنالك دلائل من الواقع تسنده وهنا تتجلى مشكلة قوات الدعم السريع وقائدها، فحتى الشعار الأخير والذي تطرحه قيادة الدعم السريع وبالرغم من أهميته وهو المتعلق بحرب الفلول، لم يتأتى هذا الشعار عن موقف إبتدرته تلك القوات، بل فإن الفلول هم من إبتدر الحرب ضد قوات الدعم السريع وأصبحت هذه القوات في موقف المدافع في بداية هذه الحرب، وبعدها تم طرح شعار محاربة الفلول من قبل قائد الدعم السريع من أجل البحث عن غطاء شرعي، ويجب التأكيد هنا، أن قائد الدعم السريع قد طرح فكرة مسبقة أمام الحركة الجماهيرية بكون قواته ستحارب من أجلها، وقد خاضت هذه الحرب وعلى هذا الأساس حينها لتطابق الموقف مع الشعار، لكن الراجح أن الشعار قد جاء ضمن منظور (الملاحقة) وهذا المنظور هو الذي حكم حركة وتطور هذه القوات، ومنها ملاحقة شعار الديمقراطية حيث تنعدم الديمقراطية داخلها، وملاحقة مفهوم الدولة المدنية حيث أن تكوينها يتعارض مع مفهوم الدولة المدنية نتيجة لأساسها القبلي، وبالنتيجة فإن هذا المنظور يمكن وصفه بالمنظور الفوقي والذي لا يتأسس على بنية أو قاعدة ذات أسس مبدئية ملتحمة مع قضايا الناس لأن القاعدة التي تتأسس على البندقية للدفاع عن الديكتاوريات تظل فاقدة للهدف المركزي والمرتبط بقضية التغيير لأنها قاعدة محكومة بالمصالح وليس المبادىء.
خاتمة
هذه الدراسة حاولت الربط بين فشل الدولة السودانية تاريخيا وبالذي يحدث في الراهن من خلال هذه الحرب الدائرة اليوم، كما أنها ناقشت طبيعة الصراع في دارفور ملقية الضوء علي إقليم دار فور وطبيعته ومن جانب تاريخي وجغرافي، وأوضحت ووفق الفرضية المرتبطة بالأبعاد الاقتصادية والسياسية وانعكاسها على طبيعة ونشأة أي قوى، أوضحت وناقشت طبيعة إقليم دارفور وطبيعة الصراع فيه مرتبطا ذلك بالواقع السياسي العام الذي سيطر فيه (الإسلاميون) على الدولة وفي هذه الظروف فقد تم إنشاء قوات الدعم السريع والتي لم تتجاوز مستويات الواقع الاجتماعي والاقتصادي لإقليم دار فور إلا من خلال النقلة التي أحدثها نظام (الإسلاميين) تجاه هذه القوات وبالذات تجاه الجانب الأقتصادي، ولقد حددت هذه الدراسة طبيعة العلاقة التي ربطت بين نظام (الإسلاميين) وهذه القوات والقوانين التي صممها نظام عمر البشير لهذه القوات والتي تمتعت عبرها بالحصانة، ومن أجل الإجابة على السؤال الرئيسي لهذه الدراسة فقد حللت هذه الدراسة وناقشت مفهوم ومضامين قوات التحرير والمليشيا والمرتزقة وحددت طبيعة هذه القوات بكونها لا تخرج من مفهوم المليشيا وبجانبه السلبي الذي يرتبط بالأنظمة الديكتاتورية وبالمال مما يحولها لقوات مرتزقة، وأخيرا فقد حللت الدراسة ونظرت في مستقبل هذه القوات في مستقبل السودان مستبقة هذا المستقبل ضمن المعطيات الحالية وضمن ربط هذه الحالة بالشعارات التي يطلقها قائد قوات الدعم السريع ومدي مصداقيتها، حيث أوضحت هذه الدراسة أن مشروع التغيير والمرتبط بتطور المجتمعات يحتاج إلى الفكر الذي يتجلي في الواقع وبالتالي فأن الشعارات والتي يطرحها قائد الدعم السريع تنسجم وطبيعة الشعارات التي تم طرحها من قبل نظام (الإسلاميين) والذي نشأت قوات الدعم السريع في كنفه، حيث لم تؤد شعارات (الإسلاميين) إلا لتدمير السودان وبالرغم من قوة هذه الشعارات، وهنا توجد الفرضية المطروحة في الدراسة والتي تقول أن أية قوى تنشأ في ظل نظام مثل نظام (الإسلاميين) ومرتبطة به وليست ضده بأنها ستحمل نمطه ونسقه المعرفي وهذا ما تحقق من خلال نمط الرأسمالية الطفيلية الذي انتقل لقوات الدعم السريع، والنسق المعرفي الذي لا يتجاوز الشعارات ومن هنا تتم مساءلة واختبار مشروع قوات الدعم السريع وبالتالي مستقبلها السياسي في السودان، إن أي عمل بحثي محكوم بفجوات وبفرضيات قابلة للنقد وهذا ما يتقبله كاتب هذه الدراسة ويتحمل مسؤولية الكتابة هنا وعلى أسس يراها موضوعية.
المصادر:
1-احمد عبد القادر ارباب- تاريخ دار فور عبر العصور-الخرطوم 1998..بحث غوغل
2-عبد البادي محمد ابكر – تاريخ سلطنة الداجو-
3-مصطفي محمد مسعد- سلطنة دار فور تاريخها وبعض مظاهر حضارتها – دار المصورات للنشر..كتاب علي النت..
4-مصطفي محمد مسعد..المصدر السابق.
5-احمد عبد القادر أرباب- المصدر السابق..
6-سلمان محمد احمد سلمان- قوات الدعم السريع النشأة والتمدد والطريق الي حرب أبريل- مركز ابحاث السودان 2023م..كتاب علي النت..
7- سليمان محمد احمد سليمان- المصدر السابق
8- سليمان محمد احمد سليمان- المصدر سابق..
9-سليمان محمد احمد سليمان- المصدر السابق
10-سليمان محمد احمد سليمان..المصدر السابق
11-en.m.wikipedia.org.12.. alarabia.net
13- المصدر السابق..
14- قدس..مفهوم التحرير- www.qudsn.com
15- نفس المصدر السابق
16- قاسم بلشان التميمي- الميليشيات ما هي؟ ولماذا..معهد ابرار معاصر- طهران- www.tisri.org
17- قاسم بلشان التميمي..نفس المصدر السابق.
18- علاء اللامي- ولماذا تستفز هذه الكلمة(Militia ) ما معني الميليشيات في العراق- الحوار المتمدن-2021م-
www.m.ahewar.or g.
19-Jeremy Scahill-
Black Water: The Rise of the Most Powerful Mercenary Army– Nation Books-و. وNew York- 2007