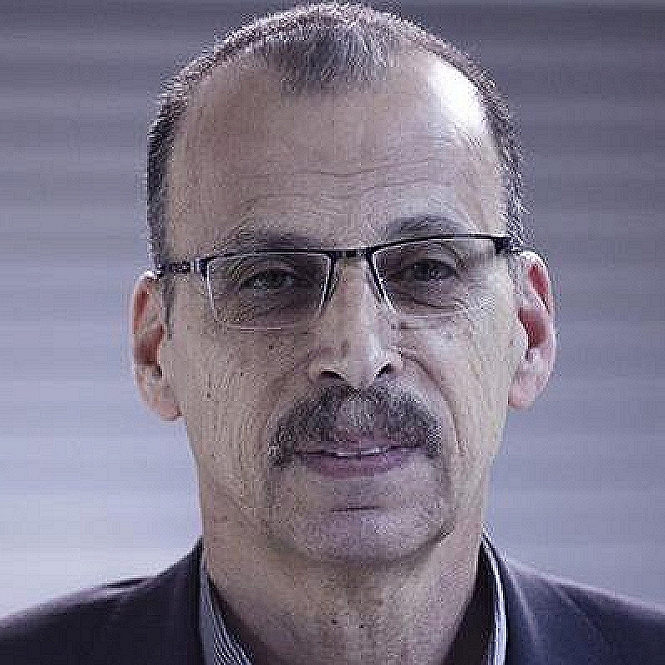أصول العلوم السياسية العربية / الاسلامية
بقلم الدكتور ضرغام الدباغ / برلين
العدد : 441
التاريخ : أبريل ــ نيسان / 2025
حين درسنا العلوم السياسية في ألمانيا بين: 1975 ــ 1982، بذل معنا الأساتذة الألمان جهداً كبيراً، ممتن منهم ليومنا هذا، فقد تعلمنا (وهذا كان الأهم) أساسيات العمل الاكاديمي، كيف نفكر (Denksystem) وكيف نقرأ ونكتب، ومن جهتي كنت أفكر كدراسات عليا باحث كيف يمكننا أن نخدم العلوم السياسية في بلادنا العربية / العراق، وكيف نستطيع العمل في تطوير الفكر السياسي العربي والنظام السياسي العربي، إذ كنت على قناعة أن هناك فكرا عربيا / إسلاميا ، وهذا بحر واسع متلاطم الأمواج وعلينا الكثير، والكثير جداً لعمله.
ندرس في الجامعات العربية الفكر السياسي الاغريقي (بتركيز على سقراط، وافلاطون، وأرسطو، وسولون)/ والروماني (بتركيز على سنيكا وشيشرون). وتنتاب الشكوك الاعمال الاغريقية (سقراط، افلاطون، أرسطو) حول صحتها، فالفارق بين نسخة وأخرى كبير جداً ولا توجد نسخة أصلية للكتب.، فهي موجودة بنسخ عديدة، وجرى تجميعها خلال عشرات وربما مئات السنين، حتى أن العالم / المرجع جورج سباين يكتب بصراحة عن المؤلفات الاغريقية هذا ما هو موجود والقارئ ليس لديه خيار (take it or leave it) خذه أو دعه. في حين أن أصول المراجع العربية ما تزال محفوظة بخطوطها الاصلية، (شاهدت بعضها بنفسي في باريس).
أنقطع الفكر الأوربي لقرون طويلة عن تقديم شيئ يستحق الذكر إلى عصر النهضة (بين القرن 15 وحتى القرن 17) ومع أن هؤلاء المفكرين الأوائل قدموا للإنسانية منجزات فكرية، إلا أن المفكرين والعلماء في وادي الرافدين ووادي النيل وبلاد الشام واليمن، في عصور قبل الميلاد، قدموا بدورهم منجزات فكرية وعلمية لا تقل عنهم أهمية، في مجالات عديدة، في مقدمتها الهندسة(سد مأرب)، والرياضيات(قناة سنحاريب)، والقانون (مسلة حمورابي).
في المجال السياسي، نجح عصر النهضة الأوربي (بين القرن 14 وحتى القرن 17)، بتقديم منجزات مهمة، ولكن المنجز السياسي لم يكن شيئاً خارقاً، أمام منجزات العلماء العرب التي تواصلت حتى القرن الخامس عشر،: (حتى سقوط الأندلس) أبن خلدون، الفارابي، الماوردي، ابن رشد، أبن الأزرق، الطرطوشي، أبن أبي الربيع، فهؤلاء علماء كبار تعلم منهم الأوربيون، وأعمالهم تدرس في الجامعات الأوربية كمراجع. ومن بين أروع ما قدمه الأوربيون في تلك المرحلة وبعده ” عصر التنوير ” كان كتاب أنطونيو ميكافيلي “الأمير” و”المطارحات”، والأفضل كتاب جان جاك روسو “العقد الاجتماعي”، ثم العمل الممتاز لشارل مونتسيكيو “روح القوانين” ، ولكن أي منها لم تكن متفوقة في جوهرها وعمقها على الأعمال العربية كمقدمة أبن خلدون، والاحكام السلطانية للماوردي، وأبن أبي الربيع وأبن الأزرق بصفة خاصة.
العمل الأوربي المهم، الذي قاد حقاً لتداعيات ومتابعات مهمة كان كتاب “ثروة الأمم”، لآدم سمث وهو عمل اقتصادي بالدرجة الأولى، يطالب بتحرير العمل ورأس المال من أي قيود، مطلقا، أن : “الفكر لا يعمل ولا ينتج إذا كانت الأيدي مغلولة ” ولكنه أستثمر ً كثيرا سياسيا، ومنها ومعها أبحرت سفينة الديمقراطية في صياغة أفكار في نظام الدولة مؤسسة على احترام قوة رأس المال، ومؤسساته، وضمان حريته انطلاًقاً من مقولة آدم سمث ” دعه يعمل دعه يمر/ let him work let him pass ” تأسس عليها الكثير من الأفكار الديمقراطية رغم كونها مصطلحا اغريقياً في الأساس، إلا أن المجتمع الاغريقي لم يكن ديمقراطيا، بل طبقياً واضحاً، وحادا حيال العبيد والفقراء يحرمهم من المزايا الاجتماعية، فيما ينال النبلاء، كل المزايا.
وتطور الأنظمة الرأسمالية في غرب أوربا بدأ من هولندا، ثم بريطانيا، وفرنسا ثم بانتقالة صعبة لوسط أوربا (ألمانيا / النمسا) ولكنها تعثرت بتأثيرات الحركة الفاشية الإيطالية، وحين انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، اكتسبت مزايا وخصائص جديدة، حتى يحق القول أن تجربة أنظمة الحكم في أوربا وأميركا الشمالية، لم تكن متماثلة تماماً مع أوربا رغم وجود خصائص مشتركة. والأساس الجوهري هو النظام الرأسمالي الذي يرفض ” كأساس فكري وسياسي” وضع أي حدود لنشاط رأس المال، بل ويطالب بوضع أسس لكافة تفرعات الحريات الاجتماعية لضمان تقدمه وأرباحه. ورغم ذلك فالبلدان الرأسمالية المتقدمة تمكنت كل منها من تطوير نظام سياسي له خصائصه بهذه الدرجة أو تلك، ولكن البلدان الرأسمالية تطالب اليوم البلدان النامية بنسخ تجربة بحد ذاتها، ورغم أن أنظمتها ذاتها لا تخلو من هنات، وثغرات، قد لا تبدو واضحة وسط صخب إيقاع الحياة، ولكن من يعيش في المجتمعات الأوربية بوسعه أن يلاحظها، وليس هذا فحسب، بل أن أحزاب المعارضة الأوربية، وخاصة اليسارية تشير بوضوح إلى أخطاء وثغرات تعتبرها “جسيمة” وفي السنوات الأخيرة، تقدمت أحزاب البديل (اليمين المتطرف) في صناديق الانتخابات، وبرلمانات الولايات، وما سبب تقدمها الكبير، إلا أخطاء الأحزاب الديمقراطية وتعتبرها اخطاء اجتماعية فادحة،
وإذ لا نستطيع أن نحكم بدقة على حجم العمل البحثي الفكر السياسي الإسلامي لدى الشعوب الإسلامية. سأركز على عمل الباحثين العرب. وكنت أعتقد (حتى عودتي للوطن 1983) أن علماء السياسة العرب المعاصرون مقصرون في بحث جوانب الفكر السياسي العربي، الذي ينبثق من الفكر الإسلامي، ولكني حين صرت أبحث في المكتبات العربية، فوجدت أن الفكر السياسي العربي / الإسلامي مطروق بشدة بين الباحثين العرب (بالطبع بمستويات ونتائج مختلفة)، ولكن لابد من الاقرار أيضاً أن معظم الباحثين لا يبحثون بالعمق المطلوب، ولنكن صريحين أكثر لا يتناولون الجوانب التي تحتاج فعلاً للتطوير والتحديث، وفي مقدمة تلك الجوانب، ما يسمى (عصرنة/ Modernisation) اللغة والمفردات، ودعم وإسناد الأفكار ببيانات معاصرة واحصاءات ومعطيات ضرورية لتفي باستحقاقات عصرنا الراهن.
القارئ للكتب والمصادر من أمهات الكتب، للعلماء العرب، يجد صعوبات في الفهم والاستيعاب الدقيق للمصطلحات المستخدمة في القرن التاسع والعاشر الميلادي (قبل أكثر من 1000عام) ومن تلك مثلاً أعمال عظيمة تستحق أن توضع بين أيدي الباحثين ككتاب المقدمة/ أبن خلدون، والاحكام والخراج لأبي يوسف، السلطانية للماوردي وغيرها. لذلك لم تعد مفاجأة لي، أن أجد خريجوا كليات العلوم السياسية، من حملة الشهادات العالية، لم يقرأوا لأبن خلدون أو الماوردي، وحتى الفارابي، وبوسعي أن أجزم بموضوعية، أن أعمالاً عظيمة كمقدمة ابن خلدون، والماوردي، ستبقى منارة للأجيال أذا أشتغل عليها محققون يعملون على عصرنتها، وتقديمها بحقائق ووقائع ومعطيات حديثة، واحصائيات، وبتقديري أعمالاً كهذه يمكن أن يقوم بها باحثون في الجامعات العربية بكفاءة علمية. بتشكيل فرق عمل من طلبة الصفوف المنتهية في الجامعة في اقسام : العلوم السياسية، الاجتماع يعملون بأشراف أساتذة مختصون. فمن المؤسف أن نجد علماء أوربيون كبار يهتمون بأبن خلدون ويعتبرونه من أعمدة الفكر السياسي / الاجتماعي، أكثر من اهتمام علماؤنا العرب.
وباستثناء الاهتمام الواسع (نسبياً) بحركة المعتزلة، وأقل منه بكثير الاهتمام بحركة الخوارج (بفصائلها)،واهتمام شبه منعدم بحركة المرجئة، وفحصها بعين العصر، وكتابة البحوث والدراسات، وإشاعة رغبة وروح البحث والدراسة في موضوعات الحركات الديمقراطية (تقبل الرأي الآخر، واعتماد الحوار) هي خير وسيلة لتعميم روح البحث العلمي في موضوعات من صلب مجتمعنا يتفهم التطور الضروري. وفي هذه المناسبة لابد من التنويه بالجهد الكبير جداً والمفيد والمثمر الذي بذله العلامة والمفكر د. محمد عمارة ود. فهمي هويدي في هذا المجال، وأعماله من المصادر المهمة.
وفي مطالعة الكتب القديمة والوسيطة والحديثة، لا نستطيع تجاهل عدد من الثغرات في الفكر السياسي الإسلامي، بعضها هيكلي بنيوي، وبعضها شكلي بسبب تقادم الفكر دون أن يحاول علماء السياسة العرب، والمسلمون ولوجلها ومعالجتها معالجة جريئة علمية وعملية، والبحث في ابعادها وفي إشكالات تطبيقها، كالبيعة مثلاً، شروط تحققها واستحقاقها القانوني ومكانتها في الدساتير الحديثة، وأن يوضع موضع التطبيق والتنفيذ في الحياة السياسية المعاصرة، كبند أساسي ومهم.
وبتقديري يجب أن تحتل مؤسسة ” الحل والعقد” اهتماما مماثلاً، ويحدد أعضاؤها بعناية ودقة، وصلاحياتها، وأن يكون من بينها، آليات انتخاب وتعين وتثبيت اقتراح المرشح / المرشحين للبيعة، وهنا تلعب آليات تداول السلطة أهمية مضاعفة لما كانت عليه في القرون الهجرية الأولى، والوسطى، إذ أن الاقتصادات قد تطورت وكذلك معطيات السياسة الداخلية والخارجية. وبديهي أنها في عصرنا الراهن واحدة من اهم القضايا السياسية.
وتحتل الشورى، أهمية مضاعفة في عصورنا الراهنة، والشورى تعني إشراك أكبر عدد، أو ممثلين لفئات في القرار السياسي.، بكافة مراحله منذ المشاورات الأولى وحتى صياغته النهائية. والشورى كمؤسسة، إلى جانب مؤسسة الحل والعقد، والبيعة، هي من أهم الفقرات في الفكر السياسي العربي / الإسلامي، والتي تستحق من الفقهاء والعلماء بحثا ودراسة، في وضع ثوابت أساسية، لتكون نقاطاً دالة في الموضوعات التي تعبر عن هوية الفكر السياسي، التي بحسن صياغتها وتطبيقاتها، تبعد الفكر السياسي العربي عن الفردية والطغيان، والانتكاسات، وتؤكد على النظام التعاقدي الذي هو جوهر النظام السياسي العربي / الإسلامي” إِن اللَه يأْمركم أَن تؤدوا الأَمانات إِلَى أَهلِها وِإذا حكمتم بين النَاسِ أَن تحكمواْ بِالعدلِ إِن اللَه نعمَّا يعظكم بِه إِن الله كانَ سَمِيعًا بَصِيرا (58)…يا ايها الذِينَ آمَنواْ أَطِيعوا اللَّهَ وَأَطِيعواْ الرسول وَأُولِي الۡأمرِ مِنكم فإِن تنازعتم فِي شيءٖ فردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِن كنتم تؤمِنونَ بِاللَّه واليومِ الۡأٓخرِ ذلك خير وأَحسن تأۡوِيلا ﴿59﴾ ” سورة النساء
من المهم التمعن بهذه العناوين الهامة، وتحديد أبعادها، ومن غير المفيد تغيير أسم البرلمان إلى المجلس الوطني، أو مجلس الشورى، ولكن دون تحديد جوهر العملية الشوروىة، من هم عناصرها، وشروط أفرادها، كم هي أعدادهم بالنسبة إلى القوى الاجتماعية التي يمثلونها، بحيث يأتي تمثيل مجلس الشورى واقعياً ومفيداً، والمسألة ليست تكريماً ولا تشريفاً، بقدر ما هي تفعي عمل هذه القوى الاجتماعية بالإيقاع المطلوب في العملية السياسية والاجتماعية.
الحيلولة دون النظام الفردي، وعدم السماح بتوفير ظروف الطغيان والديكتاتورية، هو الهدف الجوهري الأول، والهدف الثاني هو منح المرونة لتغير رأس النظام (الملك، الرئيس، الأمير) سلمياً، وأن تكون هناك “هيئة، تشكيلة، لجنة” قادرة على إنهاء حكم الرئيس / الملك / الأمير (خلعه) في عملية تشاورية، وتحديد مهام المؤسسات الثلاث: البيعة، الحل والعقد، الشورى. وصياغة نظام يحول دون تحول النظام إلى نظام فردي / اقطاعي.
وبالطبع مثلت الشريعة (القرآن والسنة) المصدر الرئيسي لتفقه العلماء والمفكرين العرب، ولكن الأحداث السياسية، الداخلية منها والخارجية، إضافة للمتوارث من أنظمة الحكم والسياسة، كان لها دورها. في منح السمات والمؤشرات للأنظمة العربية. فقد طرح التطور في الإسلام نتيجة الفتوحات والاجتهاد وتحرير الأمصار العربية، أحداثاً سياسية فتحت آفاقاً جديدة للتطور الفكري السياسي بالاتجاهات الرئيسية التالية:
1 . مشكلات الإمامة والخلافة، التي استحوذت على الاهتمام الواسع وأفرزت الحركات السياسية.
2 . الأحداث الكبرى والسير والمعارك، الفتوحات والمفاوضات، الهدنة والتحكيم، وغيرها مما رافق تلك الأحداث.
3 . كشف أسباب النزاعات والصراعات والخصومات السياسية والقبلية والتيارات الفكرية وأسباب ظهور الفرق والمذاهب والحركات وتطورها.
4 . بحوث في النظام المالي للدولة الإسلامية والموضوعات الاقتصادية الرئيسية.
5 . النظام القضائي وفلسفة العدالة ومناهج الفقه والعدل.
6 . مباحث في الإدارة والتنظيم السياسي.
7 . العلاقات الاجتماعية والسياسية والمالية مع غير المسلمين.
ولم يصل الفكر العربي الإسلامي إلى قمة نضجه بسهولة ويسر، بل أن ذلك كان نتيجة لمسيرة طويلة مضنية كانت حافلة بالتجارب الثرية التي أغنت الفكر ونحته سمة أساسية وهي الواقعية وقابلية التحقيق، فلم يكن الفكر السياسي العربي الإسلامي يدور حول مشاريع خيالية، بل كان يعالج مشكلات سياسية / اقتصادية/ اجتماعية، ويضع الحلول أو يتصورها في شتى الظروف التي مر بها النظام العربي الإسلامي، فالقاضي أبو يوسف كتب رائعته “الخراج” والنظام السياسي في بداية عصر الفكر الذهبي وازدهاره، والماوردي كتب ” الأحكام السلطانية” وقد تراجعت هيبة دولة الخلافة، أما أبن تيمية فقد ألف “السياسة الشرعية” في ظل اندحار النظام العربي، أما ابن خلدون، فقد كتب ” المقدمة ” والأندلس تعيش عصر ملوك الطوائف، وفي كل هذه الظروف المتفاوتة: مزدهرة، متدهورة، منحطة، والمفكر العربي كان يتأمل ويفكر وينتج وكانت مسيرة الفكر السياسي تتقدم وتسجل منجزات،.
وفي أواخر العصر العباسي ظهرت نهضة فكرية، وبالطبع لذلك ظروفه الذاتية والموضوعية، نختصرها بنضج التجربة والفكر معاً لشجرة غرست في بداية تأسيس الدولة العربية الإسلامية(في العهد ألراشدي) ودارت خدمتها في العصر الأموي والعباسي الأول، فشبت ونهضت في أواسطه، وتسامقت وازدهرت في متأخره، نهضة فكرية عارمة، وكان عدد المفكرين والفلاسفة والكتاب في قضايا العلوم السياسية والفكر السياسي كبير جداً، قمنا بإحصاء المشهورين منهم فبلغ 33 كاتب ومفكر في الشؤون السياسية و27 في قضايا الحكم والدولة والإمامة والخلافة، ومن بين هؤلاء من بلغ الشهرة، مثل: الجاحظ، والإمام الغزالي وأبن الجوزي وغيرهم كثير، هذا عدا عن كتب كثيرة حول جوهر وأعمال الوزارة والوزراء والخلفاء والحجاب وأخبار التاريخ السياسي للأشخاص والدولة.
وإذا ركزنا هنا على مساحة الفكر السياسي الذي تضمنته الشريعة فإننا نلاحظ أن المبادئ السياسية تركزت في ستة منظومات سياسية رئيسية:
1 . منظومة مبادئ اتخاذ الإمارة.(نوهنا عنها في مؤسسات البعة، الحل والعقد، والشورى).
2 . منظومة مبادئ الدعوة إلى العمران، (وهي الدعوة للتنمية).
3 . منظومة مبادئ الأمر بالمعروف. (منظومات العمل الاجتماعي).
4 . منظومة مبادئ النهي عن المنكر.
5 . منظومة المبادئ السياسية العامة.
6 . منظومة مبادئ سياسية / القرار السياسي الخارجي/ العلاقات الدولية، والحرب والسلم.
ومن البديهي أن تضم كل من هذه المنظومات، أو المحاور الأساسية في ثناياها على مجموعة من المبادئ التفصيلية الفرعية، لتشكل بمجموعها المنسجم، نظرية سياسية للحكم والعمل، متلازمة مترابطة بصورة منطقية، تمنح العلوم السياسية والفكر السياسي العربي الإسلامي سماته المميزة، وقد وردت في مصدري الشريعة (الكتاب والسنة) ولكن بالألفاظ والمصطلحات السياسية السائدة في ذلك العصر. فمثلاً (النفاق) وهو مصطلح سياسي هام يعني أن القاموس السياسي المعاصر (الانتهازية)، والربا، وهو الفائدة على راس المال، أي وفق القاموس المعاصر للاقتصاد السياسي، رأس المال المالي، وهو أحدى قوانين الرأسمالية الاحتكارية. وفي مجال السياسة الدولية أحد ابرز أساليب تصدير راس المال الاحتكاري.