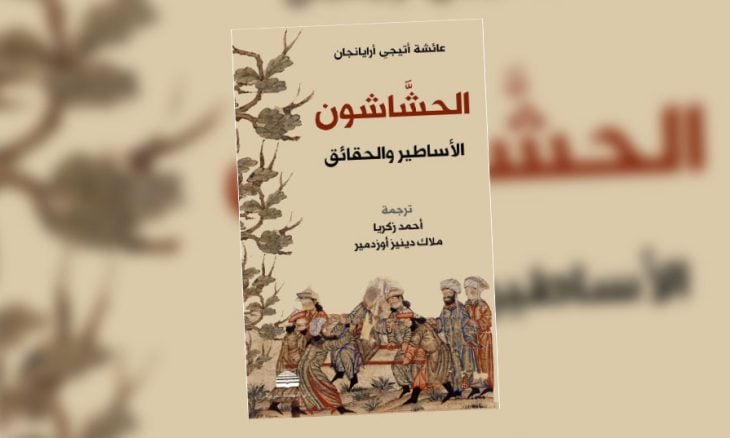الخطاب النظري كتعزيز للممارسة الفنية: تجربة شاكر حسن آل سعيد من العمل إلى الأثر

الخطاب النظري كتعزيز للممارسة الفنية: تجربة شاكر حسن آل سعيد من العمل إلى الأثر
حاتم الصكَر
يلتفت عبد الكبير الخطيبي، وهو يبحث في فن الخط والرسم المعاصر إلى ما في تجربة الفنان شاكر حسن آل سعيد من تطوير (لنظرية عرفانية ورمزية مصغّرة). وأنه «يحرر الحروف ليلقي بها في مغامرة الفن التجريدي كعنصر من تجريدية جديدة، حيث أصبح الحرف أثراً».
كان حديث الخطيبي عن مجموعة رسامين مثل رشيد قريشي وكمال بلاطة وحسين زندرودي إضافة لشاكر حسن، اختاروا استلهام الحرف العربي المرسوم بكيفيات يسمي الخطيبي منها الحروفية الهندسية التي تعيد بناء الأبجدية، والشعارية المشبّعة بالعلامات، والتزيينية الشائعة التي تعتمد النص المقروء. لكنه يضع أعمال شاكر حسن آل سعيد ضمن نمط من الحروفية التجريدية حيث يندرج الحرف في طبقات لونية تهب العمل هوية ثقافية ذات جذر علاماتي حضاري.
لقد كان الاشتغال النظري المبكر لشاكر حسن موازياً لمنجزه في الرسم، ويقترب من ميتا لوحة أو أثر. فهو يرصد مرجعيات عمله وآفاق تلقيه ومقروئيته، ودلالاته الروحية والنفسية، وكثيراً ما كان يحاور ذاته كفنان و(أنويته) كما يسميها كإنسان. ويرقب كذلك معارج نمو وعيه وإدراكه خلال العمل. ويصب جهده النظري لتفسير مكنونات أعماله، ويبسط ما لم يظهر فيها من هواجس، وما يصاحبها من نزعة فنية لتدمير اللوحة كوجود خارجي، لصالح الأثر الذي يقترب في فهمه من تفريق رولان بارت بين العمل والنص الأدبي.
لقد مضى التجريد كمرحلة أخيرة بالفنان شاكر حسن إلى الالتقاء بالفكر الصوفي مدعوماً بالعدَّة الثقافية التي اكتسبها من قراءاته للمصادر التفكيكية والسيميائية، مع محافظته على الاهتمام بالرؤية الشعبوية للفن المتمثلة في الجَفر والحروف والتعاويذ والكتابات الجدرانية، وتنظيمها فكرياً وجمالياً في النزعة الحروفية التي يُعدّ الفنان من روادها عربيا.
يجمع شاكر حسن دراساته المتفرقة ومقالاته لينشرها في كتب، تتعدد موضوعاتها وتتباين. فثمة معالجات ظاهراتية للمكان، يسكب فيها الفنان من روحه وحلمه وتصوراته ورؤاه على الشيء أو المكان أو الرمز أو الأمثولة شعبية أو تراثية، قديمة أو معاصرة، واقعية أو أسطورية، فيمنحها وجوداً جديداً، تماماً كما هي في أعماله عادةً. وثمة معالجات تتأمل الماضي الحضاري ومنجزه الماثل، والفكر الشعبي، والموروث الروحي والثقافي وطقوسه وتوصلاته.
لقد كان تأثير تأملاته تلك جليّاً في تطوير منظوره للعمل الفني وتشكيله، مروراً بمراحله المعروفة التي يلخّصها هو ذاته في مقدمة دليل معرضه الاستعادي الكبير عام 1996، بأنها أي المراحل، تتدرج «من التشخيصية إلى الانطباعية إلى التجريدية». وكان عنوان تلك المقدمة «لامقروئية النص في رسومي»، ذا دلالة كبيرة على تفهمه لسوء تلقيه من قبل مشاهديه، فضلا عن قراءة دراساته ذات الطابع التأملي. لكنه من ناحية أخرى يشير صراحة إلى رضاه النفسي عن تلك اللامقروئية أو اللغز الغامض في أعماله ودراساته وتأملاته.
ويهمني في ما قاله عن مأزق قراءة نصوصه، أن أشير إلى استخدامه مصطلح (النص) بدل (العمل). فهو يؤكد استنتاجنا حول تأثره ببارت في الانتقال من العمل بمحدودية أعرافه ومزاياه واشتراطاته وأدواته، إلى (النص المفتوح). وهو النص البصري في حالة رسام كشاكر حسن يخلط الحرف والتشخيص أحياناً مع التجريد، ويستخدم تقنيات متنوعة غير تقليدية. ويقترح لاحقاً برامج عمل تحطم الأطر والمساحات والسطوح التصويرية، وتخرج حتى من الهوية اللونية، مكتفية مثلاً بذكر اسم اللون في مساحة بيضاء بدل وجود اللون نفسه، كأنما برغبة خفيّة من الفنان لتنشيط مخيلة المتلقي وتفاعله مع الغياب الحاصل في اللوحة، والقيام بفعل قراءة معروف في نظريات التلقي وجمالياته، وهو ملء فجوات النصوص، وما يترك فارغاً دون ذكر عادة، لأسباب مختلفة: بنائية أو تركيبية ولغوية أو دلالية، أو تحت إغراء الألغاز والتعمية، والهروب من محدودية المعنى، والاكتفاء بالدلالات المتولدة بوحي العمل، كما هو معروض للمشاهدة.
لكنه من ناحية أخرى يشير صراحة إلى رضاه النفسي عن تلك اللامقروئية أو اللغز الغامض في أعماله ودراساته وتأملاته. في هذا المجال يُعد كتابا شاكر حسن «الحرية في الفنّ و«دراسات تأملية» من أكثر أعماله النظرية تنوعاً وأهمية. فهو يقدم تصوره للحرية في الرسم، والرؤية التي تعتبر المشغّل الأساسي الهام للإنجاز البصري. ويرى أن الإنسان هو الحرية، وأن الوعي الفني هو الحرية الإنسانية. ويقرن ذلك بالتأمل. وهو عنده لحظة طاهراتية كما نفهم من توضيحه لها في «البيان التأملي»، حيث يسند (للفنان الحق) كما يصفه، دور اقتراح إعادة النظر للعمل الفني، بكونه مادة قابلة للتأمل والكشف عن الحقيقة…
وإذ يخرج شاكر حسن من العمل إلى النص، فإنه يتسلح بهذه الرؤى البديلة التي تحرر النظر في مرحلة التمثل والرؤية، ثم في إعادة تمثيلها وإنجازها في نص متاح للتأمل أيضاً.
وعند هذه النقطة يسند شاكر حسن للمتلقي دوراً لا يقل عن دور الفنان ذاته، في إظهار العمل من الوجود بالقوة إلى الوجود بالفعل الذي هو المنجز الفني.
هذه الدورة التأملية المفترضة سوف تنضج لاحقاً في الأعمال التجريدية المستلهمة من الفكر الصوفي، والمعززة بمقتبسات يزخر بها خطاب شاكر حسن النظري. ويتوافق مع تلك المرحلة من حياته التي يصفها بأنها ولادة ثانية له، تمثلها عودته من باريس، وخيبته بالفلسفة الغربية التي كانت الوجودية أبرز ممثليها في حينه. تلك الولادة التي يتحدث عنها شربل داغر في دراسة اختارها شاكر حسن مقدمة لكتابه «أنا النقطة فوق فاء الحرف»، ويصفها بأنها كانت قيصرية، بمعنى أنها جاءت إكراهاً لا بسياق طبيعي، وكأن المعوّل عليه كان أن يفيد شاكر حسن من معايشته للفن الأوربي في عاصمته المكرَّسة باريس، وأن تغتني تجربته بتلك المعايشة والمشاهدة وتفاصيل الحياة بأبعادها كلها. ولكن شاكر كما يصفه شربل داغر «لا يسترخي في القناعات الموروثة، ولا يهنأ للإجابات السهلة». وهكذا ظل شاكر حسن يتساءل ويراجع قناعاته كلما تجذرت في الزمن وانعكست في الأعمال.
لقد غدا التنظير مراجعة تطهيرية دائمة لفكره وشغله معاً. ومجلى للتأمل في كيفية الموازنة بين ذاته وشخصيته. لقد باح بهذا الصراع الحارق في مراسلة خاصة معي قمت بنشرها لاحقاً، يقول: «فمن ذا الذي يستطيع أن يتغاضى عن العلاقة بين (الذات) و(الشخصية) إلا بالهاجس والكلام؟ (فلم يبق إلا صورة اللحم والدم). ومن ذا الذي يستطيع أن يميز بين كونه (ضحية) أو (بطلاً) إلا في أن يتعامل مع (الطبيعة البشرية) وليس (عقلانية التقنية) التي بدأت تهدم (الطبيعة)؟ أي نسغها (الحرفي) لكي تحيله إلى نسغ (تقني)؟».
تقود تلك التأملات التي يبثها العارف والشاهد والموجود من أجل نقاء العالم وإنسانية الفن وحريته، إلى النظر في المحيط كوجود يحقق فيه الإنسان رؤاه. فاختلطت الإنسانوية والذاتية في تلك العوالم التي تضاء بالحرية والإنسانية، وتخلد بالأعمال لا الأقوال. وتحضر هنا أمثولة جلجامش والسندباد وبغداد والمرأة في ألف ليلة وليلة وطقوس المراثي والعزاء وسواها، لتعيد الاهتمام بالبحث والتأمل، حتى أنه يصرح بأن البعد الواحد الذي نادى به، ما هو إلا «تأملٌ للكون أو وصف شهودي للعالم الخارجي، وبواسطة لُقيةٍ فنية يتوحد فيها الإنسان والعالم كأثر لا كخلق».
ويتعدى فعل التأمل من الفنان إلى المُشاهد الذي يتقاسم هذا الدور مع الفنان. وقد ذكر شاكر حسن ذلك في نص البيان التأملي، إذ قال إن التأمل من جانب المشاهد هو (شهود) الحقيقة من خلال الكون وبضمنه العمل الفني. لكنه لا يرقى إلى (التعرف) على الحقيقة الكونية عبر العمل الفني الذي ينجزه الفنان.
من هنا يمكن تفسير إدراك شاكر حسن للإعراض عن خطابه، وتفهمه لا مقروئية نصوصه الفنية. فالمشاهد يضع العمل مندرجاً كمفردة في كون واسع. فيما يذهب الفنان إيجابياً إلى التعرف على الحقيقة الكونية، انطلاقاً من العمل الفني ذاته.
وهذا يفسر ما وددت أخيراً الإشارة إليه. وهو ما يعوز فكر شاكر وخطابه من عدم وجود طلبة يتفهمون اشتغالاته بما أنها ليست حصيلة حرفة وتقنيات، بقدر ما هي تأمل وتعرف وبحث دائم ومساءلة لجوج للحقائق والأشياء. فالطلبة لا يتفاعلون مع منجزه، بل يكتفون بالانفعال به، أو استنساخ تجربته بتقليد مشين لم يكن يرضاه هو نفسه. إذ أصبحنا نرى بعض أعمال من يدّعي التلمذة لشاكر وهي تتطابق كلياً مع أسلوبه ورؤيته معاً. وهو أمر يشبه التحديق في مصدر ضوئي قوي وباهر يسلب الرؤية من عين المبصر، من حيث يتوقع الحصول على نور أو ضوء من ذلك المصدر. وقد تنبه دارسو الفن في العالم إلى وقوع المريدين في أسر الفنان وهم يحاولون النسج على منوال تجربته. وهي في جوهرها لحظة فريدة تحضر فيها الذات والعالم والموضوع والمادة منصهرة في بوتقة واحدة، تتطلب فهماً يوازي المهمة التأملية تنظيراً وممارسة.