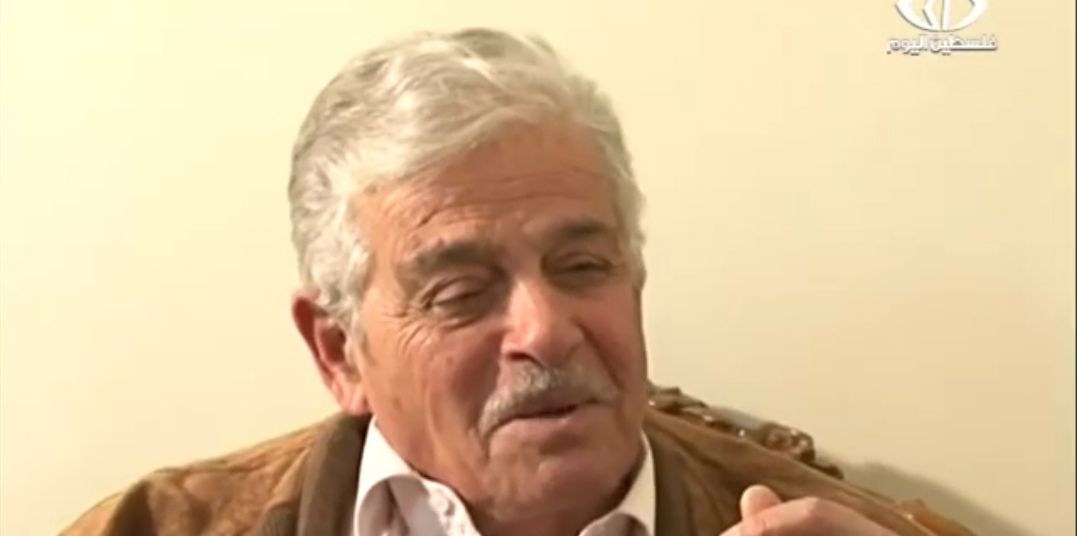إدوارد سعيد: حاجة وضرورة

إدوارد سعيد: حاجة وضرورة
صبحي حديدي
ضمن البرنامج الثقافي لمعرض الرباط الدولي للكتاب، تشرّفت هذه السطور بالمشاركة في ندوة بعنوان «في الحاجة إلى إدوارد سعيد»، بمشاركة الناقد المغربي أنور المرتجي، الذي أصدر مؤخراً كتابه الرائد «خطاب ما بعد الكولونيالية: تمثيلات المثقف والسلطة»؛ وأدار الندوة الشاعر والإعلامي المغربي مصطفى غلمان. الإدارة الثقافية للمعرض شاءت وضع اللقاء في الإطار التالي: «ألسنا اليوم أحوج إلى هذا الأكاديمي العالمي ممّا كنّا عليه في السابق؟ مشددة على القضية الفلسطينية وعلى راهنية فكر سعيد ورؤيته في كتابه «الاستشراق».
الأرجح أنّ أغلبية ساحقة من المشتغلين بمسائل الإطارَين المشار إليهما، القضية الفلسطينية والاستشراق، تفتقد المفكّر والناقد الفلسطيني الكبير إدوارد سعيد (1935 ـ 2003)؛ اليوم تحديداً، بالفعل، في ارتباط وثيق مع سلسلة من الظواهر والوقائع والتطوّرات والتفاصيل: في النظرية النقدية والعلوم الإنسانية إجمالاً، وفي الفنون والحياة البحثية والأكاديمية، ثمّ في السياسة الدولية وانشطارات العالم إلى شمال وجنوب. وبهذا المعنى، فإنّ العودة إلى سعيد ليست حاجة ماسة فقط، بل ضرورة حيوية لازمة أيضاً.
ففي الجانب الفلسطيني نفتقد رؤية سعيد الثاقبة لتلك الأبعاد الخافية التي تكتنف ظواهر تبدو جليّة واضحة، وليس في مستوى التحليل السياسي وحده، بل في التعمّق الطباقيّ، كما اعتاد الراحل تسمية منهجيته الكفيلة بدراسة باطن السطوح؛ في قلب ما يتراكب ويتعقّد ويتنافر ويتوحّد ويتآلف في آن معاً، داخل حال منفردة قد لا يلوح البتة أنها أكثر من تفصيل عرضي بسيط.
وبين كتاباته الكثيرة الغزيرة عن فلسطين والفلسطينيين، وبالتالي عن دولة الاحتلال الإسرائيلي وماضي وحاضر ومستقبل الحركة الصهيونية؛ تجد هذه السطور دلالات عديدة في التوقف عند واحد من أهمّ أعماله، ولعله بين الأخطر والأجدى والأبكر استشرافاً لمآلات الصراع العربي – الإسرائيلي، ولاصطفافات الغرب الرسمي والشعبي خلف الكيان الصهيوني. اعتبار ثانٍ يزكّي هذا الكتاب، هو أنّ محتوياته تخاطب الراهن بقوّة، سواء لجهة حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزّة، أو انحطاط معظم الديمقراطيات الغربية إلى درك سحيق من السكوت عن جرائم الحرب أو التواطؤ معها أو حتى تشجيعها.
كذلك فإنّ سعيد حاجة/ ضرورة في جانب مركزي من شخصيته العميقة والغنية: أنه كان، ويظلّ اليوم بعد 22 سنة على رحيله، رجلَ الأسئلة الجدلية المفتوحة أكثر من الإجابات القارّة المغلقة، وباعث القلق والتشكك والبحث وليس حامل الاستقرار والطمأنينة واليقين… تماماً كما أراد لنفسه من نفسه، وأراد لها من الآخرين. وكما هو معروف، في مطلع ثمانينيات القرن المنصرم، كان سعيد قد طوّر سلسلة مفاهيم جديدة تصبّ في هذه الدائرة الحوارية النقدية الانشقاقية، فتحدّث عن «النظرية المترحلة»، حيث الأفكار والنظريات تسافر مثل البشر ومدارس التفكير، منطلقة من شهادة ميلاد، ونقطة بدء، ومسار رحيل، وشروط وصول، ومقتضيات رحيل جديد؛ وناقش «النقد الديني»، حيث يجري نسخ الثقافة إلى شعائر وشعائر مضادة، وإلى لافتات مطلقة تلغي أي تمييز جدلي. ولعلّ الأهمّ بين هذه المقترحات النوعية كان مفهوم «النقد العلماني»، الذي استخدمه سعيد في مقالة تمهيدية لكتابه «العالم، النصّ، والناقد»، 1983، وجاء بمثابة ردّ فعل شجاع على انحدار النظريات النقدية الأمريكية نحو نزعة تجريدية تقدّس النصّ في ذاته، وتعزله عن محيطاته الاجتماعية والثقافية والسياسية والتاريخية، بل تجعله بديل التاريخ أحياناً.
ولسوف تظلّ حاجتنا ماسّة إلى شخصية سعيد كناقد ثقافي يفكّر خارج الصندوق كما يُقال، كي نعيد اكتشاف واستكشاف شخصية فريدة على غرار الطبيب النفسي والمناضل والثوري فرانز فانون مثلاً؛ إذْ كان سعيد رائداً في استرجاع هذا المارتينيكي اللامع، وتوظيف أفكاره ضمن النسق العامّ لنظريات الخطاب ما بعد الكولونيالي. وفي مقالته المعروفة «تمثيل المستعمَر: مُحاوِرو الأنثروبولوجيا»، أشار سعيد إلى جدل التحرير الذي حاول فانون فرضه على أوروبا مستمتعة بلعب «الدور غير المسؤول لجميلة الغابة النائمة»، وإجبار المتروبول الأوروبي على التفكير في تاريخه؛ بالتضافر مع تاريخ المستعمرات المستيقظة من السبات القاسي، والجمود الفاسد للهيمنة الإمبريالية. ولقد حذّر سعيد من تشويه رؤية فانون الشاملة إذا لم نطوّر قدوته في التشديد على اندماج أوروبا ضمن موقعها الإمبراطوري، في سيرورة انحلال الاستعمار؛ الأمر الذي يُلزم بوضع أوروبا وجهاً لوجه أمام سؤال الهوية، ذلك الشريك السرّي في التأمّل الأنثروبولوجي لـ «الآخَرية» و»الاختلاف».
تبقى -غنيّ عن القول- حاجتنا الدائمة إلى سعيد لاستكمال النقد العميق، النوعي والرائد والاستثنائي الذي أخضعه لمؤسسة الاستشراق، واستكشاف الشيفرات الخفية التي تكتنف الخطاب المعرفي الاستشراقي، وتعريتها. وكان كتاب «الاستشراق»، 1978، نقلة سعيد الحاسمة نحو تحليل العلاقة بين السلطة والمعرفة، وكيف دخلت في صلب مهامّ تولت مؤسسة الاستشراق تنفيذها لصالح السياسات الاستعمارية، وشكلت جزءاً تكوينياً من عوامل صعود الإمبريالية.
صحيح أنّ الكتاب احتلّ مكانته البارزة في التحليل النقدي لنصوص الاستشراق، من جهة أولى؛ ومحنة الثقافات «الآخَرية» في علاقتها بالخطاب الثقافي الغربي المهيمن، من جهة ثانية، ولكن من الصحيح في المقابل أنّ الدروب إلى تلك المهامّ ما تزال طويلة، وعرة، وجديرة بالمسير والمتابعة؛ على شاكلة ما يقترن بشخصية سعيد من حاجة وضرورة.
كاتب وباحث سوري يقيم في باريس