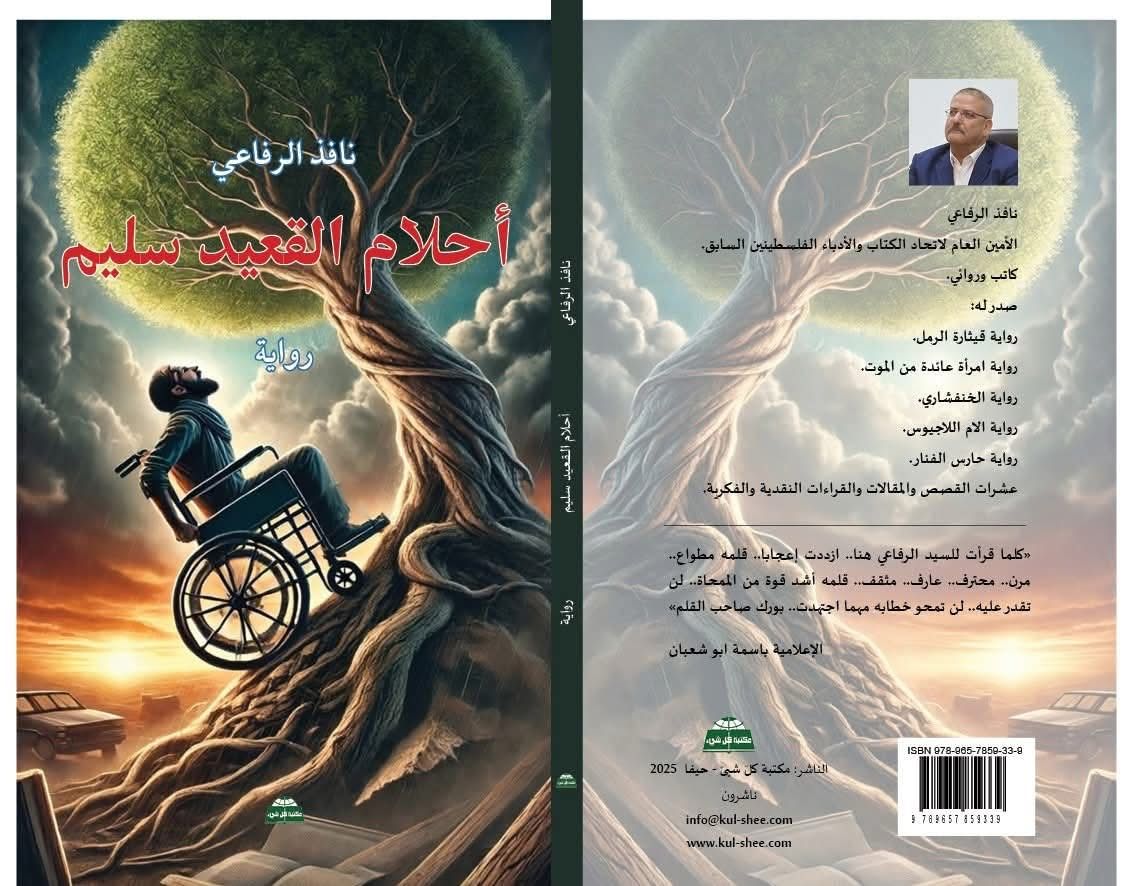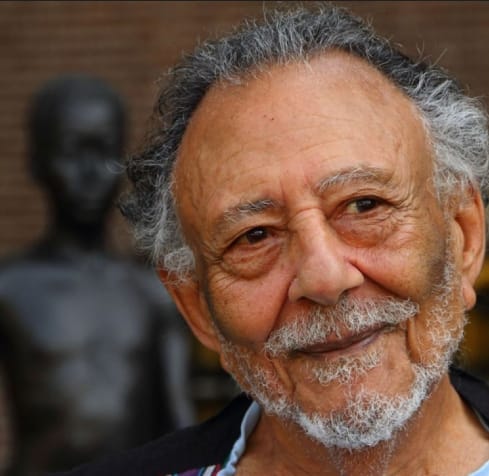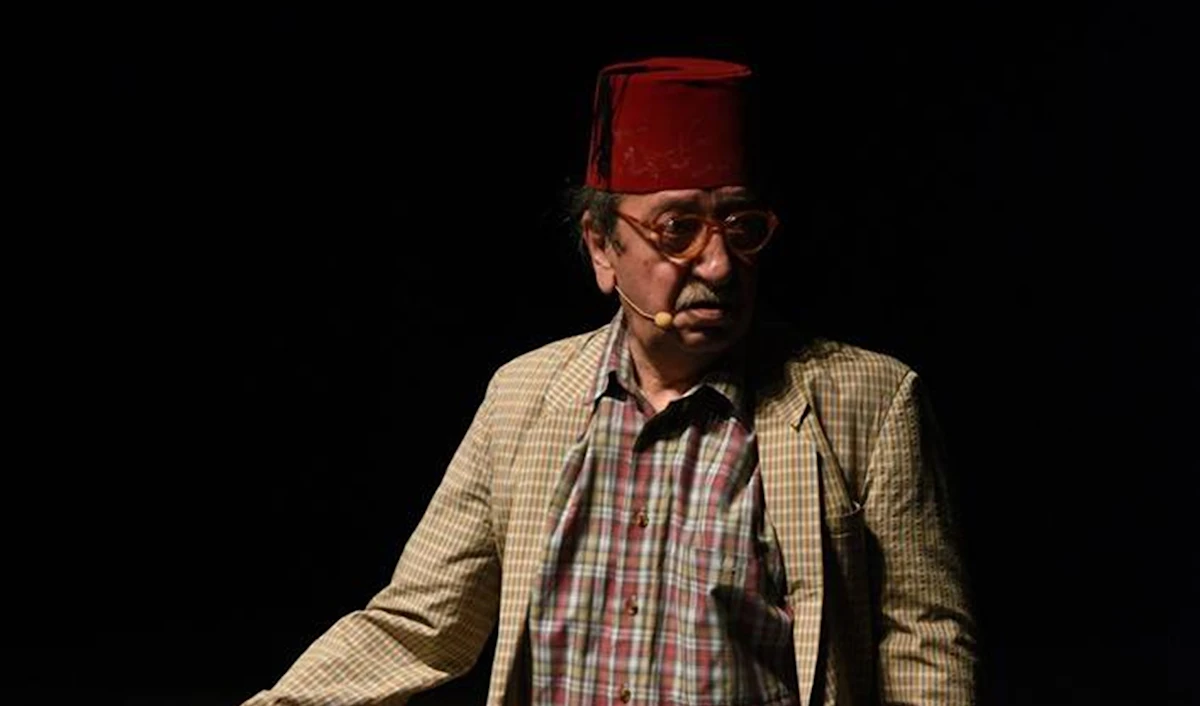اللغة العربية وبناء النموذج الحضاري

مصطفى عطية جمعة
اللغة أيضا ظاهرة اجتماعية، وعامل حضاري، ومن الثابت تاريخيا أن العربية كان لها دور هائل في التعبير عن الكشوف العلمية، ولها مقدرتها الذاتية على التعبير الفني الدقيق، فهي تحتاج إلى استنهاض همم العلماء العرب المعاصرين، من أجل تعريب المصطلحات والرموز العلمية، على أن نكون واعين بأنها قضية حضارية وليست ترفا علميا.
وقد مرّت اللغة العربية بوصفها لغة حضارية بتجربة تاريخية ضخمة، أبرزت طواعيتها للاكتشاف والتوليد، وفي استطاعتها – كما ثبت حديثا- أن تواكب النماء الحضاري، فهي ما تنفك قادرة على اختراع التعابير الحية لجميع الفنون والعلوم. وهذا لا يعني أنها تراجعت في العصر الحديث، بعد المدّ الاستعماري الذي ضرب أقطار العروبة والإسلام، وبطء حركة التعريب، ومنافسة اللهجات العامية لها، وافتقارنا إلى حد كبير لمراجع علمية عربية في مختلف العلوم العصرية والفنون الجديدة، والمراجع المتوافرة، لا يتم تحديثها بشكل دائم. فمن المسلم به في الدراسات الحضارية أن اللغة عنصر علمي مستقل. وتبدو استقلالية اللغة – بدرجة كبيرة- في العلوم الطبيعية، مثل الرياضيات والفيزياء والكيمياء والطب والجغرافيا، بوصفها علوما لا خلاف على أثرها في التقدم العلمي والحضاري بين البشر، وإن كان الأمر ليس على إطلاقه. فالعلوم الطبيعية وما يرتبط بها من اختراعات وتقنيات مفيدة لعامة البشر، إلا أنها تحمل الكثير من الخلفيات الحضارية والثقافية، التي تظهر في صياغة المصطلحات والمفاهيم، واللغات الأصلية التي تكتب بها، ودورها في رفع شأن حضارة ما، والترويج لقيمها وشعاراتها.
أما العلوم الإنسانية، فترتبط بالهوية الحضارية، وتتصل بالفكر والثقافة؛ واللغة المعبر بها تقع في القلب منها، ولا بد من دراستها لأي باحث يرغب في فهم الحضارة المستهدفة بشكل موثق، فمن أراد معرفة حضارة اليونان وثقافتهم بشكل جدي، وبفهم أعمق، فعليه إجادة اليونانية، خاصة للمختصين في العلوم أو التاريخ اليوناني بشكل مباشر، فالأمر يرتبط هنا بمسألة الهوية الحضارية وإعادة بناء النموذج الحضاري، وتعود اللغة العربية فيه لتكون لغة العلم والتعلم، والبحث والتأليف، والمخترعات، نسترشد في ذلك بواقع الحضارة الإسلامية في عصرها الذهبي، وقد عاشت أكثر من عشرة قرون، تسيدت فيه الأرض، وكانت مراكزها الحضارية نبراسا لشعوب العالم، ونحن نقصد هنا المنجز الحضاري، وليس التاريخ السياسي، بما فيه من صراعات؛ معلوم أنها من نواتج السياسة وأهوائها، وذلك واقع في كل حضارات العالم ودوله وأممه قاطبة، مع الأخذ في الحسبان فترات القوة والاستقرار السياسي في العصور الإسلامية، وشخصيات الخلفاء والسلاطين والملوك العظام، وبعبارة أخرى، من المهم دراسة المنجز الحضاري الإسلامي: علوما وفنونا وإبداعا، واللغة العربية منه في القلب، لنجيب عن سؤال: كيف كنا متميزين، وكيف يمكن أن نعيد أمجادنا؟
يفصل عبد الحليم عويس سمات الحضارة الإسلامية، بأنها حضارة إنسانية متعاونة، لا تعرف استعلاء ولا تجبرا، ولا نهبا أو احتلالا، وأنها أقامت حوارية كاملة مع الحضارات السابقة والمعاصرة لها، وأن الوسطية كانت سمة لها، في رسالتها الدينية، وفي خطابها الإنساني، حيث أعلنت احترامها للإنسان وللكرامة الإنسانية، ونشرت في سبيل ذلك منظومة قيم وأخلاق سامية. فلا يمكن أن تستعيد اللغة العربية مكانتها العالمية، إلا بعودة الأسباب التي جعلتها تتبوأها، ألا وهي تفعيل عوامل الصعود الحضاري، التي اتخذت العربية لغة معتمدة لها.
إزاء ما تقدم، يمكن القول إن سبب انتشار اللغة العربية في أنحاء العالم، في القرون الوسطى، يعود إلى سيادة النموذج الحضاري الإسلامي، وهي سيادة لم تتأتَ بسبب احتلال عسكري، أو قهر سياسي، أو هيمنة وتبعية، وإنما لما تميّزت به الحضارة الإسلامية من سمو أخلاقي، ورفعة قيمية، واختزنتها شعوب الأقاليم المفتوحة في ذاكرتها الجمعية، وهم يقارنون بينهم وبين أحوالهم تحت حكم كسرى في فارس، أو قيصر في الروم، أو ملوك أوروبا وإقطاعيها. وقد جاء انتشار العربية بالنظر إلى كونها لغة الحضارة الإسلامية الأساسية، علما بأن هناك لغات أخرى، ضمن إطار الحضارة الإسلامية، كُتِبت بأحرف عربية، وكانت رديفة للفصحى، بعدما امتاحت منها كثيرا من المفردات والمصطلحات، مثل الفارسية والتركية.
وقد تمثلت الأدوار الحضارية للعربية الفصحى في كونها لغة العلوم والفنون والآداب، ثم هي اللغة التي حملت أبرز الكتب المترجمة عن الحضارات السابقة، وتضافر علماء المسلمين على شرح هذه الكتب، مثل شروح مؤلفات أرسطو، ثم هي اللغة التي كانت جسرا حضاريا لحضارة أوروبا.
ومن هنا نشدد على أهمية النظر في السياقات الحضارية والتاريخية للغة العربية، ونحن نروم جعل اللغة العربية لغة عصرية متطورة، فلا يمكن فهم تطور العربية لغويا وثقافيا وحضاريا، إلا بفهم مجمل السياقات الزمنية والتثاقفية والحضارية، التي صاحبت هذا، وهذا لا يعني إهمالنا النظر الجزئي، والدراسات الفرعية، وإنما المستهدف تقديم رؤية إجمالية، تأخذ أبعادا سياسية ودينية وثقافية واجتماعية، جنبا إلى جنب مع الموقع الجغرافي للعالم الإسلامي، الذي مكّنه من الاطلاع ثم حفظ علوم الحضارات السابقة، ثم البناء عليها، وبعد ذلك نقلها إلى حضارات الأرض المعاصرة له تاريخيا، أو اللاحقة عليه زمنيا، لتستمر مسيرة الحضارة الإنسانية، عبر نقل مشاعلها بين الأمم.
إن هذا التأثير متوقع، وقائم، ولا يقتصر على الحضارة الإسلامية ولا القرون الوسطى، بل هو قائم إلى عصرنا، ويكفي أن نرى حياتنا المعاصرة، وما ننطقه على ألسنتنا، فسنجد مئات الألفاظ من اللغات الأوروبية، ناهيك عن الاختراعات والأجهزة، ومصطلحات العلوم والفنون، فتأثير الحضارات قائم وحادث، بل هو من لوازم الحياة الإنسانية، بأن تغزو الحضارةُ القوية الشعوب الأقل والأضعف ثقافيا وعلميا، ولكن الفارق أن الحضارة الغربية لم تعرف إلا الهيمنة والتسلط ونهب الموارد واستعباد الشعوب، بدعوى نشر حضارتها، والتي كانت في حقيقتها احتلالا عسكريا، وقهرا سياسيا، وإبادة عنصرية.
أكاديمي مصري