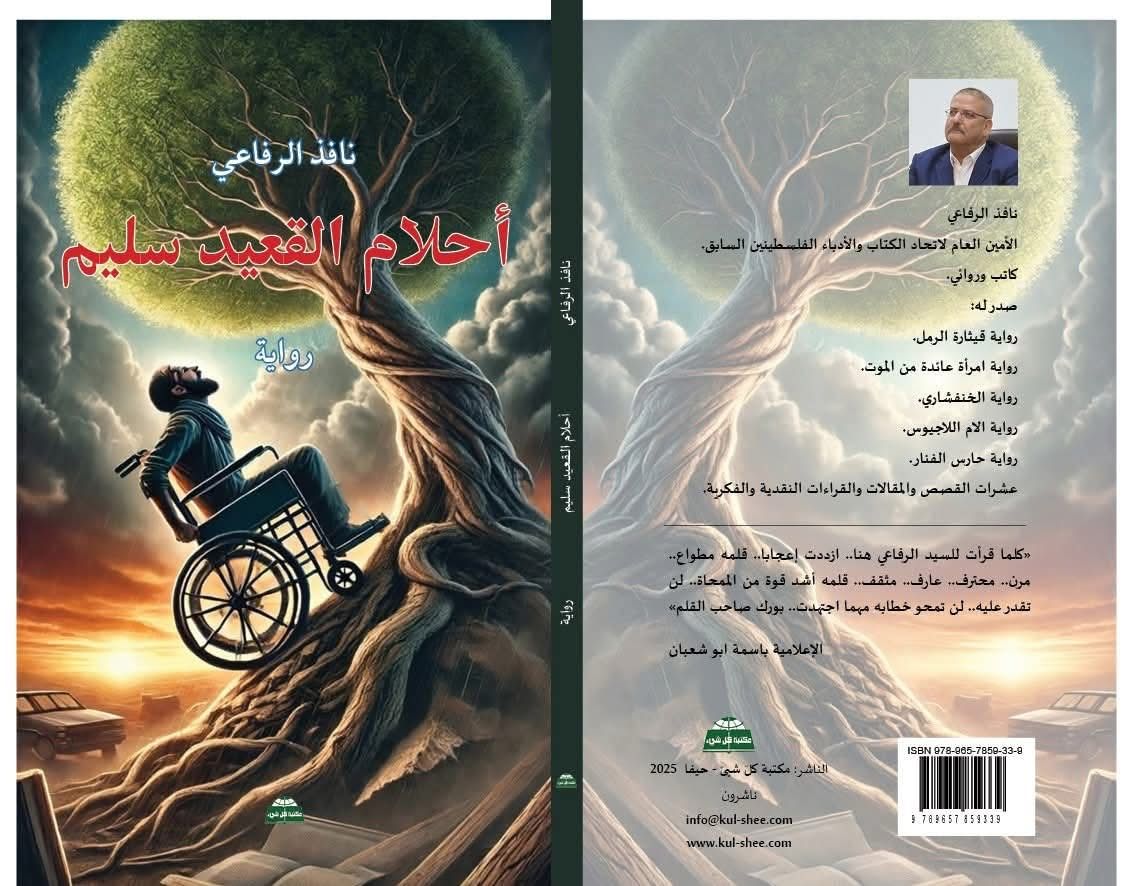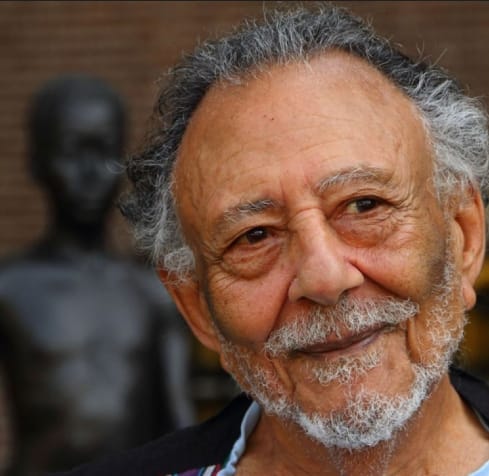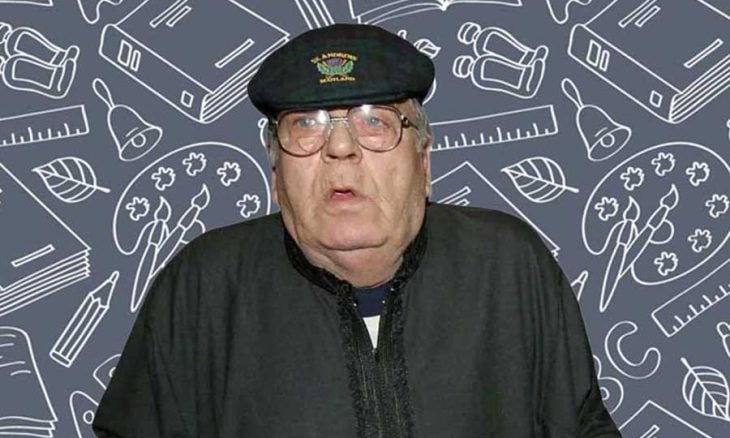
قصيدة النثر… المغامرة الملعونة وحلم الماغوط

علي حسن الفواز
ما كتبه محمد الماغوط عن حرية الشعر وعن مغامرة التمرد على «برية القصيدة» تأخذنا إلى ما يشبه مساءلة تاريخ الشعر، والكشف عن ارتباطه بمركزية قصيدة الشطرين، أو ما يسميها البعض بـ»العمود الشعري» الحامل لـ»ديكتاتوريات شعرية» ولتوصيفات حادة ارتبط وجودها هو الآخر بشعراء فحول، تمترسوا بطبقاتهم وأصنافهم، حتى بدت هذه القصيدة وكأنها تملك حدودا قارّة لمفهوم «الشعر» بوصفه مركزا وديوانا، أو بوصفه أفقا استعلائيا يُعطي لأنموذجه القوة، ورمزية العلاقة بوجدان «الأمة/ الجماعة» وبقياس «الهوية/ اللغة».
قصيدة النثر ارتبطت بتحولات ضدية مع التاريخ، الشعر، حيث انكسر معها «القياس» إلى الاجتهاد، والشكل إلى المتن، والاستبداد إلى الحرية، وبهذا فإنها تجاوزت «برية الشعر» وقاموسه، إلى تمثلات ارتبطت بحيوية التجدد، وبرغبة الكائن الشعري في أن يستعمل حريته، وفي أن يتمرد على اقفال البلاغة، والشغف بإعادة قراءة ملامحه في اللغة، وفي المدينة من خلال مرايا وجوده وليس من خلال تاريخه..
انحياز الماغوط إلى قصيدة النثر، كان تمثيلا حرا لقلقه، ولكراهيته للتاريخ، فبقدر ما تعني كتابتها نزوعا للمغامرة، والتلذذ بالفرادة، فإنها تعني- أيضا- دخولا أراد من خلاله أن يتجاوز عقدة الشاعر الأب والفحل، والانغمار بفكرة «الحنان» كما سماها، حيث اصطناع ألفة جديدة، وحساسية جديدة، ولغة تتقشّر عن الغلظة، وعن الحبسة، وعن ذاكرة لم تسعف الكثيرين من التحرر منها.. شغف الكتابة الجديدة التي أرادها الماغوط عنوانا لـ»حلمه الشعري» وضعته أمام كثير من الفوضى، بما فيها فوضى التسمية، وعنف توصيفات «أصحاب الخبرات» الذين ربطوا عمود الشعر بعمود المقدّس، وبعمود الهوية، وأن ما قام به الشعراء الجدد يُعدّ مروقا وخروجا عن «قياس الأمة والجماعة» حتى توسّم بعضهم لقب «شعراء ملعونين».
مغامرة «قصيدة النثر» ارتبطت بمنابر ثقافية حملت هي الأخرى وسم «اللعنة» والخيانة، التي جعلتها مُتهمة بشبهات العلاقة الدونية مع الآخر، والنوم على سريره، والانغمار في لذائذ خطاياه التاريخية و»الاستعمارية» لكن هناك قراءة أخرى، أجدها ذكية، وتدخل في مجال أنثروبولوجي أكثر مما هو تاريخي، فما طرحه الروائي علي بدر حول علاقة مجلة «شعر» وهي منبر مهم في مشروع «حداثة الشعر»، بما سمّاه بثقافة الأقليات، يؤشر خطّا آخر لفكرة التجاوز، والخروج من «تضايف» التاريخ، فـ»أبناء ثقافات هامشية – أدونيس العلوي من الساحل السوري ـ يوسف الخال الإنجيلي اللبناني ـ أنسي الحاج الماروني المتأمرك ـ فؤاد رفقة المنفتح على التصوف والفكر الباطني- كلهم، بطريقتهم، لم يكونوا أبناء الطبقة الثقافية القومية الحاكمة، بل أبناء توترها وظلالها ومقاومتها الجمالية «حملوا معهم هواجس التغيير، وحساسية البحث عن «ذات شعرية أخرى» وتحت يافطة تتمثلها أسئلة البحث عن الهوية، لأن أبناء هذا الهامش لم يكتبوا قصيدتهم، وإعلانها في مجلة «شعر» بوصفها تمثيلا لجماعة «بل بوصفها الوعي المهزوم، الوعي المقموع، الوعي الذي لا مكان له في البلاغة القومية. وهكذا، تحوّلت المجلة إلى ما يشبه حركة داخلية للهوامش، تنتج خطابا لا هو سياسي، ولا ديني، ولا هوياتي، لكنه ضد الكل، باسم الشعر. أرادت شعر أن تُسكت الجوقة، أن تُربك الصوت الواحد».
هذه الرؤية تحمل معها نوعا من الاستفزاز، وأنها ستكون باعثة على الإثارة، وحتى الخلاف حولها سيكون كبيرا، لاسيما وأن الحديث عنها ارتبط بتاريخ غامض للصراعات الهوياتية، وعلى نحو جعلها تدخل في صراع افتراضي مع مجلة «الآداب» مثلا، بوصفها تحمل هاجسا قوميا، وبهذا فإن ما يطرحه الشعراء من أفكار حول مفهوم المغايرة، وحرية الكتابة سيكون بعيدا عن تلك البراءة، لأن من يقف خلف منابرهم سيكون «العدو القديم» الذي ورط شاعرا مهما مثل توفيق صايغ بمشروع شعري تحول إلى صدمة وإلى مفارقة بسبب عائدية التمويل، فـ»إصداره لمجلة «حوار» أصابه بصدمة، بعد أن تبين له، ودون علمه على الأرجح، أنها ممولة من وكالة المخابرات الأمريكية، الأمر الذي ألب عليه الأصدقاء والأعداء» ليواجه بعدها مصيرا تراجيديا تسبب في موته..
القصيدة بين المنبر والمشروع
كشف الدخول الثقافي إلى صفقات بعض «المشاريع» عن خفايا خطيرة، وعن أسرار قد تدفع إلى اختيار منابر تتحول إلى فخاخ، وإلى مآزق حقيقية للحالمين بشهوات التجديد، وبصياغة تاريخ نافر لثورتهم الثقافية، الشعرية بشكل خاص، وهو مأزق تورط به الشاعر بدر شاكر السياب، الذي نشر «شتائمه» ضد الحزب الشيوعي العراقي في مجلة «الحرية»، وهي مجلة للقوميين العرب، جمعها في مرحلة أخرى الناشر خالد المعالي صاحب دار الجمل في كتاب، أثارت عندئذ عاصفة «لا شعرية» ليس فيها سوى كشف المزيد من مآزق السياب الوجودية والإنسانية.
العودة إلى حديث «قصيدة النثر» ليس بعيدا عن الحديث حول المنابر والمشاريع الثقافية، فبقدر ما اندفعت إليه الأشكال الشعرية الجديدة من فوضى في التسمية، فإنها بدت أكثر إثارة للعصف، ومن خلال ما بدا واضحا في «البيانات الشعرية» الصاخبة، في لغتها المتعالية وفي سرياليتها، ما جعل من قصيدة النثر وكأنها تهمة، لاسيما بعد أن ترجم أدونيس فصلا من فصول كتاب سوزان برنار «قصيدة النثر من بودلير إلى أيامنا» ليشعل نارا في موقد خامل، حيث تفجّرت معها فتاوى ثقافية ودينية، اتهمت مجلة «شعر» بأنها منبر معادٍ للأمة، لم تشفع لها أطروحات الحداثة، ولا ثورية العقل النقدي الجديد.. ما أشار إليه الماغوط وهو يربط القصيدة التقليدية بقيود «القسوة والغطرسة اللفظية»، كشف عن أسئلة صاخبة، لكنها مواربة لـ»العقل الشعري» في مناكدته للتاريخ، وفي نزوعه للتمرد، وفي تجديد الذائقة الشعرية، وفتح الباب للمغايرة دون عقد، أو حساسيات قامعة، وفي الكشف عن أزمة علاقة تلك القصيدة بالتاريخ، وأن وجودها يقترن بالحاجة إلى التجديد، وإلى الكتابة الشعرية نثرا، لتكون عنصرا في تغذية القصيدة، وحتى في البحث عن مطهرات لتنقية الجسد واللغة والفكر، ودفع الشاعر إلى تقويض كثير من الأوهام الشعرية، التي ظلت عالقة بالمركزية الشعرية العربية..
ما كان يقوله الماغوط ناقدا أو ساخرا، تحول إلى حافز، أو وعي نقدي بضرورة مراجعة تطهيرية لعلاقتنا بالتاريخ الشعري، وبمؤسسة القصيدة ونظامها البنائي ذي الحدود، ليجد الشاعر نفسه إزاء غواية وسحر، تدفعه إلى التمرد على «البداوة» والدخول إلى المدينة عبر «الحضرية» بوصفها السسيولوجي، وبما يجعل الشاعر الحر إزاء قلق آخر وهو يعيش أزمة وجوده في اللغة، وفي التاريخ الذي جعل من «الشعر/ الديوان» وكأنه نوع من تلك المركزية التي تُخفي أزمة الحرية، وأزمة الوجود.
الماغوط وأزمة التشهي الشعري
قد تبدو تجربة الماغوط لها خصوصيتها وفرادتها، وعلاقتها بالتمرد على السائد، من خلال أيديولوجيا «الحزب القومي السوري»، أو من خلال علويته النسقية، وحتى من خلال علاقته المثيرة للجدل مع زوجته الشاعرة سنية صالح، التي دفعته إلى ما يشبه عبث هوس المغامرة، والذهاب إلى التمرد على مركزية الأيديولوجيا والطائفة والحب، ليبدو صاخبا في اللغة وفي السخرية من العالم، ومن السلطة والمكان والمقدس، وبقدر ما شكّل له أدونيس من عقدة ثقافية ووجودية وحتى عائلية، فإنه ذهب إلى ما يشبه الخصوصية في كتابة قصيدة تشبهه، فيها من النثر المكثف، واللغة العارية، والسخرية الساخطة، مثل ما فيها من الصور التي تعكس أزمة المثقف العربي الموزع بين التاريخ والحداثة، بين الصحراء والمدينة، بين الحرية والاستبداد، بين السلطة والعائلة، بين المرأة والجسد المعطوب بالأيديولوجيا..
لا أتهم الماغوط بالسذاجة، والبساطة، فهو يعرف بعض أسرار الطريق إلى الكتابة، لكني أتهمه بأنه سريع على طريقة العدائين، وهذا ما يتقاطع مع غواية قصيدة النثر التي تتطلب تأملا في الرؤيا والحدس، وفي حيازة الحساسية التي لها مجسات الطائر، إنها قصيدة بطيئة، تتشكل على مهل، لا تبحث عن بيت للنوم، قدر بحثها عن بئر للغوص، وعن قميص لاستذكار الخطيئة، وعن خريطة للاستدلال على المدن الغائبة والاستعارات المعطلة، وهذا ما يجعل قصيدة النثر لعبة خطرة في مواجهة تاريخ القصيدة الهندسية الصارمة والقاسية، التي صنعها بلاغيون يعرفون قدرتها على «التدجين» وعلى إغواء السلطان، واستدعاء المغني، فضلا عن قدرتها الضدية في المواجهة مع الحرية ذاتها، إذ هي تنزع إلى وعي مختلف، وإلى حوار حر مع الآخر، فلا تكتفي بالثياب العائلية، بل تتمرد على الاكتفاء لتمارس طقوسا في التعري والتشهي وتقشير اللغة من التقرن البلاغي، وفي إعادة قراءة اللغة عبر السحر وليس عبر التاريخ.