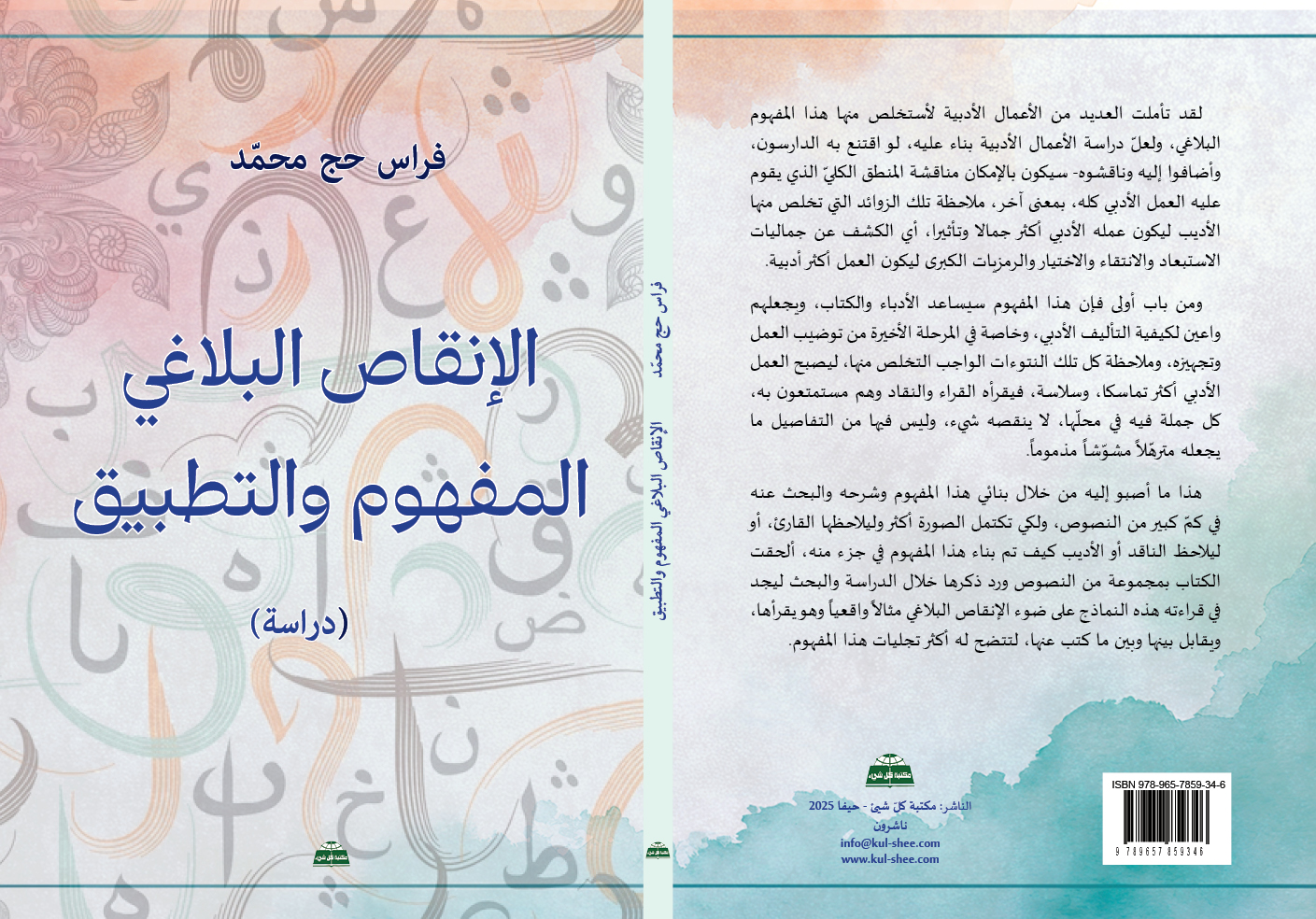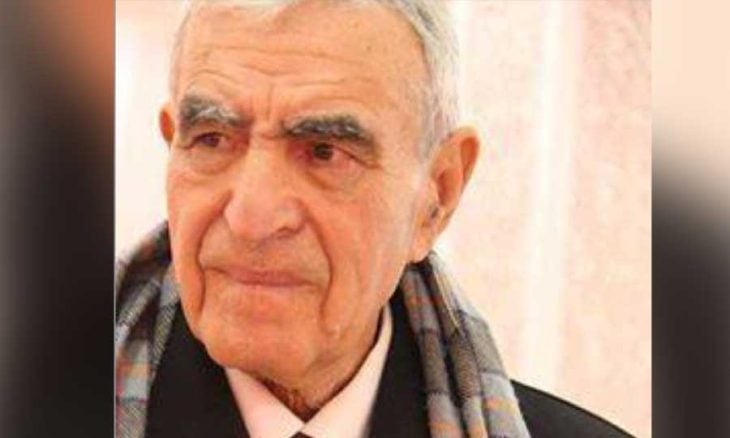
حتى لا تنطفئ الشموع: عبد العزيز المريبح و أريحيّة الشعر

منصف الوهايبي
تعرّفت إلى الشاعر الراحل عبد العزيز المريبح منذ الثمانينات، إن لم تخنّي الذاكرة، في الأمسيات الشعريّة التي كانت تنعقد هنا وهناك؛ وكان لها جمهور نوعيّ من المثقّفين والمدرّسين والطلبة والتلامذة. وكانت أكثر القصائد التي تلقى ذات منحى وطني أو غزلي. ويتهيّأ لي بعد كل هذه السنوات، وأنا أقرأ ديوان الراحل، وأقدّمه لقرّائه، بتوصية منه، أنّ صاحبه شاعر «ملتزم» مثل أكثر أبناء جيل الاستقلال وما بعده من الشعراء والكتّاب، وجلّ هذه القصائد التي تُجمع اليوم في كتاب مستقلّ؛ تحتفي بقضايا الوطن والناس والكادحين عامّة وشواغلهم. والشاعر يسعى جاهدا لأن يكون في الصميم من شعريّة متنوّعة تتمثّل أساسا الفضاء الوطني والعربي في صوره الواقعيّة والتاريخية، حيث تحضر تونس وفلسطين والعراق ولبنان جنبا إلى جنب في: قصائد مثل «بطاقة حبّ إلى تونس الخضراء» و»بطاقة حب إلى مساكن» (مدينة الشاعر) و»بين مساكن والقيروان» و»ملحمة الصمود الفلسطيني»..
وهو فضاؤنا نحن التونسيّين بامتياز، وإن كان البعض سعى خائبا، وبذل ضائعا في العقدين الماضيين، بذرائع من ماض استعماريّ ولّى، إلى إبعادنا عنه، ناسيا أنّ للجغرافيا أحكامها وأنّها قد تصنع التاريخ قبل أن يصنعها. والشعر له من الأريحيّة ما يمنحنا مثل هذا التواصل الحر المبنيّ على الإرادة الواعية، أو التواصل الذي نتعلّم منه جميعا أن الثقافات لا تُغتصَب ولا يمكن إخضاعها لأيّ نوع من التّلقيح القسري. فقد تلاقت في الأندلس وهي جزء من تاريخنا نحن المغاربيّين، ثقافات شتّى ذات أصول إسلامية ومسيحيّة ويهوديّة… في أفق من «عالميّة» رحبة قائمة على التّنوّع، حتى إن البعض يجد في الأندلس نواة تاريخيّة وأنموذجا مكتملا لثقافة المستقبل، وامتدادا للإطار الكونيّ في جذوره الأقدم في فينيقيا واليونان.. كرة مركزها في كلّ مكان ومحيطها ليس في أيّ مكان… صورة لعالم رحب، مركزه في كلّ نقطة على سطح الكرة الأرضيّة، ومحيطه في كلّ نقطة على هذا السّطح.
نقف في هذا الديوان «حتى لا تنطفئ الشموع» على الشكل العريق في ثقافتنا، وأعني «قصيدة البيت»، ولا أقول القصيدة العموديّة، لأنّها كما بيّنت في مقال سابق، تسمية غير دقيقة؛ فعمود الشعر هو نظريّة الشعر عند العرب، وليس شكل القصيدة. والوزن ليس حلية خارجيّة، وإنّما هو من كنه بنية العربيّة ونظامها الصرفي. وهذا الوزن مشرع على كلّ إمكانات الشعر، إذا كان الشاعر متمرّسا به وبلطائفه. في «قصيدة البيت» تخبر اللغة عن نفسها، بالقدر ذاته الذي تخبر به عن تمثّل لحقيقة موجودة سلفا أو لمعنى قائم في العالم، وشهادة لنظام ما للكون، مرتّب ملموس. والإقرار بهذا قد لا يعدو رؤية مثاليّة تتصوّر الانسان موجودا في نظام خارج نطاق سيطرته، وإن لم يكن خارج نطاق قدرته على تنظيمه. وقد تكون هذه القصيدة «العموديّة المعاصرة» عند الشاعر، على قلق هذا المصطلح ، ردّا على «قصيدة الباب الدوّار»، كما أحبذ أن اسمّي النمط السائد اليوم، من «الكتابة» السائبة المنساحة، التي يرى فيها البعض إحالة وفساد معنى، أو إفراطا في استخدام اللغة واستهانة بقواعدها وأنساقها. ولهذا نجد الشاعر يعترض عليها بل يدينها. وواضح من هذا الديوان أنّ الشاعر يدرك أنّ «العدول»، إنّما هو القصد.
ولولا القصد لاستوتْ أقاويل الكتّاب والشعراء، بأغاليط الأطفال وهلوسات المجانين اللغويّة. لأقل إنّي أقرأ هذا الديوان في سياق تاريخ الأدب التونسي الذي يتّسع لكلّ الشعراء، وفي ضوئه، يمكن أن نميّز بين نظامين في الكتابة يكشفان عن خطّتي تلفّظ مختلفتين: كتابة متجرّدة من كلّ جسمانيّة، سواء أكانت أيقونيّة أم قوليّة، كلـّما جرت المسموعات من الأسماع مجرى المرئيّات من البصر، بعبارة حازم القرطاجنّي. وهذا ليس مخصوصا بالقديم، أو «قصيدة البيت»، أو «القصيدة العموديّة» ، وإنّما يشمل أيضا «قصيدة التفعيلة» في نماذج غير قليلة منها. هذا النمط هو في تقديرنا أقرب ما يكون إلى «البيكتوغرام»، أو «التصويريّة»، حيث يمكن فصل الكلمة عن الصورة، ويتحقّق «الاختلاق الإمكاني»، أو الخيال التـّصوري، ويكون لـ»الحقائق»، أصل في الأعيان وسند من الواقع. فلا غرابة إن قام التصوير في الشعر على ما قام عليه عمود الشّعـر، أي على ركنين لا غنى عنهما هما، الإصابة في الوصف والمقاربة في التـّشبيه؛ إذ يحتفظ «الشّيء» في هذين الأسلوبين بوضوحه وتمايزه، أو بانتسابه إلى عالم الأشياء، وما انشداد إلى «المرئيّ» حيث الكلمة لا تحجب عن الشّيء، بل تجلوه وتفصح عنه، إلاّ دلالة على ماديّة الصّورة من جهة، وعلى نظريّة في الإدراك من جهة أخرى، تقوم على التمثّـّل؛ أي أن ندرك هو أن نسمّي الأشياء أو نعرّفها. والشاعر في هذا الديوان وفيّ لهذا النوع من الإدراك، حيث الإشارة منشدّة إلى وظيفتها الدّلاليّة التـّواضعيّة، أو المرجعيّة أو التـّوصيليّة، أي هي لا تخون رابطة العقد بين المنشئ ـ الكاتب والسّامع/ القارئ. ويتوضّح ذلك في قصائد غير قليلة، من حيث هي تعاقد. والتعاقد، نظاميّ نسقيّ غير مباغت، وحصوله منتظر. ومردّ ذلك إلى أسباب قد يكون أهمّها تدارك عوز اللّغة، وغايات قد يكون هدم نظام الخطاب الشّعريّ القائم قادحها. ونعني به النّظام العموديّ المنشدّ إلى رواسم متعاودة ونماذج جاهزة؛ فلا غرابة أن يكون الخطاب الشعري في «لا تطفئ الشموع» محكوما، في جانب لافت منه، بالوظيفة التّنبيهيّة التي تستجلب مزايا الشّفهيّ في أشكالها الأشدّ تراخيا في القدم، والأكثر اطّرادا في الاستعمال. ولعلّها محاولة من الذّات للظـّفر بـ»هويّـتها» وبيان موقعها. والخطاب الشعري، إنّما يُكْتنهُ في جانب منه، في ضوء التقبّل من حيث هو مفهوم جماليّ يتّسع لشتّى المواقف المزدوجة، أو المختلفة التي هي في هذين النمطين من الكتابة: التصويريّة ورسم الفكرة؛ محصّلة مشادّة بين «الكتابيّ» و»الشّفهيّ». وربّما كان هذا الخطاب في قصيدة البيت أمسّ بالشّفهيّ، حيث «ثقافة القصيد» إنّما هي ثقافة الذّاكرة، أو «ثقافة الأذن» التي تلزم الشاعر ببناء قصيدته على طريقة عقليّة متوازية فلا ينْميها ولا يزيد فيها استرسالا إلا طبعا، أو إرسالا على سجيّة؛ حيث الإيقاع الزماني المسموع (الوزن/ التفعيلة) في علاقة حميمة بالإيقاع المكاني المرئي.
على أنّ هذا تقديم وليس دراسة أو قراءة في الديوان، الذي يطرح علينا أسئلة تاريخنا الأدبي، الذي لم يكتب على ما ننشده، وقد يتسنّى لنا في فسحة أخرى أن نبحث في ما إذا كان الشاعر التونسي عامّة يترسّم في نصّه جانبا من حياته، أو يكشف عن مطارح أفكاره وخوالج نفسه، وما إذا كان النصّ سردا تاريخيّا مداره على الماضي وغياب الذات المتلفّظة، وليس تلفّظا يُفسح المجال، في الملفوظ، لظهور آثار تلفـّظه أي الإشارات الدالّة على ضمير المتكلّم، وضمير الخطاب (أنا/أنت)، وظروف المكان والزمان (هنا/الآن)، واسم الموصول واسم الإشارة، وأزمنة الفعل، خاصّة المضارع أو «الحال» كما كان يسمّيه العرب، وما إليها من سمات التلفظ في الخطاب التي يصعب تأّويلها إلاّ إذا انتقلنا من الملفوظ إلى مقام التلفّظ، أي إلى الضمير المتكلّم وإلى مكان قوله وزمانه. لكن ليس من حقّي أن أقطع برأي في مسائل كهذه قد تكون أعلق بالفرد منها بالجماعة؛ وهناك شعراء مهما يكنْ نصيبهم من الشعر، ليسوا بمنجاة من التّحوّلات التي طرأت على مجمل القيم التي كان الفكر البشريّ ولا يزال يجريها مجرى الوجود، إمّا لرمزيّتها المجرّدة، أو لانتسابها إلى مجال الغائيّة. ونقدّر أنّها اليوم متعيّنة في ظلّ تنامي التّدبير الرّأسمالي للاقتصاد وللمجتمع؛ وهي تُرى وتُلمس سواء في معيشنا أوما يحفّنا من وسائل الاتّصال المسموعة والمرئيّة.
وهذا لا يعني الانتقال من سجّل مثاليّ إلى سجلّ مادّيّ؛ على نحو ما قد يتوهّم بعض بني قومنا من ذوي الإدراك الديني السّاذج، وهم يعيشون التحوّلات التّاريخيّة «العجيبة»، وإنّما نعني بالأساس التّحوّل من مستوى تنتسب إليه قيم هي ضروب وجود.
لعلّ المطلوب دائما هو أن نفحص بنية ذواتنا؛ عسى أن نتبيّن ما إذا كان الأمر معقودا على ذاتيّة فرديّة، أم على ذاتيّة جمعيّة. وهذا يعني أن نفتح الخطاب الشعري على أفضية علوم النّفس وعلوم الاجتماع، وبشكل أخصّ على الفضاء الأنثروبولوجيّ. فهذه العلوم، خاصّة الأنثروبولوجيّ منها، تدفعنا إلى أن نقايس أنفسنا، نحن العرب، بغيرنا من الأمم التي تستأنف اليوم التّأسيس المعرفيّ لعالم لا نعرف أيّان سيرسي بنا وبهم. لنفتح هذا الخطاب دون وجل أو خوف، على مصراعيه، إذا كان له مصراع، بل لعلّ المنشود أن يكون صورة من بيت أبي الشمقمق:
فأنتَ إذا أردتَ دخلتَ بيتي / عليّ مسلّما من دونِ بـــــابِ
لأنّي لم أجدْ مصراعَ بابٍ/ يكونُ من السحابِ إلى الترابِ
كاتب تونسي