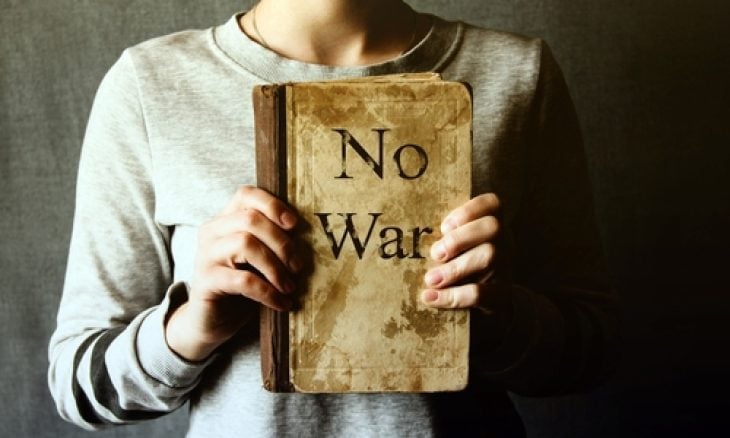
الكتابة في زمن الحرب

رامي أبو شهاب
قد يبدو العنوان مستهلكاً، ولاسيما حين نستحضر رواية الروائي الكولومبي غابرييل غارسيا ماركيز «الحب في زمن الكوليرا» غير أنّ هذا التقارب في العنوان يبدو مُلزماً في هذا السياق، ذلك أن ماركيز لم يكن بعيداً في أعماله الأخرى عن الانحياز للإنسان، ونقد القيم السلبية، كما في روايته «خريف البطريرك» وغيرها من الأعمال التي تتخذ من الألم أو القهر جزءاً من خطابها، فالكتابة تبقى اليأس الأخير لمن لا يملكون القدرة على التغيير.
تبدو الكتابة عن الحرب إشكالية، وأعني الحرب الحقيقية، لا كما أوهمتنا بها هوليوود التي صورت بطولات زائفة، أو قيماً لم تكن سوى وهم في أفلام تصور الشّر الذي ينتصر على الخير، ففي طفولتنا- (المتعجلة) بوصفنا فلسطينيين طارئين- غمرتنا الحماسة والفخر، ونحن نرى سيلفستر ستالوني «رامبو» يخوض بطولات خارقة، ويقتل أكبر عدد من الأشرار الفيتناميين، وهذا يأتي بالتجاور مع مئات الأفلام التي روجت للنموذج الأمريكي الذي يساند الضعيف، وبأن الآخر لم يكن سوى ذلك البربري، والشرير (صاحب الأرض). لقد بدأت الحكاية مع أفلام الغرب الأمريكي، التي غالباً ما يوجد فيها بطل وسيم يصطاد الهنود الحمر المتوحشين، بيد أنّ الممثل كيفن كوستنر، جاء ليقدم نموذجاً يخالف السائد في فيلم «يرقص مع الذئاب» ومن ثم توالت بعض الأفلام التي بدأت تنظر إلى السكان الأصليين بوعي متوازن، يكاد يقترب من أن يمثل نوعاً من الوعي بالتاريخ، والاعتراف بالخطيئة، وكأن وعي الأمريكي قد استيقظ أخيراً، لكن لا يمكن الجزم بذلك!
تبدو الكتابة عن خطيئة الولايات المتحدة الأمريكية لازمة، فهي حيثما تحل يكون الخراب جزءاً من واقع الوجود، وأمريكا ليست سوى تلك القيادة التي يمكن أن تضحي بآلاف من الأبرياء والأطفال، كي يتمكن رئيس ما من الحصول على ولاية ثانية، لكن على جثث الأطفال ليضرب بعرض الحائط كل القيم التي تدّعي أمريكا الدفاع عنها. ربما هذا يعرّي أكبر أكذوبة في العالم بأن قيادة هذا البلد تعتمد منظوراً قيمياً، لكن الحقيقة أنها مسكونة بإرث من التوافق السياسي القائم على تكريس ممارسة استعمارية مبطنة، في حين أن الكتابة عن العرب قد يبدو إشكالياً، فثمة تباين أو اختلاف تجاه الوجود الفلسطيني الذي ينظر إليه.. إما بوصفه يعني قيمة أخيرة لأمة فقدت القيمة، وإما بوصفه أمراً مزعجاً يلوث معنى الحياة، أو رفاهية الوجود، ولهذا فإن الكتابة عنه قد تزعج الآخر في كلا الحالين.
تبقى الكتابة جزءاً من المعضلة، فهل يمكن الكتابة في زمن الحرب؟ والسؤال هنا معني بقدرة الإنسان على أن يتجاوز هذا الحرب كي يكتب عن رواية، أو فيلم، أو عن الحب مثلاً، لا تبدو الكتابة في هذا الزمن سوى رفاهية، نعم إنها رفاهية نخجل منها. فإن تكتب يعني أنك تمتلك شيئاً من الوقت، وأنك تشعر بالأمان، ولديك ما يكفيك من طعام، ولا بدّ من وجود فنجان قهوة كي تتمكن من ممارسة الكتابة، هي حالة تقودنا إلى الخجل، وهنا نستذكر الشاعر الفلسطيني محمود درويش الذي اختزل الخجل الوجودي أمام الذات الأخرى في قصيدته الشهيرة حين قال: «وأعشق عمري لأني إذا متّ أخجل من دمع أمي» غير أنّ درويش يقدم صورة تمتلك عنفاً من الانزياح الذي لا يتقنه سوى شاعر استثنائي، فنحن نخجل من وجودنا، أو ربما لأننا على قيد الحياة في زمن يفيض بالموت.
تبقى الكتابة جزءاً من المعضلة، فهل يمكن الكتابة في زمن الحرب؟ والسؤال هنا معني بقدرة الإنسان على أن يتجاوز هذا الحرب كي يكتب عن رواية، أو فيلم، أو عن الحب مثلاً، لا تبدو الكتابة في هذا الزمن سوى رفاهية، نعم إنها رفاهية نخجل منها.
محمود درويش جعل موته مجلبة للخجل نظراً لما سوف يعنيه هذا الموت من حزن يثقل قلب الأم، وهنا نستعيد الأمهات اللواتي يستشعرن ما كان درويش يعبر عنه، بيد أن وعي الخجل لدى من يموت لن يكون قائماً؛ لأن الموتى هم من الأطفال الذين يحتاجون أمهاتهم، أو الأطفال الذين لم يكتمل فرحهم بالأم، ولم يكتمل فرح الأم بهم، هي تلك الحرب التي تقوض معنى الحياة حين نحاول أن نكتب عنها.
ترقى الكتابة إلى أن توصف بأنها الفعل الأكثر تتويجاً لاختزال الإنسان في قيمة عليا، غير أنها تبدو ضئيلة أكثر مما نتوقع، ولاسيما حين تعجز عن التغيير، والأخير منوط بأشخاص في عالم يحكمه من لا يكتبون، وربما لا يقرؤون، هم فقط يتقنون القتل، أو يتواطؤون على القتل. قد تبدو أدبيات الروايات والسينما وكل الفنون، التي حاولت أن تقارب معنى القتل في الهولوكوست، التي شكلت أبرز انفجار خطابي في القرن العشرين، الذي ما زال مستمراً إلى الآن بوصفه فعل انحياز للإنسان في مواجهة الشر، فالوعي الخطابي في الكتابة.. بدا منافقاً حين يتجاهل إبادة جماعية ترتكب في زمننا هذا، فالعالم لم يحرك ساكناً حين كان النازيون يمارسون المحرقة، ومن ثم اضطر العالم للتخلص من عقدة الذنب عبر تقديم ولاء التكفير من خلال اجتراح إبادة أو محرقة جديدة، فالضحية باتت هي الجلاد، ولم تكن الضحية سوى شعب لم يكن له ذنب سوى أنه وجد في مصادفة قدرية على أرض، وفي زمن ما، ومع ذلك حاولت حنة آرنت، أن تسبر أغوار الشر الذي رأت فيه بأنه لحظة انفصال عن الوعي، ليكون فعلا لنواتج ميكانيكية ذات مدلول وظيفي، فأدولف أيخمان – أحد مسؤولي الرايخ الثالث – كان يؤدي وظيفته فقط، لكن بعد كل ذلك، هل سيأتي يوم نكتب فيه عن عقدة الذنب الغربية أو العربية تجاه الشعب الفلسطيني؟ أم ان الجميع كان يؤدي وظيفته.
ضمن سياق الكتابة نستذكر رواية لكاتب تعرض لوعي ليدرك أكذوبة الوجود، هناك في جنوب افريقيا تخلص الروائي جي إم كوتزي من لعنة أن يكون ضمن نظام فصل عنصري، فارتحل بعيداً عن تعريف العنصرية، وكتب رواية لا تبدو لي سوى جزء من بناء مفارقة لا يمكن أن ندركها إلا في المنظور الذي نتخفف فيه من النعوت والأسماء، لنعرف أن الذات لا تُعرف، إلا بالفعل، ففي رواية «في انتظار البرابرة» التي نهضت على تصوير مستعمرة تنتظر (تخيلاً) هجوم البرابرة (السكان الأصليين) فترسل القوى الإمبراطورية حامية عسكرية لحماية المستعمرة، فتشن الحملة حرب تصفية وإبادة تجاه الشعب الذي كان آمناً مستقراً في أرضه، هكذا تمارس اللغة غوايتها في تضليل المعاني، فانتظار البرابرة لم يكن سوى تلك القوى الإمبراطورية المحتلة، ضمن وضع جناسي واضح.
هكذا نخلص إلى الكتابة بأن البرابرة ما هم إلا من يدعون بأنهم على قمة العالم المتحضر، أو كما يصفون أنفسهم بالعالم الأول، غير أنّ الحقيقة على العكس من ذلك، فهم الذين كانوا الأكثر بربرية، والأكثر دموية على الإطلاق، لكن ماذا يمكن أن نقول، أو كيف يمكن للكتابة أن تتجاوز رداءة هذا العالم، فالكتابة من وجهة نظري أداة للتغيير، لكنها بطيئة، تحتاج إلى الكثير من الوقت، لكن الموت والقتل يبدو أسرع… لا يريد أن يتوقف، فكيف يمكن أن نكتب في زمن الحرب، ولا سيما حين تكون الكتابة عاجزة عن وقف الحرب!
كاتب أردني فلسطيني







