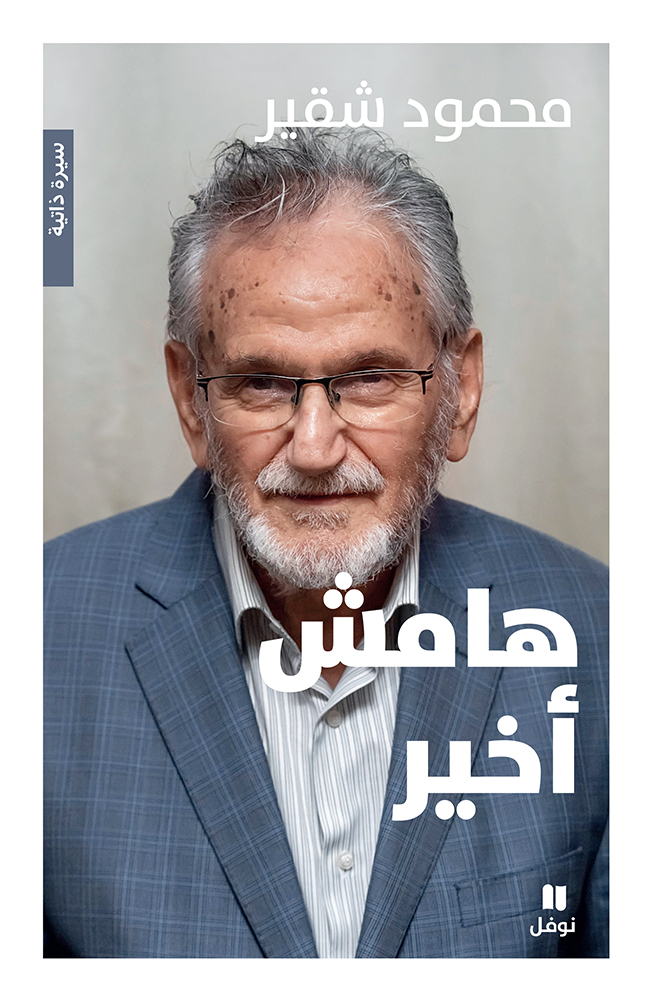كيف تحولت الجزائر العاصمة إلى أزقة مُعتمة؟

سعيد خطيبي
لا تزال الجزائر العاصمة تشكل استثناءً بين جيرانها. مدينة تنام باكراً، ثم تستيقظ متأخرة. أما صباح الجمعة فتبدو مثل مدينة أفرغت من ساكنتها. تفتقر إلى أمكنة ترفيه، وحيز الثقافة فيها يتقلص. غيّرت وجهها من «مقام» يحتفي بروح المُحررين، إلى مئذنة بناها صينيون. عاصمة يؤم إليها الجزائريون كلهم، بحكم احتكارها الإدارات، لكن سرعان ما ينفرون منها. الازدحام من سماتها، لأنها لا تتيح مواقع تنفيس. هي عاصمة بلد يحتل مرتبة مُتقدمة عالمياً في تصدير الخمور، لكن حاناتها تغلق واحدة تلو الأخرى. فشراء النبيذ لا يقل مخاطرة عن شراء سلاح. طغت فيها سلوكيات لا تُطابق ماضيها، والشعبوية صارت لغة في شوارعها.
إن اللحظة التي تحيا فيها هذه المدينة العريقة لم يسبق لها أن عرفتها من قبل. تكاد تتحول إلى مرقد وكفى، متنازلة عن تاريخها الذي تحسدها عليه مدن أخرى. هذه المدينة التي مرّ منها فينيقيون، رومان، فاطميون، مرابطون، إسبان، عثمانيون وفرنسيون، قبل أن تستعيد استقلالها، ظلت أرضاً مفتوحة على الحضارات، لكنها الآن تغفو في شبه غيبوبة. ما زال الناس يلوكون في ما بينهم كلمة «باديسية». هذه الكلمة الطارئة، التي ظهرت في خضم الحراك الشعبي عام 2019، نسبة إلى عبد الحميد بن باديس (1889- 1940) الذي لم يرض بالحداثة، فدعا الناس إلى العودة إلى الدين. فهل يصح، فعلاً، أن تصير عاصمة البلاد «باديسية»؟
ثقافة القرصان
شرعت الجزائر العاصمة في التشكل، على وجهها الحالي، في القرن السادس عشر. في زمن سادت فيه القرصنة. كان القرصان يأتي بالغنيمة من البحر قصد إعمار البر. يعلم أن مهنته تناقض القانون والأعراف، وسببت حروباً مع شعوب مجاورة، مع ذلك دافع عن مصلحته، من أجل تشييد مدينته. القراصنة كانوا سادة البلاد. ومن خصائص القرصان أن يتعامل مع الناس جميعهم، من غير تمييز، يتعلم منهم من أجل أن يطور مهارته، يُخالط من يعرفهم ومن لا يعرفهم. فهو شخص منفتح على الأجنبي. وتلك واحدة من سمات المدينة تاريخياً. كان سكان العاصمة أكثر ميلاً إلى الانفتاح منهم إلى الانغلاق. يتقبلون الغريب ويحفلون بالضيف. فالكرم في جيناتهم. لذلك يبدو من النشاز حصرهم في فكرة «الباديسية» التي تنفر من الغريب.
هذه الأيديولوجيا المستحدثة التي ترى في الغريب عدواً لها. كما أن القرصان يُغامر خلف الحدود، بينما أهل العاصمة باتوا شبه محتجزين في الجغرافيا، لا يُسافرون إلا قليلاً. لقد انفصلت المدينة عن ماضيها في هذه النقطة، وانقلبت على القراصنة الذين بنوها، مع أنها تحتفظ بواحدة من خصالهم الأخرى وهي الإقبال على الفرح. فالأعراس في الجزائر العاصمة من شأنها أن تدوم أسبوعاً كاملاً. والغرض منها ليس الاحتفال بالعروسين، بل اقتناص أي سبب من أجل الترويح عن النفس، بل إن ناس العاصمة بوسعهم أن يرقصوا على أنغام أغنية مأتم.
قبل سنوات، انتشرت أغنية راقصة، كلماتها تتحدث عن عذاب القبر، يقول فيها صاحبها: «كولي يا دودة.. لحمي وعظاي (عظامي).. خلي فمي ولساني.. باش نقابل مولاي» يحكي فيها عن تحلل جثته تحت التراب. مع ذلك لا يزال الناس يرقصون عند سماعها. كما إن الجنائز في هذه المدينة لا تخلو من هامش بهجة في توديع الميت. لم يتخل أهلها عن ثقافة القرصان، في الفرح والإقبال على الحياة، لكنهم تخلوا عن صفته في تشييد البر، وانبرموا إلى منطق «الباديسية» في إطفاء أنوارها كلما خيم الغروب.
الفراغ الروحي
جاء «الباديسيون» بأطروحة تُعارض الحداثة، وتدعو الناس إلى عودة إلى الدين، كوقاية من التحولات ـ السياسية والاجتماعية ـ التي تعيشها الجزائر العاصمة، مستغلين الفراغ الروحي الذي يحيا فيه الناس، مع أن الإنسان في الجزائر العاصمة له علاقة سليمة بالدين، لا تشوبها مغالاة. تاريخياً، فإن الإسلام في هذه المدينة إسلام متصوف. فشيخ العاصمة هو عبد الرحمن الثعالبي، ومقامه يزوره الناس كل حين. مدينة كان يتجاور فيها المسجد والكنيس والكنيسة من غير عداوة. وأهلها ينأون عن التطرف. يدعوهم الفقهاء إلى تحريم الموسيقى، فيزدادون تشبثا بها، حيث لا يخلو حديث بين اثنين عن ذكر الأغاني والمغنين، يدعونهم إلى معاداة الفن، لكن الجزائر العاصمة مدينة فنون ورسم ونحت، وهي حرفة تتوارثها العائلات في ما بينها. كما إن الساكن في الجزائر ظل طويلاً يقتبس من الدين ما يناسبه، مقتدياً بالمثل الشعبي: «صل وارفع صباطك» فالناس لم يخضعوا إلى الدين كما جاءهم حرفياً، بل «جزأروه» جعلوه جزائرياً، أدخلوا عليه تعديلات بما يُناسب حالاتهم، وتلك أيضاً خصلة مقتبسة من ثقافة القرصان، الذي لم يذب في الغرباء الذين جاؤوا إلى بلده، بل جعلهم يذبون في عاداته وتقاليده.
صارت ثقافة القرصان مجرد ذاكرة بعيدة في أذهان من يسكن الجزائر العاصمة. تقلبات الأزمنة أحالتنا إلى إنسان يُخاطب السماء وكفى، راجياً بركاتها، من غير أن يفعل شيئاً على الأرض. منغلقاً على نفسه، مقتدياً بتعاليم «الباديسية». لم يعد البحر الذي يُقابل المدينة حيزاً للحلم أو المغامرة، بل صار الشباب يستديرون إليه وهم يفكرون في مغادرة من غير عودة، في ركوب قارب يوصلهم إلى سواحل إسبانيا، فينفصلون بأبدانهم عن تاريخهم مثلما انفصلوا عنه روحياً. صار الإنسان في الجزائر العاصمة يحلم بآخرته أكثر مما يحلم بدنياه. لا يعيش يومه، بل ينتظر ساعة المغرب كي يوصد بابه، فينام مثلما من أضاع الشغف بالعيش. تغلبت الأمنيات على روح المقاومة. مقاومة الركود الذي تحيا فيه عاصمة البلاد. لم يعد السير في الشوارع الفارغة ليلاً آمناً، لم تعد المرأة تشعر بالانتماء إلى المكان. هكذا فقدت الجزائر العاصمة زهو أيامها، تراجع ضجيج مثقفيها وفنانيها، وانحبست في انتظار مستقبل آخر، يُعيد إليها رداءها الأصيل.
روائي جزائري