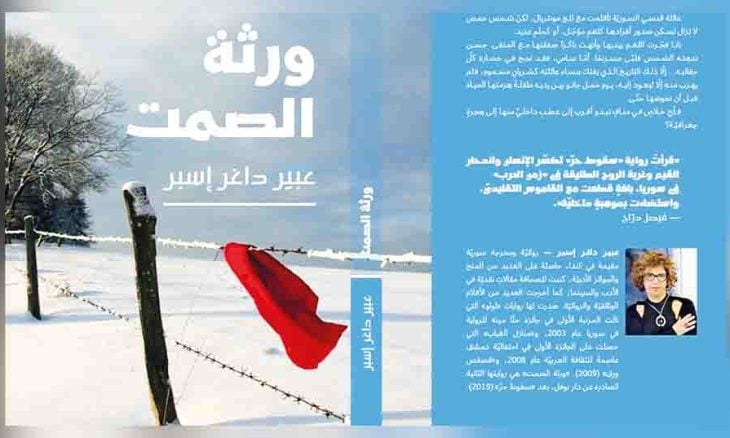تطور الاستدلال العقلي في الفلسفة العربية الإسلامية

مهدي غلاّب
في موضوعات تبيان المنطق بطرائق الاستدلال العقلي، كان للفلسفة العربية الإسلامية دور مهم، ظل يتعاظم على امتداد فترات الأوج الذهبي في العصر الوسيط، مستفيدة من النظريات اليونانية الأولى، خاصة المقولات الفلسفية المنسوبة لأرسطو وأفلاطون. فلمع نجم عدد من المتكلمين وأصحاب البيان وأهل الحكمة والعقل والعلم بداية بالفارابي وابن سينا والطوسي وصولا إلى الشهرستاني صاحب «الملل والنّحل» والرازي المعروف بابن الخطيب فركن الدين الفقيه تلميذ الطوسي الذي ولد عام 1247، دون أن ننسى العالم محجة الدين الإمام الغزالي. برز في شرح مقولات المنطق اليوناني الأولى المنسوبة لأرسطو العديد، منهم الجيزي (ابن الجيزة) المصري المُلقب بالحسن علي بن رضوان الذي برع في اعتماد أساليب القياس المنطقية العقلية والحسية التي قلصت – بفعل احتمالاتها البسيطة والمعقّدة – الهوّة بين التصوّر والواقع، وقرنت بين المحسوسات والمعقولات في أشكال القضايا وأضربها المتفاوتة، باعتماد طرق القياس الحملي. مثال القضايا الكلية «كل رمل تراب، وكل تراب جاف فكل رمل جاف»، والجزئية على نحو «كل عاقل رجل وكل عاقل شجاع، فبعض الرجل شجاع»، والتحجج والاستدلال بقضايا القياس الحملي البسيط والمركب، وقضايا القياس الشرطي البسيط والمركب، عبر مراعاة عنصر الاحتكام للحد الأوسط في خوض المقاربات الفلسفية النظرية والهندسية الشكلية.
على شاكلة الطّرح الكندي وقبله بكثير إقليدس صاحب نظرية التوازي، والمقاربات العلمية عبر الاستنتاجات من خلال حالة واحدة أو أكثر، والفلكية التي تضبط القضايا وتحدد أوجه الاختلاف وتقرب الطرح من بيئته بالاستناد إلى أمثلة وملاحظات تجريبية. فكان تناول القياس في المنطق الفلسفي بمثابة أوج العطاء المعرفي في التاريخ العربي وشكّل التحاما مثمرا مع مبادئ وأصول المنطق اليوناني، شارحا في جانب منها ومكملا في جانب آخر مع تحليل معتبر أوصل جوهر خباياه وخفاياه إلى جمهور العارفين والسائلين والمتعلمين والباحثين في المحيط العربي الإسلامي، وأضاف لكنهه نكهة شرقية عقلانية متبصرة، ضمنت المحصلة الإيجابية وساعدت في زيادة بناء الفكر والنظر وتحفيز الاقتباس لإنتاج الثراء، وتطوير شتى العلوم في المعاني والبيان والبلاغة والبديع والسجع.
بلغ تناول العلاّمة ابن رضوان، لمقالتي أرسطو في القياس الحملي والشرطي من حكمة وروية وبديهة، ما بلغه تناول مقالتيه في البرهان – اللذين سنمر عليهما في قراءة تالية – بواسطة انعكاس المحمول على الموضوع، والموضوع على المحمول في أشكال القضايا السالبة الكليّة والسالبة الجزئيّة ثم الموجبة الكلية والموجبة الجزئية.
ورد تناول القياس في مُؤلّف «في المستعمل من المنطق في العلوم والصنائع» لابن رضوان المولود سنة 1061م الموافق لـ453 هجرية، كتفسير للمقالة الثانية لأرسطو في عدة قضايا متباينة، تحتكم فيما بينها للحد الأوسط، باعتماد فرضيات قياسية تستند إلى التجريب والتشريح، وأحيانا المقارنة والمعادلة والحس تارة والحدس طورا لعدد من القضايا. فجاء الجزء الأول في شكل مقاربات سميت بالقياس الحملي في جزء، والشرطي في جزء تال تفنن فيه تاركا الأثر في إظهار مدى عمق الدراسة المنطقية القياسية الشرطية، كتوطئة لاحقة للعلوم العقلية.
حملت المقدمة في أبوابها السبعة تقدمة الحملي والشرطي ومختلف الضروب والأشكال في الباب الثاني، مع المرور على حالات الالتباس والتشبه بالقياس، ثم تعداد القضايا التي تسهل وجود القياس وتعسره إلى التشبه بالمقدمات واستنباط القياس وصولا إلى استعماله، سواء باعتماد أمثلة حسية تم المرور على بعضها، أو عبر خريطة شكلية مفتاحية تستدعي مختلف حروف الأبجدية، على غرار المثال العام المبسط و الناطق» آ على كل ب وب على كل ج فآ على كل ج». إضافة إلى تعداد القضايا الحملية القياسية وما تحمله من أضرب في شكل وضعيات كلية وجزئية وكبرى وصغرى، تنطلق من الوضعية السالبة لتستنتج أو لتصل إلى الموجبة الجزئية، أو الكلية، وقياسات الشكل التي تحول الضرب الموجب الجزئي إلى الموجب الكلي والضرب السالب الجزئي إلى السالب الكلي.
على نحو العلوم المتعارفة في الهندسة مثل قاعدة الكل أعظم من الجزء والخطوط الموازية للخط نفسه تكون متوازية في ما بينها، والمتعارف عليه في المنطق مثل الإنسان لا يكون واقفا وجالسا في الوقت نفسه. ومن ثمة يمر إلى تكذيب بعض القضايا باعتماد قاعدة الخُلف عبر إيراد نقيض النتيجة المتحصل عليها، نظرا لعدم تطابق الطرح مع الحقيقة والواقع. كما مثل الافتراض حلقة كبرى لتوسيع دائرة التحليل عندما يتم إدماج عناصر جديدة مستعملة والاستدلال بها لتعميم النتيجة ومزيد تقريبها من فهم الجمهور. ومكن استعمال مختلف المقاربات العقلية من تمييز الذاتي من العرضي، والحقيقي مما هو متعارف عليه بالرأي المحمود (الحد الأوسط)، مرورا إلى تحديد آليات عقلية تكاد تكون برهانية يحتكم إليها منها، القسمة التي تعتمد مفهوم الإيجاب والسلب (الحيوان مشاء وغير مشاء) ومفهوم الأجناس والأصناف (المشاء والسابح والطائر والساعي). ثم الضمير الذي يطبق الخاص (المفرد) على العام (الجمع) بمحمول واحد مثل «زيد يدور بالليل، فزيد لص» وبمحمولين مثل «زيد يدور بالليل وبيده عصا، فزيد لص». وبعد ذلك العلامة التي تشبه الضّمير، لكنها دالة على أمر من الأمور التالية، التي وجدت في الأول، مثال ذلك «رأيت امرأة تدر الحليب ومعها طفلها، فكلما رأيت امرأة مع طفلها عرفت أنها تدر الحليب»، وهناك جانب من العلامة معتمد أصلا في علم الفراسة والطب والتحدي، وكذلك شؤون المحاكم عند إصدار الأحكام، لكنها تبقى مسائل حساسة تعود بنا حتما إلى سطوة بطش الحاكم في مطاردة الخصوم والانتقام، دون المرور بالعدالة الصحيحة. هذا إلى جانب مفهومي الاستقراء والمثال، حيث إن جوهر القياس ينحصر في قرن مقدمة بمقدمة لتحصل نتيجة لأن جوهره يستعمل في المخاطبة والمعاملة، فإذا زل أحد المتعاملين عرف موضع الزلل وتمييز مواضع الصدق من مواضع الكذب في المخاطبات والكتب وذلك باستنباط الأمر الخفي واستخراج حده وتحليله إلى محموله لإثباته أو إبطاله، بحيث إن معرفته من جهله تظل مطلوبة.
وجرت العادة على أن تستعمل نتائج القياس في الصنائع المنطقية الخمس وهي البرهان، بوضع قضايا حسية مجربة، والجدل بتقابل الشيء ونقيضه والسفسطة بالادعاء بمعرفة الحقيقة زورا ما يؤدي إلى الشك فالحيرة، وبالخطابة كأداة لتسيير الرعية وتطويع الجاهل والانتهازي لأهواء القرار وأصحابه، وتبجيل مصلحة المُلك وزرع البروباغندا وصولا إلى المواضيع الشعرية التي تنبئ بسمو الفرد، باعتماد «الميميزيس»، أو محاكات الطبيعة كأحد أسمى درجات الإدراك التي تطرق لها أرسطو قديما وهيغل حديثا.
كاتب تونسي