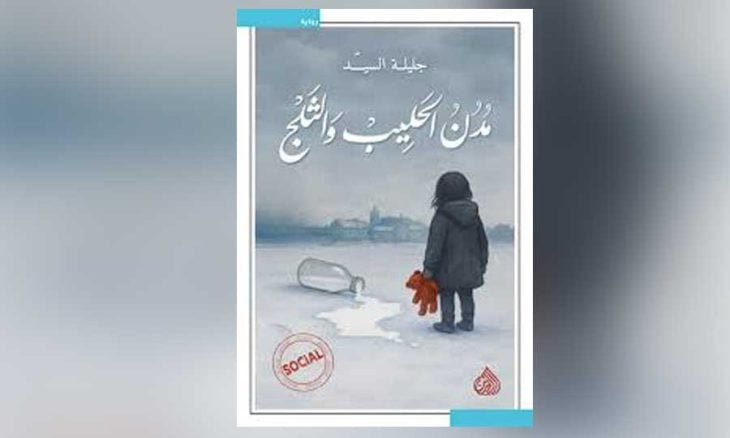التلقي المغربي لشعر محمود درويش: جدلية الموت والحياة بما هي مصدر إلهام وعطاء عابر للأزمنة

التلقي المغربي لشعر محمود درويش: جدلية الموت والحياة بما هي مصدر إلهام وعطاء عابر للأزمنة

عبداللطيف الوراري
محمود درويش المغربي
كان لقصيدة محمود درويش تاريخ خاص كانت تتجدّد عبره علاقة التلقي المغربي بعناوينها وإيقاعها ورموزها وتحولاتها النوعية، وهو ما أرسى تعاقداً ثقافيّاً وجماليّاً بينهما أثمر بحوثاً وأطاريح جامعية قيّمة، أنجزها باحثون مغاربة عن شعره وتجربته المتوترة بين السياسي والشعري على مدار عقود، مثلما كانت تترجمه الأمسيات الجماهيرية الحاشدة، التي أحياها الشاعر وحرّر كثيراً من قصائده الجديدة في هوائها. وأذكر أنّه في أواخر التسعينيات كم كان محمود درويش، حتى في لحظة مرضه وإعيائه، يطير من الصفاء وهو يُنْشد على مسرح محمد الخامس قصيدته التراجيدية المطوّلة «جداريّة» حتى عُوفي، بل إن ديوانه الفارق «ورد أقل» الذي يؤرخ لأبرز منعطف جمالي عرفته شعريّته، حين أخذ يحررها من ثقل الحادثة وضغطها السياسي والتاريخي، خرج إلى الناس من الدار البيضاء في أواسط الثمانينيات. وقد احتفظت لنا ذاكرة الشاعر النصية وجوهاً وطيوباً وأيقوناتٍ وروائح مغربيّة اِلتقطها غناؤُه في طريقه إلى تغريبتنا، بمن في ذلك «شبابٌ مغاربةٌ يلعبون الكرة».
وما يزال الناس إلى اليوم يخرجون في مظاهرات عارمة، متضامنين مع قضية فلسطين، التي اكتشف معظمهم جراحاتها من شعر الشاعر أكثر من أدبيات السياسة والنضال المباشر، ومن خلالها كانت تتماهى ذائقتهم مع القضيّة، بوصفها قضيتهم الوطنية بمنأى عن كلّ أيديولوجيا أو مناورة أو اصطفاف ضيق. ولكم كان طريفاً أنّك إذا سألت الناس في الشارع، بمن فيهم طلاب الثانوية والجامعة، عن أهمّ شعراء المغرب، فإنّهم يذكرون لك اثنين، هما: عبد الكريم الطبال نزيل شفشاون وناسك جبلها الأشهر، ومحمود درويش الذي يحسبون مسقط رأسه ناحية البحر، ومنه استلهم الإيقاع وأخذ الأسطورة.
وما يزال شعر الشاعر، بعد عقد ونصف العقد من رحيله، محطّ اهتمام النقاد والباحثين الجامعيين المغاربة، يدرسونه بمنظورات معرفية ومنهجية مختلفة لا تقع أسير شخصيته القالبية، التي درج عليها النقد الأيديولوجي بمفاهيمه الاختزالية الدوغمائية ومسبقاته الوثوقية المتصلبة، حيث تستنزفه في نماذج مُقرّرة سلفا، وكأنهم التقطوا وصية الشاعر الأخيرة، حين نبه إلى سلطة الحجب التي مورست على شعره من خلال الإفراط في استعمال التأويل السياسي والأيديولوجي في قراءة شعره، لأن ذلك يُصادر حريّته بقدر ما يُجْهز على حياة القصيدة نفسها وعبورها الحاسم في الوعي الشعري المعاصر، ضمن ما كانت تطرحه من مسائل وخواصّ جمالية وفكرية متقاطعة، وتختزنه من أبدية لا مُفكّر فيها تتجاوز الزمني إلى اللازمني. وحسبي هنا أن أذكر بعض هذه الدراسات التي صدرت بعد رحيله، وسعت إلى استعادة حرية الشاعر وحداثة شعره، بما هي مختبر جمالي وفكري، ذاتي وجمعي في آن، لكن دون نفي القضية الفلسطينية ودورها الفعلي في هندسة المتخيل الشعري. أخصّ بالذكر تلك الدراسات التي عالجت جدلية الموت والحياة في شعر محمود درويش، من منظورات متباينة؛ فلسفية وأسطورية وتأويلية، غير أنها تجمع على انحياز القصيدة للحياة.
فضاء الموت
في دراسته «جماليات الموت في شعر محمود درويش» يركز الباحث عبد السلام المساوي على فضاء الموت، الذي يتردّد في معظم أعمال الشاعر بأنساق وصيغ مختلفة، إفراداً وتركيباً، ويتخذ بعداً مناقضاً لمفهومه العادي باعتباره نهاية الحياة ودخول عالم الأبدية. فهو معبر ضروري في المشروع الحيوي لشعب يرفض أن يعيش مهاناً فاقداً هويّته التاريخية، ومن ثمة يغدو «استراتيجية أساسية لاسترجاع الكيان الروحي والمادي الذي تستحق به الحياة ان تُعاش». وقد تتبع الباحث تردُّدات موضوعة الموت وأبعادها داخل النصوص الشعرية في بنياتها النصية، أو في عتباتها الموازية (العناوين، التصديرات، الإهداءات) بدءاً من ديوانه «أوراق الزيتون» 1964، إلى ديوانه «حصار لمدائح البحر» 1984، قبل أن ينشغل أساساً بـ»جدارية محمود درويش» 2000، لما فيها من انزياح دلالي وجمالي وتخييلي داخل تصوُّر الشاعر لفكرة الموت وأبعاده برُمّتها. فقد شهدت تجربة الشاعر عبر مسارها الإبداعي الطويل مفهومين للموت: مفهوم جماعي يقوم على تمجيد الموت باعتباره عرساً للشهيد، ومدخلاً لاسترجاع الأرض والهوية، وتنظر إليه الذات بوصفها جزءاً ملتحماً بالكلّ. ومفهوم خاص يتمثل في تذويت الموت وتأمّله في سياق الرؤية الفردية المدعومة بتجربة المرض، التي قرّبت الذات من مصيرها وأتاحت لها أن تتأمل هذه اللحظة بكثيرٍ من الحكمة والتفلسف الخاص.
فمن جهة أولى، تحضر الأرض بصفتها رمزاً للأمومة المانحة للهوية، التي لا يملك الأبناء إلا أن يُؤْثروا موتهم الشخصي لكي تستمرّ الحياة فيها، أيّاً كان مكان استشهادهم، ولذلك يشغل موضوع الاستشهاد باعتباره الموت الأسمى، حيّزاً كبيراً في قصائد محمود درويش، بموازاة مع صعود حركة المقاومة الفلسطينية واقتراف آلة الكيان الصهيوني لأبشع الجرائم في حقّ الشعب الفلسطيني، ورغم أن الموت بات يحصد الفلسطينيّين في كل مكان، إلا أن ذلك لم يكن يعكس اغتراباً يستوطن ذات الشاعر، أو شعوراً حادّاً باليأس، بل كانت القصيدة، بشكل مقلوب، تطفح بقدر هائلٍ، ضمنيٍّ، بالأمل، لمّا كانت تختبر قدرة الموت العنيف وحدوده نحو إمكان إنتاج حياة جديدة أعنف، ضمن مسار ملحمي يجتهد في تحويل سقوط أجساد الشهداء إلى ملحمة حافلة بالأبعاد الدراماتيكية الخصبة.
ومن جهة أخرى، تصدر فكرة الموت، ولاسيما في «الجدارية» عن منظور ذاتي، في صلة بتغيّر مفهوم الشعر لدى الشاعر ووظيفته تبعاً لتغيّر إيقاع العصر والتطورات الحاصلة في المسألة الفلسطينية بعد مفاوضات أوسلو، أو تبعاً لأسباب فيزيولوجية تتعلق بصحّة الشاعر بعد أزمات قلبية عدة ألمّت به، وأخضعته لعمليات جراحية دقيقة، وجد نفسه خلالها وجهاً لوجه أمام الموت، ليكشف من خلالها قطيعةً ليس مع مفهوم الموت فحسب، بل مع مفاهيم نوعيّة تخص مسألة الكتابة برُمّتها. فـ»الجدارية» أتت في قلب التحوّلات وزمنها، ومثلت مواجهةً للموت بسلاح الذاكرة الحيّة التي تختزن قدراً وفيراً من الأحداث والرموز الثقافية. وكانت الخلفية الثقافية التي يصدر عنها الشاعر، وهو يرفع جداريّته في وجه الموت عبر رثائه والسخرية منه، تنسجم تماماً مع مقصديّته في الإفصاح عن تشقُّقات كينونته وأناه الغنائي، بعد العلم الذي انتهى إليه في طوافه الطويل، وفي مغامرة روحه من رحلة البحث، ناشِداً ومُنشداً. وهكذا يأتي الحديث عن الموت الذي اصطرعت معانيه في وعي الذات ومجهولها، مشتبكاً برموز الحياة التي تُنعش ذاكرة الكائن ومقاومته لأشكال النبذ والفناء.
وفي تأويله لجماليّات الموت، يصدر الباحث عن استراتيجية نقدية تستقصي أجروميات الشكل الشعري عبر عناوين فرعية، بدءاً من معجم الموت إفراداً وتركيباً، وتحليل رمزية الألوان ودلالات الزمان والمكان في تحديد صور الموت، ثم التناصّ، كونه دليلاً على ثراء النص الدرويشي ولغته الشعرية التي تتحرك داخل مرجعيات أسطورية وأنطولوجية وثقافية تراثية وكونية متنوعة تفتح خطاب «الجدارية» على آفاق رحبة ومتباينة من المعرفة كسلاح مواجهة وتحدٍّ للصمت.
رؤية تمّوزية
وفي دراسته «تحولات تموز في شعر محمود درويش» يتناول الباحث علال الحجام شعر الشاعر ضمن حركة الشعر الفلسطيني الحديث، الذي حاز فرادته من صهر الخاص في العام، والفردي في الجماعي، وخلق مسافة بينه وبين القضية، لا للقطع معها، وإنما لإحراز استقلال نسبي عنها واقتحام فضاء مغامرته الواسع. ولهذا شكّل لنفسه حداثة خاصة تعي أن نجاح تجربتها في الشعر العربي رهينة بمغامرة إنتاج اللغة الشعرية، وانفتاحها على ما هو كوني ووجودي ضمن الرؤية التموزية، التي استطاع أن يطورها ويمدّها بوسائط رمزية مؤهلة بما تكتنزه من طموح وتحرر وإيمان بالغد. وانسجاما مع هذا التصور، حاول الباحث إقامة معرفة داخلية بالنصوص، يسائلها تارة ويحاورها أخرى، متفحّصا أهم مكوناتها الشعرية، وهما المستوى الدلالي والمستوى الصوتي. ناقش في الأول أشكال التصوير الشعري، فلم يهتم بالصورة الفنية فقط، بل تتبع إواليات بناء الصورة التي تتدخل أصناف متعددة في تشكيلها مثل الصورة الأيقونية المحاكية والصورة الأسطورية؛ وهي الصورة التي كانت إيذانا بتأمّل الرؤية المهيمنة في شعر محمود درويش: الرؤية التموزية. فإلى جانب العلاقات المتشابكة التي تنسجها الصورة الفنية عادةً بين الحسي والمجرد أو بين الطبيعي والإنساني، انتبه الباحث إلى التمييز في الشعر بين «الأسطورة» باعتبارها سردا، و»الأسطوري» باعتباره نمطا أعلى أو نمطا بدائيّا، وقاده الأمر إلى استخلاص مقامين لتجلّي الأسطوري عند الشاعر؛ هما: مقام الفردوس ومقام الجحيم، اللذان تبلور نتيجة تمازجهما وتواليهما أساسُ الرؤية المتمثل في مقام ضمني ثالث هو مقام الانبعاث.
لقد ظلّت الرؤية التموزية تتجذر في أهم نصوص محمود درويش على امتداد حوالي خمسة عقود، وكان ثمة ميل ملحوظ لدى الشاعر في تأمله الجدل الأبدي القائم بين الموت والحياة، وهو جدل انتهى فيه إلى الانتصار للانبعاث بوصفه اختيارا لا واعيا نابعا من مرارة المعاناة وعمق التجربة؛ وهذا الأمر قاده ـ لا شعوريّاً- إلى شق طريق البحث عن مظاهر الحياة في سياق بعدين اثنين: أولهما هو الخصب طبيعيّاً أو بيولوجيّاً، والثاني هو الخلود والحياة بعد الموت: يعبر الأول عن نموذج التضحية الوثنية البدائية التي تتجسد في أساطير الموت والانبعاث وعقائدها، ويتخذ الثاني الموتَ بوّابةً للحياة عبر التضحية والفداء، كما نجدها في الديانات السماوية، خاصة المسيحية. ويعكس البعدان معاً إيمان الشاعر الراسخ بـ»التقابل الموجود بين شخصية الفلسطيني الباحث عن وطنه في طريق التضحيات الجسام والنضال المستمر، وبين شخصية السيد المسيح الذي افتدى بني البشر تخليصا لهم بعذاب الصليب من تبعات الخطيئة حسب التصور المسيحي».
وإمعانا في الانتصار للحياة، لاحظ كيف يخرق الشهداء العادة في متن الشاعر، مستعيرين لهم ما يقوم به الأحياء من أفعال وأعمال وحثّ وتحريض على التحرر والانعتاق، متبادلين الأدوار معهم، كما تحلّ الأرض ومكوناتها في الإنسان ويحل الإنسان بدوره في الأرض ومكوناتها، على نحو يعكس العلاقة بين الحياة والموت في الرؤية التموزية، التي تؤدي إلى مستوى عالٍ من الحلولية بقدر ما يصبح ممكنا الحديث عن حياة في الموت.
توسيع الوجود الشعري
يقترح أحمد بلحاج آية وارهام في دراسته «أنســاق التوازن الصوتي في شعر محمود درويش» قراءة وصفية تأويلية تركز على فعالية هذا الشعر التي تتأتّى من «الطاقة الإنشادية السحرية» في تشابكها مع بنية الخيال وتحولات الدلالة. فالعمارة النصية في أي عمل للشاعر تنهض على خواص تعبيرية وجمالية مبتكرة، من خلالها تنتظم الذات في خطابها، وتمارس لعبتها الشعرية التي تقرن الموت بالحياة في مختلف سياقاتهما معجما وصورة، وتدمجهما في فضائها كموضوعين حيَّين وليس كوجهين متقابلين؛ حيث يفلسفهما الشاعر، ويؤنسنهما، ويحاورهما شعريّا في صيرورتهما إلى حدّ التوحد والاندماج، على نحو يحول فكرتي الموت والحياة إلى «فكرة شعرية خاضعة لمنطق الدوالّ ومنطق الخيال، وإلى معادلة أَسْطَرَةِ الشاعر وذاته الشعرية، والارتفاع بهما خارج البعد الإنساني القابل للموت والحياة بالمعنى المادي التقليدي» بشكل يتسامى فيه الشعر والشاعر، فلا يعني موتُ الشاعر موتَه، وإنما يعني «طيرانه حتى الأزل». فأعمال محمود درويش من «عصافير بلا أجنحة» إلى «أثر الفراشة» هي ـ في نظره- عبارة عن «رواية لقصيدة الموت والحياة» بكل ما تشي به من أحلام مُنشدَّة إلى اللانهائي، وترقى إليه عبر جماليات اللغة وسحر الإنشاد، التي تضيف إلى غنائية الإيقاع ألوانا وأساليب تتحايل على الموت وفجائعية الأحداث، وتحولها إلى رموز أساسية من رموز الحياة.
فهذا الانهمام بفكرتي الموت والحياة يتصل بالجوهر الشعري عند محمود درويش، ويأخذ مديات أرحب تكشف فاعليتهما في الذات والعالم، من خلال طريقتين فنيتين، هما: التوازن الصوتي والتساوق الدلالي باعتبارهما بنيتين متجادلتين في الجسد النصي، حيث يغدو الشعر مكنـز الوجود ولغة ممكناته واحتمالاته، وحيث الوجود نفسه يمارس لعبة الحياة (= الحب) ولعبة الموت (=الكُرْه) وَفْق جدلية الملء والإفراغ، الإثبات والنفي، تبعًا لوقع الأحداث على الشاعر ومعايشته لها في الزمان والمكان، وما ترخيه من تحولات مفجعة أو سارّة في العالم على ذاته المرجعية والتخييلية في آن.
ومن هنا، فإن أغلب المعاني التي يطرحها معجم الحياة والموت عند الشاعر، تتحرك وفق استراتيجية فنية مزدوجة: تحويل الموت إلى حياة نابضة بالتوهج والتألق، كما هو في موت الشهيد الذي هو عتبة أساس للدخول إلى الحياة بمعناها الأسمى (الأرض، الحرية، العدالة، الحب، الجمال، الإخاء)؛ وتذويت الموت، وتأمُّله، ومحاورته في سياق الرؤية الفردية المدعومة بمرجعيات ثقافية متباينة، وبتجارب الذات في مختبر الوجود. وضمن هذه الاستراتيجية تجري إعادة التسمية بشكل يتخفف من إكراهات التلقي وضغوطاته، التي تريد أن تؤطر الشاعر ضمن يافطات معلومة وتتداوله جماهيريّاً ونقديّاً؛ أي كشاعر مقاومة، أو سلطة جمالية واسعة على جمهور الشعر. فقد وسع الشاعر حدود التلقي بوعيه الحادّ، الذي يتمثل شعرية الوجود خلف ما هو موجودٌ، وينظر إلى القصيدة بوصفه حركةً وحلماً وتوقاً إلى اللانهائي. ومثل هذا الوعي هو الذي جعله يستقيل من السلطة بكل تجلياتها، وينجز مفهوماً جديداً يوسع المختبر الشعري ويُحرّره من النظرة الأحادية للعالم، ومن صرامة مبادئ العقل، بقدر ما ينفتح على الاختلاف والتعدد، وعلى الحرية والإمكانات الجديدة التي يتيحها إيقاع الذات في كل مرة لاستكشاف معنى للحياة وصيرورتها التي لا تتحدد بزمان أو مكان ما.
كاتب مغربي