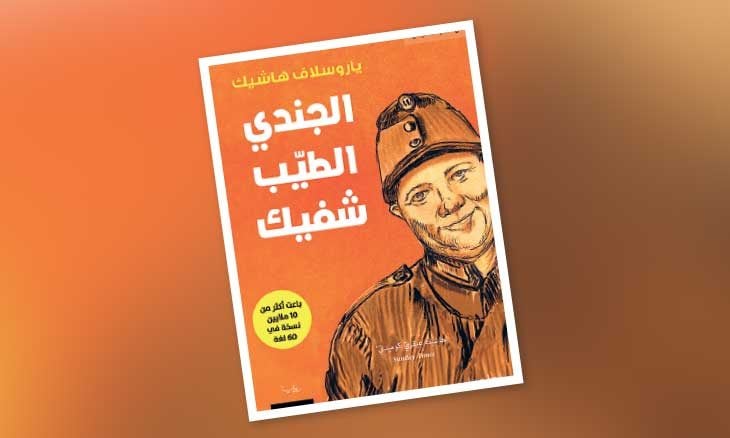ترجمة الروايات.. طَبقُ الإبداع «البايت»

بروين حبيب
سألني بعض القراء المتابعين حين اطّلع على مقالي الأسبوع الماضي أين يجد الترجمة العربية لرواية «أصدقائي» للكاتب البريطاني الليبي هشام مطر؟ فأجبته ضاحكة، لكنه ضحك كالبكاء بأن عليه الانتظار بضع سنوات ليتمكن من قراءتها بلغة الضاد، في حين أن ترجمتها الفرنسية صدرت بعد يومين فقط متزامنة مع الطبعة الأصل الإنجليزية. وحين أبدى استغرابه أخبرته أن أشهر كتب هشام مطر أعني مذكراته «العودة: آباء وأبناء والأرض بينهما» لم تترجم إلى الآن إلى العربية، رغم أنها صدرت منذ ثماني سنوات (2016) وحازت جوائزَ عديدة ومنها جائزة البوليتزر بعد سنة من صدورها، وتُرجمت إلى أكثر من عشرين لغة، وصنفت أخيرا في قائمة «نيويورك تايمز» ضمن أهم مئة كتاب في القرن الواحد والعشرين، فكم سنة على القارئ الذي لا يتقن سوى اللغة العربية أن ينتظر لقراءتها؟
وتأخّر ترجمة الروايات العالمية إلى لغتنا ليس ظاهرة جديدة، ولا تنقصنا الأمثلة على ذلك يكفي أن نذكر أن رائعة نابوكوف «لوليتا» انتظرتْ أكثر من ثلاثة عقود لتصدر مترجمة إلى اللغة العربية، على يدَي سهيل إدريس، وهل كان من الطبيعي أيضا أن ننتظر أكثر من خمس عشرة سنة حتى يحصل ماركيز على جائزة نوبل لنستمتع بقراءة أيقونة الواقعية السحرية «مئة عام من العزلة» بلغتنا، وكانت جائزة نوبل في الأدب – حين ينالها روائي – دائما دافعا أساسيا لتسابق الناشرين إلى ترجمة روايات الفائز إلى اللغة العربية، فلولاها ما كنا سمعنا بالروائي التنزاني ذي الأصول اليمنية عبد الرزاق قرنح، رغم أن مواضيع رواياته تهم القارئ العربي فهي تتناول قضايا الهجرة والاستعمار والعنصرية وتمازج الثقافات، ورغم أنه لم يكن نكرة قبل نوبل، فقد كتب عشر روايات ناجحة وصل بعضها قبل ربع قرن من نيله جائزة نوبل إلى قائمة البوكر القصيرة سنة 1994، وإلى قائمتها الطويلة سنة 2001، تفاجأ المثقفون العرب على اختلاف أطيافهم بفوزه، وتفاجأوا أكثر أنهم لم يجدوا له رواية واحدة منقولة إلى لغتهم.
وأذكر مثالا آخر، فحين كتبت مقالي «حيز الخلود» قبل أربع سنوات في هذه الصحيفة عن الروائية آسيا جبار، لم يكن قد تُرجم لها إلى العربية سوى سيرتها الذاتية «بوابة الذكريات» مع أنها أشهر كاتبة جزائرية تكتب باللغة الفرنسية، ونُشرت روايتها الأولى «العطش» منذ قرابة سبعين سنة ولها أكثر من خمس عشرة رواية، كما كانت أول كاتبة عربية تحظى بعضوية الأكاديمية الفرنسية عام 2005 قبل أمين معلوف بسنوات. ورغم وفرة أبناء بلدها من الجزائريين خصوصا والعرب عموما الذين يترجمون عن اللغة الفرنسية، ووجود جائزة أدبية باسمها في الجزائر ما زلنا بشوق لقراءة كتاباتها بالعربية. لا أنكر أن هناك مؤسسات كبيرة تهتم بالترجمة على رأسها المركز القومي للترجمة في مصر، الذي وضع نصب عينيه ترجمة ألف كتاب في السنة كما جاء في موقعه الرسمي، رغم اعترافه أن هذا الرقم متواضع جدا مقارنة ببلد مثل إسبانيا، حيث يصل نصيب كل مليون مواطن إسباني إلى 250 كتابا مترجما، في حين أن نصيب كل مليون مواطن عربي حوالي كتاب مترجم واحد. كما أن هناك مشاريع لتمويل الترجمة من خلال برامج ترعاها دول عربية أو ملحقات ثقافية أجنبية، إلا أننا ما زلنا بعيدين عن الحدّ الأدنى المقبول، فلا يزال ميدان ترجمة الروايات (وترجمة باقي التخصصات لا يختلف عن ذلك) يعاني من الارتجال والفوضى وقلة الاحتراف في كثير من الأحيان، دون ذكر التعدي على حقوق الملكية الفكرية، رغم القوانين التي من المفترض أن تكون رادعة. لكن لبعض الناشرين إبداع يحسدون عليه في التحايل عليها، لعل أطرفها ما قام به أحد الناشرين من تغيير عنوان رواية أمبرتو إيكو الشهيرة «اسم الوردة» إلى «الجنس في الكنيسة» مراهنا على الغرائز في ترويج الرواية، وهروبا من أصحاب الحقوق الأجانب.
ومن المفارقة – وهو أمر يعطّل أيضا سرعة ترجمة الروايات المهمة ـ أننا نجد في الوقت الذي نشتكي فيه من غياب روايات مفصلية في الأدب العالمي عن الساحة العربية، نجد في المقابل عدة ترجمات لرواية واحدة، ورجوعا إلى المثال السابق عن رواية «مئة عام من العزلة» التي بقيت مركونة في أدراج هيئة الكتاب في مصر سنتين، حين ترجمها سليمان العطار لولا أن نفض عنها الراحل صلاح عبد الصبور الغبار وكان رئيسا للهيئة آنذاك، وأمر بطباعتها، ومنذ تلك اللحظة حَلِيَتْ في عيون الناشرين، فنجد لها في المكتبات قرابة عشر ترجمات مختلفة، ومن المنطقي أن واحدة منها فقط لها حقوق الترجمة، في حين استمدت البقية حقوقها من الربح المضمون من وراء بيع رواية رائجة مثلها. وبمقارنة بسيطة مع حضور هذه الرواية في اللغة الإنكليزية، نجد لها ترجمة واحدة فقط صدرت قبل 54 سنة قام بها غريغوري راباسا، وكانت متقنة إلى الحد الذي قال عنها ماركيز نفسه بأنها تفوقت على نصه بالإسبانية. ولم يجد الناشرون ولا المترجمون حاجة لتشويش القارئ بترجمات مكررة، بل توجهوا إلى مشاريع أخرى، وما أكثر الروايات اللاتينية الرائعة التي تنتظر نظرة من مترجم عينُه في الأغلب على ما سبقت ترجمته، وضُمِنَ رواجه سعيا وراء الربح لا غير.
ما الداعي الأدبي لنجد لروايات مثل «الأمير الصغير» لسانت إكزوبري، أو «الغريب» لكامو، أو «مزرعة الحيوان» لأرويل قرابة عشرين ترجمة باللغة العربية، تجعل القارئ في حيرة في المفاضلة بينها مع غياب حركة نقدية تتتبّع الترجمات وتبيّن جيدها من رديئها؟ قد تكون إعادة الترجمة مبررة وهو أمر شائع في الأدبيات الغربية، إذ نجد لـ»محاكمة» كافكا، أو «البحث عن الزمن المفقود» لبروست، أو «الحرب والسلام» لتولستوي أكثر من ترجمة، لكن يحدث ذلك لدواعي واضحة كأن يقترب المترجم الجديد أكثر من الخصائص الأسلوبية للروائي الأصلي، فبعض الروايات تُرجمت بلغة أدبية راقية مبتعدة عن لغة الروائي، التي قد يكون ذات خصوصية أو مطعّمة بلهجة عامية مما يفقد الترجمة روحها، وهذا مفهوم بل مطلوب، أو لسبب آخر مثلما ذكره الكاتب حسونة المصباحي عن دواعي إعادة ترجمة رواية أورويل «1984» حين كتب بأن «الترجمة الجديدة تخلت عن الماضي لصالح الحاضر، لكي يكون الواقع المرعب الذي تصفه الرواية أكثر حضورا. كما أنها ابتكرت عبارات وأوصافا تتناسب بشكل بديع مع أجواء الرواية الكابوسية، ومع خصوصيات الأنظمة الشمولية التي برع جورج أورويل في وصفها». فهذه من جملة الأسباب المعقولة لإعادة الترجمة، لكن أن تُترجَم الرواية خمس عشرة مرة ليس لذلك من مبرر سوى الرغبة في الربح لا غير، والارتجال مع غياب تام للتنسيق بين دور النشر، أو حتى بين المترجمين فمؤكد أنه ليس وضعا صحيّا، وتصبح هذه التعددية غير مبررة أكثر في وقتنا الحالي، حيث يمكن أن نعرف فيه بكبسة زر واحدة هل أن العمل مترجم سابقا أو غير مترجم مع سهولة الحصول عليه بصيغة إلكترونية في اللحظة نفسها.
لماذا لا تعاد ترجمة بعض الأعمال التي نقلت عن لغة وسيطة وليس عن لغتها الأصلية، فروايات دوستويفسكي بالعربية منقولة عن الفرنسية وليس عن الروسية مباشرة، رغم جمال لغة سامي الدروبي، وينسحب ذلك على روايات شهيرة مثل «كافكا على الشاطئ» لموراكامي المترجمة عن الإنكليزية و»بلد الثلوج» لكواباتا المترجمة عن الفرنسية، بل يتسع ذلك ليشمل أغلب الإنتاج الأدبي المكتوب بغير اللغات الثلاث الإنكليزية والفرنسية والإسبانية. وإذا كانت الترجمة خيانة – كما يقال – فالنقل عن لغة وسيطة خيانة مزدوجة، تُفقد النص الأصلي الكثير من روحه.
ولأني لا أعرف لغة موليير أتمنى أن أقرأ بالعربية بعض ما لفت انتباهي من روايات أصبحت ظاهرة مثل «رهينة» لسارة ريفنس.. فهل سأضطر لانتظارٍ يمتد لسنوات، إن كان في العمر بقية حتى تتحقق أمنيتي البسيطة؟
شاعرة وإعلامية من البحرين