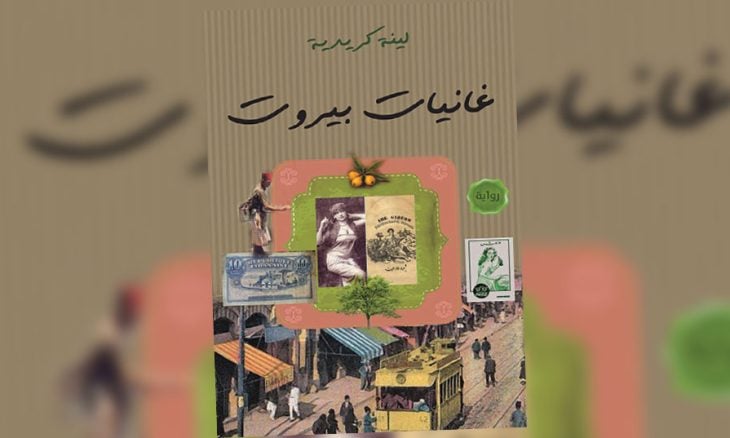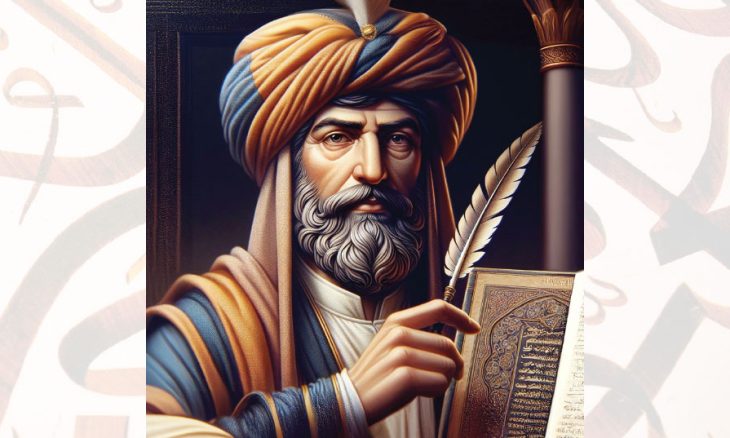
اللغة العربية في منظور ابن خلدون: قراءة لسانية سوسيو ثقافية

مصطفى عطية جمعة
متميزة هي رؤية عبد الرحمن بن خلدون لانتشار اللغة العربية وتمددها شرقا وغربا، ذلك أنه قرأها بأبعاد ثقافية، واجتماعية، وأنثروبولوجية، ودينية.
ففي كلامه كثيرٌ من الإشارات عن حركة العربية من الجزيرة العربية إلى بلاد الأمصار المفتوحة، فقد بدأ بالنظر إلى لغات أهل الأمصار (البلدان المفتوحة)، فوجد فيها اختلافا كثيرا عن العربية الأصيلة التي نطقت بها القبائل العربية، ونزل بها القرآن الكريم، مقرا بأن اللسان العربي أصابه التبديل والتغيير، مع دخول شعوب البلدان المفتوحة في الإسلام، وإقبالهم على تعلم اللغة العربية. ويُعزي ابن خلدون ترك أهل الأمصار للغاتهم الأصلية وإقبالهم على التحدث بالعربية؛ إلى عوامل عديدة، منها ما هو سياسي، متمثلا في غلبة العرب على الشعوب الأخرى، وتكوينهم للدولة المسلمة، فمن شأن المغلوب أن يقلّد الغالب، ويقتدي به. وهو ما يبينه ابن خلدون في موضع آخر بأن «المغلوب مولع أبدا بالاقتداء بالغالب؛ في شعاره وزيّه ونحّلته وسائر أحواله وعوائده، والسبب في ذلك أن النفس تعتقد الكمال فيمَن غلبها، وانقادت إليه، إمّا لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمه، أو لما تغالط به من أن انقيادها ليس لغلب طبيعي، إنما هو لكمال الغالب، وتأمل في هذا سر قولهم «العامة على دين الملك»، فإنه من بابه، إذا الملك غالب لمن تحت يده، والرعية مقتدون به».
فهذا عامل نفسي جمعي، يصيب الشعوب، عندما تجد نفسها مغلوبة منقادة لأمة أخرى، فتظن أن تقليدها للغالب سيكون سبيلها للنصر، وهي رؤية تصدق على الشعوب المستعمَرة في العصر الحديث، وتصدق أيضا على أهل الأمصار في الحضارة الإسلامية، مع الأخذ في الحسبان أن العرب سعوا لإقامة العدل، ونشر الإسلام، فلم تكن فتوحاتهم استعمارا أو احتلالا، وهو ما يؤكد عليه ابن خلدون وهو ينظر في أحوال الفرس، الذين ملأوا الدنيا كثرة بعدد جنودهم، فلما ملكهم العرب، وفتحوا بلاد فارس، وأسقطوا ملك كسرى؛ تلاشت قوتهم. وقد أحصى سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه)- بعد فتحه المدائن عاصمة فارس- عدد الجنود الفرس، فوجدهم مئة وسبعة وثلاثين ألفا، منهم سبعة وثلاثون ألفا أرباب بيوت (أسر)، ومع ذلك انتهوا وضعفوا، ويعلّق ابن خلدون على ذلك بقوله: « ولمّا تحصّلوا في ملكة العرب، وقبضة القهر (السلطان)، لم يكن بقاؤهم إلا قليلا، ودثروا (مُحوا) كأن لم يكونوا. ولا تحسبن أن ذلك لظلم نزل بهم، أو عدوان شملهم، فملكة الإسلام في العدل ما علمت، وإنما هي طبيعة في الإنسان إذا غُلِب على أمر، وصار آلة لغيره».
فقد كان العدل ديدن سياسة المسلمين في حكمهم لشعوب الأقاليم المفتوحة، وفقا لأوامر الإسلام، وإن وُجِدت بعض المظالم هنا أو هناك، فقد كانت استثناءً من القاعدة، وقد رضيت شعوب الأمم والحضارات الأخرى بحكم المسلمين؛ لما وجدوه من نظام عادل، وسياسة حكيمة، وبمرور الوقت، تشربوا الإسلام عقيدة ودينا ولغة، ومن ثم كان لهم دور في بناء الحضارة الإسلامية، وأخرجوا علماء نطقوا بالعربية، وألّفوا بها.
وفي تحليل ابن خلدون توكيد على البعد النفسي للشعوب المغلوبة، أمام الأمة المنتصرة عليهم، فلا يعوزها العدد، وإنما تصبح نفسيتها قابلة للاستلاب، ولكن ليست قابلة للاستعمار، على حد توصيف مالك بن نبي في كتابه «في مهب المعركة: نحو إرهاصات جديدة للثورة» لموقف الشعوب المستعمَرة مع الاستعمار الغربي الحديث، ويفصّل ابن نبي ذلك، بأن هناك احتلالا مؤقتا لجيش أجنبي، لا يؤثر في حياة الشعب المغلوب، بل يكتفي بتأمين احتياجاته، ونهب ثرواته، مع الهيمنة. وهناك حالة الضم، التي تؤثر في حياة الشعب المغلوب، وقد تغيّر مصيره بصورة مطلقة، وعندما يقع هذا التغيير، تتغير البناءات الداخلية، نتيجة اندماج خصائص الشعبين العنصرية، مصهورة في بوتقة جديدة، وقد يكون مطبوعا بخصائص أحد الشعبين، الغالب أو المغلوب، وذكر أن الشعب الصيني لم يتأثر بالشعوب التي احتلت أرضه، مثل المغول والمندشو، بل اكتسبت هذه الشعوب وتعلمت من الحضارة الصينية، وقد يندمج الشعبان المنتصر مع المنهزم، ويظهر شعب جديد، كما في حالة الشعب السلتي بعد غزو الرومان له، واستفادة كل شعب من مزايا الآخر، وهو يختلف حسب حالة كل نموذج في التاريخ، فلا يمكن التعميم إلا في إطار محدود.
وهناك ثوابت ومتغيرات في حالة الفتوحات الإسلامية العربية؛ فأبرز الثوابت تقبّل الشعوب لحكم المسلمين ولنهجهم في الحكم، خاصة أنها شعوب خضعت لامبراطوريات عظمى، مثل الفرس والروم والهند والصين، ثم انتشار الإسلام لدى غالبية سكانها، ثم اللغة العربية، التي انتشرت على مستويين: مستوى عالٍ (كليّ) شمل لغة الحياة اليومية والعبادة والعلم والثقافة، ومستوى أدنى (خاص)، شمل لغة العبادة والعلم، وظلت اللغات الأصلية على الألسنة، وبعضها كُتب بأحرف عربية. أما المتغيرات، فإن كل شعب شكّل ثقافته الخاصة، ضمن تفاعله مع الثقافة الإسلامية العامة، واختلفت مساهمات كل شعب في مجرى الحضارة الإسلامية؛ وتميّزت حسب عطاء كل شعب حضاريا، وحسب اختلافه في العادات والتقاليد والملابس والفنون، وكذلك في الخصائص المزاجية والجسدية والنفسية المتأثرة بالبيئات المختلفة (الصحراوية أو الزراعية أو البحرية)، وكذلك في الظروف السياسية والاقتصادية، ولكن النهر العام للحضارة الإسلامية شمل هذه الشعوب وصهرها، بل إنه صهر الأمم التي تغلبت على المسلمين يوما، مثل المغول الذين تحولوا للإسلام وشريعته، فقد تحوّل المغول إلى الإسلام في عهد أحد أحفاد هولاكو، وهو أحمد توكودار، الذي أسلم، على يد أحد العلماء المتصوفة، وسعى إلى توطيد العلاقة مع دولة المماليك في الشام ومصر، وإنهاء الصراع مع العالم الإسلامي، وتواصلت الجهود في ذلك، حتى انتشر الإسلام في أنحاء دولة المغول وشكّل ثقافتهم.
كاتب مصري