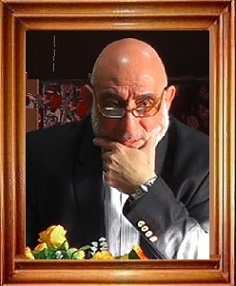خرجت والعتمة تحاصرني، انطلاقًا من مخيم الشاطئ بمدينة غزة؛ للوصول إلى مستشفى المعمداني، حيث يرقد أبي مصابًا، بعدما بترت قدمه وتمزقت روحه؛ فأنا وإخوتي الثلاثة نتناوب في رعايته ومتابعة حالته الصحية، بينما يرزح أخ رابع في جنوب قطاع غزة، محاصرًا ونازحًا، لا يعرف إلا فتات الأخبار من مكالمة هنا أو هناك، عن وضع أبي الصحي وظروفنا القاهرة.
أنطلق من البيت الذي أنزح فيه بشارع قهوة غبن، بعدما دمر بيتي وأصبح أثرًا وأطلالًا. أحمل العتمة في قلبي وأمشي، أسابق المسافات القصيرة، فوقي طائرة الدرون الإسرائيلية المسيرة، قلبي ينبض بقوة، أخشى أن تقصفني في هذا الخواء، والشوارع فارغة. أواصل السير حتى أصل ناصية الشارع، أتأمل التراب الذي غرق قبل أسبوعين بدم الأطفال، أصدقاء ابني رؤوف، من كانوا يلعبون البنانير “قلول”، ثم فجأة جاء قرار غاشم لصعودهم نحو السماء بعنف من طيار إسرائيلي يعتقد أنه إله، أطلق صاروخًا عليهم عند العصر، فصار اللاعبون الصغار أشلاءً، واللعبة صارت أحجية، ممراتها تفضي إلى الهاوية. وطفلي رؤوف الذي ترك اللعبة يومها بعد نادته الجدة ليتناول طعام الغداء، ما يزال يبكي أصحاب ورفاق جاءوا من أصقاع شتى إلى المخيم، لتتوحد الأوجاع وينتصر الدم على الطائرة.
إلى الأمام قليلًا، كان يجلس أصدقائي، خمسة كأصابع اليد، ملتحمون بقضية عظمى، يحملون الوطن في قلوبهم، يعملون على رعاية الناس إبان اجتياح مستشفى الشفاء، يجلسون تحت ظل شجرة يتيمة، يضحكون فتتناثر الضحكة إلى قطع كالزجاج، ويطيرون إلى سماء لازوردية بصاروخ غادر، يموتون كأنهم لم يكونوا، ثم يدفنون في متنزه المخيم، متراصين كالياسمين، باتجاه المسجد والقِبلة.
الطريق لم يعد آمنًا، كل البيوت مدمرة، ملامحها باهتة، كأنها تبكي الصباح، لا صوت لفيروز في الأروقة، خطواتي إيقاع يربكني، والمسيرة في الأعلى ترصدني، تتتبع حركتي وهاتفي، ملامح النهار تبدو يائسة من شخير النائمين تحت الركام، حيث لم تستطع آلات رجال الدفاع المدني من انتشال الجثث بعد تدمير الوسائل الحديثة التي برفقتهم، والإبقاء على بِزة هؤلاء الرجال فقط.. الأنين في البيوت المدمرة عظيم، يحمله طائر “الكركز” الذي يزورنا في الخريف، لينقل السلام من بلاد الله إلى أرضنا مغمسة بالآلام. الناس تقطن في حواصل ومحال تجارية بقي منها بعض الأعمدة والجدران، لا يخافون الدمار الذي لحق بتلك الأبنية أو صوت الكلاب الضالة أو مرافقة القطط.
أتمتم بيني وبيني عن الأسرة التي تضع جيادًا عند مدخل بيت مرموق، لا أعرف من تكون، لكنها أسرة –فيما يبدو- تعمل على نقل البضائع من خلال عربات الحمير والأحصنة، تقطن اليوم في منزل لا تعرف أصحابه، خسروا فيه كل ما يملكون، مترفون، لديهم ربما عدد من السيارات الفارهة والجيبات الحديثة، فروا بها من المقتلة إلى المناطق الآمنة بجنوب القطاع، ولا أمن في أي رقعة من هذا الوطن المحاصر. لتأتي أسرة من الشمال، متواضعة، ربما لا تملك ثمن رغيف الخبز، لتعيش على أطلال هذا المكان الفاره، معادلة غريبة وصادمة، تعبر عن واقع غزة المختلف، الطبيعي هنا هو الجنون.
عند مفرق الدنف، أو هكذا يسميه أهل مخيم الشاطئ، قريبًا من المكان الذي استشهد فيه الصحفي إسماعيل الغول، تقف شجرة الجميز شامخة، لا يصعد على فروعها الأطفال، ولا يتسلقها أحد، كأن الأطفال فقدوا طفولتهم، الشغف وحب المغامرة انتهى إلى غير رجعة، كأن أولوياتهم تغيرت وكذلك نمط حياتهم. المتاريس والحجارة والركام تمنع السيارات المتهالكة من السير، الطرق كلها لا تؤدي إلى روما بل إلى الركام، الشوارع والطرق والأزقة والردهات مغلقة، هذا بيت فلان وتلك عمارة علان، هذا مسجد وهذه كنيسة، هذه الفيلا تم إنشاؤها قبل الحرب بشهرين فقط، بلغت تكلفتها أكثر من ثلاثة ملايين دولار، ثم أضحت أطلالًا، إلى الأمام قليلًا باتجاه مستشفى الشفاء، التخوم كلها جبال من حجارة، بيوت صارت حطامًا كما أصحابها، على هذا الجدار بعض كلمات كتبها جندي إسرائيلي باللغة العبرية، ربما يتوعدنا بمزيد من الموت أو العذاب، وفي الزاوية يجثم محترف شبابيك على الأرض، سقط مضرجًا بألوانه ولوحاته، لا حياة في المدينة. إلى الأمام قليلًا دار الكلمة، وقد اغتيلت الكلمة وانتهك عرض الصورة، وصار المشهد كابيًا، يوحي للمشاهد بحجم الإبادة التي حدثت أمام مرأى العالم.
كنت أظن أنني الوحيد في هذا اليباب، لكنني اكتشفت عدم صوابية ظني، هناك بعض الشبان يجمعون الحطب، آخر يحاول قطع شجرة، وطفل يصعد التلال ليحصد بعض أخشاب كنبة هنا أو خزانة هناك، لسرير لطفل أو مرفأ للسلام. ترى: ماذا يعمل هؤلاء الشبان؟ هل كانوا طلبة جامعات أم مهندسين أم ماذا؟ وهذا الطفل: ألم يكن عليه أن يذهب إلى المدرسة؟ تلك المدارس التي صارت مراكز إيواء ثم تحولت إلى مقابر. وما زال القتلى يربضون داخلها أحياء وأموات.
مسيرتي طويلة، وطريقي إلى المعمداني بعيد، أتأمل مستشفى الشفاء المحترق، هنا كان المستشفى الأكبر في قطاع غزة، وربما فلسطين، تغير كل شيء فيه، حتى بات لوحة سوريالية مثيرة للشفقة، على الجانب الغربي، زُرع الشهداء زهورًا، وعلى الجانب الجنوبي تحولت ثلاجة الموتى إلى تلال من القمامة، وفي الشرق بعض أطلال لمجازر ارتكبها الاحتلال ومارس الإبادة بحق أطباء ومرضى كانت لهم حيوات كاملة، بأحلامها وآلامها، ثم قام بدفنهم في مقابر جماعية كما باقي مستشفيات قطاع غزة.
أيمم شطر الشرق النائم، لكن جلبة تيقظني، إنه صوت الأطفال والنساء والعجائز، يصطفون في طوابير عند مخبز العائلات، بشكل لا يمكن للوعي أن يدركه أو للصورة أن تعبر عنه، إنه يشبه السجن، الأسوار العالية، الأسلاك الشائكة، الألوف التي تتصارع لأجل ربطة خبز لا تكفي نصف نهار.. يا الله، ما الذي جرى لنصل إلى هذا الحال؟ وكيف نوقفه؟
أواصل السفر إلى الهاوية، بقدمي المغبرتين، وملابسي المتسخة، ينتصب أمامي مركز رشاد الشوا الثقافي، حيث كنا نعقد لقاءاتنا وأمسياتنا الأدبية والفنية، لقد تغير المكان إلى الأبد، وصار سقفه مفتوحًا، كأنه يستجدي الخلاص مثلنا، لا كتب في المكتبة، لأنها صارت مادة جيدة لطهي الطعام بعد انعدام توفر غاز الطهي، والحروف ربما صرخت بأعلى صوت، تألمت وبكت، لكن الطاهي لا يسمع، أميٌ لا يقرأ، ولا يعرف أقسام المكتبة، وضع كتب ماركيز وبورخيس ونجيب محفوظ والبياتي بجوار كتب آينشتين وربما كتب البوطي وابن كثير وابن ماجة وماركس ولينين داخل فرن طيني أو علبة لإشعال الحطب، كي تلتحم الكلمات وتصنع كتابها المقدس المحترِق كالأطفال في غزة.
حي الرمال، المكان الأكثر شهرة ورقيًا في مدينة غزة، لا شوارع مرصوفة فيه، لا مقاهي أو مطاعم، لا أبنية أو حدائق، إنما أخاديد تم حفرها لأجل معرفة مكان الأنفاق ورجال المقاومة، وفي الزوايا الغارقة في غربتها، بعض ملابس معلقة، نجت من الموت بأعجوبة.
عند مفرق السرايا، ينتشر الباعة، يتثاءبون كأنهم أناس طبيعيون، كأنهم ينامون مثل الآخرين، وصوت ارتطام الصواريخ بالأهداف المدنية يصم الآذان، أحاول الاختباء تحت ظل أي جدار، لكن الفراغ هو سيد الموقف، فأترك قرار الحياة للشظايا المتناثرة. وأمشي باتجاه الشرق، الأطفال يستيقظون أيضًا، يحملون جالونات المياه، يضعونها في منتصف الشارع، يرتبون الميكانو لأجل عربة متهالكة تحمل مياه صالحة للشرب، رغم أنها مليئة بالنترات المسرطنة والجراثيم والبكتيريا حسب إحصائيات العديد من المؤسسات المحلية والعالمية، على رأسها وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.
على جانبي الأيسر تقبع حديقة بلدية غزة العامة، محاطة بالحزن، فهي مدمرة الأسوار، محترقة الأشجار، وأخرى ماتت بعد إصابتها بجلطة دماغية، أو اضطرابات القلب نتيجة الخوف الدائم من القصف العشوائي. ولا سكان في هذا الخواء.
وأمضي إلى حتفي، ومشاهدات القهر التي لا تتوقف في المعمداني، أصل دوار السامر، حيث كانت السينما رمزًا رغم تعطلها منذ سنوات طوال، ثم سوق فراس الشعبي، المكان الذي يرتاده عِلية القوم وعوامهم، اختفت مظاهر الحياة فيه، وبقيت القمامة رديفًا للبسطات والمحال والباعة، معلبات بمئات الألوف، تحترق لأنها كانت غذاء الغزيين بعد المجاعة التي انتهكت إنسانيتهم، وجعلتهم وحوشًا ضارية تبحث عن لقمة العيش حتى في طعام الحيوانات، ذلك الطعام الذي لم يكن موجودًا في الأصل.
وقبل الوصول إلى المستشفى، يجثم فوق نفوس الغزيين مقر بلدية غزة الأثري، ذلك المكان الذي يمثل المقر الرئيس لتنظيم حياة السكان داخل المدينة، لكنه كان المكان الأكثر عشوائية وعبثية، يدخل المواطن فيه مؤمنًا ويخرج كافرًا بكل شيء، وهو رغم عبثية الصورة، ما بين الدمار والذكريات، إلا أنه يمثل معلمًا مهمًا لكل غزي، يؤمن أن الحق أدلج.
في وسط مدينة غزة، قريبًا من المعمداني، ينتصب تمثال العنقاء، كرسالة إلى العالم من أن الفلسطيني يبعث في كل مرة من الرماد كما تقول الأسطورة الكنعانية، لهذا ظلت المدينة مقبرة للغزاة، وستظل حلقة في شوكة الأعداء، رغم الأشلاء والدماء التي نزفت وتنزف، فالفلسطيني يؤمن أن الطريق إلى الوطن محفوف بالمكاره، والعبرة بالخواتيم، وسيصل الفلسطيني إلى بلاده وقراه، عاجلا أم آجلًا.
عند البوابة، الباعة والمرضى والأطباء والعامة، وصوت كنيسة تدق الأجراس، بينما يؤذن المسجد للصلاة على شهيد ارتقى إلى العلا وهو يضرب الدبابة بقذيفة محلية الصنع. كل الأصوات تلتحم حتى الآلام والأحلام لتصنع فرانكشتاين جديد، سينتقم من قاتليه، حين يتوحد الدم العربي في مواجهة أعتى استعمار احتل العقول وعطل الوعي وتملك الجسد. وحين تدرك النخب مترامية الأطراف أن الصمت خيانة، والصراخ فريضة أمام الشيطان. وحين تنتفض الشعوب أمام مؤسسات صنع القرار والسفارات المعادية والحدود.
المستشفى العربي الأهلي (المعمداني) مسيحي البصمة، وطني الانتماء، إنساني الصِبغة، سيخلق ذلك الفرانكشتاين، وستعود الكنائس والمساجد لترفع صوت الإله إيذانًا بالتحرير.