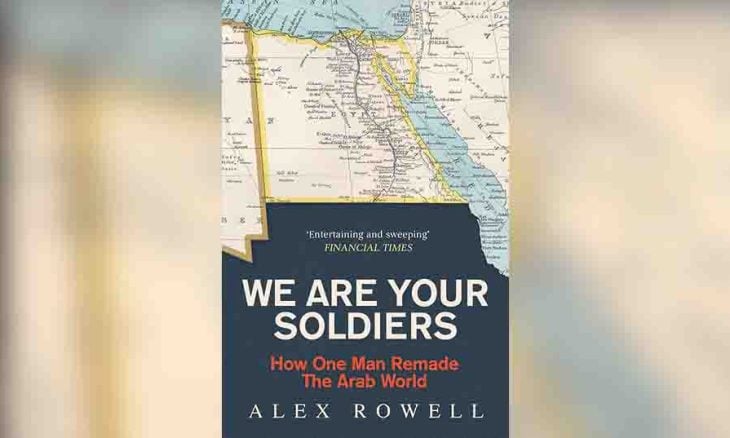عندما تتحول حياة الكاتب إلى سلعة

عندما تتحول حياة الكاتب إلى سلعة
سعيد خطيبي
عندما توفي كاتب ياسين (1989)، أصدر محمد الغزالي فتواه الشهيرة، يمنع فيها دفن الجثمان في مقابر المسلمين. ولسنا نعلم كيف تغلغل الغزالي إلى قلب المتوفى، من غير أن يعلمنا كذلك ما هي الدوافع التي تحدد أن شخصاً مات مسلماً، أم غير ذلك. لكن فتواه سارت بين الألسنة، فقد كان الغزالي يرأس الجامعة الإسلامية في قسنطينة، لا أحد يخالفه في رأي، كما طافت شهرته أرجاء الجزائر، بحكم أنه حظي ببرنامج في التلفزيون، كان يبث في ساعة الذروة. مع ذلك، فإن التاريخ انتصر على التضييق، ودُفن كاتب ياسين في مقبرة المسلمين، وظن البعض أن تلك الفتوى سوف تذروها الريح. لكن وقع العكس. فمنذ ذلك الحين شرع الغزالي الباب واسعاً من أجل التدخل في الحياة الشخصية للكتاب، فيجعل منهم الناس سلعة يمضغونها في أوقات الفراغ، يتداولونها في المقاهي أو في البيوت. ثم انتقلت تلك «السلعة» إلى التلفزيونات، وصار من العادي أن نصادف برنامجاً يكرس وقتاً عن كاتب، ليس في الخوض في أعماله، بل من أجل الخوض في حياته الخاصة، في نشر أسرار المؤلف، أو التسرب إلى بيته أو أبنائه أو زوجته أو أهله أجمعين. لم يعد الكاتب يتعرض إلى نقد ما يكتب، بل إلى انتقاد طريقة عيشه، مشيته، شكل ملابسه أو ماذا ينتعل. صار يُحاكم على كلامه في فضاء عام، وليس عما يُدونه في كتب. بات الكاتب عارياً إزاء شهوة «السبق» أو «الحصري»، التي تتراكض خلفها قنوات التلفزيون. في استباحة الحياة الشخصية عكس ما تقتضيه القوانين.
في الجزائر، حيث النقد هو الخاصرة الرخوة، وحيث النقاد انسحبوا إلى عملهم في مدرجات نصف فارغة، في تصحيح أوراق امتحانات أو في التهامس عن زيادات في الراتب، فقد ناب عنهم جمهور السوشيال ميديا وشاشات التلفزيون، ولأن هؤلاء لا زاد لهم في النقد الأدبي، فإنهم يلتمسون انتقاد الآخرين، يستثمرون ما تخوله لهم الصورة والكاميرا فيحولون حياة الكاتب إلى نكتة أو عبرة، من أجل جمع اللايكات أو المشاهدات. هذا الواقع يجعل الكاتب لا يشعر بأمان، بل يشعر كمن يسير في أرض ألغام، فكلما ارتقى في سلم النجاح، وكلما تقدم خطوة إلى الأمام، فهو يعلم أن قناصاً يترصده، وفي الغالب سيكون قناصاً من أقرب الناس إليه، سوف يحاول إسقاطه.. لأن من لم ينجح يود أن يفشل الآخرون. سوف يجد الكاتب حياته وقد تحولت إلى مادة في الإعلام، والغرض منها ليس الرفع من معنوياته أو دعمه، بل الغاية منها أن يشعر بإحباط، أن يكفر باليوم الذي كتب فيه، أن يكفر بالأدب الذي آمن به.
ومن جماليات اللغة العربية، أن ما نكتبه يطلقون عليه «أدباً». والأدب ينطوي على تهذيب واحترام، على الإنصات إلى الآخر وانتقاء ألطف الكلام في حال الرد عليه. لكن في الجزائر هناك من قرر أن الأدب له معنى آخر، يتناقض مع ما أوردناه. فصارت الإساءة أدباً، والمساس بالحياة الشخصية للمؤلف أدباً كذلك. وعندما اختلطت المفاهيم، صار الكاتب في الواجهة، يدفع فدية إزاء أمر لم يقترفه.
لطالما كانت الجزائر تفتخر بكتابها، لأنهم رافقوا تاريخها العريق، تفتخر بلوكيوس أبوليوس، الذي كتب أول رواية في الإنسانية «الحمار الذهبي»، في القرن الثاني من الميلاد، تفتخر أن ميغل دي ثربانتس دون مسودة (دون كيخوتة) في سنوات أسره في مغارة في الجزائر العاصمة، تفتخر أن الرواية المعاصرة في شمال افريقيا خرجت من الجزائر كذلك نصر الدين ديني وسليمان إبراهيم، عام 1910، تفتخر بمقاومة الاستعمار في صحبة كتاب (محمد ديب، كاتب ياسين ومالك حداد)، تفتخر بالرعيل الأول من كتاب ما بعد الاستقلال، على غرار عبد الحميد بن هدوقة وزهور ونيسي. في بلد كان فيه الأدب من المقدسات، يتصدى له نقاد، وليس من فاض وقتهم في السوشيال ميديا، أو من فتحت لهم أبواب فضائيات التلفزيون. فماذا حصل وتقهقر الكاتب إلى هذه المراتب الدنيا؟ وصار يستباح في خلوته، وكأنه ليس امتدادا لأولئك الذين صنعوا تاريخ البلاد؟ ماذا يبقى في بلد عندما يفقد رأس ماله الرمزي؟ عندما يقاطع الكتاب والأدباء!
إلى وقت قريب، كنت أمتعض من سلوكات بعض الجرائد، ومعها تلفزيونات وهي تنبش الحياة الشخصية لمشاهير الغناء أو السينما أو الرقص. يدخلون بيوتهم من غير إذن، ويتسابقون في التشهير بفضائحهم، يتحدثون عمن تزوج وعمن تطلق، عمن سافر وعمن مكث على أريكته، عمن أنجبت وعمن أجرت عملية تجميل، عمن اشترى سيارة ومن تربي قطاً في حديقتها، حولوا حيوات البشر إلى مزرعة تدوسها الأقدام، وقد قدرت ـ بسذاجة ـ أن تلك الأفعال تأتي من باب الفضول، ولم أتخيل أن يصير الفضول قاعدة، والتعدي على الحرمات وجهة نظر. ففي وقت وجيز، وجدتني أشاهد برنامجاً في تلفزيون يصف كاتباً من الجزائر بأنه خريج بيت بغاء، ثم شاهدت قناة أخرى وهي تستضيف شقيقة كاتب آخر وجرى الحديث عما يدور خلف الأبواب الموصدة وخلف الحيطان، بل إن المساس بحرية الكتاب بات من حرية التعبير، بينما الخوض في قضايا الناس العاديين، وطرح ما يقاسونه من مشقات الحياة صار غير مرغوب فيه، صار هذا الإعلام يتفاده، خشية مقص الرقيب. والخوف من الرقيب أعلى مرتبة من التشبث بالأدب والأخلاق، أو هكذا يفكرون، بدل أن يصير التلفزيون مشغولاً بما يمس حياة المواطن من مشاغل، أن يندد بالإقصاء أو العنف أو يدعو إلى تسهيل حياة الناس، جرى طمر تلك القضايا، والاهتمام بما يتلفظ به كاتب أو ما يدور في عقله. نعم، صار من الصحافيين من يؤول كلام الكتاب، وينطق مكانهم ثم يحاكمهم. كل ذلك يحصل في بلاد صارت تندر فيها المكتبات، في بلاد حيث الكاتب صار يلتقط صورة مع قارئ، لأن القراء نسمع عنهم ولا نراهم، في بلاد حيث الكتب تمنع أو تحاصر، وإن صدرت في الخارج يصعب عليها الدخول، في بلاد حيث الرقابة الذاتية في توسع، والكاتب يحسب ألف حساب إزاء كل كلمة يدونها، في بلاد حيث الكتاب في تناقص، يهجرون أو يسكنون الصمت. في بلاد لن يطول فيها الحال وتتوقف وسائل الإعلام عن الطعن في الكتاب، لأن هؤلاء في طريقهم إلى الفناء.
روائي وصحافي جزائري