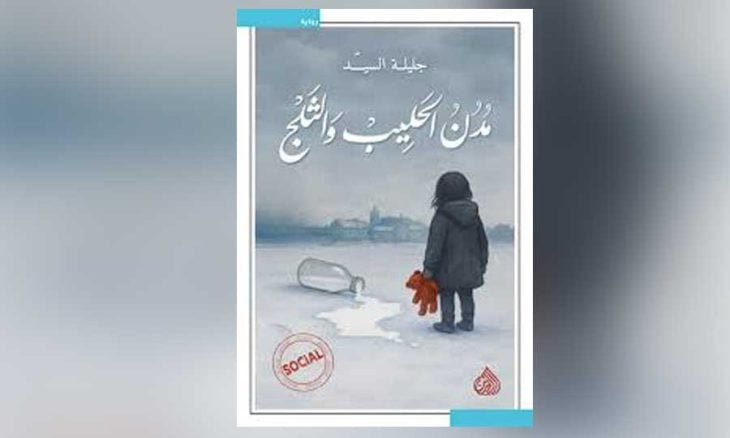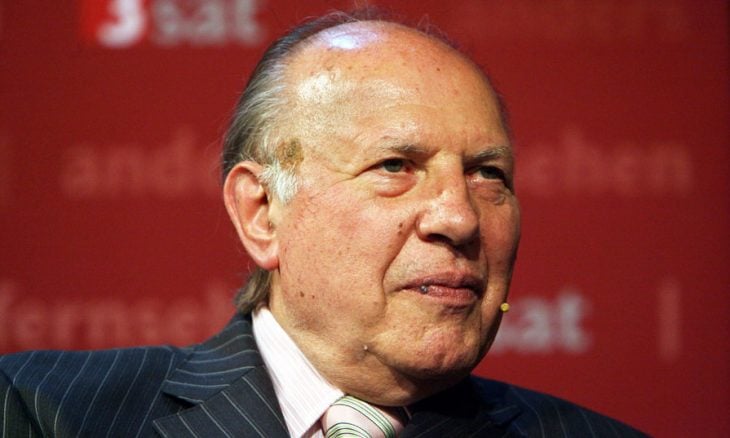سقوط الأبد: كيف قرأ المثقفون السوريون الحدث وما هي رؤاهم للمستقبل؟ “1”

محمد تركي الربيعو
تقدم صحيفة «القدس العربي» هذا التحقيق ضمن سلسلة من ثلاثة حلقات مخصصة لاستكشاف الواقع السوري بعد سقوط نظام الأسد. في هذا الجزء، نسلط الضوء على قراءة المثقفين السوريين للحظة التحول الكبرى، ورؤاهم لمستقبل البلاد، في ظل تحديات إعادة البناء وإعادة تعريف الأدوار الثقافية والسياسية.
على الرغم من مرور أسابيع قليلة فقط على سقوط النظام السوري، إلا أن المتابع للنقاشات الدائرة بين السوريين حول مستقبل بلدهم، لا بد أن يلاحظ أن هناك نفسا جديدا، لم يعهدوه في السابق. صحيح أن الأشهر الأولى من عمر الثورة السورية التي انطلقت في شهر آذار/ مارس عام 2011، كانت قد جلبت وفتحت النقاش واسعاً حول التغيير وضرورته، إلا أن الموجة الجديدة من التغيير في البلاد، قلبت الأمور رأسا على عقب، ووضعت السوريين أمام مرحلة أخرى، تتمثل في إعادة بناء البلاد ومؤسساته. من هنا، يظهر اليوم عدد من المثقفين السوريين، وهم يحاولون تقديم طروحات جديدة حول المرحلة الجديدة، وبالأخص على صعيد إعادة تعريف أدوارهم، وتشكيل المؤسسات الثقافية، وغيرها من القضايا المتعلقة بمستقبل البلاد.
حاول السوريون على مدار أربعة عشر عاما تقريبا العمل على إسقاط النظام، إلا أن الظروف الدولية، وتناحر القوى السياسية المعارضة، كلها عوامل جعلت من فكرة إسقاط الأسد، أقرب ما تكون للحلم المستحيل. وكانت قوات الأسد بعد عام 2016، قد تمكنت بمساعدة إيران وروسيا، من إعادة السيطرة على عدة مناطق تابعة للمعارضة، ما خلق شعوراً سلبياً عاما داخل البلاد وخارجها، يوحي ببقاء الأسد وعائلته في الحكم لسنوات طويلة. من هنا شكلت لحظة سقوط النظام حدثاً مفاجئاً، بالنسبة لأشد المتفائلين من المثقفين السوريين. ويبدو أن هذا الشعور ما يزال يعيشه قسم كبير منهم، حتى بعد وقت قصير من فرار الأسد، ومن بين هؤلاء الروائي السوري فواز حداد، الذي يذكر في مقابلة مع صحيفة «القدس العربي» أن ما حدث أشبه ما يكون بالخيال، وعلينا أن نصدق ما حدث، مع أننا غير قادرين على استيعاب ما جرى. ويضيف، منذ عدة أيام أخشى أن أفتح عينيّ، خوفا من أن أجد ما جرى مجرد حلم ليس إلا. وكان حداد قد غادر مدينته دمشق منذ قرابة 12 عاما، بسبب تأييده الثورة، والأوضاع الأمنية، ولذلك لا ينسى أن سنوات الحرب كانت مؤلمة بالنسبة له، ففي كل يوم كان يشعر كما يقول» بأنني أفقد مدينتي، وهذا ما شكل إرباكاً في حياتي الشخصية، وفي رواياتي. فدمشق كانت مكاني الوحيد في كتاباتي، وإن تنقلت أحيانا بين عدة مدن، لكن دمشق استأثرت بي، خاصة أنني دمشقي اعتدت على حياة مرسومة في داخلها. فمن الشوارع، إلى الأزقة، والمكتبات، المقاهي، والسينما، وكأن كل هؤلاء انتزعوا مني فجأة، أو بالتدريج».
ومنذ اللحظات الأولى من سقوط النظام، تحرك سوريون كثر ممن يعيشون خارج البلاد، أو في مدن أخرى نحو دمشق، وهنا يؤكد حداد أنه عندما شاهد النظام وهو يسقط، شعر وكأنه قد استعاد مدينته، «بعد زمن بدا وكأنني عشت عمري في فراغ، وكتبت عن فراغ. فجأة امتلأت حياتي وبات لرواياتي سند حقيقي.. اليوم عدت أعيش، وكانت دمشق برهانا على وجودي».
وعن لحظة سقوط الأسد، يؤكد أيضا الباحث والمؤرخ السوري تيسير خلف، أنه لا يوجد أسوأ مما كان تحت حكم آل الأسد، وهو أسوأ شيء ممكن أن يتخيله عقل بشري. ويؤكد خلف أن السوريين بكل طوائفهم سعيدون بهذا الشيء، وأنه لم يبك أحد على النظام، فالجميع بمن فيهم العلويون، بصقوا عليه وشتموه عندما خرج.
الشيء ذاته هو ما يراه أيضا الكاتب السوري عمر قدور، الذي يعتقد أن ما حدث من تغيير مفاجئ وسريع هو تغيير مستحق منذ عام 2011، وربما 2012 على أبعد تقدير. ورغم من أن هذا التغيير جاء محمولا على تفاهمات دولية تسمح بحدوثه، إن لم نقل إنها سهلت حدوثه، إلا أن ذلك برأيه لا ينتقص من أهمية ما حدث في البلاد.
مخاوف وقلق:
وكانت قوات المعارضة السورية، قد دخلت دمشق أولا من جهة الجنوب في ليلة 8/12/2024، بينما استطاعت القوات القادمة والمعروفة باسم (إدارة العمليات) والتي يقودها أحمد الشرع (أبو محمد الجولاني سابقاً)، من دخول المدينة في اليوم التالي، وقد أثار هذا الحضور بعض المخاوف، فالشرع كان قد أمضى سنوات طويلة من حياته في القتال إلى جانب الجماعات الجهادية العالمية، قبل أن يعود ويؤسس لحركته «جبهة النصرة»، ولاحقا «هيئة تحرير الشام»، التي وإن بدت أنها أقرب ما تكون لحركة محلية، إلا أنها في المقابل ظلت تتبنى الرؤية السلفية الجهادية. ويعتقد قدور أن هناك الكثير من الريبة تجاه الشرع ـ الجولاني نفسه، بسب حكمه الإسلامي في ادلب، وأيضا الحكم السلطوي /الفردي لديه، ووجود سجون للناشطين في تجربته، وبالتالي نحن أمام تجربة غير ديمقراطية في حواضنه، ومناطق نفوذه الرئيسية، يخشى من تكرارها على مستوى سوريا، وكل هذا يجعل الخشية مبررة، وإن كان الواقع حتى الان ليس على قدر المخاوف، لكن هذه المخاوف ستبقى مبررة حتى إتمام الانتقال الديمقراطي في سوريا، ووجود هيئة منتخبة، وقوانين واضحة لا تثير أي ريبة أو التباس.
في المقابل يبدو الأكاديمي السوري في جامعة لويزيانا الأمريكية أحمد نظير الأتاسي، أكثر قلقا بعض الشيء، إذ يعتقد أن السلفيين بشكل خاص، والإسلاميين عموما، لا يمكن أن يقاوموا إغراء السلطة، أوالتغلغل والاستيلاء وفرض السلطة. ولعل ما يدعم رؤية الأتاسي، حسب البعض، هي التعيينات التي اتخذها الشرع في الأيام الماضية، والتي غالبا ما جاءت بأشخاص مقربين منه ومن تياره السلفي. ولتجنب هذا السيناريو، يرى تيسير خلف أن على النخب السورية العودة لدمشق، وبدء حراكها، ودون ذلك فإنها ستكون مسؤولة بشكل من الأشكال عن تأبيد، ومساعدة «هيئة تحرير الشام» في الاستحواذ على السلطة، لكن عموما يبدو خلف متفائلا من عدم الوقوع في هذا السيناريو، فهو يعتقد أن السوريين عانوا وقاسوا ولن يكرروا التجربة، حتى لو «كان من يحكمهم ملاكاً» على حد تعبيره، كما يعتقد أن هناك قوى وأحزابا جديدة ستظهر، ولن تكون على النمط القديم، بل أقرب لنمط الحركات الاجتماعية الجديدة، التي عادة ما تتبنى سياسات مرحلية ونقاط معينة، دون أن تجمع الأيديولوجيا أفرادها بالضرورة. وهو رأي يؤكد عليه الأتاسي، الذي يرى أن على النخب السورية المسارعة، في بناء النقابات، والتركيز على فكرة الحكم المحلي (اللامركزية الإدارية)، الكفيلة كما يعتقد بعدم عودة نموذج الاستبداد.
إسلام سلفي أم وسطي:
يعتقد بعض المراقبين أيضا، أن الصراع على فهم الإسلام وعلاقته بالحكم، قد يكون محور الصراع بين عدد من القوى الرئيسية في سوريا. وكانت البلاد قد عرفت منذ الستينيات تقريبا قدوم حزب البعث العربي الاشتراكي، الذي حاول تبني رؤية وصفها بالعلمانية تجاه العلاقة بين الدين والدولة. مع ذلك فإن فترة البعث وآل الأسد، ترافقت مع صعود للنفس الطائفي في البلاد والسياسة، وعادت وشهدت البلاد في مرحلة الثمانينيات من القرن المنصرم صعوداً للتيارت الإسلامية، قبل أن يتراجع دورها بعد ما عرف بأحداث حماة. ظلت المدن والحواضر الرئيسية في سوريا مثل حلب ودمشق أقرب ما تكون للنمط المتدين المحافظ، الذي حاول أن يتأقلم أيضا مع التغيرات في العقدين الأخيرين، وهو ما بدا من خلال شكل الحجاب في شوارع دمشق، الذي أخذ يتلاءم بتصاميمه ولونه مع الموضة الجديدة. تغير المشهد قليلا، بعد قدوم الثورة، وبرز من خلال تصاعد دور التدين السلفي، الذي في رأي بعض الباحثين جاء ليتلاءم مع ظروف الحرب، والعنف الذي شهدته البلاد على يد قوات النظام. وعندما دخل أحمد الشرع دمشق في الأيام الأخيرة، بدا وكأنه يعلن عن مرحلة جديدة من الإسلام، مغايرة للإسلام الوسطي الذي عرفه السوريون، خاصة أن الأخير بدا في أول أيامه محجما عن التواصل مع علماء مدينة دمشق، كما أن ما زاد من هذه الشكوك هو قرار حكومته بمنع عدد من خطباء المدينة، من تقديم خطبة الجمعة بسبب ارتباطهم كما يقولون بالنظام. وفي هذا السياق يعتقد محمد أمير ناشر النعم، وهو باحث في الفكر الإسلامي السوري، في حواره مع صحيفة «القدس العربي»، أن هذا الفتور بين «هيئة تحرير الشام» وطبقة العلماء التقليديين في دمشق، هو أمر مسوغ ومفهوم، بناء على العلاقة السابقة التي نسجت بين المؤسسة الدينية التقليدية، ونظام الأسد. مع ذلك، فهو يعتقد أن هذا الخلاف قد لا يعكس بالضرورة صراعا بين اسلاميين في سوريا (سلفي/ وسطي) بالضرورة، وأن طبقة العلماء التقليديين سيحاولون التكيف مع الحكم الجديد. كما يعتقد أن «هيئة تحرير الشام» ذات الخلفية السلفية الجهادية، ستلين إن كانت يابسة. وستغدو مرنة إن كانت قاسية. ويضيف النعم بأن الشرع لم يعد مقتنعا بالمنهج السلفي، والبراغماتية التي نراها في أفعاله وتصرفاته تدل على هذا الأمر، وأن التجربة بالغة السوء التي طبقتها بعض الجماعات السلفية السورية خلال الثورة، بالإضافة لعوامل محلية وإقليمة أخرى، قد تدفع الاتجاه السلفي إلى مستوى آخر، وربما نعود الى السلفية الإصلاحية السورية التي انبثقت في نهاية القرن التاسع عشر على يد طه الجزائري وعبد الرزاق البيطار وجمال الدين القاسمي.
زينة الفضاء العام أم طباخات؟
وكان أحد المقربين من الشرع قد صرح في أحد مقابلاته الأخيرة، بأن النساء لا يصلحن للعمل في بعض المهن، بسبب طبيعتهن البيولوجية، وقد أثار هذا الكلام نقاشات واسعة ومخاوف، من أن يكون بمثابة مقدمة للتضيق على حرية النساء وحركتهن في الفضاء العام. وتعد سوريا من أوائل الدول في منطقة الشرق الأوسط، التي شهدت حراكا واسعا حول حقوق النساء، إذ كتبت زينب فواز 1860ـ 1914 مثلا مع بدايات القرن العشرين، منددة بدعوة بعض السوريين والسوريات إلى حصر عمل المرأة في المنزل، أو النظر بسلبية تجاه النساء اللواتي يوجدن في المجال العام. وبعيد الخمسينيات، أخذ حضور النساء يتزايد في المجال العام السوري، ليغدو لاحقا أمرا طبيعا في حياة كل المدن السورية. وعلى الرغم من أن النظام السوري، لم يبد ممانعة في حضور النساء داخل المجال العام، إلا أنه في المقابل غالبا ما قيد من حقوقهن. وفي هذا السياق تؤكد الأكاديمية آراء جرماني لصحيفة «القدس العربي» أن النساء تعرضن لعنف واسع في سوريا خلال فترة حكم آل الأسد، وهذا العنف غالبا ما تمركز في القوانين، إذ نرى مثلا أن قانون الأحوال الشخصية ما يزال معمولاً به منذ عام 1951، وهو قانون رغم أنه يستند للشريعة الاسلامية، إلا أنه لم يجر تطويره، على صعيد موضوعات الزواج، أو حضانة الأطفال، أو على مستوى حصول الأطفال من آباء غير سوريين على الجنسية السورية، كما أن القانون السوري برأيها لا يحتوي ليومنا هذا على قوانين حول العنف الأسري. من هنا تعتقد الجرماني أن النساء السوريات عانين من عنف كبير خلال الفترة الفاتئة، بسبب هذه القوانين، ما يتطلب ضرورة إصلاحها. وحول المخاوف من تصريحات بعض المقربين من الشرع، ترى جرماني أنها مخاوف محقة، وتشير في هذا السياق إلى نتائج دراسة أعدتها مؤخرا بعنوان «العنف ضد النساء في سوريا» خلال الحرب، وشملت 1226 حالة، أظهرت أن أكبر نسبة عنف ضد النساء كانت في المناطق التي تحكمها «هيئة تحرير الشام»، كما أن نسبة عمل النساء في المجالس المحلية لا يتجاوز 10%، وهن في الغالب زوجات، أو من عائلات المقاتلين. وبالتالي فإن النموذج الذي يحاول الشرع نقله اليوم لكامل سوريا، هو نموذج عنيف تجاه النساء كما تشير الدراسة. من جانبها تؤكد الكاتبة والناشطة النسوية المعروفة مي الرحبي، أن على السلطة الجديدة أن تكون واعية ومسؤولة تجاه التعامل مع حقوق النساء، خاصة أن هناك اليوم مئات الآلاف من السوريات المختصات في شتى العلوم، ومن الواجب الاستفادة من خبراتهن في الدولة الجديدة، بدل التفكير بالحد من دورهن في الفضاء العام.
هل تستفيد حكومة دمشق من الماضي؟
وكانت مدينة دمشق قد عرفت قبل مئة سنة وأكثر، مشهدا شبيها بما عرفته قبل عدة أيام. ففي عام 1918، استطاع الأمير فيصل برفقة الجيش البريطاني دخول مدينة دمشق، بعد هروب العثمانيين. ولعل هذه الحادثة، وغيرها من الحوادث التي عرفتها سوريا في العقود الماضية، يراها البعض اليوم بمثابة أحداث لا بد من إعادة قراءتها، لفهم الواقع. ويعتقد المترجم والباحث عمرو الملاح، أن ما تعيشه دمشق اليوم، يحمل شبهاً كبيراً بالواقع الاقتصادي، الذي عاشته سوريا عقب الانهيار العثماني، غداة الحرب العالمية الأولى. إذ غادر الجيش العثماني البلاد مصطحباً معه كل ما في خزائن المدن السورية من أموال، ما اضطر الحكومة العربية الوليدة بقيادة فيصل للاعتماد على مبلغ الإعانة البريطانية، التي لم تكن منتظمة لأسباب عديدة، بالتزامن مع سعي الحكومة مع سعي الحكومة المطرد على الولوج للمجال العام، وانبثاق الحركة الجماهيرية التي عملت على تنظيم السوريين وتعبئة الرأي العام. ولذلك يعتقد أنه من الممكن الاستفادة من هذه التجارب، لنستلهم منها بعض تفاصيل المستقبل. ويضيف الملاح أنه لا بد من القطيعة مع حقبة البعث، والقطع لا يكون بإجراء تعديلات على الدستور الراهن الذي عدل عهد الرئيس الهارب المخلوع، وإنما عبر تبني دستور 1950، الذي قد يصلح ليكون مرجعية مؤقتة لتنظيم المرحلة المقبلة من تاريخ سوريا الجديدة، وانعقاد مجلس حكماء يضم نخبة من الاختصاصيين في شتى الميادين ممن يقيمون في الداخل أو الخارج، ليتولوا إدارة مرحلة الحكم الانتقالي بسب تعذر إجراء انتخابات نيابية الآن. وينحدر الملاح من مدينة حلب، التي عانت كثيرا في السنوات الأخيرة، جراء ما تعرضت له من دمار كبير، ولذلك يؤكد أن هذه المدينة، التي تتسم إثنيا ودينياً، قد شهدت تحولات جذرية، وبدأ العمل على تخريبها اجتماعيا وثقافياً، وتهميش نخبها الاجتماعية منذ الخمسينيات، لا سيما إبان عهد الوحدة، وبلغ ذروته في ظل حكم البعث، ولذلك فهو يرى أن المدينة بحاجة في المرحلة المقبلة لإيلائها المزيد من الاهتمام، خاصة انه كان لها نصيبها من الدمار، والذي يتحمل فيه النظام البائد المسؤولية الأكبر. ولذلك لا بد من إعادة إحياء الاقتصاد والصناعات التحويلة والحرفية التي تشتهر بها، وسن تشريعات وقوانين تشجع صناعييها ممن أسسوا معامل في مصر، ليشاركوا في بناء سوريا الجديدة التي يحلم بها الجميع..
كاتب سوري