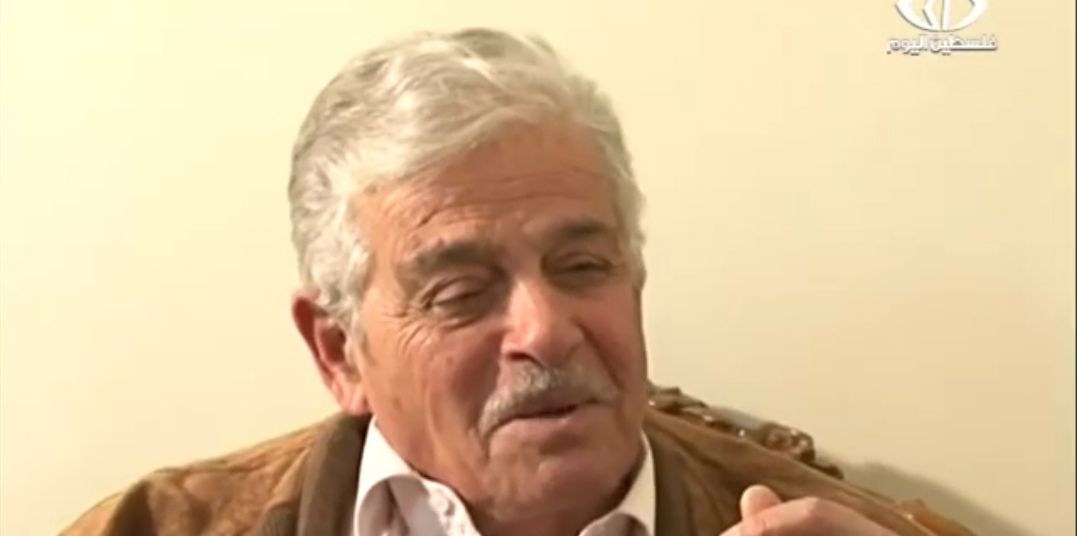مقالات
كتاب مفتوح الى رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان بقلم الاستاذ الدكتور محمد مراد باحث وأستاذ جامعي متقاعد من الجامعة اللبنانية
بقلم الاستاذ الدكتور محمد مراد باحث وأستاذ جامعي -المنبر الثقافي العربي والدولي-
كتاب مفتوح الى رئيسي الجمهورية والحكومة في لبنان
بقلم الاستاذ الدكتور محمد مراد
باحث وأستاذ جامعي متقاعد من الجامعة اللبنانية
الى فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون المنتخب بصورة غير مباشرة من كل الشعب اللبناني قبل انتخابه المباشر من المجلس النيابي، وكذلك الأمر نفسه، الى دولة الرئيس نوّاف سلام المكلّف تأليف حكومة العهد الأولى، اليكما هذه المطالعة – الرؤية الإصلاحية الانقاذية من أحد أساتذة الجامعة اللبنانية ( أستاذ متقاعد) متوخيا بكما قيادة السفينة اللبنانية الى شاطئ الأمان المرتجى لاستعادة الدولة الوطنية اللبنانية التي تبقى معقد الرهان الأوحد على قيامة لبنان – وطن الرسالة والانسان والحرية والانفتاح الحضاري على العالم.
نحو استراتيجية تأسيسية لبناء الدولة الوطنية المستدامة في لبنان
أ. د. محمد مراد
باحث وأستاذ جامعي متقاعد من الجامعة اللبنانية
إنّ المراقب الموضوعي لحركة تطور المجتمع اللبناني في تاريخه الحديث والمعاصر، يرى أنّ المسار التطوري لهذا المجتمع كان يحصل دائما على قاعدة أزمة عميقة على مستوى البنية الاجتماعية – السياسية، لا سيّما في الجانب المتعلق منها بإنتاج أو بإعادة انتاج السلطة السياسية الحاكمة، فجماعات المكانة أي أصحاب النفوذ الزعامي – السياسي كانوا يلجأون دائما الى توظيف المسألة الطائفية – المذهبية، بوصفها المصدر الاستثماري الأكثر اعتبارا بين سائر المصادر الأخرى لمواقعهم السلطوية وتعزيز شروطهم التفاوضية في كل مرّة يعاد فيها توزّع السلطة على قاعدة المحاصصة أو الأنصبة بين سائر القوى الطائفية المختلفة.
إنّ ظاهرة التطييف السياسي كأحد أبرز آليات انتاج السلطة استمرّت ظاهرة ملازمة لتطور الحياة السياسية في الدولة اللبنانية الحديثة بدءا من نشأتها في العام 1920، مرورا بالاستقلال الوطني في العام 1943، وصولا الى صيغة الطائف للميثاق الوطني التي أوقفت الحرب – المأساة ميدانيا عام 1989، دون أن توقف الصراع السياسي المخزون تاريخيا، ثمّ تلتها تسوية الدوحة في العام 2008. فعلى الرغم من كل هذه المحطات التسووية استمرّت المحاصصة قاعدة ثابتة في توزّعات السلطة، لا سيّما توزّع المناصب الحكومية والبرلمانية بين الزعامات الطائفية التي عرفت ثباتا طويلا في مواقع الحكم، والتي كانت تضع نفسها فوق الدولة وفوق القوانين العامّة التي اعتمدت كآليات لتسيير الدولة وإدارة شؤونها.
ولمّا كان لبنان مجتمعا تعدديا ضمّ حوالي تسعة عشر مكوّنا روحيا، فقد كان من الطبيعي أن تصادف عملية مقاسمة السلطة بين الطوائف المتعددة عقبات، لا بل تجاذبات وتعارضات، لا سيّما وأنّ عملية المحاصصة بحدّ ذاتها كانت على ارتباط وثيق بمتغيّرات القوى الطائفية في صعودها أو هبوطها من ناحية، وبدور المؤثرات الخارجية الدولية والإقليمية ذات التأثير البالغ على حركة المشهد اللبناني الداخلي من ناحية أخرى. من هنا، كان مسلسل الأزمات اللبنانية ظاهرة ثابتة في تاريخ لبنان الحديث والمعاصر، فما كادت أزمة تختفي حتى كانت تطل أزمة جديدة، وذلك في كل مرّة تتعثّر فيها عملية محاصصة السلطة بفعل المتغيّرات الحاصلة على مستوى الجماعات والقوى الطائفية نفسها على مستويين اثنين:
الأول، داخلي ويتمثّل بمتغيّرات سكّانية ديمغرافية، واجتماعية، واقتصادية، وثقافية، وسياسية أيديولوجية، وعسكرية ( ميليشياوية ) خارج المؤسسة العسكرية الرسمية للدولة.
الثاني، خارجي ويعكس المتغيّرات الخارجية من دولية أو إقليمية وتقاطعاتها مع المشهد الداخلي اللبناني.
لقد استمرّت البنية السياسية اللبنانية، وهذا هو الأخطر في تطور لبنان السياسي منذ قيام دولته الحديثة وحتى اليوم، في كونها بنية مخزونة بعناصر خارجية. فالعناصر الحاملة لهذه البنية من داخلية وخارجية كانت تتحوّل باستمرار الى عناصر تضادّ داخل البنية نفسها مع مجرّد أي تأزّم يطرأ داخليا أو خارجيا، ذلك أنّ أي أزمة داخلية كانت تجد لها أصداء سريعة في الخارج الإقليمي أو الدولي، وكذلك، فإنّ أي أزمة في هذا الخارج كانت تثير أزمة موازية أو امتدادية لها في الداخل اللبناني المحلي الذي كان شديد الانفعال والتفاعل معها بقوّة.
إنّ توصيفا موضوعيا لحركة المتغيّرات الطائفية، وكيف أنّ هذه المتغيّرات أفضت الى اختلال التوازن في توزّعات السلطة، يظهر، الى حدّ بعيد، أنّ ثمّة قانونا تاريخيا طائفيا – سياسيا حكم انتاج أزمات لبنان المستمرّة دلّت عليها غير أزمة من أزمات الشغور في رئاسة الجمهورية وفي تأليف الحكومات وتوزيع الحقائب الوزارية، حتى بات المجتمع اللبناني في كثير من الأحيان أقرب الى الانقسام العمودي السياسي-الطائفي، الأمر الذي كان يهدّد مستقبل الكيان الوطني ويضعه على حافّة المجهول.
إنّ حلا جذريا للمسألة اللبنانية التي ما زالت تتواصل لأكثر من قرن من الزمن مضى على قيام الدولة الحديثة في العام 1920، يكمن أولا وأخيرا في تغليب الخيار الوطني، وتأكيد نهائية الدولة الوطنية اللبنانية كمشروع استراتيجي حاضن للوطن اللبناني أرضا وشعبا ودولة مؤسساتية دستورية ديمقراطية.
يبقى قيام الدولة الوطنية المستدامة شرطا مركزيا في اعتماد استراتيجية تأسيسية ترتكز الى مبدأ التراكم الخطّي الإيجابي انطلاقا من الآتي:
1 – المواطنة كهويّة ثابتة في الانتماء الى الوطن اللبناني، مقابل انتفاء خصوصيات الانتماء الطائفي والمذهبي والجهوي. إنّ انجاز المواطنة اللبنانية يبدأ مع تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفقا لما نصّت عليه أحكام دستور دولة الاستقلال التي جاءت متضمنّة في بيان أول وزارة استقلالية برئاسة رياض الصلح في 7 تشرين الأول ( أوكتوبر) 1943. أمّا تركيب هذه اللجنة فينبغي أن يضمّ فاعليات وشخصيات رسمية وشعبية، ورموزا نخبوية فكرية وثقافية وأكاديمية تمثّل التيار اللاطائفي، لمباشرة الخطوات الإجرائية باتجاه العبور من دولة الطوائف والمذاهب المتعددة الى دولة المواطنين- دولة الشعب اللبناني الواحد.
2 – إقرار قانون جديد للتمثيل النيابي يأتي على قياس الدولة والشعب وليس على قياسات المصالح الزعامية- الطائفية. من مواصفات هذا القانون الانتخابي اعتماد جغرافية انتخابية على أساس الدوائر الكبرى، والتمثيل النسبي، وخارج القيد الطائفي. يتضمّن أحكاما واضحة وصارمة لجهة سقف الانفاق المالي الانتخابي وتحديد وسائل مراقبته، وأحكاما لجهة تنظيم الاعلام والاعلان الانتخابيين، على نحو يضمن فرصا متكافئة للتكتلات واللوائح المتنافسة ديمقراطيا.
3 – إصدار قانون عصري للأحزاب السياسية يعزّز التوجهات الفكرية والسياسية الوطنية والديمقراطية، ويحدّ من الاصطفاف الطائفي والمذهبي. إنّ مثل هذا القانون يساهم في إغناء الحياة السياسية، ويعزّز الروح الوطنية، واليه يعود الدور الأكبر في قيام جماعة الدولة على أساس وضع الدولة فوق سائر الجماعات الطوائفية ، وليس كما هو حاصل اليوم من حيث وقوف الجماعات الطوائفية فوق الدولة.
4 – إقرار مبدأ عدم الجمع بين النيابة والوزارة، نظرا لأنّ مثل هذا الجمع يساعد على تقوية النفوذ الزعامي – السياسي لدى النائب – الوزيرمن ناحية، ويقلّل من فرص توسيع نطاق المشاركة الديمقراطية من ناحية أخرى.
5 – قيام سلطة قضائية مستقلّة عن السلطة الإجرائية، وذلك بانتخاب عدد من أعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي نفسه .
6 -تفعيل الهيئات الرقابية وتحديث الإدارة، واعتماد مبدأ الأهلية والكفاءة في التوظيف لمكافحة الزبائنية السياسية الحامية لكل أشكال الفساد الإداري والمالي المستشري في الإدارات والمؤسسات العامّة.
7 – اعتماد الانتظام الدوري في إجراء الانتخابات البلدية، الأمر الذي يؤسّس لانتاج سلطات ديمقراطية قاعدية أي على مستوى قاعدة الهرم السلطوي، ذلك أنّ تأسيس الديمقراطية القاعدية هو المدخل الضروري لتأسيس ديمقراطية رأسية أي على مستويات رئاسة الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء.
8 – تعديل المادة 21 من الدستور بهدف خفض سنّ الاقتراع الى الثامنة عشرة، لما لهذا الأمر من أهمية بالغة لتوسيع مساحة المشاركة الديمقراطية للمواطنين.
9 – احترام مبدأ المساواة بين المواطنين وفق شرعة حقوق الانسان، وإزالة كل أشكال التمييز ضدّ المرأة، وتطبيق بنود اتفاقية حقوق الطفل المدنية.
10 – إقرار قانون يشرّع الزواج المدني الاختياري كخطوة في اتجاه تكريس الحقوق والحريات الطبيعية غير المتعارضة مع روح الدستور اللبناني وأحكامه، وذلك على طريق الفصل بين الدين والدولة، وبناء الدولة المدنية الحديثة التي تحترم وتصون وتحمي حقوق المواطنين جميعا في ممارسة خياراتهم الفكرية والسياسية ومعتقداتهم وشعائرهم الدينية وسوى ذلك.
11 – اصلاح اقتصادي – اجتماعي من خلال الآتي:
أ – تعزيز الدور الناظم للدولة في تصحيح اختلالات آليات السوق وما ينجم عنها من فوضى اقتصادية، وتفاقم الاحتكار، وتفاوت اجتماعي.
ب – العمل على تضييق فجوة الاختلالات القطاعية أي بين قطاعات الإنتاج الزراعة، الصناعة، الخدمات والتجارة.
ينبغي على الدولة اعتماد خطط استراتيجية للتنمية الاقتصادية تقوم على تشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية الثلاثة، وعلى إيلاء أهمية للتدخّلات الإيجابية في تنمية المناطق الطرفية والأرياف الزراعية، وذلك بهدف الوصول الى توازن انمائي على مستوى القطاعات المنتجة من جهة، وعلى مستوى كل المناطق اللبنانية من جهة أخرى. وفي هذا المجال، تبرز أهمية تفعيل المشروع الأخضر الذي أنشىء برؤية شهابية إصلاحية اعتمدها العهد الشهابي في العام 1963 لتطوير الزراعة اللبنانية، وقد قام بانجازات مهمة على صعيد استصلاح الأراضي، وزيادة المساحات الزراعية التي تلازمت مع زيادة الإنتاج، وأسهم في الحدّ من الهجرة الريفية، وكذلك من النزوح الى المدن،لاسيّما الى العاصمة بيروت.
ج – وجوب إعادة إحياء وزارة التخطيط والتصميم العام، وهي وزارة قامت بالتخطيط العمراني والاقتصادي بالارتكاز الى معطيات إحصائية علمية، ومن خلال في مسوح في غاية الأهمية للسكّان والصادرات والواردات والميزان التجاري ورخص البناء، وحركة المرافئ وبصورة خاصّة مرفأ بيروت الذي لعب دورا مركزيا في الاقتصاد العربي واللبناني قبل الحرب الكارثية التي اندلعت في نيسان 1975.
د – وجوب مراجعة السياسات المالية، ووضع الخطط الكفيلة بالحدّ من الدين العام ومن خدمته المرهقة لخزينة الدولة وللموازنة العامة السنوية.
ه – اصلاح النظام الضريبي على قاعدة اعتماد مبدأ الضرائب المباشرة التصاعدية على المداخيل والأرباح والشركات والاستثمارات وغيرها.
12 – اعتماد اصلاح اجتماعي من خلال الآتي:
أ – عدالة توزيعية شاملة اقتصادية واجتماعية وإنمائية وسياسية، مقابل انتهاء مقولات الغبن والغنم التي سادت تاريخيا بين الطوائف والمناطق اللبنانية.
ب – التخطيط لسياسة اجتماعية تسهم في اتساع شبكات الأمان والضمانات الاجتماعية، لاسيّما في ميادين السكن والاستشفاء والتعليم والشيخوخة، وحماية مؤسسة الضمان الاجتماعي والسعي لتطويرها وتحديثها من أجل التقدم باتجاه دولة التنمية والرعاية الاجتماعية، تكون بديلة من الدولة المغانمية القائمة على المحسوبية والزبائنية.
13 – في مجال التربية والتعليم والثقافة:
أ – تعزيز وترسيخ الثقافة الوطنية وتطويرها كبديل نهائي للخصوصيات الثقافية الطائفية والمذهبية.
ب – اعتماد برامج ومناهج تربوية تنشأ عليها الأجيال اللبنانية القادمة تنشئة وطنية غير طائفية أو مذهبية أو مناطقية أو ولائية للخارج.
ج – تشجيع مؤسسات البحث والتطوير العلمي، والحدّ من هجرة العلماء والأدمغة الشابّة الى الخارج.
وهنا، ينبغي إيلاء الاهتمام الكافي بالجامعة اللبنانية وإعادة الاعتبار لموقعها التربوي والأكاديمي والبحثي في تعزيز موقعها الوطني في انتاج الثقافة الوطنية والمعرفة والتطوير العلمي في ضوء مواكبتها الحداثة والتكنولوجيا المبتكرة عالميا.
خلاصة :
إنّ أسباب تعثّر النهوض اللبناني تكمن أولا وأخيرا في السياسات التي اعتمدت في معالجة الأزمات المتلاحقة منذ قيام الدولة اللبنانية الحديثة وحتى اليوم. فلم تستطع المعالجات إيجاد الحلول الناجعة والدائمة لتلك الأزمات، وإنّما كانت في معظمها محاولات لتأجيل الأزمة وليس الى إلغاء أسبابها ومحاصرة مفاعيلها وتداعياتها التراكمية. فقد ظلّت الأزمات تتواصل على شكل حلقات في سلسلة متجددة ومعادة الإنتاج بصورة مستمرة.
إنّ خروج لبنان وطنا ودولة من مأزق أزماته المتجددة إنّما يكون بقيام الدولة الوطنية اللبنانية وفقا لمرتكزات تأسيسية هذه أبرزها:
1 – الخروج النهائي من صيغة الدولة المغانمية والسلطة الريعية في توزّعات الحصص والأنصبة الطوائفية والمذاهبية، والانتقال الى صيغة الدولة المؤسساتية ارتكازا الى مبدأ الوطنية اللبنانية الجامعة.
2 – التأسيس لمواطنة لبنانية تنتفي معها حالة ” المواطفة” المحكومة لغريزة ثقافية طائفية كانت هي المسؤولة دائما عن انقسامية المجتمع اللبناني الى وحدات مجتمعية متغايرة في بنيتها الثقافية، وفي مسلكياتها وتعبيراتها السياسية أيضا.
3 – إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية والرئاسية، واعتماد آليات عصرية في تأليف الحكومات القادمة، وذلك وفقا لمعايير ومقاييس المصلحة الوطنية العهليا، وليس وفقا لمصالح واعتبارات زعامية وحزبية طائفية ومذهبية وفئوية. وهنا، نقترح أن يكون انتخاب رئيس الجمهورية بوصفه الرأس الأعلى في السلطة التنفيذية، مباشرة من الشعب اللبناني، لما لهذه الصيغة من أهمية تفاعلية بين سائر المكوّنات الاجتماعية التي تؤلّف المجتمع اللبناني.
4 – التشجيع على تأسيس أحزاب وطنية لبنانية تكون مشدودة في ولاءاتها، أولا وأخيرا، الى لبنان الوطن والدولة، لبنان الجغرافيا والهويّة، لبنان وحدة الشعب والمصير المشترك، لبنان الانفتاح على العالم العربي وعلى سائر العالم.
5 – تعزيز الدور الريادي لمؤسسات وهيئات المجتمع المدني التي تبقى هي الأخرى بمثابة صمّام الأمان للسلام الوطني اللبناني، وهو السلام الكفيل بإخراج لبنان والدولة من عنق الأزمات الضاغطة، والولوج الى رحاب الاستقرار الذي بات راهنا ومستقبلا حاجة وطنية ملحّة للشعب اللبناني برمته.
6 – إصدار قانون اللامركزية الإدارية في ضوء التخطيط الاستراتيجي للإنماء القطاعي الإنتاجي والمناطقي المتوازن.
7 – تعزيز الروح الوطنية لدى المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة التي أثبتت في كل مرّة، وفي كل أزمة، استجابتها لمصالح الوطن والشعب دون غيرها.
8 – إيلاء أهمية استثنائية للثلاثي الوطني: الجيش، القضاء، الجامعة اللبنانية، هذا الثلاثي هو بمثابة الضامن الحقيقي لمستقبل الكيان الوطني اللبناني وتطوره الديمقراطي ونهوضه الشامل والمستمر.
إنّه التحدّي الذي يواجهنا جميعا، فهل نحن قادرون على توليد استجابات من شأنها النهوض بالوطن اللبناني المرتكز الى قواعد التطور الديمقراطي من خلال تكامل عمل المؤسسات الديمقراطية، واعتماد مبدأ المواطنة كشرط معياري لقيام الجماعة الوطنية اللبنانية المتماثلة من حيث وحدة نسيجها الاجتماعي والثقافي، ووحدة المصالح المشتركة، مصالح الحياة والمصير الواحد؟