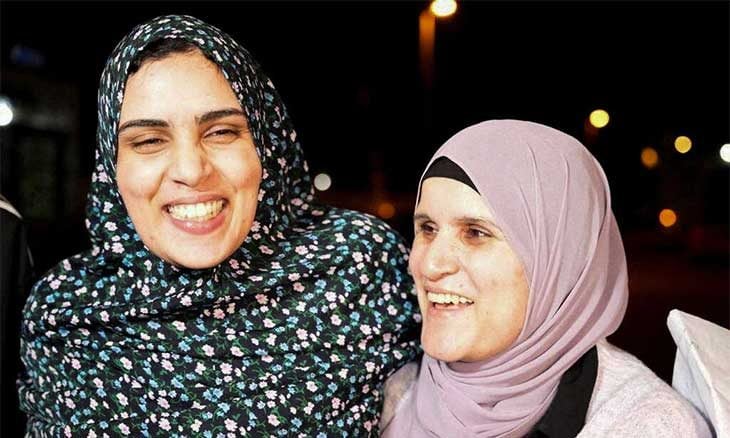سوريا والقومية العربية

سوريا والقومية العربية
ايمن رفعت
رغم أنه من المبكر محاولة استشراف آفاق ما يحدث في سوريا، لكن لنا أن نتساءل هل يمكن اعتبار سقوط نظام الأسد البعثي في سوريا نهاية للقومية العربية أم فقط نهاية المرحلة الثانية منها وأن سوريا علىً موعد آخر مع القدر لتبدأ مرحلة ثالثة من القومية العربية؟
المرحلة الأولى من القومية العربية
بدأت المرحلة الأولى من القومية العربية في سوريا أوائل القرن العشرين، بالدعوة إلى نهضة عربية كرد فعل على القومية التركية وسياسة التتريك الذي فرضته حكومة جمعية الاتحاد والترقي (والمعروفة بتركيا الفتاة) في الدولة العثمانية، كما تأثرت بالفكر القومي الغربي والإحساس بخطورة الاستعمار الأوروبي الذي احتل عددا من الولايات العربية العثمانية ويتطلع إلى المزيد، فقد كان معظم رواد ومؤسسي القومية العربية من السوريين الدراسين دراسة غربية، وقد تجمعوا في في جمعيات ونواد مثل جمعية العربية الفتاة والجمعية العلمية السورية والمنتدى الأدبي والجمعية القحطانية وجمعية العهد وغيرها.، وآمنوا بالعروبة كعقيدة ناتجة عن تراث مشترك من اللغة والثقافة والتاريخ إضافة إلى مبدأ حرية الأديان، فرغم أن معظم العرب آنذاك كان ولاؤهم لدينهم أو طائفتهم أو قبيلتهم أو حكوماتهم المحلية، إلا أن القوميون العرب رفضوا بشكل عام الدين كعنصر أساسي في الهوية السياسية، وعززوا وحدة العرب بغض النظر عن الهوية الطائفية، وهكذا ولدت القومية العربية كحركة علمانية منفصلة عن الدين لكن غير معادية له، خاصة بسبب الدور الكبير الذي لعبه المسيحيون الشوام في الحركة القومية، مثل ناصيف اليازجي وبطرس البستاني ونجيب عازوري وميشيل عفلق وقسطنطين زريق، ومع ذلك لم يعادِ القوميون العرب الدولة العثمانية، فلم يطالبوا بالانفصال عنها بل بالإصلاح داخلها، واستخدام أوسع للغة العربية في التعليم والإدارات المحلية، وإبقاء المجندين العرب في وقت السلم في خدمات محلية. أسس مجموعة من الطلبة الشوام في باريس جمعية العربية الفتاة التي أقامت المؤتمر العربي الأول في يونيه 1913 في قاعة الجمعية الجغرافية في باريس، وقد انتهى المؤتمر إلى قائمة من المطالب للحكم الذاتي داخل الدولة العثمانية.
استغل وزير الحرب البريطاني اللورد كيتشنر أفكار القومية العربية في رسالته إلى أمير مكة المعين من قبل العثمانيين الشريف حسين بن علي (1854-1931)، حين طلب منه المساعدة في الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية، فقد رأى اللورد كيتشنر في الشريف حسين تأثيرًا روحيًا أكثر من تأثير القوميين السوريين. فقد كان السبب الرئيسي وراء هذا الطلب هو مواجهة احتمال إعلان العثمانيين للجهاد ضد الحلفاء، والحفاظ على دعم 70 مليون مسلم في الهند البريطانية، وخاصة أولئك الذين كانوا في الجيش الهندي وتم نشرهم في جميع الجبهات الرئيسية للحرب. اغتنم الشريف حسين الفرصة وتبادل عشر رسائل مع المندوب السامي البريطاني في مصر، السير هنري مكماهون، من يوليو 1915 إلى مارس 1916، مطالبًا بضمان بريطاني لدولة عربية مستقلة والموافقة على إعلان الخلافة العربية. وافق مكماهون على مكافأة الشريف حسين بإمبراطورية عربية تمتد من مصر إلى بلاد فارس، في مقابل قيادة ثورة عربية ضد الإمبراطورية العثمانية.
استدعى المكتب العربي للمخابرات البريطانية في القاهرة ت. إي لورنس، المعروف باسم “لورنس العرب” (1888-1935)، وأرسله إلى شبه الجزيرة العربية في مهام استخباراتية في عام 1916. كان لورنس عالم آثار بريطاني يمارس عمله في الشرق الأوسط، حيث درس اللغة العربية. في عام 1914، تم اختياره من قبل الجيش البريطاني كغطاء لمسح عسكري لصحراء النقب، في جنوب فلسطين. كانت مهمته في شبه الجزيرة العربية هي أن يكون وسيطًا للقوات العربية أثناء الثورة العربية، إلى جانب ضباط بريطانيين آخرين، لدعم القوات العربية ضد العثمانيين.
أرسل الشريف حسين قواته غير النظامية (المعروفة باسم جيش الشريف أو الجيش العربي)، تحت قيادة ابنه الأمير فيصل ولورنس العرب، لمهاجمة خط سكة حديد الحجاز، الذي يمتد من دمشق إلى المدينة المنورة، لمنع العثمانيين من إرسال المزيد من القوات. تقدمت هذه القوات غير النظامية شمالاً إلى العقبة حيث هزم هجومهم البري القوات العثمانية هناك في 6 يوليو 1917. في الوقت نفسه، قاد المارشال إدموند ألنبي قوة المشاة البريطانية من مصر المحتلة شرقًا إلى غزة، لكنه فشل في الاستيلاء عليها مرتين قبل إجبار العثمانيين على الانسحاب في ليلة 7 نوفمبر 1917. من تلك النقطة فصاعدًا، قاتلت قوات الحسين جنبًا إلى جنب مع القوات البريطانية أثناء تقدمها شمالاً إلى دمشق، حيث التف القوميون العرب حول الأمير فيصل بن الحسين الذي أعلنوه ملكا، وقد أدت هذه الثورة المدعومة من الاستعمار إلى تسليم الشرق العربي إلى انجلترا وفرنسا، وعندما أمر الملك فيصل بالاستسلام للاحتلال الفرنسي، أدرك وزير حربيته يوسف العظمة أن حب السلطة لا الفكر القومي هي الحافز الحقيقي الملك، فعارض قرار الملك بحل الجيش، وقاد جيشه لمحاربة الفرنسيين، ليصبح وزير الحربية العربي الوحيد الذي أستشهد خلال معركة في العصر الحديث.
المرحلة الثانية من القومية العربية
في أوائل الخمسينيات وصل ضباط قوميون إلى السلطة في مصر بانقلاب عسكري، وفي السينيات وبنفس الطريقة وصل ضباط من حزب البعث القومي إلى السلطة في العراق وسوريا وتبعهم ضباط يمنيون وضابط مهووس في ليبيا، فبدأت مرحلة جديدة من القومية العربية تتجاوز ثورة الشريف حسين لتعود إلى فكر المؤسسيين السوريين كحركة علمانية منفصلة عن الدين لكن غير معادية له، ولكن هذه المرة مسلحة بديكتاتورية عسكرية وفكر اشتراكي.
انتهى المشروع القومي في مصر بهزيمة عسكرية لم تتجاوز مصر آثارها حتى الآن، حتى بعد انتصارها في حرب أكتوبر، حيث أخرجت اتفاقية كامب ديفيد مصر من الصراع العربي الإسرائيلي، وانتهى المشروع القومي في العراق بالغزو الأمريكي، وفي ليبيبا بذبح الرئيس وفي اليمن بحرقه، وفي سوريا بهروبه أمام تقدم الثوار نحو عاصمة حكمه.
وبسقوط نظام الأسد سقط آخر نظام يرفع شعار القومية العربية، فلماذا فشلت المرحلة الثانية من القومية العربية؟ هناك أسباب عدة لهذا الفشل. أولا، ارتباطها بالديكتاتورية العسكرية في مصر وسوريا والعراق واليمن وليبيا. ثانيا المتاجرة بقضية فلسطين دون ان تستطيع ان تقدم لهذه القضية شيئا إلا أن زادتها تعقيدا. ثالثا الفشل في احتواء التيار الإسلامي لأنه تيار أممي (عابر لفكرة الوطن) رغم أن الإسلام يشكل أحد مكونات القومية العربية، ورغم أن القومية العربية استوعبت وتحالفت مع تيارات اشتراكية أممية. رابعا كانت القومية العربية دخيلة على العقل العربي، اقتبسها المثقفون الشوام من الغرب، واحتاجت الي يد الاستعمار الإنجليزي لدفعها، ثم دبابات العسكريين.
كان المشروع الناصري أهم صيغة من صيغ هذه المرحلة من القومية العربية، وقد تجاوز تأثيره منطقة الشرق الأوسط، ولكن منذ هزيمة هذا المشروع في ٦٧، غابت الرؤية عن السياسة العربية التي تحولت إلى مجرد رد فعل، وذلك لأن العرب عاجزون عن تحريك واقعهم أو توجيهه أو إيجاد بديل له، وقد نتج عن هذا العجز ظاهرتين. الأولى هي تشكيل مثلث للقوى المؤثرة في الشرق الوسط من إيران وإسرائيل وتركيا، وبالطبع يلعب النظام العالمي الأحادي (مثتملا في الولايات المتحدة) دورا محوريا بين رؤوس هذا المثلث. الظاهرة الثانية هي تحول العقل العربي من مسار التحرير الوطني إلى مسار محافظ يحاول إيقاف حركة التاريخ وتثبيت الواقع، إدراكا منه بأنه بأنه لم يعد فاعلا في هذا الواقع، بل مفعولا به من مثلث قوى غير موثوق بها، فإذا كنا عاجزين عن التقدم خطوة واحدة، وفي نفس الوقت لا نثق في المؤثرين، فعلى الأقل يمكنا التشبث بمواقعنا فلا نتراجع، ولكن لأنه يستحيل إيقاف عجلة التاريخ أو التغلب على حركته ، فقد تراجع العرب للوراء خطوات كثيرة، وسيطر هذا المسار المحافظ على العقل العربي حتى في نخبته المثقفة التي تحولت (ياستخدام مصطلحات جرامشي) من دور المثقف العضوي في الربط بين البنية الفوقية والتحتية للمجتمع إلى مثقف تقليدي أنعزالي يخدم مصالح الطبقة الحاكمة. تفضل هذه النخبة الديكتاتورية العسكرية (بقايا المشروع الناصري) على التيارات الدينية التي نتجت عن مشروع النهضة الإسلامية وأنتجت في أفغانستان تجربة رجعية معادية لكل أشكال التحديث، بينما على الأقل حافظت الديكتاتورية العسكرية على هامش صغير من التحديث، وإن كان شكليا. وإذا كان هذا المبرر لانحياز المثقفين مفهوما، فإن رفضهم للتيارات الدينية بحجة أنها لا تؤمن بالديمقراطية مثير للسخرية بدرجة كبيرة، كأن الديكتاتورية العسكرية تطبق نظاما ديمقراطيا! والحقيقة أنهم لا يتذكرون الديمقراطية إلا في نقد التيارات الدينية. وبدلا من دورهم في توعية وتثقيف الجماهير، فإنهم يختلقون الخطر كأنهم زرقاء اليمامة، ويلغون العقول تسهيلا لقيادة القطعان وحشرها في حظائر الديكتاتورية العسكرية. على سبيل المثال، يخوف هولاء المثقفون شعوبهم مما يحدث في سوريا، ناسين أن دفع الشر المؤكد أولى من تجنب الشر المحتمل، وأن تحرير الإنسان أولى من نحرير الأرض، فيدعون قلقهم من احتمال انقسام سوريا أو وقوعها في حرب أهلية، ولكنهم ينسون أن سوريا تحت حكم الأسد انقسمت بالفعل ووقعت فريسة حرب أهلية وتحت النفوذ الأجنبي الروسي والأيراني والأمريكي والبريطاني. ويتباكون على احتلال إسرائيل المنطقة العازلة مع سوريا بعد رحيل الأسد، متناسين أن الحكم العسكري في مصر يتجاهل احتلال إسرائيل محور صلاح الدين في رفح رغم اتفاقيات الأمن. ويتهمون ثوار سوريا أنهم دخلوا دمشق بدعم أجنبي، ناسين أنه لا يوجد حاكم عربي الآن لم يصل إلى منصبه دون دعم أجنبي. ألم يقل الدكتور مصطفى الفقي (سكرتير الرئيس مبارك للمعلومات ثم رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان) أن الرئيس القادم لمصر (بعد مبارك) يحتاج إلى موافقة أمريكية وعدم اعتراض إسرائيلى؟
المرحلة الثالثة من القومية العربية
بعد دخول القوات الأمريكية بغداد وسقوط نظام صدام البعثي في العراق، دعمت إيران التيارات الشيعية ودعمت السعودية التبارات السنية، فمرت العراق بأزمة طائفية كبديل عن النظام القومي المعادي للديمقراطية وحقوق الإنسان، وعندما انطلقت شرارة ثورات الربيع من تونس إلى مصر ثم ليبيا وسوريا واليمن والبحرين، اتضح أن ما يجمع الشعوب العربية أكبر مما يجمع الآنظمة العربية، وظهر تيار شعبي عربي يدعو لوحدة عربية يقودها الشعب، وليس الأنظمة المتسلطة التي ركبت موجة القومية دون أن تنجز شيئاً يذكر في هذا الاتجاه، فهل يمكن اعتبار الربيع العربي مرحلة شعبية من مراحل تطور القومية العربية بعد المرحلة الاولى التي ارتبطت بالاستعمار ثم المرحلة الثانية التي ارتبطت بالديكتاتورية العسكرية؟
هناك ثلاثة تحديات لكل هذه المراحل، التحدي الأول هو العلاقة بالغرب، فبينما ارتضى قادة المرحلة الاولى أن يكونوا أداة في يد الغرب الذي لم يحافظ على وعوده لهم، فإن المرحلة الثانية كانت تحاول تقليد الغرب لكن بشروطها، فاصطدمت به، لتبدأ المرحلة الثالثة الآن محاولة إلا تستفز الغرب لتركز على لملمة جراحها وبناء أوطانها من الداخل، والتحدي الثاني هو العلاقة بالدين، فلقد كان للتيارات الإسلامية دور لا ينكر في الربيع العربي، والتحدي الثالث هو الديمقراطية وحقوق الإنسان.
لكن هل يمكن اعتبار أحداث سورية الأخيرة جزء من الربيع العربي؟ قد تكون هذه الأحداث بداية المرحلة الثانية (الثورة) من الربيع العربي لتصحح أخطاء المرحلة الاولى (الانتفاضة)، فالفرق بين الثورة والانتفاضة الشعبية أن الاولى تسعى لإسقاط النظام الحاكم لا إصلاحه، ولكي تستطيع الثورة أن تسقط النظام الحاكم فلابد لها من التسلح بقوة تستطيع بها مواجهة النظام، وقيادة سياسية تستطيع أن ترسم أهدافا استراتيجية، ولكن لم يكن للربيع العربي قيادة سياسية، فلقد سبقت الشعوب نخبتها، واستعاض الشباب الغاضب عن القوة المسلحة باستراتيجية المظاهرات المليونية الني احتلت الميادين في حالة من العصيان المدني، وقد جعلت السماوات المفتوحة قدرة النظم الحاكمة على إخفاء قمعها محدودا، فاضطرت هذه النظم إلى الخضوع لمطالب المتظاهرين، وتغيير الوجوه الحاكمة، حتى تمكنوا من استيعاب الغضب الشعبي دون تغيير حقيقي في بنية النظام الحاكم، فكل ما حققته “الثورة” المصرية هو استبدال القادة العسكريين لمبارك به.
فهل ما حدث في سوريا في الأيام السابقة مرحلة من مراحل الثورة الشعبية التي بدأت مع الربيع العربي سنة ٢٠١١ ضد الديكتاتور بشار الأسد؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فلماذا قامت الآن بعد ثلاثة عشر عاما من تحت الرماد كطائر العنقاء؟ يربط القوميون العرب استعادة الثورة السورية لعافيتها مؤخرا بخطة نتنياهو لتغيير خريطة الشرق الأوسط، والتي أعلن عنها في سبتمبر الماضي أثناء خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة. فلتفعيل خطته كان لابد من تقسيم سوريا وإضعاف الفريقين المتقاتلين دون السماح لأحدهما أن ينتصر على الآخر نصرا نهائيا، وبالطبع ليس هناك للتقسيم طريقة أفضل من إشعال صراع طائفي بين الشيعة (الممثلة في النظام السوري المدعوم من إيران) وبين السنة (الممثلة في هيئة تحرير الشام المدعومة من تركيا “عضو الناتو” ودول الخليج العربي)، ولم لا والمشرق العربي يعيش الآن عصر ملوك الطوائف.. المرحلة الاخيرة قبل سقوط الأندلس في المغرب العربي. ولقد وافقت أمريكا على هذه الخطة لتشتيت الجيش الروسي وإشغاله عن أوكرانيا، وكذلك قطع الأذرع الإيرانية المحيطة بإسرائيل. وهكذا ظهر الجولاني، عضو سابق في تنظيم القاعدة، سجنته القوات الأمريكية في العراق، وتحالف مع داعش ثم انشق عنها، وتصنّفه الحكومة الأمريكية كإرهابي ومازالت مخابراتها ترصد مكافأة ١٠ مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي للقبض عليه، ومع ذلك تحاوره أكبر قناة إعلامية أمريكية، فيظهر فيها كنجم سينمائي لا مقاتل متخفي، وقد تخلى عن كوفيته ولحيته الكثيفة، ويتحدث – دون الاستشهاد باي نص ديني – عن أمله في تحقيق دولة القانون وحماية الأقليات وانهاء الطائفية ، لأنه – على حد تعبيره – لا يستطيع أحد إلغاء الاخر. هل كان هذا فيلما هوليوديا أم جزءا من محاولة ترتيب الأوراق قبل عودة ترامب (القيصر القديم /الجديد) إلى البيت الأبيض؟
يشكك القوميون في أن الجولاني قد أوصل لواشنطن تعهدات لا نعلم طبيعتها، ومما أكد شكوكهم أن إسرائيل قامت بضرب مخزن أسلحة بشار الأسد كأنها تضعفه بينما كان قوات الجولاني تزحف باتجاه دمشق، ثم يصرح ترامب بأن أمريكا يجب ألا تتدخل لأن أحداث سوريا لا تخصها في شيء.
هذه الرؤيا المسبقة هي رؤيا ايديولوجية جامدة لا تتأثر بالأحداث، بل تصادر على المستقبل، وتجعل الماضي يحكم عليه، لكن هذه الرؤيا تغيرت بعد ساعات قليلة من دخول دمشق، فالضربات الاسرائيلية المستمرة تدل على عدم وجود تفاهمات مع اسرائيل، والبيانات الروسية والإيرانية تؤكد أن الأسد غادر (كفأر) بعد تفاهمات مع الجيش والمعارضة للحفاظ على وحدة سوريا، وما بؤكد هذه البيانات التقدم السريع للمقاومة وانسحاب الجيش دون قتال، وسوف تتأكد في الايام القادمة ان لم يتم حل الجيش، كما عاد الجولاني لاسمه الحقيقي (احمد الشرع) وخطب في المسجد الأموي خطبة دينية بعد خطابه الليبرالي في حديث السي ان ان، وطلب من رئيس الوزراء الاستمرار في عمله ومن أتباعه عندم التعرض لمؤسسات الدولة. أما هيئة تحرير الشام، التي كانت تسمى جبهة النصرة، فظهر أنها مجرد الجناح العسكري للائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية التي يرأسها الدكتور هادي البحرة، في تجربة فريدة لم تشهدها المنطقة من قبل، وهي توافق تيارات سياسية مختلفة على مصالح وطنية، تعترف بها جامعة الدول العربية كممثل للشعب السوري. ولكن التحدي الحقيقي لهذا الائتلاف هو ما بعد بشار. فمن الطبيعي أن يتوافق الفرقاء في مرحلة الهدم، لكنهم يتقاتلون في مرحلة البناء.