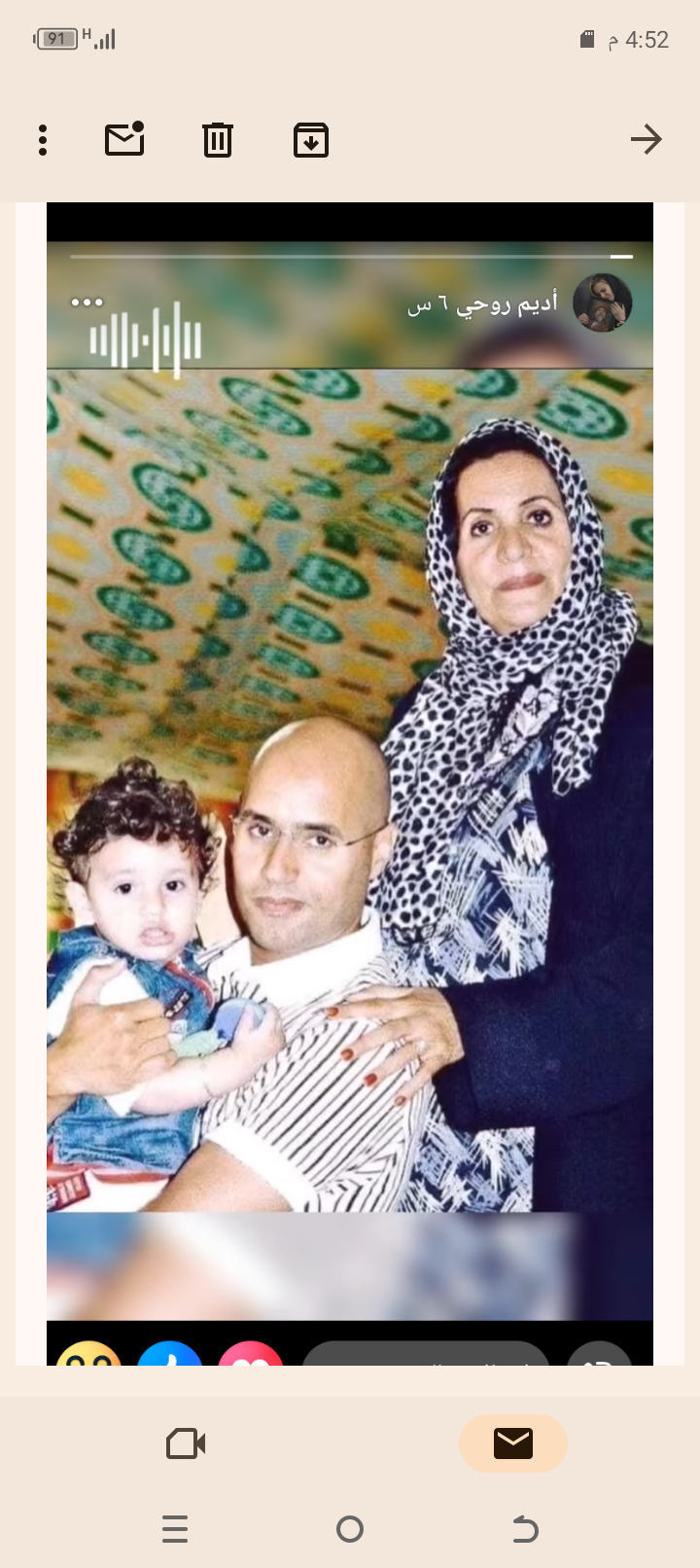حرية الإيمان وأزمة التدين الجماعي في مجتمعات الشرق

حرية الإيمان وأزمة التدين الجماعي في مجتمعات الشرق
القس د. نديم نصار
الإيمان تجربة إنسانية فردية، تنبع من القلب والعقل، وتنمو في ظل الحرية والوعي. لا يمكن لأي دين أن يشكل خطرًا على المجتمع إذا تُرك الأفراد أحرارًا في اعتناقه أو رفضه، فالإيمان النابع من القناعة الشخصية يمكن أن يكون عاملابناءً يسهم في نهضة المجتمعات، حتى في تلك التي تمتلك حساسية عالية تجاه الدين، كما هو الحال في الشرق. ولكن التحدي الأكبر لا يكمن في وجود الدين، بل في تحوله إلى ظاهرة جماعية غير منضبطة، حيث يصبح الناس جزءا من قطيع يتبع دون تفكير، ويوافق أو يعارض فقط ليحظى بقبول الجماعة. وهنا تتجلى الخطورة الحقيقية؛ إذ يصبح من يقود هذا القطيع المتحكم الرئيسي في توجيه المجتمع، متلاعبا بالأفكار والعواطف، مستغلاالجهل، ومكرسا ثقافة الإقصاء والتكفير وفرض الدين مستخدماً السلاح وفائض القوة.
عندما يتم التلاعب بالدين ليصبح أداة للسيطرة، تتحول المساءلة والنقد إلى جرائم، ويُحاصر التفكير الحر، فتسود الشعارات الجوفاء القائمة على تفسير محدد لنصوص دينية مجتزأة، تُستخدم لتوجيه الجماهير نحو مسارات محددة دون أدنى فرصة للمناقشة أو الاختلاف. هذه الظاهرة ليست جديدة، فقد شهد التاريخ أشكالامتعددة من «تدين القطيع» الذي استُخدم لترسيخ السلطة السياسية، وقمع الفكر النقدي، وإلغاء دور العقل.
التحالف بين السلطة والدين عبر التاريخ: في العصور الوسطى، تبنى الملوك والأمراء مبدأ «تدين القطيع» مستخدمين الكنيسة ورجال الدين كأدوات فعالة للسيطرة على المجتمعات. كانت السلطة السياسية تسيء استخدام الكنيسة، بسلطتها الروحية، فتقرر مصير الأفراد، وتمنح الشرعية لمن يطيع، وتكفر وتلاحق كل من يجرؤ على التمرد أو التساؤل. واستمرت هذه الهيمنة لقرون، حيث شُنت الحروب باسم الدين، وسُفكت دماء الآلاف دفاعًا عن مصالح سياسية مغلفة برداء الإيمان. لكن مع مرور الزمن، بدأت شعلة الوعي تتقد، وبدأت سلطة العقل تنتصر. كانت أولى خطوات التحرر هي ترجمة الكتاب المقدس إلى اللغات المحلية، وهو ما سمح لعامة الناس بقراءته وفهمه خارج إطار التأويل الكهنوتي. ومن هنا، نشأت مدارس النقد الديني، مثل النقد النصّي واللاهوتي والتاريخي والفلسفي، التي أخضعت النصوص المقدسة للدراسة الأكاديمية، ووضعتها تحت مجهر البحث والتدقيق بعيدا عن التفسيرات المطلقة. كل هذا أسهم في إعادة الكنيسة الى حد كبير لتلعب دورها الصحيح في المجتمع الذي اتجه إلى العلمانية وهي فصل الدين عن الدولة ونجح في ذلك بدرجات تتفاوت من بلد إلى آخر.
المسيحية في الشرق وصراع الطوائف وهيمنة المصالح: ورغم أن الفكر النقدي انتصر في الغرب، فإن المسيحية في الشرق لا تزال تعاني من الفكر الطائفي المغلق، حيث تُحكم الطوائف من قبل رجال الدين الذين يفرضون فهمًا محددًا وضيقاً للإيمان، وكأن الكنيسة ليست بيتًا للنمو الروحي والتقرب إلى الله، بل «دكان» يسعى للحفاظ على زبائنه. أصبحت الطوائف المسيحية في الشرق أشبه بـ«دكاكين» تتنافس فيما بينها لجذب الأتباع، وسط بيئة تتسم بالتناقص المستمر والمتسارع لعدد المسيحيين. في بعض الدول، مثل لبنان، تهيمن السياسة الفاسدة على المؤسسات الدينية، فتحول الكنائس والطوائف إلى أدوات لتحقيق مكاسب مالية وسياسية، مما يعمق أزمة التدين الجماعي، ويجعل أصوات المساءلة أكثر خفوتًا.
لا يمكن للمجتمعات أن تنهض ما لم تكسر حاجز الخوف وتستعيد حرية التفكير، وما لم يُفصل الدين عن المصالح السياسية التي حولته إلى أداة للسيطرة والاستغلال
تكرار التاريخ تحت عباءة جديدة: للأسف، يمر الإسلام في الشرق اليوم بالظاهرة نفسها التي عانت منها الكنيسة في العصور الوسطى. فقد تحول التدين إلى وسيلة بيد السلطة السياسية، حيث يُستخدم الدين للهيمنة على الأفراد، وتُقمع أي محاولة للخروج عن النسق الجمعي المفروض. أصبحت فكرة «تدين القطيع» السلاح الأقوى، حيث يُكفَّر كل من يطرح تساؤلات، ويُلاحَق كل من يرفض الانصياع، حتى أصبح الانتماء إلى القطيع ضرورة للبقاء في المجتمع.
هذا القمع الممنهج أدى إلى انتشار ثقافة تمجيد الموت بدلاً من بناء الحياة، حتى بات من يرفض هذه الثقافة منبوذًا، وأحيانًا مهددًا من أقرب الناس إليه. رأيت أصدقاء في لبنان فقدوا علاقتهم بأسرهم لأنهم اختاروا التفكير خارج حدود القطيع، ورفضوا الانقياد وراء رجال دين مسيسين، يرون في كل محاولة للخروج عن سلطتهم خطراً يهدد وجودهم، وليس الدين بذاته.
سوريا ولبنان والعراق… تحالف السلطة والدين: تجسد الأوضاع في سوريا ولبنان والعراق الصورة الأكثر وضوحًا لكيفية استغلال الطبقات السياسية الفاسدة للدين، إذ نجحت هذه الأنظمة في ترسيخ التدين الجمعي، وإقصاء الفكر النقدي، بحجة أن الظروف السياسية تتطلب ذلك. أصبحت المؤسسات الدينية أذرعًا للسلطة، تُحرك الجماهير، وتمنعها من التفكير المستقل وتزرع في قلوبها الخوف من الله والكتب المقدسة، حتى لا تفلت من قبضة الحكام. والنتيجة الحتمية لهذا التلاعب هي فقدان شعوب الشرق لعقولها، وثرواتها، وإمكاناتها، حيث تتجه الموارد نحو صفقات تخدم القوى الخارجية، بينما تزداد المجتمعات المحلية فقرًا وضعفًا.
استعادة الوعي وبناء مجتمع التفكير الحر: ما تعانيه مجتمعات الشرق اليوم ليس أزمة دين، بل أزمة تدين ووعي. فالدين في جوهره تجربة روحية سامية، تحتاج إلى قادة روحيين يقدمون للناس النصح والإرشاد بالمحبة وليس بتجميد عقولهم ووضعها في قوالب لا حياة فيها تقتل الروح وتحولهم إلى شبه آلات مبرمجة خاضعة إلى سلطة تقمع حرية الإيمان أو الرفض أو حتى السؤال. لا يمكن للمجتمعات أن تنهض ما لم تكسر حاجز الخوف وتستعيد حرية التفكير، وما لم يُفصل الدين عن المصالح السياسية التي حولته إلى أداة للسيطرة والاستغلال.
لقد آن الأوان لأن نعيد الدين إلى موضعه الحقيقي: تجربة شخصية تتسم بالحرية، لا وسيلة قمع أو تجارة. وحده العقل الحر يمكنه بناء مجتمع متسامح، يرى في الإيمان قوة دافعة نحو المحبة والعدل، وليس أداة للهيمنة والتفرقة ونشر الخوف. فكما نهضت أوروبا بعد عصور الظلام، تستطيع شعوب الشرق أن تستعيد إنسانيتها، شرط أن تتحرر من قبضة المستفيدين من تدين القطيع من ساسة أو رجال دين، وتستعيد حقها في التفكير، والسؤال، والمساءلة.
»
٭ المدير التنفيذي لمؤسسة «وعي»