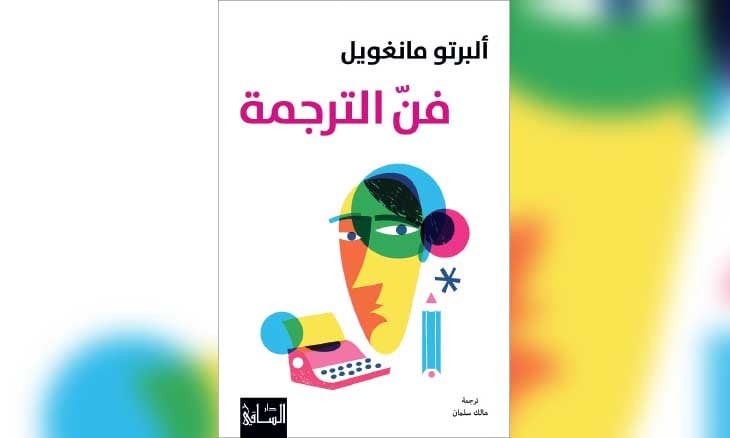
إجابة مانغويل المبدعة عن: ما هي الترجمة؟

حسن داوود
يتنقّل ألبرتو مانغويل بين العالم المكتوب، أو بالأحرى العالم المقروء، مفلسفا الكتب والمكتبات وتاريخ القراءة الصعب، ليصل أخيرا إلى الترجمة. كتابه «فنّ الترجمة» يضمّ أربعة وأربعين نصّا، أحسب أنها كتبت مقالات متفرّقة لا يتجاوز طول أكثرها الصفحة ونصف الصفحة. لكن، على غرار كل ما كتبه، تستند هذه النصوص إلى ما يصعب حصره من القراءات، المتباعدة بلغاتها وتواريخ صدورها.
في المقدمة يروي لقرّائه عن تجاربه في اكتساب اللغات المختلفة بدءا من طفولته، بعدم اكتفائه بإجادة الإنكليزية والألمانية فألحقهما، وهو في عمر الثامنة أو التاسعة، بتعلمّ الإسبانية. وفي أعمار له لاحقة كان عليه تعلّم لغات أخرى، بينها الفرنسية والإنكليزية القديمة.
كان يقرأ الكتب بلغاتها المختلفة من دون أي تمييز بينها، ومن دون تفضيل لغة على الأخرى. وحين يتكلّم مع أشخاص مختلفي اللغة لم يكن يدرك أنه يقوم، من خلال ذلك، بنقل فكرة من عالم لغوي إلى عالم لغويّ آخر. كان ذلك الانتقال أقرب إلى أن يكون بديهيا وطبيعيا يشبه التحوّل من «صباح الخير» إلى «مساء الخير» تبعا لما يمليه الوقت.
وإذ عرف أن ما أتيح له (قراءة الكتب بلغاتها الأصلية) لم يكن متاحا لكثيرين غيره، قرّر أن يترجم، «إن جميع أنواع الترجمة ضرب من النقل» يقول مستندا إلى كلمة translatio، حيث كانت تعني في العصر الوسيط نقل رفات قدّيس من مكان إلى مكان آخر، ما يعني «استئصال شيء مقدّس من الموقع الذي يستقرّ فيه وموضعته في منطقة أخرى». وينبغي هنا عدم التقليل مما تحمله كلمة «مقدّس» من معنى»، فيما يتعلّق بالموضوع المنقول. ففي مقالات الكتاب اللاحقة، سنتابع مع الكاتب تأملاته في معنى الترجمة العميق والسحري، لكنه مع ذلك لا يتورّع عن تشبيه فعل النقل ذاك بالسرقة، لكن على غرار سرقة الآثار المقدّسة: «على غرار ما يفعل اللصوص، يقوم المترجمون باختلاس ما ليس لهم لكي يُغنوا موطنهم اللغويّ الخاص».
في مقال بعنوان «سياسة» يذكر مانغويل كيف أن المترجمين عمدوا إلى إجراء تعديلات على النصوص، بما يلائم توجهاتهم الفكرية والعقائدية. فابتداء من القرون الوسطى بدأ إجراء ما سُمّي بالتنقيحات على ترجمة النصوص. في ترجمة كتاب أوفيد «فنّ الهوى» تم تغيير جملة «إن حبّ الغلمان أقلّ شأنا بالنسبة إليّ» إلى جملة بديلة هي: «إن حبّ الغلمان لا يعنيني على الإطلاق». هذا وقد أرفق المترجم القروسطي ذلك التعديل بتعليق ذكر فيه: «وهكذا نتأكّد أن أوفيد لم يكن شاذّاً سدوميا». قصائد كثيرة خضعت لتعديل مشابه بينها لمايكل أنجلو وللشاعرين الفارسيين سعدي وحافظ.
في مكان ما من الكتاب يرى مانغويل أن النص الإبداعي يتخلّق من جديد عبر الترجمة، أو أن نطفته، أو بذرته، تنمو مع الترجمة في لغة أخرى معيدة، ومع كل ترجمة جديدة، كتابة ما يشبه المسودّة الأخرى للنص الأصلي. «وعلى قارئ هذا النص، المترجَم، أن يتابع من تلك النقطة، إذ «على النص الأصلي أن يختفي تماما».
غنيّ عن القول إذن إن الترجمة القادرة على البقاء ليست تلك التي ينشغل فيها المترجم بتحقيق التكافؤ بين نصّين. فما يفعله هو التفكيك الواعي لما بناه الكاتب في نوبة ضبابية من الفهم. ذاك أن ما يعمل عليه الكاتب ليس نصّا متكافئ العناصر يقبع كل منها في مكانه الصحيح وغير القابل للإبدال. فالخيارات المتاحة للكاتب، فيما هو يعمل، كثيرة وغير نهائية في الوقت نفسه، وهو يختارها من بينها الأقرب إلى إيفاء المعنى طالما أن المعنى هذا لن يأتي كاملا تامّ الاكتمال. هي «نوبة ضبابية من الفهم» يكتب مانغويل عن حال الكاتب الذي حسبه لا يقف على أرض يقينيّة. أما قوانين الترجمة فأشدّ صرامة، ذاك لأن المترجم مراقَب دائما، أو هكذا يشعر بنفسه: إنه يتلقّى أسئلة عليه أن يجيب عنها إجابات صحيحة، كما عليه، في الوقت نفسه، أن يتبع النوبة الضبابية الخاصة به.
رغم كل هذا الجهد وهذه الدقّة يظل المترجمون قابعين في الظل. القرّاء الفرنسيون اصطفت على رفوف مكتباتهم أعمال دوستويفسكي وكيبلينغ، والإنكليز يقرأون بلغتهم مارسيل بروست الفرنسي، واليابانيون بدورهم يقرأون بلغتهم راسين وشكسبير معتقدين أنهم يقرأون نصوص الكاتبين المسرحيين، فيما المترجمون يقبعون في الظل ونادرا ما تأتي كتب الأدب على ذكرهم.
*«فنّ الترجمة» كتاب لألبرتو مانغويل صدر عن دار الساقي في 126 صفحة، سنة 2024.






