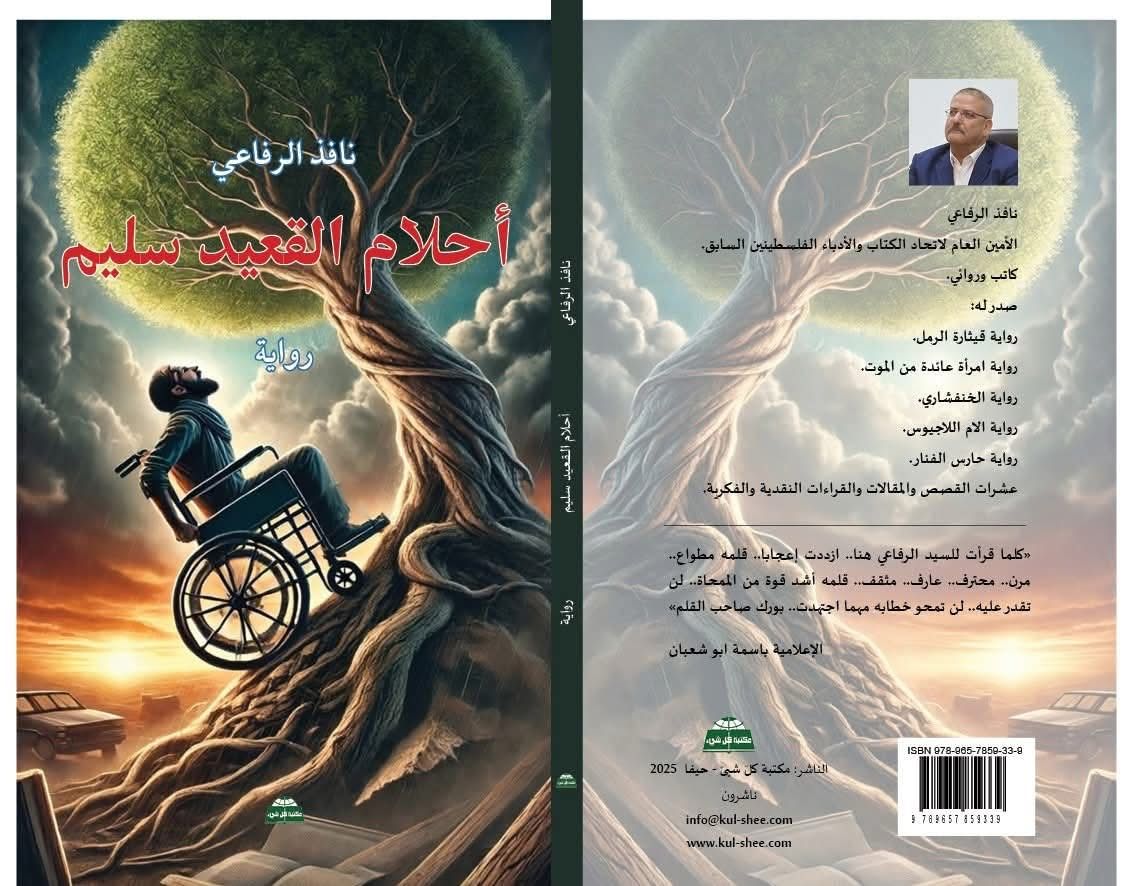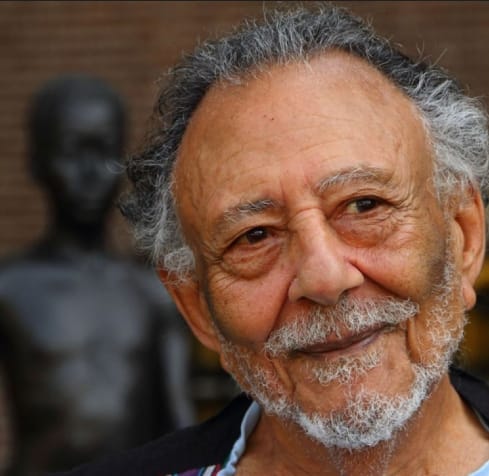دمشق… إسلام المرح أم إسلام الأحزان؟

محمد تركي الربيعو
تبدو مدينة دمشق هذه الأيام وهي تعيش مرحل جديدة في حياتها. فبعد عقود طويلة عانت فيها من الاستبداد على يد نظام الأسد (الأب والابن)، تبدو وكأنها تعود للحياة، وبالأخص بعد سنوات 2011، التي دمرت فيها أجزاء كبيرة من المدينة وريفها المحيط بها، إضافة إلى الإهمال الشديد الذي عرفته أحياؤها، وأهلها، وانتشار الفقر والفساد، وكل شيء سلبي يمكن أن يخطر في البال. ومع تنفس المدينة الحياة مرة أخرى، عاد الحديث عن تاريخ المدينة وأهلها، وما عرفته من محن ومصاعب، قبل أن تنهض مرة أخرى، فقدر المدينة كما يعتقد عدد من مؤرخي وروائيي المدينة هو أن تعيد تجديد نفسها كل قرن تقريبا. فخلال القرن الثامن عشر مثلاً كانت المدينة تعيش مرحلة عدم استقرار، وهي مرحلة استمرت لقرابة أربعة عقود، قبل أن يأتي أسعد باشا ويؤسس لمرحلة عمرانية وحضرية جديدة في داخلها، والشيء ذاته هو ما عرفته المدينة في القرن التاسع عشر، بعد مذابح 1860، فوفقا لكتاب يوجين الأخير «أحداث دمشق: مذبحة 1860 ونهاية العالم العثماني القديم»، فإن هذه المدينة شهدت امتدادات حضرية واقتصادية كبيرة بعيد المذبحة التي وقعت فيها، ما خلق أجواء جديدة للتعايش في داخلها.
وفي سياق تحليله للأسباب التي جعلت المسيحيين الدمشقيين يعودون للدفاع عن المدينة بعد 15 سنة من وقوع المذبحة، يعتقد روغان أن الأمر يعود لسياسات الموظفين العثمانيين، الذين حاولوا التركيز على تجديد عمران المدينة، وعلى تحويلها مركزاً اقتصاديا لكل المدن المشرقية المحيطة بها، ما جعل أهلها ينزعون نحو الاستقرار، بعد عقد تقريبا أكثر من وقوع مجزرة طائفية. وبالتالي فإن تجربة القرن التاسع عشر، التي تبدو قريبة بعض الشيء من ناحية رمزيتها بواقع المدينة في السنوات الأخيرة، تؤكد أن نمو المدينة وعودتها للحياة مرتبط قبل كل شيء بالسياسات الحضرية والاقتصادية والثقافية، التي ستعتمدها الدولة حيالها. وربما هنا هو مربط الفرس كما يقال، فالمدينة صحيح أنها تخلصت من حكم الأسدين، لكنها في المقابل تبدو أيضا قلقة من مستقبلها، في ظل النظام الجديد (ذي الخلفية الإسلامية). فالحديث اليومي عن مدينة دمشق بوصفها مدينة الأمويين، يوحي أحياناً، وكأن هناك أيضاً محاولة لفرض أيديولوجية معينة على المدينة وأهلها، خاصة أن هذه الإحساس يترافق يومياً مع مظاهر عديدة تتعلق بمحاولات هذه الأطراف المنتصرة فرض رؤية دينية معينة، مخالفة لرؤية المدينة، على أهلها، باسم الحشمة والدين، أو القول مثلا إن مدينة دمشق هي مدينة العلماء، أو اختصارها مثلاً بمشهد جوامعها، وكأن أهلها لا يفعلون شيئا سوى تأدية الصلوات والنوم، ولذلك لم يعد خافياً على أحد، أن السلطة الجديدة، ذات الخلفية السلفية في قواعدها، تبدو أحياناً وكأنها تنزع إلى خلق صورة جديدة عن المدينة، بوصفها مدينة تاريخية تعيش نهضة إسلامية جديدة، دون أن تراعي هذه الصورة في المقابل، أن المدينة وإن بقيت محافظة في سماتها العامة، لكن أهلها في المقابل لم يأنسوا ويلتزموا في زواياهم الصوفية فقط، بل عاشوا أيضا حياتهم اليومية، وهي حياة لم تكن تخلو من التسلية والترفيه والغناء والموسيقى.
فالدمشقيون وإن بقوا محافظين في بعض جوانب حياتهم، إلا أنهم في المقابل ظلوا أقرب ما يكون لما يسميه آصف بيات (سوسيولوجيا المرح) في حياتهم اليومية، وهذا ربما ما ميز الإسلام الشامي عموماً، عن أشكال أخرى من التدين الذي عرفته بعض البلدان العربية، وحتى الإسلامية، كما في إيران الخمينية، الذي يصفه بيات أيضا بـ»الإسلام الحزين». وربما هذا التركيز على إسلام المرح، بمعنى المنفتح على الحياة اليومية وتطوراتها، بدلاً من تخيل واعتماد صور معينة من الماضي فقط، واستعادة التأكيد عليه ضروري، رغم كل المشاق التي تعانيها المدينة، كون هذا الإسلام يتيح للمدينة نوعا من الحيوية والانفتاح بين أهلها، وأيضا في محيطها، خاصة في هذه الظروف التي تحتاج فيها سوريا لمزيد من الانفتاح والحوار وعدم التعصب بين طوائفها. كما أن استعادة تاريخ هذا الإسلام اليومي قد يكون بمثابة فرصة جيدة لخلق مخيال جديد لدى قسم كبير من الشباب ذوي الخلفيات الدينية، الذين يعتقدون أن فرض بعض مظاهر التدين كفيلة بنهوض المدن، بينما تكشف لنا مثلاً تجربة المدينة وتاريخها، أن التدين فيها لم يفرض بالقوة، وإنما هو وليد نهضة معرفية وعلمية، ومئات الزوايا والمراكز العلمية، وأنه حتى النهوض السني الذي عرفته المدينة في القرن الثاني عشر ولاحقاً، لم يكن نهوضاً قائما على السيف، بل ولد نتيجة الاهتمام بالعلم والمدارس المعرفية، وليس الفقهية فقط.
استمرار الدين وصونه في المدينة، لم يحدث فقط بسبب فرضه من قبل سلطة ما، بل لأن الدمشقيين ظلوا يتعاملون مع الدين من زاوية رحبة، وبقوا يحاولون أقلمة الدين في كل فترة ليتناسب مع مستجدات العصر، وربما هذا ما جعل المدينة تعيش دعوات إصلاحية للإسلام موازية وعميقة لما كان يجري في القاهرة مع الأفغاني والإمام عبده، إن لم يكن قد سبقها بالأساس، إذ يلاحظ ديفيد كومنز في كتابه عن «الإصلاح الديني السوري»، أن مدينة دمشق قد سبقت الإصلاحيين المصريين على صعيد السؤال الإصلاحي الإسلامي، فمع استقرار الأمير عبد القادر الجزائري في ربوة دمشق عام 1855، أبدى الدمشقيون انفتاحاً على أفكار هذا الرجل، الذي كتب في مقالة بعنوان: «ذكرى العاقل وتنبيه الغافل»، أن على الناس أن يتأكدوا من الحقيقة بممارسة العقل، وليس بقول رأي السلطة. وعاد وأكد لاحقا ضرورة تمسك المتصوفة بالقرآن مهما كانت معرفتهم الخفية عميقة، وأن الصوفي الحق هو الذي يتمسك بدقة أكبر بالقرآن. ترافق هذا التأثر أيضا بظهور طبقة جديدة من العلماء ذات الإرث الاجتماعي التقليدي مثل (عائلة البيطار، عائلة النقشبندية)، أو من خلال عائلات جديدة (القاسمي) وبالأخص مع حفيدها جمال الدين القاسمي، الذي أسس لأول حلقة إصلاحية إسلامية في مدينة دمشق داخل جامع العنابة، قبل أن يقوم العلماء التقليديون بتحريض السلطة على هذه الحلقة، في ما عرف بحادثة المجتهدين عام 1896، مما أجبر القاسمي على اعتماد خطاب أكثر تقليدية. وبالتالي نرى في هذه الحادثة وغيرها من الحوادث، أن الإصلاح الإسلامي والتجديد لا يكون من خلال السلطة بالضرورة، وإنما من خلال فسح المجال للناس للتعبير والنظر في علاقتهم بالدين، وهو ما يصون الدين ومكانته، ويجعله دوما أحد مصادر الأخلاق الأساسية.
ولعلي أختتم كلامي هذا عن الإسلام اليومي في مدينة دمشق بصورتين، نقلتهما لنا بعض كتب التاريخ والمذكرات، التي تظهر لنا صورة الإسلام اليومي الذي عرفته المدينة في الثلاثة القرون الأخيرة. الأولى نراها في رسالة كتبها الشيخ عبد الغني النابلسي في القرن الثامن عشر بعنوان «إيضاح الدلالات في سماع الآلات» بين فيها أن السماع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: منه ما هو حرام محض. وهو لأكثر الناس من الشباب ومن غلبت عليهم لذاتهم وشهواتهم وملكهم حب الدنيا. ومنها ما هو مباح. وهو لمن لا حظّ له منه إلا التلذذ بالصوت الحسن واستدعاء السرور والفرح، أو يذكر به غائباً وميتاً فيستثير به حزنه ويستريح بما يسمعه، وهو ما يظهر أن الإسلام الدمشقي بقي إسلاماً منفتحاً على الحياة، ومتطلبات الإنسان المتعلقة بالترويح عن النفس. أما الصورة الثانية فينقلها لنا التاجر الشامي أبو راتب الشلاح عن دمشق الخمسينيات، إذ يذكر أن تجار دمشق اعتادوا بعد صلاة الجمعة أن يحولوا بعض منابر الجوامع إلى منصة للحديث عن أحوال السوق، وتنظيمه والمشاكل التي يعاني منها وكيفية إصلاحها، وبالتالي نرى أن الإسلام الدمشقي ولفترة قريبة كان إسلاما حيويا، يرى في الدين مدخلاً لتهذيب النفس من ناحية، لكن هذا التهذيب والتدين لم يعن بالنسبة لهم انقطاعاً عن الحياة ومباهجها، وإنما انفتاح عليها، وعلى أمور الدنيا والسوق والترفيه، وحتى اللباس والموضة، التي يقول فيها رشيد رضا، «إن الإسلام لم يشرع للناس لباسا خاصا ولم يحظر عليهم زيا من الأزياء، فلكل فرد ولكل صنف أن يلبس ما أحب واختار»، فالتقوى إذن إحساس فرداني في أحد جوانبه، وحتى لو كان مشروعاً جماعياً، فإنه يبقى مرتبطا بالإرادة بالنفس، ودون ذلك يتحول أي مشروع تقوي إلى مشروع سلطوي، ونعوذ بالله من أن تعيش دمشق هذا السيناريو مرة أخرى، لأن في ذلك ضياع للدين والدنيا، ولأرواح مئات الآلاف ممن سعوا للحرية أولاً وأخيراً.
كاتب سوري