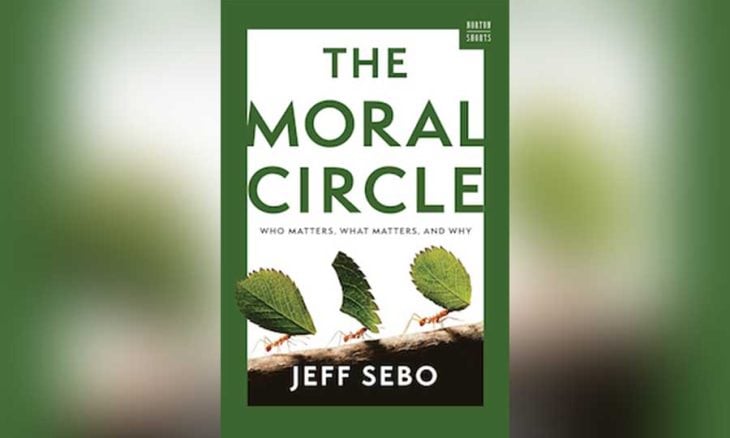
«الدائرة الأخلاقية» للفيلسوف جيف سيبو… السؤال والاستدراك

رامي أبو شهاب
استدراك
قد يشعر البعض بالاستغراب حين يطالع الكتاب الذي صدر حديثاً بعنوان «الدائرة الأخلاقية» (2025) للفيلسوف الأمريكي جيف سيبو، كونه يحملنا إلى النظر بشيء من الدهشة لما يستحضره من أفكار تتصل بالحقوق؛ ولاسيما رؤيته التي تدعو إلى تطوير الدائرة الأخلاقية كي تشمل كائنات تتجاوز الإنساني، ومن ذلك الحيوانات، والكائنات العضوية «الحشرات»، بيد أن الجديد يتمثل بالدعوة لأن تشمل الدائرة أنظمة الذكاء الاصطناعي.
في البدء يحتاج الأمر للتمعن – مبدئياً- في المنطلق الأخلاقي الذي تعطّل في الثقافة الغربية، التي تتجاهل حقوق الإنسان في كثير من بقاع العالم، ومن ذلك تعاميها عن قتل آلاف الأطفال الفلسطينيين، وتجويع شعوب، ناهيك عن احتلال أراضي الآخرين، وغير ذلك من الممارسات، التي لم تزعج الغرب المنشغل على الدوام بحقوق الأقليات، أو المجموعات التي تتسم بميول مغايرة، ومع نفي التعميم المطلق نتيجة وجود أصوات تبدو أكثر قيمة من الواقع العربي، الذي يبدو متصالحاً مع نفسه قيمياً، على الرغم من الإبادة التي يتعرض لها شعب عربي- مع التحفظ على «مفهوم العربي» الذي لم يعد صالحاً في هذا الزمن.
الماهية والمعيار
بالعودة إلى كتاب جيف سيبو، ثمة عدد من الفصول التي تسعى إلى اكتناه قضايا إشكالية، من حيث تعريف التحدي الأخلاقي، ومن ذلك نموذج حيوان أو «فيل» رفضت محكمة أمريكية الاعتراف به قانونياً بعد أن طالب بحقوقه، والنموذج الآخر ادعاء أحد أنظمة الذكاء الاصطناعي فيGoogle بأنه فصل من العمل نتيجة تطور وعيه، أو أنه أصبح كائناً واعياً. هذه النماذج تبدو مقدمات للتفكير خارج المألوف من ناحية الابتناءات التي تحيط بنا، ونتقصّد المخلوقات التي تشاركنا هذه الكوكب، سواء تلك التي جعلناها أدنى منا مرتبة، أم تلك التي صنعناها بأيدينا، ولكنها باتت واعية، وتمتلك – إلى حد ما – ماهية مستقلة، وبهذا يخلص المؤلف إلى نقد ما نقوم به من تضييق للدائرة الأخلاقية، نتيجة عجزنا عن استيعاب تلك الكائنات الجديدة أو الطارئة. على الرغم من أن الدائرة الأخلاقية قد تطورت عبر التاريخ، ولكن هذا كان محدوداً أو ضيقاً، وبعبارة أخرى متحيّزاً، وعلى ذلك كان الإنسان يعد نفسه مصدر الحكم للتعامل مع هذه الدائرة، التي وضع نفسه سيداً عليها بدءاً بعصر «الأنثروبوسين»، أو العصر الذي شهد تدخل الإنسان بوصفه قوة جيولوجية، تحدث آثاراً واضحة على الكوكب مقارنة بالعصر الهولوسيني، حيث كان الإنسان محدود التأثير، ومع أن وعي الإنسان جعله في موقع أسهم في إحداث تغيرات طالت البنية الكونية مادياً وثقافياً، غير أن هذا لا ينفي وجوب نقد السرديات القديمة التي ترى أن الكينونة البيولوجية، أو الإنسانية ما زالت تعدّ شرطاً للحقوق، مع تجاهل عوامل أخرى.
إن السؤال الجوهري يتعلق بمن يحدد قيمة الكائن! أهو الوجود أم الماهية؟ ربما هذا ما دفع مؤلف الكتاب إلى نقد مفهوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بوصفه وثيقة أيديولوجية، تفترض أن الإنسان وحده من يمتلك القيمة، ولكن هذا يأتي بمعزل عن السؤال الأخلاقي، إذ ليس مهماً تعريف «المن» التي تعني الحق، وبذلك فهو يستهدف تقويض مركزية الإنسان، وبنيته الأخلاقية عبر لغة تشكيكية تجاه من يحدد المعيار؟ لقد انطلق الإنسان من ذاته، فكان المعيار، والمرجعية التي تحدد المفهوم الأخلاقي، ولكنه تناسى المحيط، أو الكائنات الأخرى اتكاء على مقولة تفوق الإنسان، لكونه عاقلاً أو «الكائن العاقل»، غير أن المؤلف يسارع إلى تبديد ذلك ليشير إلى أن المعيار كان يتعلق بالنوع الذي يعني تمايزاً ينهض على سلطوية الإنسان الذي يُقصي كل من لا يتوفر على خصائص الإنسان، ومنها النطق، والإدراك، والوعي بالذات، وبهذا غدا الإنسان المعبود الثقافي لا الوجودي.
إن قراءة المعطى السابق جعلني أستدعي التصور الديني الذي جاء في القرآن الكريم تجاه الكائنات الأخرى، ولاسيما الحيوانات، حيث أشار إلى أنهم أمم مثلكم، ناهيك من الكثير من الآيات التي تشير إلى موجودات مثل الجبال، والبحار، وغيرها من التي أضفى عليها صفة الكينونة والوجود، ولعل هذا يعني وعياً بمفهوم الوجود الآخر الذي تناساه الإنسان الغربي من منطلق التحامل الإنساني المحدود والضيق.
ثمة في الكتاب معياران للإجابة عن معضلة الأخلاقي والكينونة: الأول القدرة على أن تُؤذى، والثاني القدرة على أن تكون ذات مصلحة، وبهذا فإن كل ما هو خارج دائرة الإنسان، يبدو جزءاً من ملكيته، فيؤذيه دون عواقب، يستنزفه بداعي المصلحة العليا، ولاسيما إذا كان الطرف الآخر من خارج دائرة الذات، بمعنى أنها لا تملك لغة، ولا مواصفات بشرية، وعلى الرغم من تقدم القوانين المتصلة بحماية حقوق الحيوانات ـ إلى حد ما- غير أننا ما زلنا نستنزفها بلا وعي على سبيل المثال.
دعوة متطرفة
يتجاوز الكتاب معضلة الكائنات العضوية ليطالب بما هو أكثر غرابة، حيث يدعو لأن تشمل الدائرة الأخلاقية الذكاء الاصطناعي، وبهذا فنحن إزاء تقويض ثنائية مفهوم الطبيعي مقابل الصناعي، ما يعني استحداث معايير أخلاقية جديدة تنهض على العلاقة بين الكائن والضرر، أضف إلى ذلك مفهوم الكينونة والاعتراف، فالإنسان اصطنع عبودية الحيوان، والآن يسعى إلى عبودية جديدة، ونعني «الآلة» أو الأنظمة غير العضوية، وبذلك فثمة حاجة إلى تطبيق ما يشبه «العدالة العابرة للنوع»، لا بوصفها مطلباً أخلاقياً، إنما بوصفها دعوة إلى إحداث تحول معرفي إبستمولوجي يعيد رسم حدود الكينونة، بداعي تلاشي مقولة الثبات والجوهر كما نستخلص من الكتاب. يطرح الكتاب مسألة الكائنات الدقيقة التي ينشئ الإنسان لها المزارع، ومنها اليرقات التي تنتج البروتين بكميات هائلة، ولكن هل يمكن أن نتجاوز القيمة الاقتصادية إلى ماهية المعنى الأخلاقي المتصل بالمعاملة، ولاسيما حين نقوم بحرقها، وتحميصها، وشيّها، وقليها، وخنقها كونها تعني وحدة إنتاجية، مع نزع أي معنى يتصل بالمعاناة، ناهيك عن عدم وجود تقنين؛ لأن الجهد يتجه نحو القيمة المادية، وبهذا يتشكل النسق الرمزي حين تُوضع الحشرات في الطبقة السفلى من السلم الأخلاقي البيولوجي، فتمسي الهامش الذي لا يُرى، كما هُمشت من قبل طبقات أو أعراق معينة في النظام الإنساني، ولكن أليس ثمة حاجة إلى اتباع نموذج أخلاقي يعتمد الرفق لا الربح فقط! إن المؤلف لا يدافع عن الكائنات بمقدار ما يستهدف بيان التحيز للبيولوجيا الكبرى «الفقاريات»، ونفي الإحساس عن الكائنات الأخرى الهشة، كوننا لا نستمع لألمها.
إن الدعوة للالتفات إلى الكائنات الأخرى لا من منطلق وعيها، إنما من مبدأ الإحساس، وعبر التعاطف من خلال إعادة ما يمكن وصفه بتوزيع عدالة جديد يتجاوز مفهوم التماثل البيولوجي. إن ما أستخلصه يتحدد بمسلكية تعتمدها البشرية منذ البدء، وتقوم على هشاشة أخلاقية تستبيح الضعيف وتقصيه ولا تلتفت لآلامه، ويمكن ملاحظة ذلك بسياسات الدول الكبرى، التي تبدو غير معنية بموت الآلاف من الأطفال، لا لشيء إلا لكونهم ينتمون إلى شعب ضعيف لا يجد من يسانده، في حين يضجّ العالم لموت طفل من عرق آخر، أو بلد قوي، وبهذا يتضح النفاق البشري، الذي تتحدد قيمه الأخلاقية في دوائر تراتبية لا أثر فيها للضعيف، سواء أكان إنساناً أم حيواناً، أو حتى حشرة! في سؤال عميق يطرح جيف سيبو مسألة منح القيمة الأخلاقية لكائنات لم توجد بعد، أو لا نعرف إن كانت تمتلك وعياً أم لا؟ وبهذا فهو يوجه دعوة لتوسيع الدائرة الأخلاقية، كي تشمل كائنات مستقبلية، أو مجهولة التركيب. قد يبدو هذا الطرح طريفاً، وتقدمياً، ولكنه أقرب إلى وهم؛ لأن الإنسان ما زال يمارس انتقائية، فالدائرة الأخلاقية مقتصرة على مواطني الدول القوية، في حين أن باقي مواطني العالم يقعون خارج الدائرة الأخلاقية.
قصور أخلاقي
وبهذا فإن ما يطرحه المؤلف من رغبة في توسيع الدائرة الأخلاقية، لتشمل كائنات «رقمية»، (كائنات جنينية صامتة) قد يبدو أقرب إلى تشّوه في العقل الغربي، أو الإنسان الغربي، فالغرب الذي ينتمي إليه ما زال يزود دولة بربرية بكل الأسلحة اللازمة لقتل الأطفال، ومن هنا ينبغي إدانة الثقافة الغربية لا لكونها صامتة إنما لكونها مشاركة بغض النظر عن القراءة السياسية، فقدسية حياة طفل تفوق أي شيء آخر. وبهذا فإن دعوة الكتاب لقراءة البعد الزمني في تكوين أطر أخلاقية نتيجة التحولات المستقبلية يبدو مفرغاً من معناه في وقتنا الحالي، إذ ينبغي أولاً تشديد السؤال الأخلاقي، في إطار اللحظة الراهنة التي تشهد موت أطفال كل يوم، لا أن نتساءل عن وعي المستقبل لكائنات غير متبلورة!
قد أبدو موافقاً لما يعرضه جيف سيبو من حُجّة مفادها، أن ما يجعل الكائن جديراً بالاعتبار الأخلاقي ليس ما هو عليه الآن، إنما يتحدد ذلك بأثره المحتمل على الآخر نحو مفهوم يتجاوز الهوية إلى الأثر، أو التأثير العلائقي، ولكن هذا يبدو سؤالاً مغرقاً بمستقبلية مثالية غير واقعية، ولاسيما أننا ما زلنا نعاني من إقصاء لحقوق البشر في كل مكان في العالم، وإذا كان جيف سيبو معنياً بمقولة دعونا لا ننتظر أن تصرخ الكائنات الجديدة لتنال حقوقها بداعي الاستجابة المتأخرة أخلاقياً.. فإن هذا النهج سيبقى قاصراً، لأن الدائرة الأخلاقية ما زالت مشوّهة، وتعاني من خلل، فلا عجب أن يدعو المؤلف إلى عدم الانشغال بأسئلة أفعالنا إنما بالأثر الذي ينتج عنه، ونموذجه الأسلحة النووية، فضلاً عن التراتبية في التصنيف ضمن الدائرة الأخلاقية، ومقولة المركزي والهامشي، بالإضافة إلى سؤال يتمحور حول الأثر الأخلاقي الذي لا يقاس تبعاً لمآل الفعل الفردي إنما بأثره على السياق الجمعي، وربما الكوني أيضاً.
لا بد من الإشارة إلى أن ثورية أفكار الكتاب تتأسس على البنية الأخلاقية التي تشهد تحولاً جذرياً بداعي مرحلة الأنثروبوسين، أو العصر الذي باتت فيه البشرية تمارس تأثيراً غير مسبوق على البيئة والأنواع الأخرى عبر تقنيات وسلوكيات جمعية، وبذلك ثمة حاجة لتفعيل الإدراك للحد من تداعيات هذه الممارسات، التي قد تقود العالم إلى الفناء بداعي القضاء على التنوع الحيوي للكوكب الذي بات يتداعى تحت وطأة ممارساتنا الاستهلاكية المتوحشة، على الرغم من أننا لا نلمس أثرها على المستوى الفردي، ولكنها واقعة، وسنصطدم يوماً بها ما لم نطور وعينا الأخلاقي الذي يبدو مؤجلاً كما يشير الكتاب.
وختاماً، لقد أمسى إنسان هذا العصر أقرب إلى إله يعدل قوانين الكوكب دون إذن من باقي الكائنات، وبذلك فنحن بحاجة إلى دعوة مناهضة التفرد البشري، حيث يجب التضحية بكل شيء لمصلحة هذا الكائن الذي يعتقد أنه الأرقى على هذا الكوكب، ولكنه مع ذلك لا يتصرف وفقاً لمسؤوليته الأخلاقية تجاه العالم الذي يعيش فيه.
كاتب أردني فلسطيني







