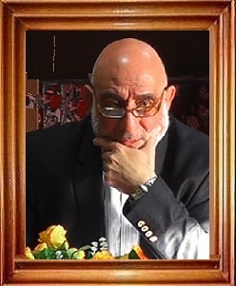النقد الأدبي والتعدد الاختصاصي

نادية هناوي
ذهبت الدراسات الثقافية مذاهب شتى في توجيه النقد الأدبي وجهات متباينة، جعلته يبدو في كثير من الأحيان غير واضح الهوية، ولا محدد المآلات، حتى ضاعت حدوده، ولم تعد بوصلته تشير إلى حقيقة وظيفته الجمالية، خاصة حين تغافل عن المنهجية واستعاض بالثقافية عن العلمية، وصار معنيا بمجالات بعيدة عنه، ما كان يُعنى بها من قبل، أو كان يتناولها لكن بشكل غير مباشر وعرضي. وهذا كله جعل الصورة العمومية للثقافة والنزعة اللامنهجية غالبتين عليه.
ومعلوم أن اللامنهجية هي عدو النقد الأدبي، لاسيما الحداثي، فالنقد حقل معرفي عماده العلمية المخطط لها بموضوعية وأدواته قائمة على جهاز مفاهيمي واصطلاحي واضح. ولا شك في أن حلول الثقافية محل المنهجية أزال أي فارق نظري أو إجرائي بين النقد والثقافة، وجعل النقد كالثقافة بلا تعريف أو تحديد، وهو الذي كان يتحلى في السابق بميسم أدبي حديّ ونزعة علمية تخصصية ما كانت تفارق وظائفه الجمالية.
بيد أن اتساع نطاق الدراسات متعددة التخصصات في الآونة الأخيرة فتح أمام النقد الأدبي آفاقا جديدة كي يستعيد صورته الحقة من جانب، ويستطيع من جانب آخر تطوير نفسه من خلال الجمع بين النهجين الجمالي والعلمي؛ فالنهج الجمالي لوحده لا يجعل النقد الأدبي مواكبا التقدم والتطور التقنيين، كما أن النهج العلمي غير كاف لأن يخلصه من التخندق عند مسائل لا يمكن للنقد معها أن يتوسع أو يتجدد. وإذا كانت البنيوية في انغلاقها، وما بعد البنيوية في انفتاحها قد أوصلتا النقد الأدبي إلى هذا المسار الثقافي، فإن نظريات التعدد الاختصاصي والتنوع الثقافي وعلوم الفريق، تحاول أن تعيد للنقد الأدبي هويته، وتلملم تشظيات جهازه المفاهيمي، من خلال أطر تعددية تجمع العلم بالنظرية ثم النظرية بالممارسة والشكل بالموضوع لا بقصد التحديد النصي، بل التنوع المعرفي المحدد بالمنهج والمؤطر بالعلم. فدورة المعرفة هي كدورة الحياة تنتهي عند النقطة التي تبدأ منها، والجديد بالضرورة سيترسخ ويصير معتادا ومن ثم يكون التحديث أمرا واجبا.
وما بين التوسيع والتجديد قطع دراسات التعدد الاختصاصي خطوات مهمة في اتجاه تجديد النقد الأدبي، ليس لأنها استطاعت أن تفصله عن الدراسات الثقافية، وليس لأن هذه الدراسات لا تريد هي أن تكون بديلا عن النقد الأدبي، بل أيضا أن التعدد الاختصاصي منح الدراسات الثقافية مزيدا من الاستقلال وجعلها فرعا معرفيا انبثق جنبا إلى جنب فروع معرفية أخرى كالدراسات النسوية والدراسات البيئية والدراسات المعرفية والدراسات الرقمية ودراسات ما بعد الإنسانية ودراسات المستقبلية ودراسات ما بعد التاريخانية وغيرها.
وبطبيعة الحال يرتهن التجديد بمقدار قوة الفاعلية التعددية، التي يتبناها نقاد الأدب في التحشيد البحثي كمشاريع ومخابر وفرق بحثية. وهذا أمر يتطلب دعما وإمكانيات توفر للنقد أجواء صالحة للدراسة والتحليل والتجريب. وهذا ما تمتعت به المدرسة الأنكلوأمريكية، من خلال تنوع الدراسات واستقلالها اولا، وكثرة المشاريع والبرامج البحثية والتدريبية ثانيا، واعتماد اللغة الإنكليزية من لدن النقاد والمنظرين المنتمين إلى جنسيات وأعراق مختلفة ثالثا.
ويمكن تأكيد ذلك بصورة أوثق بما قدمه المفكرون من طروحات فلسفية، وجهوا من خلالها العقل والطبيعة البشرية والحضارة، والعلم وجهة تخدم مصالح من هو غالب ومتقدم عالميا.
ومقصد الأنكلوأمريكيين هو الإضافة والتمايز عما هو معروف من مدارس النقد كالمدرسة الشكلانية الروسية والمدرسة الكلاسيكية الأنكلوسكسونية والمدرسة البنيوية الفرانكفونية ومدرسة فرانكفورت الألسنية وغيرها. وقد لا نغالي إذا قلنا إن المدرسة الأنكلوأمريكية ما سعت إلى التعدد الاختصاصي، إلا لأجل أن تقوِّض منجزات المدارس التي سبقتها كي تبني بدلها ما يؤكد تفردها. والدليل على ذلك هذه الرغبة العارمة لدى هذه المدرسة، في أن تتخذ من هفوات ونواقص تلك المنجزات طريقا لبناء نظريات وتصورات جديدة ومغايرة. ولا غرابة في الأمر فلطالما تنافس العالم المتقدم على التفوق والهيمنة.
ويمكن تأكيد ذلك بصورة أوثق بما قدمه المفكرون من طروحات فلسفية، وجهوا من خلالها العقل والطبيعة البشرية والحضارة، والعلم وجهة تخدم مصالح من هو غالب ومتقدم عالميا. فحين كانت الغلبة في العصر الحديث لأوروبا كتب الفلاسفة طروحات تدعم هذه الغلبة، ففردريك هيغل رسخ مقولتي الإنسان والتاريخ، وكرّس ماركس فكرة أيديولوجيا الطبقة ورأس المال، وتبنى رينان وغيره نظرية الاستشراق ووضع إيمانويل كانط أطروحة العقل المحض وملكة الحكم والعقل العملي، وأسس نيتشه لفكرة الإنسان المتفوق، وحين انتقلت الغلبة إلى الولايات المتحدة كتب المفكرون الأمريكيون وغير الأمريكيين طروحات مضادة تقوض فلسفيا الأطروحات الأوروبية حول الواقع والعقل والاستشراق والأيديولوجيا والحضارة والتاريخ والإنسان وغيرها.
إن هذا التنافس الحضاري له مبرراته التي معها يستقيم ميزان القوى في ما بينها، وأهم تلك المبررات رغبة الإنسان في أن ينفرد لوحده، وأن يكون الغالب هو الأقوى كأمر طبيعي وضروري، وأن له يهيمن على كل مجال من مجالات الحياة المختلفة. والنقد الأدبي واحد منها. وليست فكرة التعدد الاختصاصي والتنوع الثقافي بالمخالفة لتلك الرغبة، إنما هي تؤكدها من خلال جعل هذا الجمع كله موجه لغة واستراتيجيات لصالح هذه المدرسة.
ومن هنا توجه كثير من مفكري ما بعد الحداثة إلى اتباع طريق التعدد الاختصاصي، ومنهم فوكاياما الذي رأى في كتابه (مستقبلنا ما بعد البشري) أن العالم كله يقوم على التعدد، وأن التعدد (ظاهرة بشرية بحتة في الواقع. إنها مركزية بصورة ما لما يعنيه كوننا بشرا.. هناك ركيزة بايولوجية لرغبة البشر في أن يُعترف بهم، موجودة في عدد من الأنواع الحيوانية الأخرى فأفراد العديد من الأنواع الحية تصنف نفسها في تسلسلات هرمية للسيادة) وهو بهذا القول يؤكد فكرة أن الكائنات الحية تتشارك لكنها تتمايز في ما تتشارك فيه كقانون حيوي وعام، ينطبق على كل ما هو حضاري وغير حضاري. وهو ما نراه يبرر شريعة الغاب التي تتبعها الأقطاب المهيمنة على العالم من منطلق أن الغلبة قانون يسود عالم الحيوان والنبات وكذلك البشر لكن بطرز ونوعيات مختلفة.
وإذ تتبنى المدرسة الأنكلوأمريكية التعدد الاختصاصي في العلوم الإنسانية، فإن النقد الأدبي يغدو ساحة مهمة وواسعة للتنظير الفكري وتأكيد الهيمنة. ومن ذلك مثلا التنظير لما بعد الإنسانية كنزعة نقدية بايونفسية، يتلاقى فيها النقد الأدبي مع العلوم الإنسانية عامة وعلم النفس خاصة على اختلاف فروعه وتنوع مدارسه. ولا خلاف في أن تلاقي النقد الأدبي بعلم النفس مرَّ بثلاث مراحل: الأولى/ سياقية، وفيها كانت المفاهيم النفسية أو النفسانية كالذات والشخصية والسلوك والذهان والعبقرية والتداعي وغيرها قد شكلت المنهج النفسي، والمرحلة الثانية/ انفتاحية وفيها تجاوزت الدراسات النص والسياق واتجهت صوب البينية في دراسة السرد النفسي، والمرحلة الثالثة/ ما بعد كلاسيكية، وهي المرحلة النقدية الراهنة، وفيها قامت الدراسات متعددة التخصصات على توسيع نطاق الجمع بين علوم متعددة إنسانية وصرفة.