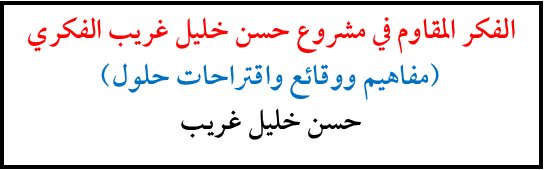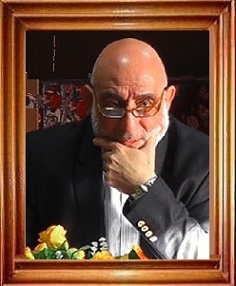العمل الشعبي مرتكز التحرر والبناء

العمل الشعبي مرتكز التحرر والبناء
إن الخراب المجتمعي والسياسي والنخبوي الحاصل عميق، وهو بات يشكل عقبة خطيرة أمام محاولات إعادة ترميم الأدوات السياسية والهيئات التمثيلية التي تآكلت كثيرا، تنظيميا وسياسيا وأخلاقيا.
منذ حرب الإبادة، ومؤخرا، ينشغل بوتيرة عالية فلسطينيون؛ أكاديميون، مثقفون، نشطاء، وأطر عمل مدني، من داخل الخط الأخضر، في محاولات للإجابة عن السؤال – المعضلة عن خيارات الفلسطينيين الذين يعيشون تحت المواطنة الإسرائيلية، بعد كل هذه المتغيرات المرعبة في بنية وطبيعة الصراع مع الصهيونية وأيدولوجيتها الاستئصالية، وفي ظل الانقلابات العربية والإقليمية والدولية، وعقد التحالفات الأمنية بين إسرائيل وأنظمة عربية، وتأثير كل ذلك عليهم.
هل يشبه وضعنا، أي فلسطينيي 48، الوضع الذي ساد بعد توقيع اتفاقية أوسلو عام 1993، الذي استسلمت فيه قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وأخرجتنا من الصراع ومن تعريفنا كجزء من الشعب الفلسطيني، أم أنه لا يقاس من حيث الخطورة والتردي. وهل الرد الذي قدمته آنذاك نخبنا وأحزابنا وحركاتنا الوطنية في مواجهة تبعات أوسلو بخصوص خياراتنا السياسية وموقعنا في الصراع وآمالنا الوطنية، يمكن أن يكون ملهما لتصوراتنا للمرحلة الحالية، وكان في حينه شعار المواطنة المتساوية كمطلب أو كتحد سقفا لمعظم الأحزاب. وكيف يمكن تحرير ذهنية الانكماش والسكون التي ولدتها حملة الترهيب النوعية بحق القادة والنشطاء والمواطنين في الأعوام الاخيرة، وتفاقمت بعد إطلاق حرب الإبادة ضد شعبنا.
من الواضح أنّ توفر الجواب على هذه الأسئلة ليس وشيكا، بل على الأرجح سيستغرق وقتا وجهدا فكريا وتنظيميا وعمليا خاصا، خصوصا وأننا أمام واقع اجتماعي تغلغلت فيه الآثار الاجتماعية والسياسية السلبية، سواء تلك الناجمة عن القمع المباشر أو الجريمة المنظمة، أو النيوليبرالية الاقتصادية، أي أننا بصدد تحولات بنيوية لا تزول أو تزال في وقت قصير أو من دون إستراتيجية بعيدة الأمد، والأهم من دون توفر إرادة حقيقية. وهذا بالضبط ما يجعل الانخراط في الجهد واجبا أخلاقيا، وضرورة وجودية، إذ إن استطالة الأزمة ستولد مزيد من الخراب الاجتماعي والأخلاقي.
إن الخراب المجتمعي والسياسي والنخبوي الحاصل عميق، وهو بات يشكل عقبة خطيرة أمام محاولات إعادة ترميم الأدوات السياسية والهيئات التمثيلية التي تآكلت كثيرا، تنظيميا وسياسيا وأخلاقيا. وأحد مظاهر العطب السياسي والأخلاقي المتراكم، هو سعي بعض هذه النخب السياسية والأكاديمية إلى اختزال الأزمة في التصويت أو عدم التصويت، والتعويل على الصناديق اليهودية – الصهيونية الأميركية “الليبرالية” لرفع نسبة التصويت بهدف إسقاط حكومة نتنياهو وجلب حكومة تبيض وجه إسرائيل، “دولة يهودية ديمقراطية”، تكون متاحة لدخول أحزاب عربية فيها، وليس لخلق فرصة تُمكّن الفلسطينيين من مجابهة الأيديولوجية العنصرية الاستئصالية والحفاظ على الذات القومية الجمعية، وتحقيق العدالة والمساواة.
من مرحلة البقاء مرورا بالمواطنة والهوية إلى التساؤل حول المواطنة
بعد النكبة عام 1948، لم يكن واقع الناجين من التطهير العرقي، وتشريد ذويهم خارج الوطن، من حيث العدد والقدرات الفردية والجماعية، يسمح بالتفكير في المشاركة في النضال الفلسطيني العام؛ كان كل همهم البقاء وانتظار الفرج من الخارج. لقد تم طرد جلّ النخب السياسية والمثقفة الفلسطينية إلى خارج الوطن، واعتُمدت سياسات محو للهوية الوطنية عبر مناهج التعليم، وتدمير البنية الاقتصادية – الاجتماعية التي استندت إليها حياتهم قبل النكبة. كما جرى تدمير مدينتهم، واحتجاز نهوضهم وتطورهم الثقافي والتعليمي والسياسي لفترة طويلة. وبعد التحرر من الحكم العسكري واحتلال بقية فلسطين عام 1967، وما تلاها من ارتفاع لمستوى المعيشة، وبدء نشوء طبقة وسطى، بدأ العمل السياسي يشهد تطورا متسارعا، تمثل في بناء أطر وطنية جديدة، وحَراكات طلابية قوية في الجامعات، ومنتديات فكرية، وتجرؤ شعبي على تحدي سياسات إسرائيل ضدهم، تتوج في إعلان إضراب يوم الأرض التاريخي عام 1976.
اتسمت مرحلة ما بعد يوم الأرض بمسارين؛ مسار الاعتزاز بالهوية الوطنية الفلسطينية، ومسار تطور العلاقة مع المواطنة الإسرائيلية، باعتبارها ليست وسيلة البقاء كما كانت في المراحل الأولى من إقامة إسرائيل، بل نافذة لانتزاع الحقوق التي تشمل المواطنة في دولة ديمقراطية طبيعية. وهكذا تطورت خصوصية مركبة لهذا الجزء من شعب فلسطين بسبب عاملين أساسيين؛ الأول، هو غياب انتصار عربي وفلسطيني على إسرائيل، باعتبارها مشروعا استعماريا اقصائيا، والفشل في إعادة اللاجئين، ومرور سنوات طويلة من العيش والاعتماد على الاقتصاد الإسرائيلي، الذي كان هدفه أساسا خدمة المشروع الصهيوني والمجتمع اليهودي الاستيطاني. والثاني، تأسيس الاقتصاد الصهيوني على تجريد الفلاح الفلسطيني من أرضه ورزقه، ومنع تشكل أي شكل من أشكال الاعتماد العربي على الذات. وقد جرت مخططات وتطورات موضوعية لتحويل الأسرلة الاقتصادية إلى أسرلة ثقافية وسياسية، تنشد الولاء للدولة اليهودية.
وفي مواجهة إفرازات هذين التحدييّن، ومع انبعاث الوعي الوطني، نشأت حراكات وطنية ترفع شعار محاربة الأسرلة والمحافظة على الهوية الوطنية الفلسطينية. وبهذا تمكن الفلسطينيون من قطع أشواط كبيرة في حياتهم الجماعية، من حيث إعادة تكوين أنفسهم كجماعة قومية نجحت في بناء عدد من المؤسسات الحزبية والتمثيلية القطرية، الوطنية والمهنية، تضطلع بنضالهم. لقد استغلت النخب الانفتاح النسبي على الحريات الذي شهدته إسرائيل منذ السبعينيات، وثابرت على العمل على توسيع هامش العمل السياسي والثقافي والاقتصادي، مما ساهم في توطيد وجود فلسطينيي 48، والانتقال إلى مرحلة جديدة من تحدي منظومة القهر والتمييز، والمطالبة بالعدالة والمساواة الكاملة، المدنية والقومية الجماعية، وكذلك في الجهر في تأييد النضال الفلسطيني العام من أجل التحرر والعودة. بطبيعة الحال لم يكن هذا التطور والنهوض الوطني مُرضيا للمؤسسة الإسرائيلية، التي كانت أجهزتها الأمنية تُراقب وتُخطط، وتحتوي حينا وتقمع حينا آخر، بل تضخم هاجسها من الوجود الفلسطيني الصاعد، وخصوصا بعده الديمغرافي. وعندما بدأت تشعر بتآكل وسائل احتوائها وقمعها، راحت تبحث عن تحديث هذه الوسائل من خلال تمرير قوانين معادية جديدة. وربما تجلت المعضلة في مواجهة نهضة الفلسطينيين مواطنين دولة إسرائيل من قبل نظام الحكم، في كونهم التزموا النضال الشعبي والقانوني والبرلماني، ونجحوا في تطوير خطاب مواطنة عصري وإنساني، وهو ما يخالف أيديولوجية إسرائيل العنصرية التي تقوم على التفوق اليهودي واللامساواة والطرد. وهذا بحد ذاته كان في حينه مُحرجا لها كونها سوقت نفسها لعشرات السنين بأنها دولة ديمقراطية وفق نموذج الديمقراطيات الرأسمالية الغربية، التي توفر لها كل الدعم المطلوب.
مرحلة جديدة تضيق فيها منافذ العمل السياسي
يجد فلسطينيو 48 أنفسهم اليوم في وضع أسوأ بكثير مما كان عليه الوضع بعد اتفاق أوسلو. فإذا كان أوسلو بمثابة تخليا عنهم من قبل قيادة منظمة التحرير، فإن فريق أوسلو أضاف إلى ذلك تخليه عن فلسطينيي غزة، ليس وطنيا فحسب، بل إنسانيا. بل أكثر من ذلك، بل تخلى عن فلسطينيي الضفة الغربية الذين تركوا فريسة لهجمات عصابات المستوطنين والجيش. والمستجد الآخر، هو مزيد من الانهيار العربي المتمثل بالتخلي عن قضية فلسطين، والتواطؤ مع الإبادة، ونسج تحالفات أمنية مشينة مع إسرائيل، وتبديد ثروات الأمة على أسلحة بهدف حمايتها من شعوبها.
أما على الصعيد الداخلي للمجتمع الفلسطيني داخل الخط الأخضر، فقد بتنا أمام تحولات اجتماعية – اقتصادية، تحمل إفرازات النيوليبرالية والنزعة الفردانية الاستهلاكية، التي ساهمت في توسيع الطبقة الوسطى، ولكن دون أن يرافق ذلك نهوض وطني كما حصل في السبعينيات والتسعينيات، بل بالعكس، فإننا نشهد تفريغا سياسيا لشرائح من هذه الطبقة يقودها جناح في التيار الإسلامي في الداخل، انحدر إلى التحالف مع الصهيونية.
وهذا ما يميز حقبة اليوم عن الحقب السابقة، ولكن هناك أيضا متغير خطير في الساحة الإسرائيلية. إنه إسرائيل الجديدة، الدموية والمستهترة بالقوانين الدولية ومتنكرة لقوانينها الداخلية.
في أواسط التسعينيات كانت إسرائيل الجديدة، إسرائيل اليمينية الفاشية، لا تزال في بداية طريقها، وتعكف على إنضاج مخططها الاستئصالي، منتظرة الفرص. في حينه، كان لا يزال بمقدور فلسطينيي الداخل، حملة المواطنة الإسرائيلية، الذين أعيد لاحقا إدراجهم ضمن المخطط المذكور، تحمُّل التضييق والملاحقة ومواصلة تحدي المنظومة، وبناء أحزاب جديدة، تتحدى يهودية الدولة وأوسلو سوية، وخوض نضالات أيديولوجية وشعبية ومواجهات ضد مخططات المصادرة والهدم. لقد شكّل ظهور حزب التجمع الوطني الديمقراطي عام 1995، كحزب قومي ديمقراطي، في ظل الانهيارات الفلسطينية والعربية، والتسليم بالصهيونية، فعلا ثوريا ساهم في إحياء الحركة السياسية المتراجعة في الداخل، من خلال إطلاق فكر وطني – قومي مؤسس على فكرة الديمقراطية والعدالة والمساواة. في بدايات هذا الظهور، ظهر الأمر وكأنه سباحة ضد التيار، بل دفع البعض للسخرية من تأسيس حزب قومي في ظل انهيار المشاريع القومية في العالم العربي، ولكن لاحقا، تأكد للناس العاديين، وكذلك للخصوم السياسيين، أن إعادة بناء الحركة الوطنية، ذات التوجه القومي، كان عملا مدروسا ومفكرا به، وأن مشروعنا لم يكن مشروعا قوميا تقليديا، بل حركة وطنية أصيلة تجمع بين القومية والمواطنة الكاملة. وبالفعل، كان استغرق التفكير والتخطيط لإطلاق هذا المشروع الوطني أكثر من عامين قبل دخوله إلى ميدان العمل السياسي. وكان من ثمار ذلك دفع الأحزاب والحركات الوطنية والإسلامية الأخرى إلى استعادة عافيتها، من خلال التنافس والتدافع على تمثيل المصلحة الوطنية. ولا بد أن نذكر أنه في هذا الفضاء، الفكري والسياسي المتشكل حديثا، صدرت وثائق التصور المستقبلي، التي مثلت تطورا متقدما عما ساد من طروحات في السابق، وإن كانت هذه الوثائق تحتاج لتطوير وربط رؤاها بالتحرر الفلسطيني الشامل، الوطني والديمقراطي. كما تميزت هذه المرحلة بنهوض شعبي جديد متدرج كانت ذروته في انخراط فلسطينيي 48 في هبة شعبية عارمة لعدة أيام مساندة لنضال شعبنا في الانتفاضة الثانية عام 2000. شكلت هذه الهبة، التي استشهد فيها 13 شابا برصاص الشرطة، ومئات الجرحى والمعتقلين، محطة تأسيسية في مسار تطور هويتهم ووزنهم في الصراع، وكذلك محطة تأسيسية في منسوب القمع. بعد هذه الهبة لم تتوقف النضالات الشعبية ضد هدم البيوت والمصادرات، وأشكال التمييز والملاحقة، وصولا لى هبات متواصلة ضد مخطط برافر الاقتلاعي بين عامي 2011 الى أواخر عام 2013، التي اثمرت عن إسقاط القانون الذي كان ينص على خطة لتهجير عشرات الآلاف من فلسطينيي النقب طمعا بأراضيهم. ويمكن القول إن هذه الهبات، التي برز فيها الشباب في تنظيمها وقيادتها بصورة فاعلة، وكذلك نجاح الأحزاب العربية في تشكيل قائمة انتخابية برلمانية واحدة، ولأول مرة في تاريخ عملهم السياسي، عام 2015، شكل آخر فصول الحيوية السياسية والشعبية لفلسطينيي الداخل.
بعد هذا الفصل العامر بالنشاط والفاعلية، طرأ عاملان قوّضا الحراك ونالا من حيوية دورهم، سواء في الدفاع عن وجودهم أو في مساندة نضال شعبهم، وفتحا مرحلة من التراجع والانحلال؛
الأول، تغوّل سلطة اليمين الفاشي، والعودة إلى تنفيذ المزيد من سياسات العصا، بما فيها القوانين المكبلة للعمل السياسي من جهة، والمغريات الاقتصادية، من جهة أخرى. أما الأخطر في مستجدات القمع والتدمير هو إطلاق العنان للجريمة المنظمة لإشغال المواطنين العرب في أمنهم الشخصي، ونزع السياسة عن أجنداتهم، وتعزيز نزعة الانزواء في نطاق الأسرة.
العامل الثاني، الوهن الداخلي وتكلّس البنى الحزبية والهيئات التمثيلية، وهو شأن يتعلق بالإرادة الداخلية، كجماعة وكأفراد.
إذًا نحن اليوم على خلاف ما بعد مرحلة التوقيع على اتفاق أوسلو، أمام مرحلة جديدة وواقع أكثر تعقيدا، مع وضوح سافر في نوايا المؤسسة الصهيونية، التي تواصل قمع حرية التعبير ومحاصرة العمل السياسي والتنظيم. ومن الواضح أن المؤسسة الصهيونية كانت تتحين الفرص للانقضاض على المواطنين الفلسطينيين الذين أعادت اكتشاف وزنهم وتأثيرهم في الصراع، فاستغلت هجوم حماس لاعتماد إجراءات قمعية شديدة ضدهم؛ وهناك من يعتقد أنهم لو تجرؤوا وخرجوا إلى الشوارع كما فعلوا في محطات تاريخية سابقة، لكانوا تعرضوا ليس لقمع سياسي عنيف فحسب، بل لمجازر وإلى تهجير. وهكذا غاب المواطنون العرب عن الفعل الشعبي الواسع والمؤثر سواء في ما يتعلق بالوقوف ضد الإبادة في غزة والتطهير العرقي في الضفة الغربية، أو في ما يتعلق بالتصدي للقوانين العنصرية والإجراءات القمعية ولمخطط الاجرام المنظم، الذي يدمر مجتمعنا ويعرقل عملية النهوض.
تصدعات في حالة السكون وبدايات تحرر من حالة الذات المردوعة
تشهد الأشهر الأخيرة محاولات، وإن كانت متواضعة، ناجحة في عملية التحرر من الحالة النفسية التي ولّدتها إجراءات القمع غير المسبوقة، في أوساط فلسطينيي 48. على سبيل المثال لا الحصر، تمكن الفلسطينيون من التحايل على منع مسيرة العودة السنوية الى إحدى القرى المهجرة، في الذكرى الأخيرة، من خلال التوزع والانتشار على عشرات القرى المهجرة.
كما تحدى الطلاب الفلسطينيون في الجامعات الإسرائيلية التقييدات وحملات التخويف والترهيب المكثفة، من خلال إصرارهم على تنظيم مظاهراتهم الوطنية في ساحات هذه الجامعات. في الوقت ذاته، تكثفت في الأشهر الأخيرة نشاطات المنتديات واللقاءات الفكرية والثقافية، ومشاورات الأطر الأكاديمية التي تبحث في كيفية إحداث نقلة حقيقية في الفعل السياسي والشعبي، في مساندة شعبنا الذي يتعرض للإبادة، وفي مواجهة مخطط الإبادة السياسية والاجتماعية التي يتعرض لها فلسطينيو 48. ويمكن البناء على هذه الحراكات لإطلاق حراك ثقافي وشعبي تدريجي، ضمن رؤية وإستراتيجية متدرجة.
ثمة تصورات واقتراحات كثيرة هامة تطرح في هذه اللقاءات، ولكن النقلة المطلوبة لا تزال معطّلة لأسباب ذاتية أكثر منها موضوعية. لم يعد تكريس جل الجهد على الأبحاث والنقاشات والتصورات النظرية، على أهميتها. لقد باتت المبالغة بذلك تبدو عجزا أو هروبا من الخروج بهذه الأبحاث إلى الميدان وساحة الفعل.
ويمكن العودة إلى أحد مرتكزات النهوض الأساسية الذي لا يُخصص له الجهد الحقيقي، أي المتعلق بالعمل الشعبي. إن نموذج النضال الشعبي يستلزم توفر ضلعين أساسيين؛ الأول، تأسيس هيئة تخطيط عمل جماهيري – شعبي يستقطب إليها وفي إدارتها خبرات حقيقية، خبرات تحمل تجربة عملية ومعرفة نظرية في مجال الاحتجاج والتنظيم، ويمكن إيجاز إستراتيجية العمل في وضع تصوّر مُشكل من مراحل، تبدأ بخطوات تدريجية متواضعة إلى خطوات كبيرة. أولها اختيار مجموعات صغيرة يتميز أفرادها بالالتزام العالي، تجتمع داخل ساحات المدن والقرى، مرفقة ببرنامج توعوي وتثقيفي، يتخذ شكل الحوار وتبادل الآراء والمقترحات، تتصل بكيفية الانتقال الى المرحلة التالية، أو المراحل التالية، وصولا بعد أشهر أو عام أو أكثر، إلى بلورة حركة أو حراك شعبي واسع الذي من شأنه أن يعيد الثقة بالعمل الجماعي، ويفتح الأفق لإعادة تنظيم المجتمع، وتحصينه سواء في وجه الآفات الاجتماعية الداخلية أو سياسات القمع والمحو والإبادة.
المرتكز الثاني؛ من الصعب أن تتشكل الهيئة من دونه، ألا وهو السند المادي. وهذا يعيدنا إلى فكرة الصندوق المالي القومي. لقد فشلت لجنة المتابعة المكلفة بهذه المهمة بحكم مسؤوليتها، في تحقيق ذلك على مدار عشرات السنين. وإذا تعذر على لجنة المتابعة بسبب الوهن غير المسبوق الذي يعتريها، التغلب على عجزها أو تمنعها عن القيام بهذه المهمة، فيجب على المبادرات العديدة القائمة أن تنشغل بهذه الفكرة الحيوية، وأن تخصص جلسات مهنية وتجد الآلية المناسبة لجباية المساهمات المادية من المواطنين العرب، بدل أن يبدد البعض الوقت والجهد في الانشغال في جلب الأموال من الصناديق الأميركية لرفع نسبة التصويت للكنيست، خدمة لأجندات ليس لها علاقة بعملية تنظيم مجتمعنا وإنقاذه من أخطبوط القمع والإجرام.
لا يحتاج الانخراط في هذه الإستراتيجية الشعبية، نظريا وعمليا، إلى شجاعة أو جرأة، إذ إن هذه الإستراتيجية ذات طابع شعبي مدني، يستطيع تحمل تبعاتها المواطن بسهولة نسبية. بل تحتاج إلى إرادة وإصرار ومثابرة، وتفكير خلاّق، وعمل ممتد.
مجتمعنا اليوم، رغم ما ألحق به من أضرار، زاخر بالطاقات الخلاقة والخبرات، وينتظر من يُطلق الخطوة الأولى في مسيرة عمل ونضال وبناء طويلة. ومن يحاولون إطلاقها كثر… كل ما نحتاجه هو إعادة تقييم هذه المحاولات، وإعادة ترتيب الأولويات والتصويب نحو الحلقة المركزية، قبل أن يتراكم المزيد من الخراب والخسارات البشرية والاجتماعية والمادية والمعنوية، فتصبح المهمة عسيرة جدا.