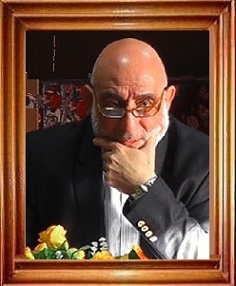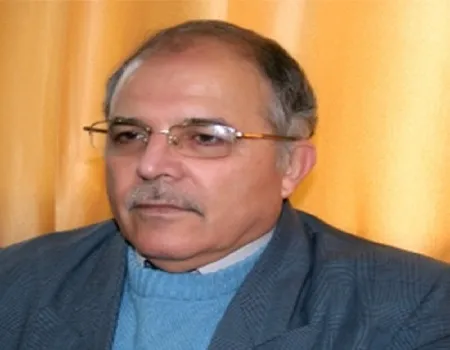نقاش في الفعل التحرّري العام

نقاش في الفعل التحرّري العام
الأخطر من ذلك هو عدم إصدار أي موقف، في الوقت المناسب، خصوصاً عندما يكون الحدث بحجم أزمة كبيرة وعميقة وشاملة على المستوى الوطني أو أبعد من ذلك. أمّا ذروة الخطورة، فتتمثّل في إصدار تقييم خطأ تترتّب عليه، بدوره، نتائج أكثر سوءاً وأفدح ضرراً!
انهيار الاتحاد السوفياتي ومعه منظومته الاشتراكية التي طبعها القائد السوفياتي جوزيف ستالين بطابعه الخاص إلى حد كبير، لم يحظَ، خصوصاً من قبل متبنّي الإيديولوجية الماركسية وتطبيقها السوفياتي، بالنقاش النقدي الضروري والبديهي: لتبيُن الأسباب واستخلاص العبر. حصلت تساؤلات. صدرت بعض المواقف والأحكام… ولكنها جميعها كانت، عموماً، ذات طابع جزئي أو سطحي أو مغرض… ولا يرقى، بالتالي، إلى مستوى خطورة ما حدث وضخامة نتائجه الآنية والمستقبلية. الحضور والمبادرة تراجعا إلى درجة كبيرة ومقلقة. سريعاً تعاظمت الخيبة والانكسارات والخواء… «ثالوث» التقدّم والتغيير والثورة، كان يقوم، تقريباً، على رجل واحدة هي «المركز السوفياتي».
أمّا الطبقة العاملة العالمية (وهي القائمة الثانية في قاعدته) وخصوصاً في البلدان الرأسمالية المتطورة، فقد انهار بعضها بشكل دراماتيكي. هي كانت متعثرة، أصلاً، بسبب تعثر التجربة السوفياتية في جانبين أساسيين: مسألة الحريات العامة والفردية، ومسألة تواضع برامج التنمية الشاملة والتقدم الاقتصادي وانعكاس ذلك سلبياً على مستوى المعيشة ومتطلبات الاكتفاء والرفاهية مقارنة بالوضع في البلدان الرأسمالية المتطورة.
سُجّلت مساهمات إيجابية للاتحاد السوفياتي في دعم حركات وكفاح الشعوب من أجل التحرّر من الاستعمار والاستغلال والعنصرية والنهب والقمع، ولكن طابعها السياسي كان يتقدّم على طابعها المبدئي في كثير من الحالات. الانهيار ترك تأثيراً سلبياً، وأدى إلى حالة من التراجع أو حتى الهزائم بهذه النسبة أو تلك.
في مجرى ذلك كان وما يزال مطلوباً التوقف عند تجربة البلدان الاشتراكية التي لم يسرِ عليها الانهيار. لماذا صمدت واستمرت؟ هل هو العامل الجيو-سياسي، أم هو الفارق ما بين الأسباب والأساليب والظروف الذاتية والاقتصادية والاجتماعية التي قادت إلى التحولات الثورية، أم هو في تباين مستوى الحزم أو القمع ما بين التجارب الأوروبية وسواها؟ لم يتم التوقف ملياً عند هذا الموضوع. هذا أمر مستغرب، كان ولا يزال.
ربما يعود السبب الأساسي في ذلك، بالنسبة إلى أولئك الذين واصلوا قناعاتهم ونشاطهم وكأن شيئاً لم يتغيّر، أنهم ظلّوا يعتقدون أن التجربة السوفياتية هي الأساس، وأن المسؤول عن الانهيار هو العامل الخارجي ممثّلاً بالإمبريالية الأميركية وأدواتها وأجهزتها فحسب! لم يشغلوا أنفسهم بطرح الأسئلة الطبيعية بشأن هذا الحدث الجلل والخطير، وبشأن المسؤوليات عنه في الداخل قبل الخارج.
في مجرى هذا النوع من التعسف والسلبية، ساد الاكتفاء مقروناً بالحذر إزاء كل سؤال وتساؤل. سُجّلت الجريمة ضد مجهول هو «العدو الطبقي» ومنظومته الإيديولوجية والسياسية والإعلامية والأخلاقية التي نجحت بفضل التجسس والخداع والتآمر والاختراقات على مستوى القيادة… في تنفيذ انقلاب دون أي مقاومة يعتد بها… وكفى الله الثائرين شر البحث والنقد و«النقد الذاتي» اللينيني!
هذا النوع من الاكتفاء، والزهد بمعرفة الحقيقة، والتهرّب من كشف المسؤولية والمسؤوليات، ضاعف من الأزمة. ضاعف منها أكثر أمران آخران: الأوّل، جنوح تيارات وأفراد إلى إعدام كامل التجربة الاشتراكية والانتقال الإيديولوجي والسياسي إلى المعسكر النقيض. الثاني، إلقاء الحرم على كل توجّه إلى النقاش وإحاطته بالشكوك والتساؤلات وتصنيفه «تخريباً» وتخلّياً وخروجاً على وعن المقدسات والمبادئ والعقيدة! هذا فيما واصل الذين استمرّوا في مواقع القيادة، سياسة دفاعية تكتفي من الدور والتأثير بالحضور والبقاء: ولو في مقاعد المتفرجين!
لماذا العودة، الآن، إلى هذا الأمر؟ لقد نجم فراغ كبير وخطير بسبب الانهيارات، وبسبب تجاهل الأسباب الحقيقية والمتنوعة عن وقوعها. حصلت محاولات محدودة كان بعضها واعداً وجريئاً. تحوّل، مثلاً، التحضير للمؤتمر السادس للحزب الشيوعي اللبناني الذي عُقد عام 1994، بعد الانهيار السوفياتي، إلى ورشة بحث ونقاش جديين وطويلين وعميقين. تم التوقّف، مطولاً، حول أسباب الانهيار في الحقول كافة: الفكرية الإيديولوجية والاقتصادية والاجتماعية والتنظيمية…إلى مسائل الديموقراطية داخل الحزب وفي المجتمع… إلى «البنية الفوقية» وكيفية مقاربة التراث وأنماط التفكير والتقاليد… إلى الشأنين الوطني والقومي في التباسات تفاعلهما (على الصعيد العربي خصوصاً)، وفي علاقتهما بالعامل الأممي العام… إلى مسألة «نموذج» المركز السوفياتي…
رغم اتساع وشمولية المقاربة النقدية والخلاصة البرنامجية التي ميزت التحضير وأقرها المؤتمر، رفع فريق محدود شعار «المراجعة النقدية» التي تقتصر على الجانب السياسي فحسب. اتضح سريعاً ولاحقاً، أن المستهدف، في مرحلة أولى، هو أدوار مسؤولين محددين، ثم مجمل موقع الحزب وتوجهاته وسياساته وعلاقاته أثناء الحرب الأهلية. لم يجرِ إعلان ذلك، ولا تمّ تقديم تصوّر أو مقاربة بديلة، ليتبيّن، في ما بعد، أنّ «تلك المعارضة» الغامضة قد كانت تمهّد للالتحاق بالتيار اليميني، وحتى بأكثر مكوناته عنصرية وتطرفاً وعلاقة بالعدو الصهيوني، وتحت مسمى مدعٍ ومضللٍ هو «اليسار الديموقراطي»!
لم يكن ذلك هو العامل السلبي الوحيد. بعض الذين صاغوا وفكروا وشاركوا في إقرار وثيقة المؤتر السادس، قد ابتعدوا أو انكفؤوا أو تراجعوا في أعقاب أو في امتداد تبلور توجه يميني شمل، تقريباً، كل القادة الأساسيين «التاريخيين» في المكتب السياسي. هؤلاء التحقوا، تباعاً، بالتحالف اليميني الموسع الذي حمل اسم «لقاء البريستول» ثم «14 آذار».
أمّا الفريق الثالث، فهو ما عرف بـ«المتشددين» الذين ما لبثوا أن بلوروا في السر غالباً، وبالتآمر دائماً، خطة لوأد محاولة ومسار النقد والمراجعة والاستنتاج في مهدها. بذلك بات ذلك المؤتمر، تدريجياً، شبه يتيم، ومن دون خطة كفاحية لتجسيد برنامجه الثوري، في الظروف الجديدة، ولإعادة النهوض بالحزب عبر عقد جديد ومشروعية تغييرية تبلور أهدافه وملامحه العامة وهياكله الأساسية وأولوياته التعبوية في مجرى الممارسة النضالية الطليعية المنشودة! أدّى ذلك إلى الضياع والخواء والخسائر والضمور والهامشية…
ماذا بشأن التطورات العاصفة قبل وأثناء عملية «طوفان الأقصى»؟ ماذا عن موقعها في المسار التحرري العام؟ هذا ما سيكون مادة المقال اللاحق في الأسبوع المقبل.
* كاتب وسياسي لبناني