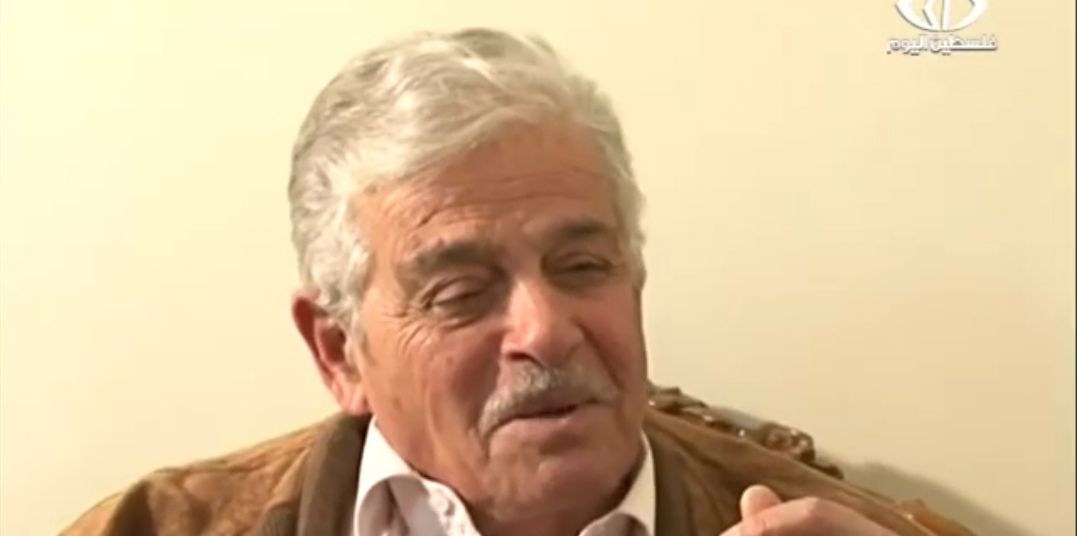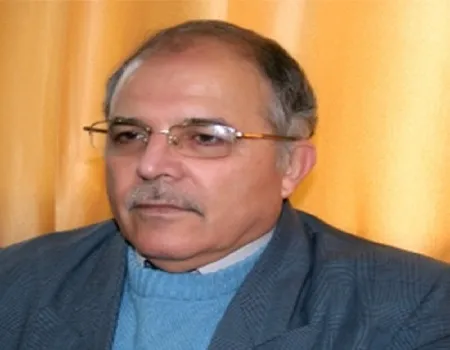سلاح حزب الله بين نقاش السيادة والتدويل وتفكك معادلة الردع

سلاح حزب الله بين نقاش السيادة والتدويل وتفكك معادلة الردع
مهيب الرفاعي
يُرسم مستقبل سلاح حزب الله ليس فقط في الضاحية الجنوبية، بل في دمشق أيضًا، حيث يتوقّف الكثير على خيارات الإدارة السورية المقبلة، ومدى قدرتها على التحوّل من دولة مأزومة إلى شريك في هندسة استقرار إقليمي متوازن…
منذ انتهاء الحرب الأخيرة بين حزب الله وإسرائيل في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، احتدم الجدل اللبناني بشأن مستقبل سلاح الحزب، في نقاش يتجاوز الشعارات والخطابات إلى قلب معادلة السيادة والدفاع واحتكار الدولة لاستخدام القوة. فبين ضغوط أميركية متزايدة لنزع سلاح الحزب، لا سيما بعد زيارة المبعوث الأميركي توماس براك، وانقسام داخلي عميق حول شرعية هذا السلاح ووظيفته، تبدو البلاد مقبلة على تحوّل في المعادلة التقليدية التي لطالما اعتُمدت لتبرير “سلاح المقاومة”. فقد تفككت تدريجيًا معادلة “الردع”، خاصة بعد اتفاق وقف إطلاق النار الأخير، رغم خروقاته من الجانب الإسرائيلي، إذ لم يعد السلاح يُستخدم حصريًا ضد تل أبيب، بل دخل حيز التوظيف الداخلي من مبدأ التخوين والتخلي عن المقاومة، ما أثار قلقًا واسعًا داخل بيئات لبنانية متعددة.
وفي ظل هذا التحول، برزت دعوات لإعادة تعريف دور الحزب بما ينسجم مع متغيرات الداخل اللبناني والتزامات اتفاق ما بعد الحرب، بما في ذلك احتكار الدولة للسلاح، دون أن تُغلق الأبواب أمام “خط رجعة” يسمح للحزب بالاندماج التدريجي في مشروع الدولة، شرط أن يتخلى عن خطابه التعبوي السابق، والتزامه بكونه حزبًا سياسيًا لا غير مع تخليه عن الجناح العسكري.
القدرات التقليدية
رغم أن حزب الله كان يحتفظ قبل حرب 2024 بواحدة من أضخم الترسانات العسكرية غير النظامية في العالم، فإن هذه الحرب شكّلت نقطة تحوّل استراتيجية في تآكل قدراته، خاصة بعد مقتل عدد من قادته العسكريين المحوريين، وتعرّض بنيته الاستخباراتية لضربات موجعة حيّدت قيادات الصف الأول والثاني. كان الحزب يمتلك ما بين 75 إلى 150 ألف صاروخ وقذيفة، بعضها دقيق كصواريخ “فاتح 110″، و”فجر”، و”زلزال”، ويملك القدرة على إطلاق نحو 3000 صاروخ يوميًا في بداية أي حرب، مع استمرارية معدّل 1000 إطلاق يومي حتى شهرين. إلا أن هذه القدرة تعرّضت للاستنزاف، سواء بفعل الاستهداف المباشر لمخازن الذخيرة، أو بقطع بعض خطوط الإمداد التي تمر عبر الأراضي السورية. كما ألحقت الحرب أضرارًا جسيمة بمنظومته الجوية والدفاعية، لا سيما أن الطائرات بدون طيار التي كان يعتمد عليها لتغيير قواعد الاشتباك، من طراز “أيوب” و”مرصاد”، أصبحت أقل فعالية بفعل تفوق المنظومات الإسرائيلية في التشويش والرصد. وفي مجال الدفاع البري، ظل الحزب محتفظًا بقدرات على استخدام صواريخ “كورنيت” و”ألماس”، لكن خسائره في الميدان خفّضت من قدرته على إدارة عمليات هجومية منظمة. أما قدراته المضادة للطائرات، والتي وصلت سابقًا إلى نحو 2500 صاروخ، فقد تبيّن أن جزءًا كبيرًا منها إمّا دُمّر أو أصبح خارج الخدمة، ما قلّص من فعالية الحزب في حماية أجوائه. كذلك، فشلت منظومته البحرية في تكرار ما حققته في حرب 2006 ضد السفن الإسرائيلية، ولم يظهر مؤخرًا أي دليل عملي على استخدامه لصواريخ “ياخونت” بمدى 300 كلم، رغم ورود تقارير تفيد بحصوله عليها.
وعلى مستوى القوة البشرية، تشير التقديرات بعد الحرب إلى تراجع عدد مقاتليه إلى ما دون 40 ألف عنصر، مع تقلص عدد المقاتلين بدوام كامل إلى نحو 15 ألفًا، نتيجة الخسائر البشرية ونزيف الكوادر القتالية المحترفة.
ما بعد حرب إيران – إسرائيل
أخيرًا، شكّلت الحرب الإسرائيلية – الإيرانية التي اندلعت في حزيران/يونيو 2025 لحظةً مفصلية في إعادة تشكيل توازنات القوة الإقليمية، بما يتجاوز ميدان الاشتباك المباشر بين تل أبيب وطهران، إلى المساحات الجيوسياسية التي تُدار عبر الوكلاء، وفي مقدمتهم حزب الله. أدّت الحرب، بالإضافة إلى عوامل أخرى، إلى قطع الممر الإيراني الذي كان يُستخدم في الإمداد العسكري، تحت وطأة الضغوط الدولية والخطوات الإسرائيلية لتعطيله. الأمر الذي جعل سلاح الحزب أقل تماسكًا، وأكثر عبئًا، ما يُعيد فتح ملف دمجه في الدولة من زاوية جديدة، تُركّز ليس فقط على السيادة، بل على واقعية القدرة والبقاء.
أدّت هذه الحرب إلى تفكّك ما كان يُعرف بـ”محور المقاومة” الذي لطالما وفّر للحزب غطاءً إيرانيًا سياسيًا وعسكريًا مكّنَه من الحفاظ على استقلالية قراره الميداني داخل لبنان، وحتى خارجه من خلال مشاركته مع نظام الأسد السابق في حربه ضد المعارضة السورية.
ومع انتقال الصراع إلى مواجهة مفتوحة بين الدول، تراجعت أولوية إدارة الساحات الثانوية، ما انعكس ضعفًا في القدرة الإيرانية على حماية أذرعها الإقليمية أو تبرير استمرارها. في هذا السياق، بدأ سلاح الحزب يتحول تدريجيًا من ميزة تفاوضية وورقة ضغط للاستفراد بالسلطة في لبنان إلى عبء إستراتيجي داخلي وخارجي. فعلى الصعيد اللبناني، تصاعدت المخاوف من جر البلاد إلى حروب بالوكالة لا طاقة لها على تحمّل تبعاتها، وهو ما زاد من حدّة المطالبة بوضع هذا السلاح تحت سلطة الدولة والمطالبة بإنهاء حالة التلفت الأمني وفوضى السلاح، لا سيما وأن المناطق المدنية تضررت بذريعة وجود مراكز تسليح بين الأحياء المدنية، سواء في الضاحية الجنوبية لبيروت أو في قرى الجنوب أو البقاع. أما دوليًا، فقد دفع توسّع رقعة الحرب المجتمع الدولي، ولا سيما واشنطن والاتحاد الأوروبي، إلى التشدد في ملف الميليشيات المتحالفة مع إيران خصوصًا، وملف الحركات الإسلامية المسلحة غير الحكومية في المنطقة؛ وطرح نزع سلاحها كجزء من أي تسوية أمنية في المنطقة. وتبعًا لذلك، بات حزب الله أمام لحظة إستراتيجية فارقة: فإما أن يعيد تعريف موقعه ضمن الدولة اللبنانية كحزب سياسي مندمج في مؤسساتها، أو أن يجد نفسه محاصرًا في الداخل ومعزولًا في الخارج، ضمن مشهد إقليمي لم يعد يحتمل استثناءات تتجاوز منطق السيادة الوطنية.
بين الرفض والتشكيك
رغم ذلك، لا يُظهر حزب الله أي نية للتراجع عن موقفه التاريخي بخصوص السلاح وترتيبات الانتشار والتعاون لفرض وصاية الدولة على الجنوب اللبناني، والموافقة على إفراغ الجنوب ضمن مبدأ المنطقة العازلة التي تؤمن بالنتيجة الجبهة الشمالية لتل أبيب وتمنع العمليات ضد مستوطنات الشمال. وفق تصريحات الشيخ نعيم قاسم، فإن السلاح ليس موضع تفاوض طالما استمر العدوان الإسرائيلي واستمرت الخروقات الأمنية والعسكرية في لبنان، مؤكّدًا أن الاستسلام غير وارد، وأن من يطالب بنزع السلاح إنما ينخرط في مشاريع أميركية وإسرائيلية وأجندات خارجية الهدف منها النيل من سلاح المقاومة في لبنان. يمكن أن نستشرف من هذا الخطاب أن الحزب، وإن كان يعترف بوجود تحديات، لا يرى تعارضًا بين سلاحه والسيادة الوطنية، ويُبقي الباب مفتوحًا لمناقشة بدائل جدّية وفعّالة للدفاع عن لبنان، لكنه لا يقدّم مؤشرات فعلية على استعداده للتخلي عن سلاحه في المدى المنظور، خاصة مع بقاء مناطق محتلة وخرق إسرائيل للهدنة. في المقابل، يُطرح سؤال الثقة والشفافية بقوة داخل الخطاب العام، خصوصًا وأن الشارع اللبناني يتساءل عما إذا كانت هناك شكوك متزايدة بقدرة الحزب على الالتزام بأي تفاهمات أو أوراق تُوقّع، ما يعمّق أزمة الثقة الوطنية. فيما يرى آخرون أن الخطوة الأولى تبدأ بإعلان مبدئي من الحزب باستعداده لتسليم السلاح للدولة، التزامًا باتفاق الطائف ومفهوم السيادة، وبدء مسار تدريجي نحو إرساء سلطة واحدة على الأرض اللبنانية دون أي ولاءات خارجية لإيران ولمحور المقاومة الذي يبدو أنه تلاشى بعد سقوط نظام الأسد في سورية وضعف وتشتت حركات المقاومة في فلسطين وضعف التواصل بين حركات محور المقاومة.
هل من دور سوري؟
على هذه الخلفية، يتقاطع الجدل الداخلي مع المبادرة الأميركية التي يجري العمل عليها في بيروت، حيث تسعى القوى السياسية إلى بلورة رد لبناني موحد على المقترحات الأميركية المتعلقة بسلاح حزب الله، خصوصًا بشأن آلية التنفيذ وضمانات الانسحاب الإسرائيلي. وبينما يتمسك الحزب برفض أي ضغوط خارجية، معتبرًا أن المسألة شأن لبناني داخلي يجب أن يُعالج ضمن إستراتيجية وطنية شاملة، تبرز أهمية الأدوار الإقليمية، وتحديدًا الدور السوري المتوقع في مرحلة ما بعد سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024. فالإدارة السورية الجديدة ستكون مطالبة بمقاربة هذا الملف ليس فقط كقضية لبنانية، بل كملف إقليمي يرتبط بأمن سورية وموقعها ضمن التوازنات الجديدة في الشرق الأوسط. ومن هنا، تتعدّد الأدوار المحتملة لسورية على ثلاثة مستويات: أمني – إستراتيجي، سياسي – دبلوماسي، وإقليمي – دولي.
على المستوى الأمني، يُتوقّع من سورية الجديدة، بعد أن قطعت ارتباط دمشق بطهران وأنهت النفوذ الإيراني والجماعات الشيعية في البلاد، أن تتحوّل من دولة دعم إلى دولة ضبط. إذ إن إعادة السيطرة على المعابر والحدود مع لبنان، خصوصًا في منطقة البقاع والقصير والقلمون، والتي كانت قد شهدت معارك كبيرة قبل أشهر بين عشائر موالية لحزب الله وقوات الأمن العام السورية، ستُفضي إلى قطع خطوط الإمداد العسكري واللوجستي التي لطالما اعتمد عليها حزب الله. كما أن التنسيق السيادي بين دمشق وبيروت يمكن أن يُسهم في إعادة بناء قدرات الجيش اللبناني، وتقديم ضمانات أمنية مشتركة تُغني عن الحاجة إلى المقاومة المسلحة.
أما على المستوى السياسي، فدمشق التي تسعى إلى استعادة شرعيتها الإقليمية والدولية، قد توظّف علاقتها التاريخية بالحزب للعب دور الوسيط في تسوية تدريجية تُحوّل الحزب من فاعل عسكري إلى حزب سياسي تحت سقف الدولة، وذلك ضمن تفاهمات إقليمية تضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وتُحافظ على توازن المصالح، لا سيما بعد الحديث عن ترسيم مناطق مزارع شبعا والجولان السوري وتفاهمات حول ملف سلام في جنوب سورية.
وعلى المستوى الدولي، فإن سورية الجديدة، إذا ما اختارت تقليص نفوذ طهران وإعادة تعريف “المقاومة” ضمن مشروع عربي سيادي، يمكن أن تضغط باتجاه نزع السلاح غير الشرعي في لبنان كشرط للاستقرار وإعادة الإعمار، وهو مطلب مشترك لبيروت ودمشق في آنٍ معًا.
في هذا السياق، تتحوّل الجغرافيا السورية من منصة دعم لحزب الله وعناصره على الحدود إلى أداة ضبط قادرة على فرض معادلة جديدة في التعاطي مع ملف سلاح الحزب، وتتحوّل دمشق من حليف مُغذٍ لحزب الله إلى ضامن محتمل لتقليص نفوذه العسكري والأمني والاستخباراتي في المنطقة. وهذا التحوّل، إذا ترافق مع مبادرات لبنانية داخلية واضحة وإرادة سياسية جامعة، يمكن أن يُمهّد لتسوية تاريخية تنتصر لمنطق الدولة. لكن هذا السيناريو يظل مشروطًا بثلاثة عناصر مركزية: أولًا، نجاح دمشق في تفكيك البنية العسكرية التابعة لإيران؛ ثانيًا، نيلها شرعية عربية ودولية تجعلها شريكًا موثوقًا؛ وثالثًا، توفّر إرادة سياسية لبنانية على مستوى الرئاسة والحكومة والجيش.
بذلك، يُرسم مستقبل سلاح حزب الله ليس فقط في الضاحية الجنوبية، بل في دمشق أيضًا، حيث يتوقّف الكثير على خيارات الإدارة السورية المقبلة، ومدى قدرتها على التحوّل من دولة مأزومة إلى شريك في هندسة استقرار إقليمي متوازن. أما لبنان، فهو أمام لحظة فاصلة لا تحتمل التردّد، بين أن يكون دولة ذات سيادة فعلية، أو كيانًا هشًا محكومًا بتوازنات السلاح.