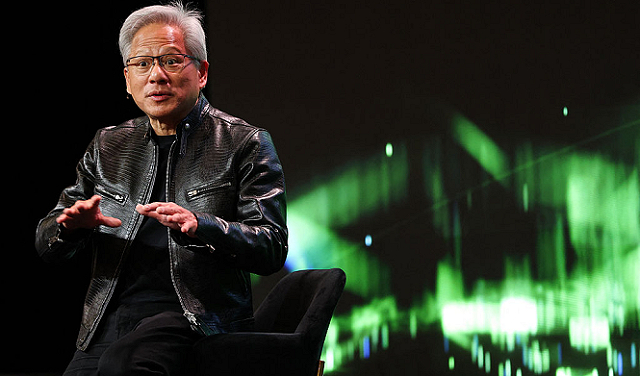حفنة عدس … ويد لا تزال تمسك الحياة

مريم مشتاوي
كان اسمه أحمد، رجل لم يكن يملك من هذا العالم أكثر من كفين، وقلب يئن من التعب، وطفل يتعلّق بذراعه كمن يتشبث بحافة النجاة.
لم يكن يحمل سلاحاً، لم يكن في جيبه مفتاح بيت، ولا ورقة هوية، ولا رغيف ساخن.
كل ما أخذه معه في تلك اللحظة كان كيساً صغيراً… كيساً أسود خفيفاً، خجل من نفسه وهو يخبئه في الجيب الداخلي لقميصه الممزق، كأنّه يخجل من فقره، من قلة ما استطاع إنقاذه.
حفنة عدس… وبعض حبات أرز
من قال إن الجيوب خلقت للنقود فقط؟
في غزة، الجيوب أوطان صغيرة، تحفظ ما تبقّى من حياة، تسرق من رماد اليوم ما قد يطهى في الغد.
أحمد لم يكن لصاً، لم يكن ينهب المساعدات، ولم يكن يركض هارباً.
كان فقط أباً… يخطو بحذر قرب مساعدات مبعثرة على الأرض، وابنه في يده يضحك دون أن يعرف أن الضحك في غزة ممنوع.
كان يحمل العدس وكأنه كنز. يعد حبات الأرز بأطراف أصابعه المرتجفة، ويهمس في داخله: «هذا يكفينا ليومين… وربما أكثر لو طبخته مريم».
مريم، زوجته، كانت بانتظاره. لا في بيت من حجر، ولا في غرفة بأثاث أنيق. كانت تنتظره خلف الخيمة، قرب برميل الماء، تعدّ في ذهنها عدد الملاعق الممكنة من تلك الحفنة.
لكن رصاص الاحتلال لا ينتظر الجائعين.
طلقة واحدة، فقط، كانت كافية لتفصل الروح عن الجسد. وطلقة أخرى، صغيرة، غادرة، استقرت في صدر الطفل، كأّنها اختارت أن تقطع اليد عن اليد.
سقط أحمد، وسقط الطفل. سقطت حفنة العدس على الإسفلت، تناثرت حبات الأرز، وتكسّرت النبضات على الإسفلت الرمادي.
كيس أسود تدحرج بين الأقدام، كأنه يبحث عن ملاذ… عن قدر صغير يحتضنه… عن امرأة تطفئ فوقه جوع الأيام.
اقتربت الكاميرا من الجيب المفتوح، كانت اليد لا تزال تمسك يد الطفل.
كأنهما ماتا وهما يهمسان لبعضهما: «لا تتركني».
لا أحد في هذا العالم يهتم بحفنة عدس في جيب رجل ميت.
لا أحد يقف دقيقة صمت على كيس أرز ملوث بالدم.
لكن في غزة… هذا الكيس كان معركة.
وهذا الجيب كان صرخة.
أحمد لم يمت، لأنه حمل سلاحاً. مات لأنه حمل العدس إلى البيت، ومات لأن قلبه اختار أن يحمل الطفل قبل الكيس.
في خبر صغير، كتبوا: «قتل رجل وطفله وهما يجمعان حبات العدس».
لكنهم لم يكتبوا عن الرغيف، الذي لم يخبز،
ولم يكتبوا عن القدر الذي بقي فارغاً،
ولم يكتبوا عن مريم… التي جلست ليلاً تعد الحبات المتناثرة على أطراف الإسفلت، كأنّها تحاول إعادة جمعه للحياة.
لم يكتبوا عن اليد التي بقيت ممدودة رغم الموت.
يد الأب، التي لم تطلق ناراً، لم تهتف بشعارات، لم تلوح بعلم… كانت فقط تمسك يد طفل… وماتت ممسكة بها.
غفوة في حضن الخوف
كان الليل في غزة كعادته حاداً ومخيفاً…
وكانت الخيمة لا تملك جدراناً تعزل الريح، ولا باباً يغلق على الأمان، ومع ذلك، كانت تلك الأم تجلس في الزاوية كما لو أنها جدار،
كما لو أنها قمر صغير يحاول أن يضيء بقايا الطمأنينة في عين رضيعها.
لم تكن تغني… كانت تهمس، كأنها تخشى أن يوقظ صوتها الجنود الذين يحيطون بغزة من الجهات الأربع.
كلماتها متقطعة، مرهقة، تخرج من قلب أثقلته الشهور الطويلة بلا حليب، بلا دواء، بلا حضن زوج، بلا غرفة تقفل من الداخل.
رضيعها على صدرها، جفناه شبه مغمضين، كأنّه يحاول أن يسرق لحظة نوم لا تكتمل.
وجهه منقط بلسعات البعوض، كأن الحياة، حتى في أقسى لحظاتها، لم تكتف بالقذائف، فأرسلت له الناموس ليذكّره أن الجسد مكشوف، وأن لا سقف يحميه حتى من الحشرات.
تمسح عن خده دمعة لم يفهم سببها، وتضمّه أكثر، وتهمس في أذنه بأغنية من زمن آخر:
يلا تنام يلا تنام، لكنها تعرف أنها تكذب.
ما من طفل يمكن أن يغفو على أصوات الرصاص. وما من أم يمكن أن تغني وهي تتحسس خريطة النزوح فوق جسد صغير.
الخيمة ضيقة. لكنها تسع الوطن كله في تلك اللحظة. تسع وجعاً لا تحمله الجغرافيا.
في الخارج، ضجيج الحرب يتكاثر. الطائرات لا تنام، والجنود لا يرحمون.
والخيمة ترتجف من زئير بعيد، لكنّ الأم تضم طفلها بقوة، كأنها تحاول أن تقول للعالم: لن تأخذوه إلا من بين أضلعي.
تتذكّر، وهي تغمض عينيها، كيف أن ولادته كانت في خضمّ القصف، كيف أنها لم تصرخ من الألم كي لا يسمع الجيران، وكيف أنها قطعت الحبل السريّ بيدها، وربطته بخيط اقتطعته من شالها القديم.
تتذكّر كيف كان يبكي أول مرة حين سقطت قذيفة على الخيمة المجاورة، وكيف أن قلبها توقف لوهلة لأنها فكرت: هل يحقّ له أن يكبر هنا؟
لم يكن هناك مهد، ولا ناموسية، ولا حفاضات. كان فقط قلبها، ويدها، وقميص مهترئ تلفّه عليه، كلما اشتدت برودة الليل.
في تلك اللحظة.
نام الرضيع أخيراً، ربما ليس نوماً عميقاً، ربما لم يغف كالأطفال الذين ينامون في أسرّة نظيفة في أماكن أخرى من هذا العالم، لكنه نام.
وهي ظلت تنظر إليه، وكأنّها تحفظ ملامحه خوفاً من أن يصبح رقماً آخر في الأخبار.
«نام يا روحي… نام… حتى يكمل القمر».
كاتبة لبنانية