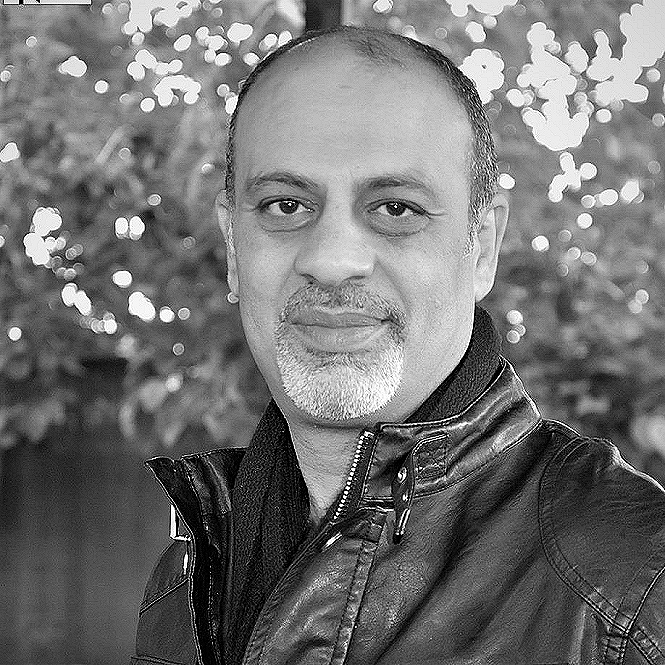الإِثنِيَّات فِي الوَطَنِ العَرَبِيّ بَيْنَ تَوظِيفِ الخَارِج لِلتَّجْزئةِ، وَتَعْمِيقِ الِانْدِمَاج في الِاجْتِمَاعِ الوَطَنِي والقَوْمِي
– الجزء الاول –
أ.د. محمد مراد، باحث وأستاذ جامعي
تمهيد
عرفت الأمّة العربية على مدى تواصل مراحلها التاريخية تحدّيات قاسية لوجودها كأمّة مخصوصة بتراكمات تراثية حضارية لم تتوفّر لغيرها من الأمم الأخرى في اجتراح العلوم على اختلافها، وفي اللغة والترجمات وانتقال الثقافة ، وفي القيم الاجتماعية والانسانية، ثمّ تلقّفت رسالة السماء في مطلع القرن الميلادي السابع فأضفت عليها طابعا رساليا في استعدادها لإرساء الاسلام كنظام حياة من ناحية، ونشره الى الانسانية كمنظومة حاملة للقيم والعدالة والسلام من ناحية أخرى .
استمرّت التحدّيات الخارجية البعيدة والقريبة من مجال الأمّة الجغرافي، فكانت تشكّل تهديدا لوجودها مانعة عليها مواصلة ارتقائها الحضاري، وحضورها الانساني الفاعل ، فهي ألأمّة ” الوسطا ” التي خصّت بأن تكون خير أمّة أخرجت للناس . إلاّ أنّ الهجمات الأشرس من محاولات استهدافها وجودا وهوية، هي التي تبرز اليوم، بهجوم اختراقي واسع وغير مسبوق في تاريخ الهجمات الاستعمارية والشعوبية، هجومات عدوانية تسارعت وتائرها مع مطلع القرن الحالي، باحتلال العراق واسقاط نظامه الوطني بوصفه النظام الحامل لمشروع الأمّة العربية في التوحّد القومي والتحرّر والعدالة الاجتماعية، وفي كونه ظلّ يمثّل خط الدفاع الأول لحماية الأمن العربي من محاولات الاختراق والتغوّل والسيطرة، واستغلال ورقة الأقليات الدينية والعرقية في تضخيم تناقضاتها بهدف اصطناع هويات أقلّوية لها تكون بديلة للهوية القومية أي للعروبة .
إنّ ما تعرّضت له الأمّة العربية، وما تزال، مرورا بسلسلة الحروب الأهلية التي ما تزال مفتوحة ومتواصلة في غير قطر عربي منذ مطلع العشرية الثانية للقرن الحالي، والتي لعب فيها الخارج الدولي والاقليمي على ورقة الأقليات الطائفية والعرقية والثقافية والجهوية، كلّ ذلك جاء لينذر بتهديد الأمة في وجودها التاريخي والحضاري، ويفتح المجال الجغرافي البشري والاجتماعي والثقافي والسياسي العربي أمام التفكيك والتفتيت والتجزئة من خلال توليد جغرافيات سياسية واجتماعية جديدة على اساس هويات اقلّوية تأخذ تعبيراتها السياسية في إطار الدويلة – الطائفة أو الدويلة – المذهب أو الدويلة – العرق أو الدويلة – الجهة العشائرية أو اللغوية أو المناطقية .
ان وجود الأقليات في الوطن العربي هو مسالة طبيعية يتشابه بها مع كل امم الارض. لذا تسعى هذه الورقة البحثية للوقوف على طبيعة هذه الاقليات، نشأتها وتطور مساراتها بين الاندماج في الهوية القومية للأمّة العربية، ومحاولات استغلالها من قبل الخارج الاستعماري كركائز للاختراق والتوظيف في استراتيجيات التفكيك والتجزئة .
1- التفاعل الايجابي للأقليات العربية مع التجربة في ظل الاسلام
إنّ المراقب التاريخي لحركة الجماعات البشرية التي انتشرت في المجال الجغرافي العربي ( الجزيرة العربية، بلاد الشام، بلاد مابين النهرين، مصر وبلدان أفريقيا الشمالية) ، يرى أنّ هذه الجماعات لم تكن متساكنة أو متعايشة على أساس من الفرز بين أكثريات وأقليّات بالمعنى الاصطلاحي الحديث لمفهومي الأكثرية والأقلية، وإنّما كانت عبارة عن جماعات أقوامية تنحدر من أصل عربي واحد مركزه الأساسي عرب الجزيرة العربية. حيث كانت هذه الجماعات تشهد باستمرار حركات نزوح داخلي متواصلة طالت المجال العربي برمته. وقد عرفت على مدى قرون عديدة سابقة على ظهور الاسلام ، تفاعلات حياة في مسارات علاقاتها البينية، الأمر الذي عزّز بينها روابط روحية مشتركة أهمّها وأعلاها رابطة الثقافة ووحدة الهوية والانتماء القومي في وقت لاحق .
ثمّ جاء ظهور الاسلام في مطلع القرن الميلادي السابع ” ليكون الحادث الخطير ” (1) في حياة العرب والأمّة العربية على السواء” حادث قومي انساني وعالمي فيه عظة بالغة، فيه تجربة هائلة ” (2) .
ثلاثة مرتكزات بنائية جديدة أفادت منها سائر المكوّنات البشرية للأمّة العربية من العرب الذين اعتنقوا الدين الجديد، وعرب آخرين من مسيحيين وغيرهم ظلوا على معتقداتهم الدينية السابقة على الاسلام، ولكنّهم استجابوا بقوّة وحماس بالغ للتفاعل الايجابي مع الدعوة الجديدة .
أمّا أبرز المرتكزات الثلاثة فكانت (3) :
الأول، بناء المجتمع العربي – الاسلامي الجديد في مرحلة البعثة النبوية ( نحو 20 سنة ) .
الثاني ، بناء نواة الدولة العربية – الاسلامية في مرحلة الخلافة الراشدة ( نحو 29 سنة ) .
الثالث ، ظهور الجغرافية السياسية للأمّة العربية، لأول مرّة، في ظل دولتي الخلافة الأموية والعبّاسية .
في ظل هذه المرحلة التي تواصلت لما يقرب من أربعة قرون لم يكن للأقليات أي مظاهر تمايز أو إختلاف مع التجربة القومية العميقة التي أسّسها الاسلام في واقع الأمّة العربية، بل على العكس كانت الاستجابة الفاعلة لسائر مكوّنات الأمّة من العرب الذين اعتنقوا الديانة الجديدة، والعرب الآخرين الذين تعايشوا معها من غير أن يعتنقوها ولكنّهم أعربوا عن كبير استعدادهم لإغناء التجربة التي اسهمت في ارتقاء وعي الأمّة لذاتها، وفي بلورة هويتها الحضارية المتمثّلة بالعروبة والقومية العربية الجامعة .
2- الأقليات العربية بين ثبوت الانتماء القومي والتوظيفات الخارجية
منذ أواسط القرن الميلادي العاشر، راحت الأمّة العربية تشهد هجمات متواصلة من الخارج الدولي والاقليمي بهدف إحداث اختراقات بالغة في بنيانها الاجتماعي والسياسي والثقافي تمنع عليها توحّدها القومي ومواصلة اندفاعها الحضاري . تواصلت هذه الاختراقات التي اتخذت من الأقليات بيئة حاضنة لتنفيذ اجندات مرسومة للتغوّل والسيطرة على حساب تفكيك وحدة الأمّة القومية ،عبر المراحل التالية :
2-1: تغلغل عناصر من غير أهل الأمّة الى مفاصل دولة الخلافة العبّاسية
بدأت هذه المرحلة مع العصر العبّاسي الثاني ( أواسط القرن العاشر ) عندما أحدث الخليفة المعتصم تغييرا في العنصر القيادي لإدارة الخلافة ، حيث لجأ الى إخراج العرب من ديوان الجند، وشكّل جيشا معظمه من الترك والديلم . ثمّ جاء الخليفة المتوكّل ليفتح المجال واسعا أمام عناصر من المرتزقة من الجند ونساء القصر، حيث تمكّنوا من الاستئثار بصناعة القرار الذي يحسم أمر اختيار الخليفة جاءت هذه التطورات لتعمل على تقديم العناصر غير العربية الى إدارة السياسة والأمن والاقتصاد في دولة الخلافة ، الأمر الذي ترك نتائج بالغة الخطورة دلّت عليها مظاهر التمزّق والتفكيك السياسي، وتدهور فعاليات الأنشطة الانتاجية والمعرفية، وتزايد في حدّة الصراعات الاجتماعية والمذهبية التي لم تلبث أن اتخذت أبعادا عرقية ودينية بين العرب مسلمين وغير مسلمين من جانب، وعناصر أجنبية من البويهيين ( الفرس ) ، والسلاجقة ( الأتراك ) وغيرهم من جانب آخر .
أمّا التطور الأكثر خطورة في هذه المرحلة، فقد تمثّل بالانشطار السياسي، حيث ظهرت سلسلة من الدويلات التي راحت تنمو على حساب السلطة المركزية لدولة الخلافة، فكانت دويلات: الطولونية، والأخشيدية، والسلجوقية، والحمدانية وغيرها ..
إلاّ أنّ ثمّة إشارة هامّة في هذا المجال ، وهي أنّه في ظل احتدام الصراع بين العناصر العربية ، والأخرى الوافدة من غير العربية ، فإنّ البنيان الاجتماعي للدولة ظلّ متماسكا ومحافظا على هويته وموروثه الحضاري التاريخي . فقد استمرّت الأمّة العربية في استكمال تكوّنها القومي ، واستمرّ التواصل والتفاعل الايجابي يحكمان علاقات الأكثرية والأقليات معا. انعكس هذا الأمر على الخيارات التي سلكها المسيحيون العرب بصورة خاصّة ، حيث أظهروا تمسكا شديدا في المحافظة على مواقفهم المناصرة والمؤيدة ، لا بل المتكاملة مع أبناء قومهم من العرب المسلمين .
باختصار مفيد ، ومن زاوية الانصاف التاريخي للمرحلة العبّاسية ، لا سيّما في ضوء التطورات التي رافقت عصورها الأخيرة ، أنّ هذه المرحلة ” لم تعرف إرهابا فكريا او تعصبا دينيا، كما لم تشهد اضطهادا عرقيا أو حروبا طائفية. ثمّ أنّ الاضطهاد كان سلطويا عانت منه الأكثرية بما يكاد يفوق معاناة الأقليات ” (4) .
2-2: الزحف الفرنجي الغربي ( الحملات الصليبية )
تمثّل هذا الزحف بسلسلة من الحملات الصليبية التي استمرّت تتواصل لأكثر من قرنين من الزمن ( بين نهاية الحادي عشر وأواخر الثالث عشر ) ، وهي حملات جنّدتها الكنيسة الأوروبية تحت شعار ” حماية مسيحيي الشرق من الاضطهاد الاسلامي، وتأمين الأمن والسلام للأماكن المقدّسة في القدس وفلسطين ” .
أمّا الدوافع الكامنة وراء هذه الحملات فكانت تهدف الى أوربة الشرق العربي – الاسلامي ، لما يشكّل ذلك من مخرج لأزمة الكنيسة وحكم الأباطرة من جهة ، واللجوء الى خيار المواجهة والصدام المباشر مع الحضارة العربية – الاسلامية من جهة ثانية، وتفويت الفرصة على النهوض العربي من مواصلة الانتشار في غير مدينة في فرنسا والنمسا واسبانيا وإيطاليا وغيرها من جهة ثالثة .
فتحت الحروب الصليبية لمرحلة جديدة من المداخلات الأجنبية راحت تفرض معادلات مختلفة على الحراك السياسي والاجتماعي والثقافي لسائر المكوّنات البشرية والعرقية والطوائفية المتنوعة والمتعدّدة في المجال الجغرافي العربي. فقد أوقع الغزو الأوروبي المسيحيين العرب في حراجة الموقف وتحت ضغط الخيارات بين الانحياز الى أوروبا الغازية التي تمكّنت من تأسيس إمارات نفوذ باللون المسيحي الغربي في عدد من مدن ومناطق الشرق العربي – الاسلامي ، وبين الثبات على هويتهم العربية وموروثهم الحضاري، وانتمائهم الى العروبة بوصفهم مكوّنا طبيعيا من مكوّنات الأمّة العربية. ومن الانصاف القول، أنّهم حسموا خياراتهم. حيث آثروا الوقوف الى جانب بني قومهم العرب بأكثريتهم الاسلامية. الأمر الذي فوّت على الصليبيين توظيف مسيحيي الداخل العربي كنقاط ارتكاز لمشروعهم في السيطرة واستغلال الثروات، من أجل توظيف كل ذلك في تعزيز الموقع العالمي لأوروبا كأحادية قطبية وحضارية مهيمنة آنذاك. فقد رأى المسيحيون العرب ، كما رأى المسلمون أيضا ، أنّ الغزو الصليبي ليس اكثر من عدوان خارجي على الأمّة ومجتمعها وهويتها الحضارية التاريخية .
كانت لهذه الرؤية أهميتها في دفع سائر الجماعات البشرية العربية من عرقية ودينية على اختلافها ، الى إظهار التماسك الروحي (5) والاجتماعي والسياسي. وهو تماسك تجلّى في أمرين بارزين : الأول ، تلاحم عربي اسلامي – مسيحي في مواجهة الغزو الخارجي دلّ عليه عدم حصول مواجهات أو حروب اهلية ذات أبعاد دينية. والثاني ، عدم استجابة المسيحيين العرب للانخراط في مشروع التغريب الذي سعى اليه الصليبيون ، فقد آثروا العربنة خيارا ثابتا على أي خيار آخر (6) .
ما ينطبق على المسيحيين العرب كأقلية قومية في المجتمع العربي في مرحلة الغزو الفرنجي – الصليبي ، ينطبق أيضا على سائر الأقليات العرقية والطائفية الأخرى . فهذا صلاح الدين الأيوبي ، وهو كردي عربي من الموصل، تحوّل الى قائد قومي بارز في قيادته معركة التحرر من الصليبيين، وفي استعادته القدس العربية بعد أن أسرها الصليبيون لنحو من مئة عام .
2-3: الإثنيات العربية في ” نظام الملل ” المملوكي قبيل الخمسينيات من القرن الثالث عشر ، كان المسرح العربي على موعد ، هذه المرة ، مع غزوات وافدة من وراء بوابته الشرقية ، بدأت بغزوة المغول عام 1258 ، الذين دمّروا عاصمة الخلافة بغداد ، وأحرقوا مكتباتها المخزونة بتراث الأمّة العلمي والثقافي . ثمّ كان الغزو المملوكي الذي أقام سلطنة اسلامية شملت الجغرافية الطبيعية والسياسية للأمّة العربية من غير أن تكون قيادتها عربية وبخصوصيتها الاسلامية .
امتدت المرحلة المملوكية لأكثر من قرنين ونصف القرن من الزمن ( 1260 -1516 ) ، أنشأ خلالها المماليك سلطنة تجاوزت في امتدادها الجغرافي المجال العربي الى مناطق بعيدة في غرب ووسط آسيا ، وصولا الى الشرق الأقصى . هذا الانتشار الواسع للسيطرة لم يكن ليتحقّق الاّ من خلال لجوء المماليك الى اعتماد سياسة البطش والقمع للقوى الممانعة لهم من جهة ، والى إضعاف الداخل عبر إحداث الاختلاف والتغاير بين الجماعات الإثنية المحلية من عرقية وطوائفية من جهة أخرى .
لقد شهد المجال العربي ، ولأول مرة منذ الفتح الاسلامي ، إرهابا من السلطة المملوكية الحاكمة ” للأقليات وصل توجيه الحملات العسكرية لقمعها ، فساد الانغلاق والتشرذم بعد طول تفاعل وانفتاح ، كما شهدت المدن فرزا سكّانيا على اساس مذهبي ، بعد ان كان الفرز السكّاني عشائريا وقبليا بصورة اساسية ، فوجدت حارات للنصارى ولليهود ، وللأكراد وللسريان ” ( 7 ) .
كانت الخطوة الأكثر وقعا للمجتمع العربي في ظلّ المماليك، نحو التحسّس بالهوية العرقية أو الطائفية الذاتية، قد تمثّلت باعتماد السلطة المملوكية الحاكمة ” نظام الملل ” في مسعى منها لاستيعاب الإشكال الإثني القائم . ارتكز هذا ” النظام الى منح أتباع كلّ اتباع شريعة سماوية حقّ الاحتكام لشريعتهم فيما لا يتعارض مع أحكام الاسلام . وبهذا اعطيت العصبيات المحلية والطوائف استقلالا ذاتيا في الشؤون الدينية ومعظم الشؤون الدنيوية، وأتيح لنخب العصبيات والطوائف ان يكون لها دور قيادي في طوائفها. كما تسبّب ذلك في تشكّل تكوينات اجتماعية قوامها الطائفة أو ” العرق ” بعد أن كانت القبيلة أو الجبّ أساس المتحدالاجتماعي العربي ” (
لكن ، على الرغم من السياسات المملوكية الدافعة باتجاه التشظّي الاجتماعي والانشطارية بين أكثرية وأقلية من منظور طائفي أو عرقي، إلاّ أنّ النتائج التي افضت اليها هذه السياسات ظلّت محدودة ولم تتطوّرالى رسم خطوط فاصلة على خارطة التقسيم الاجتماعي للمجتمع العربي. أمّا الأسباب التي حالت دون انتعاش الحالة الانقسامية بين أكثريات واقليات فتعود الى أنّ الارهاب والقهر المملوكيين كانا من فعل سلطة بلا جذور في الأرض العربية، وكانت ممارستها للقمع من غير تمييز بين أكثرية أو أقلية .
يضاف الى ذلك، سبب جوهري آخر حال دون تفاقم الإشكال الطائفي أو العرقي داخل الاجتماع العربي، هو أنّ المستجدّات السياسية والأسلوبية المملوكية في تفاعلها مع الجماعات المحلية لم تستطع أن تحدث تغييرات ذات شأن في الثوابت التاريخية الاجتماعية والثقافية والقيمية الرّاسخة . فقد ظلّت التفاعلات الحيّة تتواصل من غير انقطاع أو توقّف ، وكثيرا ما كان الولاء القبلي يتقدّم على أيّ ولاء آخر، وقد برز هذا الأمر بوضوح بين الثنائي القيسي-اليمني ، وهو انقسام لطالما شطر الطائفة الواحدة أو العرق الواحد الى محورين متنافسين، وكان لكل منهما شركاء في الانتساب القبلي من أبناء طوائف أو عرق المحور الآخر. وفي هذا المجال يسجّل للكنيسة الأرثوذكسية العربية التي هي بمثابة المرجعية التمثيلية للغالبية الساحقة للمسيحيين العرب آنذاك ، يسجّل لها احتفاظها بموقفها الصريح الرافض للتغريب، وهو ما تجلّى بوضوح مع رفض بطاركة الشرق الثلاثة المشاركة في مجمع فلورنسا لسنة 1439 م ، فراحوا واجتمعوا في القدس العربية سنة 1443 م ، مقررين بذلك رفض اتحاد كنائسهم مع البابوية في روما (9) .
2 -4 : في المرحلة العثمانية ، الإثنيات العربية بين حاجات السلطنة وامتيازات الغرب الرأسمالي جاءت معركة مرج دابق قرب حلب في شمال سوريا عام 1516 لتحدث تحوّلا استراتيجيا في واقع ومستقبل المنطقة العربية، فقد اندفع العثمانيون المنتصرون على المماليك آنذاك ، الى العمق العربي مؤسّسين لسلطنة عثمانية دامت لنحو من أربعة قرون (1516 -1918)، وهي مرحلة تركت بصماتها العميقة على بنى المجتمع العربي على غير صعيد إداري، واجتماعي، واقتصادي، وثقافي، وسياسي ، وعلى تشكّل الجماعات والهويات والأفكار، ونظم الأرض والملكية ، وعلاقات الانتاج ، والضرائب وطرق الجباية وغير ذلك .
جمعت الدولة العثمانية بين ثلاث ركائز : دينية ، إقطاعية ، وعسكرية .
على المستوى الديني كان الاسلام هو الدين الرسمي للسلطنة بدءا من السلطان الأعلى وانسحابا على سائر مفاصل الهياكل الادارية والأجهزة الدينية في الولايات والألوية التابعة لها ، لكنّ الاسلام في ظل العثمانيين لم يكن يعبّر عن حالة اسلامية روحية ووجدانية بمقدار ما كان عاملا مساعدا ” يسّر لهم الفتح والسيطرة ، وتوظيف الامكانات العربية في خدمة الامبراطورية (10) . فلم يكن عاملا تكوينيا صميميا للقومية التركية كما في الحالة العربية، لذلك ، سرعان ما برزت التمايزات القومية بين عربية وعثمانية مع سلطة مركزية غير عربية من جهة، وعاصمة للسلطنة من غير المدن العربية هي الآستانة أو استانبول التي لم تتبدّل طيلة ما يزيد على الأربعة قرون من جهة ثانية ، وباعتماد التركية لغة رسمية في الدولة والمعاملات الادارية على اختلافها من جهة ثالثة .
ولمّا كانت الاقطاعية – المرتكز الثاني للدولة ، فقد جاءت تطبيقاتها الواقعية في الممارسات السلوكية على مستوى توزيعات الأراضي ، ونظم الجباية الضرائبية ، ورفد ” بيت المال ” أي الخزينة ، وكذلك في توفير العطاءات للجند والانفاق على الحروب وغير ذلك .
ومن أجل تثبيت حكمهم في المقاطعات العربية اعتمدوا على منح قوى محلية نافذة مزيدا من الأراضي لغاية استثمارها من جهة ، وتوظيفها في خدمة نفوذهم كقوى إقطاعية محلية من جهة أخرى . لقد كان لهذا الأمر أثره البالغ على ظهور عصبيات محلية راحت تتمتع بنوع من الحكم الذاتي مقابل دفعها الضرائب المحصّلة من فلاحي وحرفيي المقاطعة الى السلطة المركزية أو لممثليها في مراكز الولايات والألوية التابعة لها .
في أواسط القرن التاسع عشر بدأت الدولة العثمانية تشعر وتدرك الضعف الذي أصاب بنيتها ، هذا الضعف الناتج عن تركيبها الداخلي الذي يتسم بالتعدد والتنوع ، وعن الاختراق الغربي لهذه البنية بدءا من الامتيازات حتى الدَّيْن العثماني (La dette) .
فتحت الامتيازات الأجنبية المتضمّنة مزيجا من الحقوق الدينية والاقتصادية والسياسية والثقافية ، واعترافا من قبل السلطنة بحق الحماية والرعاية ، فتحت أبواب الاختراق الغربي واسعة أمام غير دولة أوروبية لتأسيس مواقع نفوذ داخل مجتمع عثماني تعددي ، واقتصاد كان يدور في فلك التابعية المتزايدة لرأسمالية الاسواق الأوروبية . فقد سهّلت معاهدات الامتيازات التجارة الغربية في الداخل عن طريق مدّ شبكات التسويق الداخلي وتوسيع حلقات التبعية عبر المدرسة واللغة ، الأمر الذي وفّر الفرصة المتاحة لنخب الطوائف المسيحية وشرائح التجّار فيها ، للاحتفاظ بمواقع ممتازة في هرم الثروة والسلطة ، هذا في وقت كان الاختراق الغربي يؤدّي من وجهة أخرى الى تقهقر فئات اجتماعية اكثرها من المسلمين ، وذلك عبر انسحاقها تحت وطأة السلعة الاستهلاكية الأوروبية ، وتحت وتيرة تتجير السلعة الزراعية لمصلحة الاقتصاد الصناعي الأوروبي ، ووقوع الفلاحين في دوّامة الديون للمرابي وملتزم الضرائب ، وقد تمّ هذا أيضا في وقت كان التزاحم فيه على أشدّه بين الدول الأروبية لاكتساب مواقع داخلية في التركيب الاجتماعي – السكّاني الداخلي ، ولإجراء عمليات تقسيم لمناطق الدولة العثمانية بعد دخول الرأسماليات الأوروبية مرحلة التوظيف المالي في الخارج ، ومرحلة السيطرة المباشرة والاستلحاق (11) .
في هذه المرحلة التي احتدمت فيها المواجهة بين سياسة عثمانية احتوائية للجماعات الإثنية على اختلافها عن طريق القسرية والمركزة ، والتي كان يقابلها هجوم أوروبي يسعى لنزع الأطراف عن المركز بهدف السيطرة وتعزيز مراكز النفوذ الغربي في بيئات حاضنة من الأقليات التي راحت نخبها وتجارها ومثقفوها يدورون في فلكه ، هنا ، بدأت تتشكّل جذور واصول التكوينات الطائفية السياسية ، أي بمعناها السياسي والاقتصادي والثقافي المنتظم في مشروع ” دولة ” تبنى تحت وصاية وحماية الغرب التوسّعي ، او تجنح نحو حالة من ” الاستقلالية ” في إطار التبعية الجديدة له (12) .
هكذا ، كان التلازم شديدا بين مشروع راسمالي أوروبي مدفوعا بطموحات كولونيالية للرأسمالية التراكمية للسيطرة والتوسّع في الخارج من جهة ، وبين الملامح الأولية لمشروع قيام ” الدولة الطائفية ” او الدولة ذات الغلبة الطائفية من جهة أخرى . هذه المحاكاة بين المشروعين كانت تفتح الأفق الفكري والثقافي والسياسي بين الجماعات الإثنية العربية الى ” تحويل الوحدة المتنوعة الى وحدات منفصلة ومتناحرة ، وعلى تحويل التعددية المتوازنة في إطار حضارة توليفية واحدة هي الحضارة العربية – الاسلامية الى تعددية تقوم على الاستلاب والتمويه والتشويه الثقافي والانسلاخ عبر قشرة الاستهلاك الغربي عن الأصول والجذور ” (13) .
لقد وجد المشروع الأروبي ركائزه الاختراقية الداخلية في المنطقة العربية الخاضعة للسلطنة ، في سياسة السيطرة على السوق ، وفي تكثيف وتركيز الاختراق الثقافي بين المجموعات المللية عبر النشاط التبشيري والتعليمي ، وفي سياسة الحماية المعلنة لجذب الطوائف المسيحية عبر تحويلها من” ملل” الى ” أقليات ” . هكذا ، تكون الدولة العثمانية قد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها في البلاد العربية ، هي مرحلة نظام الملل الذي اسّس لعلاقات عصبية بين الجماعات المللية ، علاقات ما بين اكثرية عربية إسلامية، واقليات طائفية مسيحية اتاح لها ارتباطها بالغرب ان تتمتع بمكاسب وامتيازات داخل الدولة العثمانية لم تتوفر لسواها من طوائف الأكثرية الاسلامية . هكذا ، بدأت التمايزات بين الإثنيات العربية بين اكثرية مسلمة استمرت تتحمّل اعباء الخدمة العسكرية ودفع الضرائب ، ومن غير ارتقاء اقتصادي او اجتماعي أو ثقافي من جهة ، وبين أقليات دينية مسيحية بصورة خاصّة راحت تشهد ارتقاء على غير مستوى اقتصادي وتعليمي واجتماعي وثقافي من جهة اخرى .
على قاعدة الفجوة الاقتصادية – الاجتماعية بين الإثنيات العربية ، راحت نخب الأقلية من الطوائف المسيحية تطالب بالحماية الأجنبية للمحافظة على ” الحقوق ” المكتسبة وتنميتها ، مع الإدّعاء بالكفاءة للأقليات دون الأكثرية ، ومع المناداة بالتغريب كسبيل لتأمين المستقبل الأفضل ، وأنّ الاسلام والعروبة والانتماء للشرق ليس سوى علّة التأخّر والجمود .
سعت القوى الاستعمارية الأوروبية سواء اكانت دولا أم هيئات اقتصادية واجتماعية أو بعثات تبشيرية وإرسالية أو رحّالة ومستشرقين وسواهم ، سعت الى تفكيك النسيج القومي للمجتمع العربي بهدف إعادة تشكيله على اساس المذهب – الأمّة أو العرق – الأمّة . لجات أوروبا الى تشبيك عدة عوامل من الاقتصاد والاجتماع والسياسة والأفكار والثقافة ، كلّ ذلك من اجل هدف مركزي يتمثّل بتعميم الثقافة اللاقومية بشتى السبل . لقد تمّ تغييب الحديث عن المتحد الإثني باستبعاد التلفظ بكلمة ” شعب ” ، أو بكلمة ” أمّة ” ، وكان المقصود من وراء هذا التغييب التبخيس لا بل الانتفاء لمقوّمات الوجود القومي العربي ، ولعناصر الوحدة في الثقافة القومية العربية .
لكن ، على الرغم من تبلور الظاهرة الانقسامية في الاجتماع العربي بين اكثرية وأقليات عملت الامتيازات الأجنبية على توظيفها وتجنيدها كركائز اختراق لتفكيك السلطنة العثمانية من جهة ، والحؤول دون تطور الحالة الوحدوية القومية العربية من جهة ثانية ، على الرغم من كل ذلك ، فإنّ المشكلة الأقلوية لم تستطع القفز فوق المخزون التراكمي من التأثيرات التاريخية التي كانت تدفع نحو التماسك الاجتماعي والتفاعل عن طريق المجتمع القومي في إطار الأمّة العربية الواحدة . فالمشكلة الأقلوية في المرحلة العثمانية لم تستطع أن تقسم الأمّة بشكل عمودي ، حيث ظلّت الصراعات الطائفية والعرقية في مستوى أدنى من الصراعات الأكثر عمقا . فقد كانت نخب من أبناء الأقليات المسيحية أكثر تقدّما في طروحاتها لمشروع نهضوي قومي يعمل على توحيد الأمة العربية في دولة مستقلة ومتحرّرة ، ليس فقط عن السيطرة العثمانية وحدها ، وإنّما أيضا عن أي نفوذ للدول الأجنبية ومشاريعها الاستعمارية ( النخب التنويرية النهضوية في مصر وفرنسا وأدباء وشعراء المهجر الأميركي وسواهم ) .
ومن الجدير الاشارة اليه في هذا المجال ، هو أنّ ثمّة صراعات برزت في أواخر العهد العثماني لم تكن لتعكس نزوعا نحو التجزئة والتفكيك في المجتمع العربي بقدر ما كانت تعكس تجاوزا للحالة الطائفية أو العرقية . كان هناك النزاعات القبلية بين القيسية واليمنية ، وهي نزاعات ضمّت من سائر الأطياف البشرية من طائفية وعرقية ، وكذلك ، كان هناك الصراعات ذات المضمون الاجتماعي ، حيث كثيرا ما انتفضت قوى فلاّحية وحرفية ( قوى منتجة ) ضدّ القوى المقاطعجية من أمراء وشيوخ وملتزمي الضرائب ، صراعات كانت أكثر تعبيرا عن مضامين اجتماعية – اقتصادية وكذلك طبقية اكثر منها بين أكثرية وأقلية.
يتبع لطفاً..