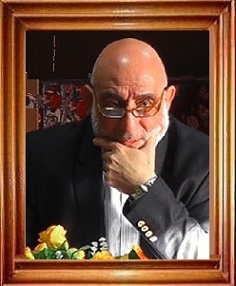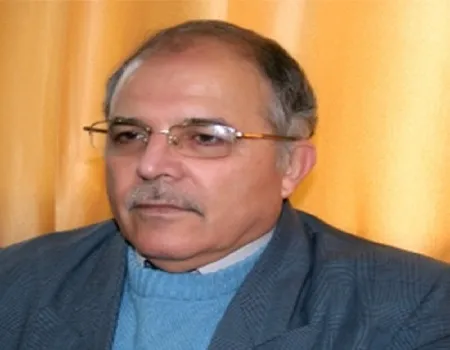فلسطينيو الربيع العربي الثاني: الأسئلة الصعبة

فلسطينيو الربيع العربي الثاني: الأسئلة الصعبة
قبل سنوات، ولدى إدراكي المتأخر أن فرج سليمان ليس لبنانياً، وإنما فلسطيني، شككت في أنه تعمّد الغناء بلهجة قريبة من اللبنانية كي تشتهر أغانيه في بيروت، خاصة بعد الثورة. «الجمهورية نت» نشرت مقالاً أن موسيقى زياد الرحباني كانت الخلفية الموسيقية لثورات سورية ولبنانية وقف ضدها (وهم أن هنالك soundtrack لحياتك، هي فكرة نرجسية، كأن تظن أن حياتك فيلم). بهذا المعنى، فرج سليمان «مريح» لأبناء الثورة، وموسيقاه معتمدة كنشيد رسمي لهم من دون تناقضات بالمواقف.
كان بإمكاني جعل هذا المقال عمومياً وأن أسمّيه: «ما بعد الربيع الثاني: الأسئلة الصعبة». لكنني لست في معرض الحكم على غير الفلسطينيين، هنا نحن بحاجة إلى الانتظار من خمس إلى عشر سنوات، لأن أنجح نواتج الربيع الثاني، وهو تفكيك محور الممانعة، ما يزال حديثاً. وليس هدفي هنا «فلسطنة» النقاش والدخول في بكائيات أن الرفاق المشرقيين خذلونا (ليس هناك شيء اسمه «فلسطنة القضية» أنت تعيش في اقتصاد سياسي إقليمي مفروض عليك وعلى غيرك).
الفكرة الأساسية هنا أنك كفلسطيني تعيش نقطة ضعف دائمة في سياق الصراع بين الفكر اليومي والأهداف البعيدة المدى. أنت ابن «المزمن» ورفاقك هم أبناء «اليوم». حازم صاغية مثلاً -والذي أعتبره العراب الروحي للربيع الثاني- قد يكون بالفعل شخصاً نبيلاً شعبوياً يحب جيل الشباب، لكنه لن يأتي بالخلاص للفلسطينيين (ولمعظم أبناء العالم العربي).
لننظر إلى خصائص الربيع العربي الثاني: الغياب الواضح لـ«الإخوان المسلمين»، التركيز على مناهضة الأنظمة السلطوية وحكم الميليشيات من دون المساس بمصالح الخليج، والانهماك بالحقوق والحريات الاجتماعية. يكتب عامر محسن عن مبدأ معلن على الأقل في الربيع العربي الأول بأن الصراع هو «بين دول وتشكيلات تمثل القوة الأميركية ودول وشعوب تقاومها». أمّا في الربيع العربي الثاني، فالهدف كان «المطالب اليومية»، أي أن تحصل على فُتاتك من منطقة لا تطمح بتغييرها.
لفهم هذه التحوّلات، علينا الدفاع عن النقد الماركسي لمناهضة الإمبريالية، بل ونقد القضية الفلسطينية. لا أقصد هنا النقد المتواطئ، مثل سلافوي جيجك الذي يريد أن يصبح «الحكيم جورج حبش» الخاص بالأوكران وفي الوقت نفسه أن ينصح الفلسطينيين «بالبرود العقلاني»، بل أتحدّث عن الماركسيين الذين حذّروا من مزاحمة معاداة الإمبريالية للأهداف البعيدة المدى للماركسية بشأن الصراع الطبقي العالمي (في الوقت نفسه، فهم هؤلاء أن معاداة الإمبريالية تصبح أولوية قصوى في حالتَي الحرب والإبادة).
ما حدث في سياقنا هو تزاحم «التفكير اليومي العربي» ليس فقط مع أهداف الماركسية، بل مع أهداف معاداة الإمبريالية البعيدة المدى، بحيث أصبح هنالك ألف قضية أخرى تعتبرك «بلا قلب» إذا لاقيتها ببرود فكري.
ما حدث في سياقنا هو تزاحم «التفكير اليومي العربي» ليس فقط مع أهداف الماركسية، بل مع أهداف معاداة الإمبريالية بعيدة المدى، بحيث أصبح هنالك ألف قضية أخرى تعتبرك «بلا قلب» إذا لاقيتها ببرود فكري
أدركت حين احتفينا في الطبقة الوسطى الفلسطينية بالثورة السودانية، أنه من الطبيعي -كفلسطينيين- أن تثلج قلوبنا الحرية «المؤقتة» للآخرين من العرب، خاصة أن ردّ فعلنا العاطفي يأتي في سياق الحرمان من ممارسة السياسة (انتفاضات لبنان والعراق ذكرتنا بانتفاضتنا الثالثة الغائبة). المضحك هنا أن صحيفة «الغارديان» استمرت في هذه السذاجة بعد اندلاع الحرب الأهلية السودانية، وقرّرت عقد مقابلة مع خمس روائيات سودانيات لفهم الموضوع (وكأننا في ندوة أدبية، لا أمام حدث جيوسياسي).
لنضع جانباً شيوع التطبيع في الربيع العربي الثاني (باستثناء الجزائر ذات التاريخ الذي لا يسمح). حتى أكثر الأسس شرعية للربيع الثاني في فلسطين ـــــ مطالب «بدنا نعيش» في غزة ولدى اللجوء الفلسطيني في لبنان ـــــــ استحوذ عليها المحور الإبراهيمي الذي يتظاهر بالإنسانية في خطاب شعبوي فارغ لا يُدخل كأس ماء واحد إلى غزة.
لكن أسوأ إرث للربيع العربي الثاني، هو تبنيه أيديولوجية العدالة الاجتماعية من الاتحاد الأوروبي والحزب الديموقراطي الأميركي، القائم على تعويم لثنائية «القامع والمقموع»، ما خلق تضليلاً معرفياً لم يجهزنا البتة لثنائية القائم بالإبادة والذي يتعرّض للإبادة. إسهام الربيع العربي الثاني خلال الحرب تمثّل في أن تلبس بولا يعقوبيان الكوفية بضعة أشهر قبل أن تنقلب إلى شخصية تجمع بين السوروسية والترامبية (الدعم المطلق لجوزيف عون كالرجل الشعبوي من خارج المنظومة).
إذا كنا سنبدأ بمراجعة أنفسنا نحن الفلسطينيون، فعلينا الاعتراف بأننا ليس كلنا غزيين، وهويتنا لا تجعلنا ضحايا بطريقة أوتوماتيكية؛ نحن مرتاحون وحياتنا اليومية طبيعية في المهجر والداخل وأجزاء من الضفة، والذي يُجرح كل يوم هو «مشاعرنا». بسطار ابن غزة على رأسي لأنه هو في غزة وأنا لست فيها: من هنا يجب أن يبدأ النقاش.
الكل يريد إسقاط نزعته النرجسية على الغزيين، رفاقنا ورفيقاتنا النسويات يعتبرون أن مشكلة المبيد الإسرائيلي هي «الذكورية السامة» (لماذا لا تحلّون مشكلاتكم العائلية بعيداً عنا؟)، ورفاقنا اليساريون الممانعون يقولون: «نحن نُباد من أحمد الشرع كما تُباد غزة، لذلك لا تلومونا إذا هربنا إلى الحضن الإسرائيلي!». ورفاقنا في الثورة السورية يرون في الإبادة الغزية دليلاً جديداً على «المؤامرة العالمية» ضد السنّة. الكل يرى نفسه في غزة، والقليلون يموتون ميتة غزية (وهنا نذكّر بالسيد الشهيد حسن نصرالله).
في العودة إلى فرج سليمان، لنعرج على كاتب أغانيه الروائي مجد كيال. كانت تجربة فريدة متابعة تطور عقل مجد خلال الربيع العربي الثاني. في البداية كان متحمساً لثورة الـ«Me Too» وحراك «طالعات» مشبهاً مواجهتها للذكورية بـ«راجمات الصواريخ». ثم في عام 2020، وجد مجد نفسه محتاراً من رفاقه، فكتب في تفاهة الطبقة الوسطى العربية وحربها الوهمية على العنصرية العرقية بعد مقتل جورج فلويد.
وأمّا بعد الإبادة، أعاد مجد اكتشاف أهمية مناهضة الاستعمار فقال مكتئباً: «أنا أكثر إشي مسلي بنظري هو العرب اللي بعنترو ضد الهيمنة الغربية بالإنجليزي». السؤال هنا يا مجد، ألم تدرك هذا الكلام في السنين السابقة، عندما كانت السكين قريبة جداً من الرقبة، وكنتم منهمكين في ما يسمّيه عوني بلال مشروع تعريب قاموس «لا حرية لمجتمع قبل حرية الفرد»؟
* كاتب فلسطيني