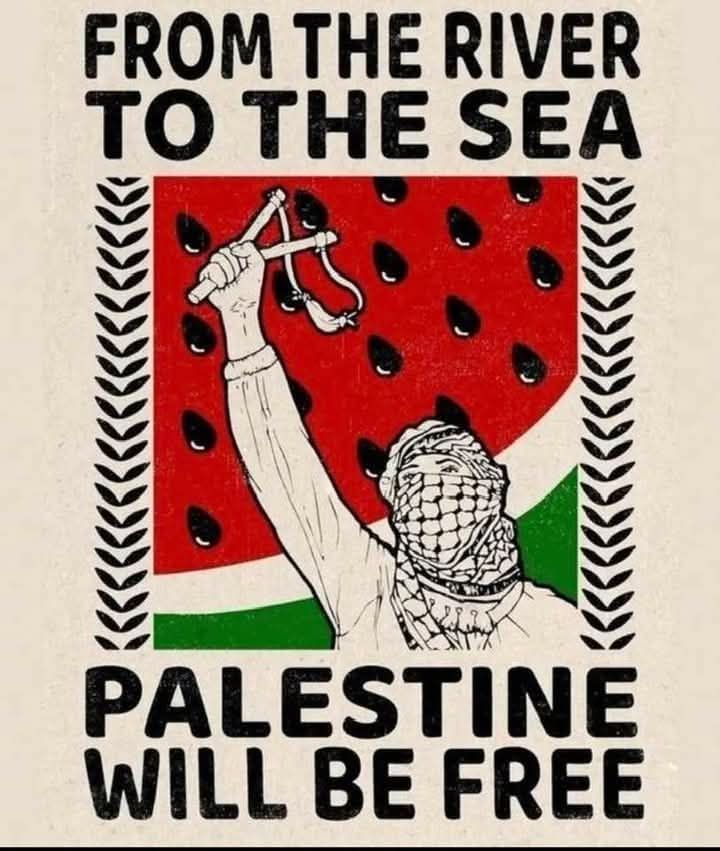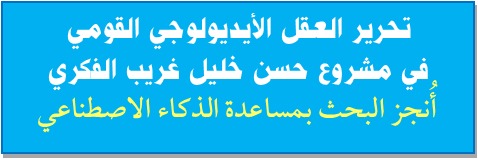الإِثنِيَّات فِي الوَطَنِ العَرَبِيّ
بَيْنَ تَوظِيفِ الخَارِج لِلتَّجْزئةِ، وَتَعْمِيقِ الِانْدِمَاج
في الِاجْتِمَاعِ الوَطَنِي وَ القَوْمِي
– الجزء الثالث –
أ.د. محمد مراد، باحث وأستاذ جامعي
3- بعد احتلال العراق : الإثنيات بين الحروب المفتوحة وتعاظم خيارات الفدرلة والتقسيم
فتح الاحتلال الأمريكي للعراق في نيسان ( إبريل ) 2003 المجال العربي السياسي والاجتماعي والثقافي أمام مرحلة جديدة تقدّمت فيها النزعات الإثنية لا سيّما الطائفية منها المشهد ، إذ راحت الجماعات الطوائفية والمذاهبية تعمل على شدّ عصبها الطائفي – المذهبي من جهة، وتسعى الى تضمين خطابها السياسي طروحات عالية النبرة تربط بين مذهبها الإثني وشكل الدولة التي تتناسب مع طموحاتها وخصوصياتها من جهة أخرى .
بدأت العصبيات الإثنية تأخذ مساراتها التصاعدية كظاهرة لافتة إنطلاقا من العراق لتنسحب بعده الى غير قطر من إجمالي إثنين وعشرين قطرا هي مجموعة الدول المنضوية في جامعة الدول العربية . أربعة عوامل أسهمت في فورة العصبيات الإثنية التي انفجرت في حرب دموية في العراق تحت الاحتلال هي:
الأول، إسقاط نظام البعث الوطني لما هو نظام علماني ينشد حضور وقوة الدولة والجيش والقضاء والتعليم والسياسة الخارجية وسائر المؤسّسات، مع تعزيز وتعميق الوحدة الوطنية لكل ابناء الشعب العراقي والقائمة منذ تاسيس الدولة العراقية عام 1921، اضافة الى الانطلاق من منظور النظرية القومية المعاصرة التي أطلقها حزب البعث في سائر مؤتمراته القطرية والقومية منذ مؤتمره التأسيسي الأول في السابع من نيسان ( إبريل ) لعام 1947 .
كانت الخطوة الأولى لحاكم العراق الأمريكي ” بول بريمر ” قد تمثّلت بإصدار قانون ” اجتثاث البعث “، وهو إجراء تظهر أبعاده الدّالة من المصطلح الذي أعطي له ” اجتثاث “، والذي يعني، ليس فقط، حلّ التنظيم الحزبي الذي كان يضمّ أكثر من 3.5 ملايين عضو ومنتسب الى الحزب، ويمتدون في كل النسيج الاجتماعي والثقافي والاداري والسياسي في العراق، وإنّما، وهذا الأخطر، في اقتلاع ومحو الفكر العروبي والتجربة الوطنية التي رسّخها حزب البعث في قيادته للدولة، التي تواصلت على مدى خمس وثلاثين عام بين1968- 2003
كان الهدف الأمريكي من الاجتثاث إزالة الموانع أمام بروز العصبيات الإثنية وخصوصا المذهبية، الأمر الذي يجعل من هذه العصبيات المذهبية ان تستنفر بشأن تحديد مواقعها وأحجامها في هياكل السلطة الجديدة التي ستتولى حكم الدولة مركزية كانت أم فدرالية أم مقسّمة الى كيانات سياسية على أساس مذهبي أو عرقي أو جهوي مناطقي، تمهيداً لتقسيم العراق.
العامل الثاني، يتمثّل بإعداد ” بريمر ” لدستور عراقي يجعل من العراق دولة اتحادية ( فدرالية ) تضمّ 18 محافظة ( 3 للأكراد، 6 للسنّة، 6 للشيعة و3 مختلطة في الوسط )، هذا ومنح الدستور الجديد حقّ كل محافظة في الحصول على حكم ذاتي إذا ما صوّت أكثرية اعضاء مجلس المحافظة على ذلك. هكذا، فإنّ دستور الاحتلال هو بمثابة تأسيس لقيام فدرالية عراقية بديلة للدولة المركزية التي نشأت في العام 1921 واستمرّت حتى العام 2003 .
العامل الثالث، هو الانقلاب الذي أحدثه الاحتلال في تركيبة السلطة الحاكمة باتجاه تطييفها. إنّ الهدف الأمريكي من هذا التطييف السياسي للسلطة يكمن في اعتماد النموذج اللبناني الذي تقاسمت فيه الطوائف والمذاهب الدولة، وجعلتها
دولة أنصبت على قاعدة المحاصصة التي كانت السبب الأساس وراء سلسلة الأزمات التي تواصلت في تاريخه الحديث والمعاصر، والتي باتت في الوقت الراهن تدفع بالكيان اللبناني مجتمعا ودولة نحو خيارات الفدرلة والتقسيم .
العامل الرابع، كان الدور الإيراني الذي وجد في احتلال العراق، وفي التغييرات الحاصلة على مستوى تكريس الطائفية الموالية له في قيادة الفدرالية العراقية، وجد فرصته الذهبية في إمساك العراق وتوظيفه في الاتجاه الذي يخدم التوجهات الايديولوجية الدينية والجيوبوليتيكية الايرانية، ذلك أنّ السيطرة على العراق تكسر الحاجز البري الذي شكّله العراق تاريخيا، والذي حال دون اندفاع إيران لتحقيق اهدافها التوسعية الى سوريا ولبنان وصولا الى السواحل الشرقية للبحر الأبيض المتوسط، بما يسمح باستعادة أمجاد امبراطورية فارس القديمة .
هكذا، فتح احتلال العراق لمرحلة حافلة بالنزاعات الإثنية، وبصورة خاصّة الطائفية، بحيث راحت هذه النزاعات ترسم حدودا فاصلة بين المذاهب ، ” هي حدود الدم ” التي بدأت في العراق مع الاحتلال، ولم تلبث أن جرى تصديرها الى لبنان، والبحرين، والكويت، والسعودية، واليمن، في حين شهدت الأقطار الأخرى انتعاشا لنزاعات إثنية طائفية (السودان، مصر)، وعشائرية ( ليبيا، الصومال، موريتانيا)، ولغوية ثقافية (الأمازيغية في كل من الجزائر والمغرب).
3 -1: نماذج من تعبيرات تفاقم النزاعات الطائفية بعد احتلال العراق
تجلّت ظاهرة التفاقم في النزاعات الإثنية بغلبتها الطائفية – المذهبية في العديد من أقطارالوطن العربي في أعقاب الاحتلال الأمريكي للعراق، بالكثير من المظاهر التي كانت تتصاعد بهدف إحداث أزمة بنيوية في مجتمع الدولة القطرية العربية، لدفعها نحو الإضعاف والتفكيك، وصولا الى خيارات غير محسوبة من الفدرالية الموسّعة والتقسيم الى كيانات جزئية .
في العراق، سعى الاحتلال لتسويق ” طائفية نظام البعث “، الأمر الذي دشّن لسلسلة من الأفعال الكيدية والانتقامية طالت العديد من منتسبي البعث ومناصريه وعوئلهم من جميع الطوائف سنّة وشيعة ومسيحيين وأكراد وسواهم . وتصاعدت أعمال العنف ضدّ كل أشكال التنظيم الحزبي للبعث، واتخذت أساليب بالغة الشدّة من مثل لجوء ميليشيات طائفية مرتبطة بايران، مدعومة ومغطّات من قوّات الاحتلال، الى ارتكاب مجازر وتصفيات جماعية بحقّ العناصر البعثية أو السوق بها الى التغييب القسري والمعتقلات السرية .
وجدت تلك الميليشيات المسلّحة مبرراتها في أفكار روّج لها وغذّاها الحاكم الأمريكي ” بول بريمر ” دستوريا ومؤسسيا . فقد ذّكّرت ديباجة الدستور الجديد بمعاناة طائفة معينة دون غيرها في ظل نظام البعث، وسمّيت في المتن ممارسات شعائرها الدينية وأوجب الدستور احترامها ( 26)، في حين لم تخصّص للطوائف او الأقليات الأخرى من أشوريين وأزيديين وصابئة وغيرهم بأي ذكر بخصوصية كل منها. وكانت سياسة الاحتلال قد انتقلت الى الترجمة التطبيقية عندما قدّمت الفئات الطائفية الموالية لايران في جميع الهياكل المؤسسية للدولة العراقية وبحصّة تمثيل فاقت ضعفي العرب الاخرين استنادا الى تقديرات أطلقت جزافا من غير الاستناد الى إحصائية علمية ذات ثقة يعتدّ بها. وفي النظام البرلماني الجديد، جعل من رئيس الوزراء المترشح عنها الحاكم الأقوى الذي يتمتّع بصلاحيات دستورية وتنفيذية وبكونه القائد العام للقوات المسلّحة .
في اليمن، انطلقت الاعتراضات الزيدية من إقليم صعدة معقل الزيدية اليمنية، ثمّ مالبثت الاحتجاجات أن اتخذت شكل التنظيم المجدّد للزيدية بوصفها مذهبا متمايزا راح يدعو الى الإمامة وتقويض النظام الجمهوري القائم منذ عام 1962، والى الترويج لمذهبه في تطبيقاته الأيديولوجية والسياسية الإيرانية .
بدأ التمدّد الزيدي بقيادة حسين الحوثي ( خلفه بعد مقتله أخوه عبد الملك الحوثي ) منذ عام 2004 أي بعد أقلّ من سنة واحدة على احتلال العراق . راح التمرّد ينمو باضطراد ” على أرضية طائفية في الأساس، اي على أرضية الخلاف بين منطق تثبيت يمنية المذهب الزيدي من جهة، ومنطق نقل التجربة الايرانية وإعمال مبدأ ولاية الفقيه من جهة أخرى. ” ( 27)
في البحرين ، أدى المناخ المذهبي المسيطر على المنطقة برمتها منذ العام 2003، الى تحويل كل نقاش سياسي داخل مجلس النوّاب البحريني الى توتّر ديني طائفي من غير اعتبار الى حجم وأهمية القضية أو مجموعة القضايا المطروحة للنقاش. فقد ظلّ الاستقطاب المذهبي هو الحدث الأبرز الذي طال سائر قضايا المجتمع والسلطة والدولة، حتى وصل الأمر الى إثارة مشكلات في غاية الحساسية من مثل تأسيس ” هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، والموقف من المقاومة الوطنية العراقية، وحتى الفقر والبطالة، كما طال أيضا قضايا أخرى من مثل قضية تجنيس مواطني دول الخليج بالجنسية البحرينية ” ( 28 ) .
في الكويت ، اخذت العلاقات المجتمعية تشهد، بعد احتلال العراق، تطورات ذات منحى مذهبي – سياسي، إذ كانت القضايا البرلمانية المثارة داخل مجلس الأمّة الكويتي ( البرلمان )، بدءا من قضية تقسيم الدوائر الانتخابية وأثرها في الإخلال بالتوازن الديمغرافي المذهبي، وانتهاءً بقضية تدريس فقه معين دون غيره، الذي وصف بأنّه فقه الأغلبية في المدارس والجامعات، كلّها قضايا ونقاشات كانت تدور في محاور للاصطفاف الطائفي والشحن المذهبي المقرون بعنف الخطاب السياسي والذي يدفع بالمجتمع الكويتي الى رسم خطوط تماس بين المواطنين المسلمين، والتي من شانها أن تدفع نحو الانقسام والتفكّك على غير صعيد اجتماعي وسياسي وثقافي .
في السعودية، لم تكن الاصطفافات المذهبية ببعيدة عن دولة فيها هي الاخرى تركيبتها الإثنية الديمغرافية من ناحية، وعن موقعها المجاور على الضفة الغربية للخليج العربي لكل من إيران والعراق واليمن من ناحية أخرى. ففي وثيقة أعدّها نحو 250 شخصية من الرموز المجتمعية من السعوديين، ورفعوها الى العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز عام 2003 ، وقد جرت مناقشتها بلقاء جمع الملك وولي العهد ب 18 شخصا من موقّعي الوثيقة . ادت الى مظاهر الانفتاح للدولة على تلك المطالب فيما يخص الممارسات الدينية المذهبية، وإصدار مطبوعات …ألخ. لكن اندلاع حرب اليمن والانخراط الايراني الطائفي فيها، زاد من حساسية العلاقة المجتمعية داخل المملكة، بحيث كادت ان تنحو نحو تعقيدات داخلية على غير مستوى سياسي واجتماعي وديني .
في لبنان، عادت الاصطفافات الطائفية السياسية على أثر اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في 14 شباط ( فبراير) 2005، وهو الشخصية البارزة ليس على صعيد انتمائه الديني وحسب، وإنّما على الصعيدين العربي والدولي بصفته زعيم سياسي ورجل أعمال ساهم في اعمار لبنان، وله موقع مؤثّر في تركيبة السلطة والدولة بعد انتهاء الحرب الأهلية، والتوصّل الى تسوية الطائف للوفاق الوطني عام 1989، وهي التسوية التي أوقفت الحرب ميدانيا دون أن توقف تداعياتها وإفرازاتها. أفضت وثيقة الطائف الى دستور جديد للدولة اعاد توزيع السلطة والصلاحيات والمسؤوليات على اساس طائفي -مذهبي سواء على مستوى الرئاسات الثلاث ( الجمهورية، النوّاب، الوزراء )، أو على مستوى المناصفة بين المسلمين والمسيحيين لأعضاء المجلس النيابي بحصة 64 نائبا لكل مجموعة طائفية .
أعقب اغتيال الحريري سلسلة اغتيالات شملت رموزا بارزة في فريق 14 آذار المعارض لسوريا وحزب الله وامتداداته الاقليمية. ففي 7 أيّار ( مايو ) 2008 ، كاد لبنان ان يفتح لمرحلة جديدة للحرب الأهلية، لكن تدخّلا عربيا قادته دولة قطر هذه المرة، حيث تمّ التوصّل الى تسوية الدوحة التي نزعت فتيل الانفجار لكنّها لم توقف سلسلة الأزمات اللبنانية التي تواصلت، والتي لم تلبث أن انفجرت بشدّة، وما تزال منذ تشرين الأول ( أوكتوبر ) 2019، بين محورين: احدهما بقيادة حزب الله وامتداداته الاقليمية، والآخر محور معارض يرفع شعار ” السيادة واستعادة الدولة والاستقلال ” .
في سوريا، اتخذت النزاعات الإثنية الطائفية والعرقية طابع الحرب الأهلية بين المكوّنات الدينية والاثنية المحلية. اندلعت الحرب في مطلع آذار ( مارس ) 2011، ولم تلبث أن تطورت الى صدامات مسلّحة ساخنة مع ظهور تنظيمات تكفيرية مصنّعة مخابراتيا من جهات دولية وإقليمية، وتحت مسمّيات ” تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام ( داعش )، و”جبهة النصرة “، و”فتح الشام”، إضافة الى ” قوات سوريا الديمقراطية “، وهي عبارة عن ميليشيات كردية سورية مسلّحة .
لم يلبث المشهد الحربي في سوريا أن انفتح أمام تدخّلات دولية وإقليمية متعددة من زاوية المصالح والحسابات الاستراتيجية. دوليا كان التدخل العسكري الروسي المباشر بدافع الحفاظ على المرافىء السورية على المتوسط كمحطات لتسويق الغاز الى أوروبا، وإقليميا كانت إيران الدولة الأكثر تحشيدا لعناصر محاربة إيرانية وعراقية وشيشانية ولبنانية (حزب الله). بالمقابل كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتموضع عسكريا في مناطق الثروة النفطية في شرق الفرات، كذلك كان لتركيا بأيديولوجيتها الإخوانية ( إخوان مسلمين ) أسبابها الدافعة الى التدخل العسكري لمنع قيام كيان سياسي كردي محادد لها، الأمر الذي تخشى معه أن يتطور الى قيام دولة كردية كبرى في المربع الكردي الإقليمي الذي يجمع أكراد سوريا وتركيا والعراق وإيران .
وإذا كانت حروب الإثنيات الطائفية والعرقية في اقطار العراق ولبنان وسوريا واليمن والبحرين قد أفضت الى نتائج غير مسبوقة في حسابات الضحايا البشرية ، وفي تهديم بنى الدولة وتدمير الروابط الاجتماعية والثقافية والتاريخية، فإنّ ” الفوضى الخلاّقة ” التي بشّر بها الرئيس الأمريكي ” جورج بوش الإبن ” بعد احتلاله العراق، لم تلبث أن باتت شعارا نافذا على أرض الواقع في مصر
وتونس والجزائر وليبيا والسودان وسائر اقطار الوطن العربي ونظامها الاقليمي، الأمر الذي باتت معه هياكل هذا النظام، في حال عدم تدارك العرب للامر، على عتبة تشكّل جديد لنظام إقليمي يستجيب لاستراتيجيات استعمارية وصهيونية متجددة لتفكيك عرى الروابط القومية والتجزئة السياسية والاجتماعية والثقافية، وإعادة تركيب جغرافيات سياسية تستجيب لمصالح الخارج الدولي والإقليمي في التوسّع والسيطرة والتغوّل على حساب الوحدة الوطنية للدولة القطرية (الدائرة الصغرى) وتفاعلها مع الدائرة الكبرى أي الدائرة القومية المجسّدة لوحدة الأمّة العربية وقيام مجتمعها الوحدوي التحرري النهضوي .
4- في التكلفة العالية للصراعات والحروب بين الإثنيات العربية
إذا كانت الصراعات والحروب على اختلافها تسجّل تكاليف وأثمانا بشرية ومادّية في غير مكان من أماكن حدوثها، فإنّها في الحالة العربية تتجاوز سقوفا قياسية في حسابات التكلفة الباهظة، والسبب المركزي الذي يكمن وراء الفداحة في التكلفة، فإنّما يعود الى الشحن النفسي والتعبئة الدينية (الطائفية) التي يتحول معها الاستعداد للمواجهة الى أيديولوجيا ضاغطة على الفكر والسلوك والممارسة القتالية .
يضاف الى الأيديولوجيا كمحرّك نفسي في الصراع الإثني ” الطابع الأخطبوطي لشبكات العنف، وسهولة التنسيق بين الفروع والأعضاء بفعل الثورة الاتصالية، والتغطية الإعلامية الواسعة لنشاط تلك الشبكات على نحو ييسّر لها أعمال التعبئة والتجنيد، هذا فضلا عن اشتداد التعصّب للطائفة والمذهب بفعل انتعاش الانتماءات الأولية(29)، مقابل تراجع وانحسار الروابط الاجتماعية وانهيار الثقافة الوطنية .
في لبنان، قدّر عدد ضحايا الحرب الأهلية التي تواصلت على مدى خمس عشرة سنة بين عامي 1975 – 1990 بحوالي 130 ألف قتيل، و207 آلاف جريح ، و170 ألف مفقود، وتعرّض ما بين 700 الى 750 ألفا للتهجير القسري الداخلي، وزهاء 400 ألف آخرون للهجرة الى الخارج (30).
في العراق، جاء في صحيفة ” لانسيت الطبية ” في عددها الصادر في 6 تشرين الأول ( أوكتوبر) لعام 2006، أي بعد مضيّ ثلاث سنوات على الاحتلال الأمريكي، أنّ عدد القتلى العراقيين بلغ 655 ألف عراقي، هذا واشارت الصحيفة
الى مصاعب في البحث تعود الى الأوضاع الأمنية الشديدة التوتر، بحيث لم يتمكن الفريق الباحث من إدراج حالات كثيرة للقتل الجماعي، أو عدم رصدها بدقّة، وهذا ما حصل فعليا مع أحداث العنف الشديد التي تلت تفجير مرقدي الإمامين علي الهادي وإبنه حسن العسكري في سامرّاء. وانتهت الصحيفة الى وصف ما يجري في العراق بأنّه ” يعدّ النزاع الأكثر دموية في العالم في القرن الحادي والعشرين (31) .
وفي تقرير آخر لبعثة المساعدة الموفدة من الأمم المتحدة للعراق في تشرين الأول ( أوكتوبر ) 2006، اشار الى أنّ القتلى المدنيين في هذا العام وحده بلغ 34452، والجرحى 36685، في حين أنّ عدد المهجّرين في داخل العراق قفز من 800 ألف عام 2003 الى 1.024 مليون في عام 2006، وأنّ عدد اللاجئين العراقيين الى الخارج بلغ 500 ألف لاجىء لحين اعداد ذلك التقرير، اعقبته ملايين عديدة في السنين اللاحقة.
بين الأسباب الدافعة الى تعاظم العنف في العراق في اعقاب الاحتلال، تلك التي تعود الى اختراق الميليشيات الطائفية التي جنّدتها قوى السلطة الحاكمة في ظل الاحتلال، أجهزة الأمن، بل المشرفين على هذه الأجهزة أنفسهم ( نموذج باقر صولاغ وزير الداخلية آنذاك )، وهناك أيضا المرارة التي ولدتها صراعات ما بعد الاحتلال في نفوس العراقيين من جرّاء تسريحهم من وظائفهم المدنية والعسكرية، بالاضافة الى تهميشهم سياسيا وخدماتيا، كلّ ذلك أدّى الى عوامل عنف الفعل وردّ الفعل الطائفي (32) .
في اليمن، سجّلت أعمال العنف في الحرب الأهلية التي انفتحت بين الجماعة الحوثية وقوى السلطة المحافظة، سجّلت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من المواجهات في العام 2004، ما يزيد على 400 قتيلا، وخلال اسبوعين فقط من شهر نيسان ( إبريل ) 2005 ، 280 قتيلا، وخلال أول شهرين من العام 2007، ما يزيد على 700 شخص (33). ولم تلبث ضحايا الصراع المذهبي أن شهدت ارتفاعا مضطردا، لا سيّما بعد أن توسّعت مساحات الاشتباك من إقليم صعدة (إقليم البداية) لتشمل تسعة أقاليم في العام 2007، ثمّ لتشمل سائر الجغرافية الادارية اليمنية، ولتنتقل الى الدول المجاورة من خلال حرب الطائرات المسيّرة والصواريخ البالستية الدقيقة والذكية، والتي طالت غير مدينة ومنشأة في المملكة العربية السعودية، وكذلك في دولة الامارات العربية المتحدة .
في سوريا، وهي اكثر الساحات العربية (بعد العراق) اشتعالا في حروب مذهبية وعرقية تشابك فيها المذهبي والعرقي السوري مع الأيديولوجي المذهبي الإيراني والتركي، مع التوظيف الجيوسياسي الدولي الأمريكي والروسي . ومع انّه لم تتوفّر دراسة تتمتع بالثقة الاحصائية، إلاّ أنّ الخسائر البشرية فاقت مئات الآلاف من الضحايا، وموجات الهجرة واللجوء الى الخارج بلغت الملايين الى لبنان والأردن ودول الخليج العربي، وكذلك الى غير دولة أوروبية وعالمية أخرى .
إنّ انتعاش الصراعات الإثنية لم يتوقف على اقطار المشرق العربي وحدها، وإنّما طال أيضا اقطارعربية اخرى هي مصر وليبيا والسودان وتونس والجزائر والصومال والمغرب .
وازاء كل هذه التحديات الوجودية التي تواجهها الامة العربية ، ما هي الخيارات و الآليات المتاحة امامها لاحتواء تداعيات الحروب والنزاعات الإثنية ؟.
هذا ما ستتم مناقشته في الجزء الرابع.
يتبع لطفا..