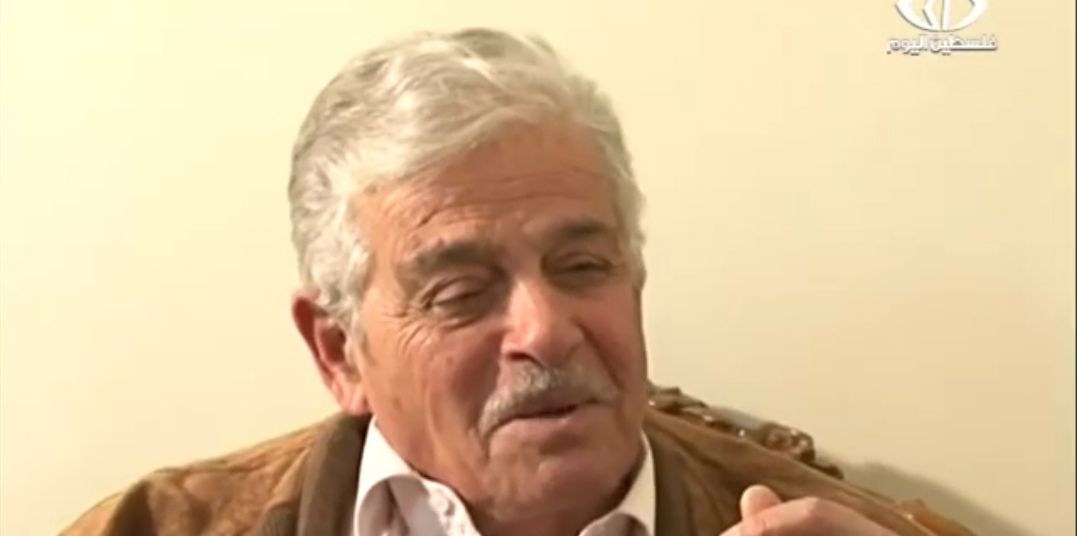سحر الهوية وخطرها: عن تسييس الانتماء وتحويله إلى أداة صراع بقلم أ. طارق عبد اللطيف أبو عكرمة-الهدف السودانية –
بقلم أ. طارق عبد اللطيف أبو عكرمة-الهدف السودانية -
سحر الهوية وخطرها: عن تسييس الانتماء وتحويله إلى أداة صراع
أ. طارق عبد اللطيف أبو عكرمة-الهدف السودانية –
في لحظات الانهيار الوطني، تصعد الهوية من عمقها الوجودي لتتخذ هيئة رمح سياسي يُغرَز في جسد المجتمع، لا لتوحيده بل لتشريحه. يصبح الانتماء، الذي كان يوماً مصدرًا للمعنى والدفء والرسوخ، أداة حادة لإعادة إنتاج الانقسام، ومسرحًا لتصفية الحسابات على رقعة الجغرافيا والتاريخ. وفي السودان، البلد الذي وُلد من رحم التنوع، لم تُعامَل الهوية كنعمة حضارية قابلة للنسج في نسيج وطني جامع، بل تحوّلت إلى لعنة معلّقة فوق رأس الدولة، تُستدعى في كل أزمة لا كوسيلة للفهم، بل كسلاح للفصل، والإقصاء، وإعادة التوزيع القسري للانتماء.
هذا التحول لم يكن قدرياً ولا عفوياً، بل صُنِع بعناية، ضمن مشروع طويل الأمد من الاستغلال الأيديولوجي للانتماءات العرقية والدينية والثقافية. تحوّلت الهوية، في المخيال الجمعي، إلى ساحة صراع مفتوحة، لا ميداناً للتفاعل الخلّاق. وأُفرغت من بعدها الإنساني لتُعاد قولبتها في شكل سياسي، يخدم هيمنة طبقة أو سلطة أو جماعة، ويُشرعن الظلم باسم التاريخ، ويُفرغ العدالة من معناها تحت لافتة الاعتراف بالخصوصيات.
الهوية، في جوهرها الفلسفي، ليست قالباً جامداً، بل سيرورة حية، تتشكل في فضاء اللغة، والذاكرة، والتاريخ، والانتماء إلى المكان والناس. هي سؤال مفتوح أكثر منها إجابة مغلقة. غير أنها حين تفشل النخب في تقديم مشروع وطني جامع، تصبح الهوية بديلاً عن السياسة، لا مكملاً لها. حين يغيب العقد الاجتماعي، يتم استدعاء الهوية بوصفها نقطة ارتكاز وجودي، لكنها سرعان ما تتحوّل إلى جدار فاصل، لا جسر تواصل. في التجربة السودانية، تبدو الهوية وقد تمّت مصادرتها على يد ثلاث قوى:
أدلجة الدين حتى صار معياراً للمواطنة.
قراءة عنصرية للإثنيات جعلت بعضها مركزاً وبعضها هامشاً.
تحويل اللغة إلى أداة فرز رمزي بين النقاء والخيانة.
هكذا، لم تُترك الهوية لتتطور بحرية، بل أُسِرَت في قوالب أيديولوجية. لم تكن مشروعاً ثقافياً مفتوحاً، بل بُنيت كـ (تقنية هيمنة)، كما يقول ميشيل فوكو، تُعيد إنتاج السلطة لا توزيعها، وتُغذّي الانقسام لا تتجاوزه.
في السودان، لم تَعُد الهوية أداة فهم الذات، بل صارت أداة لتفكيك الجماعة. تم تقسيم الخرائط السياسية والاجتماعية وفق خطوط إثنية ومناطقية، فاختُزل الإنسان في قبيلته أو ديانته أو لغته. وتشكلت الأحزاب، وصيغت التحالفات، ووُزعت المناصب، ليس على أساس الكفاءة أو المشروع، بل على أساس من ينتمي إلى أي جماعة. تحوّلت الهوية إلى عملة سياسية تُتداول في سوق النفوذ، ومجرد وسيلة لضمان الحصص في وطنٍ يتحلل تحت وطأة التنافس الإثني المستمر.
لكن الأخطر من كل ذلك، هو أن الدولة لم تكن مجرد ضحية لهذا الانقسام، بل كانت فاعلاً رئيسياً فيه. منذ لحظة الاستقلال، فشلت الدولة السودانية في أن تعرّف نفسها كمشروع وطني يعلو على الانتماءات الأولية. لم تكن دولة ما بعد الاستعمار، بل كانت امتداداً له. بدلاً من أن تُبنى الدولة على مفهوم (المواطنة الجامعة)، أُعيد تأسيسها على قاعدة الهيمنة المركزية، حيث السلطة والثروة والثقافة تحتكرها جهة، ويُطلب من بقية المكوّنات أن (تتأدب) سياسياً كي تُعترف بها.
وهكذا، لم تكن الحرب في الجنوب، ولا في دارفور، ولا في جبال النوبة أو النيل الأزرق، مجرد تمردات مسلحة، بل ارتدادات طبيعية لفشل مشروع وطني لم يعترف بالتعدد كمكون تأسيسي. وبدل أن تستجيب الدولة للمطالب السياسية والاقتصادية والثقافية بعدالة، عمدت إلى تخوين تلك المطالب وتصنيفها كأجندات انفصالية، ما دفع بالمطالب المشروعة إلى هوامش الخطاب، وأدى إلى إنتاج مقاومات مسلحة لا تهدد السلطة فحسب، بل تهدد شرعية الوطن ذاته.
في هذا السياق، تتحوّل الهوية إلى سحر قاتل، تمنح الفرد وهم الانتماء، لكنها تسلبه قدرته على التفكير خارج حدود (نحن) و(هم). تخلق وهم الصفاء، لكنها تبني جحيماً دائماً من الريبة والتهديد. تُبسِّط المعقد، لكنها تختزل الإنسان في صفة، وتُلغي تعدده، وتُحوِّله إلى مقاتل بالرمز بدل أن يكون مواطناً بالمشاركة.
وهنا تكمن المفارقة، في أن أخطر الحروب ليست تلك التي تُخاض بالرصاص، بل تلك التي تُزرع في الذاكرة، ويتم توريثها عبر الأجيال كـ (حق مقدَّس) أو (ثأر قومي). الحرب تنتهي بتوقيع، لكن خطاب الهوية المسلّح لا ينتهي إلا بتحطيم المخيال الجمعي، وإعادة إنتاجه بلغة جامعة تعترف بالكل، لا تقهر الجزء.
الخروج من هذا الفخ لا يتم عبر محاربة الهويات، بل عبر تحييدها سياسياً وإطلاقها ثقافياً. فالمطلوب ليس أن نتجاوز الانتماءات، بل أن نحرّرها من وظيفتها السياسية كآلية لتوزيع النفوذ. المطلوب هو أن يُعاد تعريف المواطنة لا كغطاء قانوني هش، بل كفكرة وجودية تُؤَسَّس على الاعتراف، والمشاركة، والمساواة. والمطلوب أيضاً، أن تُبنى الدولة السودانية على أسس جديدة:
- التأكيد على وحدة السودان شعباً وجغرافيةً وتاريخاً ومصيراً.
- أن تكون العدالة الاجتماعية مقدمة على المحاصصة.
- وأن تكون التنمية حقاً لا منة، تُوزَّع لا بحسب الجغرافيا، بل بحسب الحاجة.
- أن يُعاد الاعتبار لسردية وطنية تُكتَب من كل الجهات، ويُعاد فيها إدراج المنسيين لا تغييبهم.
أن تُكتَب الهوية السودانية لا بلغة الدم أو العرق أو التاريخ المنتقى، بل بلغة الإنسان الحيّ الذي يسكن في كل جهات السودان، ويصنعه لا بوصفه ميراثاً، بل بوصفه مشروعاً.
في النهاية، الهوية ليست جريمة، لكن تسييسها هو الجريمة الكاملة. وما لم تُفكَّك هذه الآلية، سيبقى السودان عالقاً في دورة لا تنتهي من الحروب الأهلية الرمزية والمسلحة. لن تنقذه اتفاقيات محاصصة، ولا دساتير فوقية، بل ثورة في الوعي والمخيّل، ثورة تعيد للهوية معناها الإنساني، وتُخرجها من قبضة السياسي إلى رحابة المجتمع. السودان لا يحتاج إلى حروب جديدة باسم الانتماء، بل إلى شجاعة أخلاقية تعيد تعريف الوطن لا كميراث إثني، بل كعقد إنساني، يجمع المختلفين لا على الرغم من اختلافهم، بل بفضله.