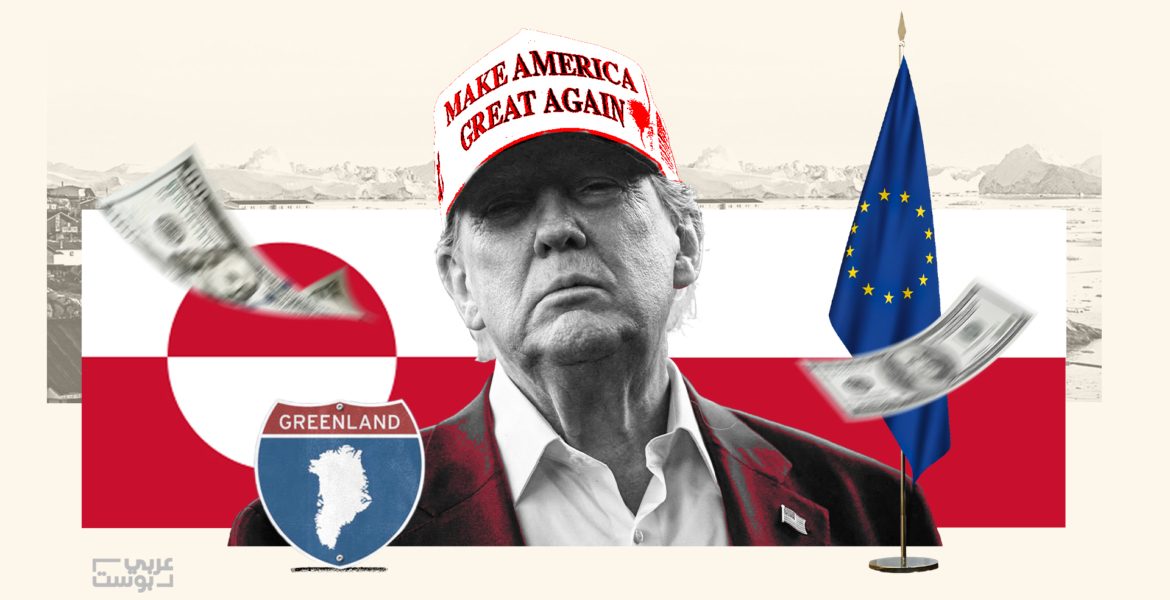في إريتريا المسلمون أكثرية لكنهم مضطهدون.. نظرة على “كوريا الشمالية الإفريقية” التي يطمح العالم إلى استمالة نظامها
في إريتريا المسلمون أكثرية لكنهم مضطهدون.. نظرة على “كوريا الشمالية الإفريقية” التي يطمح العالم إلى استمالة نظامها
على سواحل البحر الأحمر في منطقة القرن الأفريقي الاستراتيجية في الجهة المقابلة لليمن والسعودية تأسست قبل 32 عاماً دولة إريتريا بعد استقلالها عن إثيوبيا، وهي الآن تُعتبر بوابة استراتيجية تربط الخليج العربي بالمحيط الهندي وإفريقيا الشرقية، إلى درجة أنها أصبحت محط أطماع قوى دولية تسعى لتثبيت أقدامها في المنطقة.
الدولة التي تملك نحو ألف كيلومتر من السواحل المطلة على البحر الأحمر اختارت أن تكون مدينة “أسمرة” عاصمة لها ولُقبت بـ”روما الصغيرة” بسبب مبانيها ذات الطراز الإيطالي الحديث (Art Deco) من حقبة الاستعمار الإيطالي، كما تملك البلاد جُزراً مدهشة ذات المياه الفيروزية والشعاب المرجانية الغنية.
لكن خلف هذا الجمال الطبيعي الذي يُصدّره المسؤولون عن البلاد هناك جانب مظلم في هذا البلد الأفريقي الفتي، إلى درجة أن المقرر الأممي الخاص المعني بحقوق الإنسان في إريتريا عبد السلام بابكر وصف النظام فيها بأنه “نظام مصمم لنشر الإرهاب وممارسة السيطرة على حياة الإريتريين ويلعب دوراً مهماً للغاية في خنق أي معارضة سياسية”.
ودفعتنا التقارير الأممية الأخيرة بشأن وضعية حقوق الإنسان في هذا البلد الأفريقي والتقارير المتواترة التي تتحدث عن تمييز يطال المسلمين الذين يشكلون أكثر من 52% من سكان البلاد، إضافة إلى التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، إلى البحث عن حقيقة هذا البلد الغامض، وهل هو فعلاً “كوريا شمالية إفريقية” كما وصفته التقارير الغربية؟
لماذا إريتريا مهمة لنا وللعالم؟
قبل الخوض في الوضع الداخلي في دولة إريتريا وطبيعة النظام الذي يحكمها وكيف يُدبّر شؤون “الأغلبية المسلمة” في هذا البلد الأفريقي، ارتأينا أنه من اللازم البدء بالبحث أولاً عن الأهمية التي تشكلها إريتريا بالنسبة لمنطقتنا العربية والعالم، إلى درجة أنها باتت محل أطماع قوى إقليمية ودولية تسعى للسيطرة على موانئها الاستراتيجية.
فملامح دولة إريتريا بدأت في الأول من سبتمبر/أيلول 1961 عندما شنّ مقاتلو جبهة التحرير الإريترية (ELF) أول هجماتهم ضد منشآت الشرطة الإثيوبية، معلنين بذلك انطلاق واحدة من أطول حركات التحرر في القارة الإفريقية والعالم، دامت نحو ثلاثة عقود.
برز الاهتمام العربي بإريتريا حتى قبل بدء حركة التحرر، إذ إن جبهة التحرير الإريترية تأسست في يونيو/حزيران 1960 في العاصمة المصرية القاهرة بقيادة إدريس محمد آدم، وانطلقت شرارة الكفاح المسلح في غرب إريتريا في الأول من سبتمبر/أيلول 1961 بقيادة حامد إدريس عواتي.
بل إن الرئيس المصري السابق جمال عبد الناصر، حسب نائب رئيس جبهة التحرير الإريترية حسن أسد، “بارك الثورة الإريترية رغم أنه واجه ضغوطاً شديدة من إثيوبيا”، وفق تصريحات صحفية سابقة لعضو الهيئة المركزية لجبهة التحرير الإريترية عثمان صالح.
خلال مراحل الحرب برزت الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا كمنافس قوي وفاعل، وشهد عام 1988 معركة محورية في “Afabet” حققت فيها الانتصار الاستراتيجي الأكبر في الحرب، ما مكّنها من تحرير أجزاء واسعة من البلاد والاستعداد للهجوم النهائي على مدينة أسمرة التي ستصبح فيما بعد عاصمة للبلاد.
في مايو/أيار 1991 تمكنت قوات الجبهة الشعبية من دخول أسمرة، منهيةً بشكل فعلي السيطرة الإثيوبية، ما مهّد الطريق لنيل الاستقلال، وهو ما تحقق بعد تنظيم استفتاء في أبريل/نيسان 1993 تحت إشراف الأمم المتحدة، صوّت خلاله 99.8٪ لصالح الاستقلال، وأُعلنت دولة إريتريا رسمياً في 24 مايو/أيار 1993.
لم تكن مصر الوحيدة التي دعمت استقلال إريتريا، إذ إن سوريا والعراق دعما الحركة الإريترية سياسياً وعسكرياً، معتبرينها كفاحاً ضد الهيمنة الإثيوبية، كما ساهمت الجزائر وليبيا والكويت واليمن في تقديم دعم مالي وسري للجبهة، ولعب السودان دوراً عملياً من خلال السماح باستخدام أراضيه لنقل الأسلحة والتخطيط العسكري.
وعلى الرغم من اعتماد أسمرة اللغة العربية كلغة عمل إلى جانب الإنجليزية والتجرينية، إلا أنها تكتفي بوضع مراقب في جامعة الدول العربية منذ عام 2003، وأكد الرئيس الإريتري أن لا نية له في الانضمام بشكل كامل إلى الجامعة العربية.
فيما تباينت العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية حالياً، إذ إن للرئيس أفورقي علاقات متميزة مع مصر التي كانت أول دولة اعترفت باستقلال أسمرة عن أديس أبابا، فيما أقامت الإمارات قاعدة في ميناء أسمرة/مصوع لدعم عملياتها في اليمن، كما لعبت دور الوسيط في المصالحة بين إريتريا وإثيوبيا عام 2018.
إريتريا أصبحت عضواً مؤسساً في “مجلس الدول المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن” الذي تقوده السعودية ويضم أيضاً مصر والأردن والسودان ودولاً أخرى. وأظهرت إريتريا رغبة في تعميق أواصر الصداقة مع السعودية مقابل دعم في ملف الأمن والتسليح.
في المقابل، ساد التوتر لسنوات بين إريتريا وبعض الدول العربية، خاصة اليمن والصومال بسبب مشاكل مرتبطة بالنفوذ الجغرافي والصراع على بعض الجزر في البحر الأحمر بالنسبة لليمن، وهو نزاع انتهى بقرار من المحكمة الدولية لصالح صنعاء، بينما تحسنت لاحقاً العلاقات مع الصومال.

ومنذ استقلالها توجهت أنظار القوى الإقليمية والدولية إلى دولة إريتريا الناشئة نظراً لموقعها الاستراتيجي وأيضاً لإمكانياتها الطبيعية:
- إريتريا تمتلك ساحلاً يزيد على 1000 كلم على البحر الأحمر، مقابل السعودية واليمن، وعلى مقربة من باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية في العالم.
- هذه المنطقة تمر عبرها نسبة كبيرة من التجارة العالمية، إضافة إلى استخدام الممر لنقل جزء مهم من النفط الخليجي خاصة نحو أوروبا وآسيا.
- القوى الكبرى مثل الولايات المتحدة، الصين وروسيا تعتبر أن وجودها، سواء عبر القواعد العسكرية أو التحالفات، في هذا الممر البحري يمنحها أوراق ضغط استراتيجية على طرق التجارة العالمية.
- تل أبيب وواشنطن تعتبران العلاقة مع أسمرة مهمة أيضاً لتأمين الملاحة في البحر الأحمر وللتأثير في دول الجوار مثل السودان وإثيوبيا.
- القوى الكبرى ترى أن التعاون الأمني مع إريتريا يساعد على مراقبة التحركات المسلحة ومكافحة القرصنة في البحر الأحمر وخليج عدن. واشنطن مثلاً استخدمت إريتريا في بعض برامج المراقبة الاستخباراتية.
- إريتريا غنية بالمعادن النفيسة مثل الذهب والنحاس والزنك إلى جانب الغاز الطبيعي، وهو ما دفع شركات تعدين صينية وكندية وأسترالية إلى العمل على استغلال هذه الموارد، ما يجعل القوى الكبرى تتنافس على النفوذ الاقتصادي في البلاد.
هذا الاهتمام الدولي والعربي الرسمي بدولة إريتريا يوازيه غضب عبّرت عنه منظمات أممية ودولية مهتمة بحقوق الإنسان بسبب الوضع الصعب في “كوريا الشمالية لإفريقيا” وفق ما وصفت تقارير دولية هذه الدولة الإفريقية الفتية التي يبلغ عدد سكانها 3.5 مليون نسمة.
كيف يبدو الوضع داخلياً؟
شبّهت تقارير حقوقية دولة إريتريا بـ”كوريا الشمالية لإفريقيا“، على اعتبار أنه بعد حصولها على الاستقلال عام 1993، تم تشكيل الجمعية الوطنية لإريتريا، الهيئة التشريعية للبلاد، وأُجريت انتخابات الحكومة الانتقالية، والتي كانت أول وآخر انتخابات وطنية في إريتريا.
إذ إن الرئيس الحالي والأوحد للبلاد، إسياس أفورقي، عُيّن في نفس السنة رئيساً للبلاد من قبل الجمعية الوطنية، ولم يُجرِ أفورقي، الذي يبلغ من العمر 79 عاماً وكان أحد قادة حرب التحرير والاستقلال عن إثيوبيا، أي انتخابات عامة، ليستمر في حكم البلاد منذ 32 عاماً.
وبعد ثلاث سنوات من الاستقلال تم التصديق على دستور إريتريا، الذي عزز نظام الحزب الواحد في البلاد، حيث تتكون الجمعية الوطنية الآن من نصف اللجنة المركزية للحزب الوطني الديمقراطي، والنصف المتبقي من الأعضاء المنتخبين.
نظام أفورقي لم يقف عند ذلك الحد، إذ إنه في عام 2001، تم حظر جميع وسائل الإعلام الخاصة، ومنع الصحفيون الأجانب من دخول البلاد إلا إذا وافقوا على الإبلاغ الإيجابي، ليستأثر بعد ذلك الرئيس أفورقي بدءاً من عام 2002 بممارسة السلطتين التنفيذية والتشريعية في البلاد.
في يونيو/حزيران 2025 قدم المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إريتريا، محمد عبد السلام بابكر، تقريراً إلى مجلس حقوق الإنسان أشار فيه إلى استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في البلاد، بما في ذلك:
- الخدمة الوطنية الإلزامية غير المحددة المدة: التي تُعتبر شكلاً من أشكال العمل القسري.
- الاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري: خاصة ضد الصحفيين والمعارضين السياسيين.
- القيود على حرية الدين والمعتقد: حيث يُمارس التمييز ضد الأفراد غير المنتمين إلى الطوائف الدينية المعترف بها.
- الانتهاكات في منطقة تيغراي: استمرار مشاركة القوات الإريترية في ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في منطقة تيغراي الإثيوبية.
وفي خطوة مثيرة للجدل، تقدمت إريتريا بمقترح إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو/حزيران 2025 لإنهاء ولاية المقرر الخاص، وهو ما لاقى معارضة من الدول الغربية التي اعتبرت ذلك محاولة للتهرب من المساءلة الدولية.

وبطبيعة الحال فإن الجانب الديني لم يكن بمعزل عن هذه الإجراءات السلطوية التي أقرها النظام الحاكم في إريتريا، والذي فرض الالتزام فقط بالمعتقدات الدينية الأربع التي تقرها الدولة وحظر غيرها، مع العلم أن دستور البلاد لم يُدرج أي دين أو أديان رسمية.
لكنها تعترف رسمياً بعدد محدود من الأديان:
- الإسلام (على المذهب السني)، وهو ثاني أكبر ديانة في البلاد. وتشير تقديرات “Pew Research Center” إلى أن حوالي 36.6% من سكان إريتريا مسلمون حسب بيانات 2020، بينما قدّرت وزارة الخارجية الأمريكية عام 2019 النسبة بحوالي 49%.
- المسيحية الأرثوذكسية الإريترية، وتعد هذه الكنيسة الأوسع انتشاراً في إريتريا، وتضم حوالي 56% إلى 58% من السكان وفقاً للإحصاءات الحديثة، ويبلغ العدد التقريبي للأتباع ما بين 2.5 إلى 3 ملايين شخص.
- المسيحية الكاثوليكية، يشكّل الكاثوليك الجزء الأقل من المسيحيين. حسب تقارير Pew Research فإن نسبتهم تتراوح بين 4% إلى 5% من السكان، بينما تشير بيانات “Vatican Statistical Yearbook 2022” إلى أن عدد المعمدين الكاثوليك نحو 176 ألف شخص، أي ما يقارب 4.84% من السكان.
- الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، هذه الكنيسة البروتستانتية (اللوثرية الإنجيلية) معترف بها رسمياً، ولكن عدد أتباعها صغير نسبياً. حسب World Religion Database لعام 2020 يُشكّل البروتستانت (بما في ذلك اللوثريون) حوالي 4% من السكان الكليين، وضمن المسيحيين هؤلاء البروتستانت يمثلون الأقلية.
هذه هي الديانات والمذاهب المسجلة رسمياً لدى الحكومة، وأي نشاط ديني خارج هذه الأطر يحتاج إلى ترخيص صارم، بل إنه حتى الديانات المعترف بها رسمياً تخضع لإشراف الدولة، وتحتاج إلى موافقة حكومية للطباعة، توزيع الكتب الدينية، إدارة المدارس والمستشفيات وغيرها من الأنشطة.
كما أن نظام الرئيس إسياس أفورقي اتُّهم بالتمييز حتى بين الأديان الرسمية المعترف بها من قبل السلطات، خاصة عندما يتعلق الأمر بالإسلام والمسلمين في البلاد، والذين كشفت تقارير حقوقية دولية تعرضهم لمختلف أنواع التمييز والتضييق حتى فيما يتعلق بالأعياد الدينية للمسلمين في البلاد.
الإسلام والمسلمون في إريتريا
لا يستقيم التحقيق عن وضع المسلمين الراهن في إريتريا دون البحث عن تاريخ الإسلام والمسلمين في هذا البلد الأفريقي، الذي كان خلال بداية ظهور الإسلام في الجزيرة العربية ضمن مملكة الحبشة التي تضم حالياً كلاً من إثيوبيا وإريتريا والصومال، وعند ذكر الحبشة يتبادر إلى الذهن ملكها النجاشي الذي فر إليه الصحابة هرباً من بطش قريش، وكان ذلك عام 615 ميلادية.
وتذكر كتب التاريخ أن الإسلام دخل إلى الأراضي الإريترية في أُولى أعوامه، وجسّد أحد أبرز مظاهر العبور التاريخي الأول للرسالة الإسلامية إلى خارج الجزيرة العربية. وتشير المصادر إلى أن أحد أقدم أيقونات هذه الحقبة هو “مسجد الصحابة” في مدينة مِصعوة، والذي يُعتقد أنه أُسّس في أوائل القرن السابع الميلادي.
وهو ما أكده عثمان صالح، عضو الهيئة المركزية لجبهة التحرير الإريترية، عندما قال في حديث سابق لموقع رصيف: “عرفنا الإسلام قبل المدينة المنورة”، في إشارة إلى استقبال بلاده هجرتي المسلمين من مكة إلى الحبشة، هرباً من إيذاء قريش للدعوة الإسلامية في بداياتها.
وأسهم موقع إريتريا على ساحل البحر الأحمر في تعزيز انتشار الإسلام، وخاصة في السواحل الشرقية، حيث نشأت في أواخر القرن السابع وبداية القرن الثامن ممالك إسلامية على امتدادات الساحل، وانتشر الإسلام تدريجياً في أواسط القرن التاسع بين الجماعات المحلية.
وفي وقت لاحق أصبحت إريتريا منفى للدولة الأموية تُرسل إليه معارضيها، ثم حدثت لاحقاً هجرات عربية إليها، آخرها هجرة قبيلة الرشايدة، وهي قبيلة يعود نسبها إلى بني عبس من عدنان في الجزيرة العربية، لتنتشر بعد ذلك قبائل المسلمين في مناطق متفرقة من إريتريا الحديثة.
أين يتواجد المسلمون في إريتريا؟
يشكّل المسلمون في إريتريا ما بين 37% إلى 52% من سكان البلاد، بحسب تقديرات مختلفة، إذ إن السلطات لم تُجرِ أي إحصاء عام للسكان منذ استقلالها عن إثيوبيا عام 1993، لكن البيانات الرسمية في إريتريا تشير إلى أن نسبة المسلمين في البلاد من بين مجموع السكان لا تتجاوز 37%.
في المقابل، نجد تقارير أممية ومنظمات أجنبية تشير إلى أن النسبة أكبر من ذلك بكثير. فعلى سبيل المثال، تشير الوكالة الأمريكية الدولية للحوكمة الدينية (USCIRF) إلى أن 49% من سكان إريتريا مسلمون مقابل 49% مسيحيين.
بينما أشارت مؤسسة Aid to the Church in Need في تقرير لها عام 2016 إلى أن نسبة المسلمين حوالي 50%، والمسيحيين حوالي 48%، فيما يعتنق 2% ديانات أخرى. بل إن منظمة “The Global Economy” قدّرت نسبة المسلمين في إريتريا عام 2013 بـ55% من مجموع سكان البلاد.
هذه الأرقام تجعل من الإسلام أكبر الأديان انتشاراً في إريتريا، وتنعكس هذه الحصة الديموغرافية في توزيع جغرافي متنوع، خاصة في المناطق المنخفضة والساحلية والحدودية للبلاد التي تملك حدوداً مع كل من السودان غرباً وإثيوبيا جنوباً ثم جيبوتي في الجنوب الشرقي.

وفقاً لمركز “PEW”، يتركز المسلمون بنسبة كبيرة في مناطق منخفضة وغنية بالتعدد الإثني، حيث توجد أغلبية مسلمة في نطاقات متعددة مثل Anseba وGash-Barka، وكذلك المناطق الساحلية الشمالية والجنوبية على البحر الأحمر. ويمكن توزيعهم جغرافياً كما يلي:
- 30% في مناطق تيغراي “Tigray”: يعيشون في المناطق الغربية والسهول الساحلية والشمالية، ويعتنق حوالي 95% منهم الإسلام السني.
- “SAHO” ويشكلون حوالي 4%: يتوزعون على الساحل والجزر جنوب شرق أسمرة (Asmara)، ويدين معظمهم بالإسلام.
- “AFAR” ويشكلون ما بين 3 و4%: مقيمون في المنطقة الجنوبية على البحر الأحمر، غالبيتهم مسلمون.
- “BILEN” ويشكلون نحو 2%: يقيمون في منطقة Keren في Anseba، ويختلف انتماؤهم الديني، فحوالي نصفهم مسلمون.
- “NARA” ما بين 1 و2%: يقطنون غرباً على الحدود مع السودان، ويشكل المسلمون بينهم غالبية (85%).
- “Beja/Hedareb”: يسكنون المناطق الشمالية الغربية، ويعتنق معظمهم الإسلام.
- الرشايدة ويشكلون ما بين 1 و2%: عرب أصليون جاءوا في القرن 19، يقطنون السواحل الشمالية، ويتحدثون لهجة عربية ولهم تأثير تجاري محلي.
القوة والنفوذ الاجتماعي للمسلمين في إريتريا
بين الجماعات المسلمة، تبرز قبيلة “الرشايدة” بكونها صغيرة عددياً لكنها مؤثرة اقتصادياً، خاصة من خلال تحكمها في جزء من النشاط الاقتصادي غير الرسمي (الاقتصاد “الأسود”) والتجارة السوداء في البلاد.
أما Tigre وAfar وSaho، فيتمتعون بنفوذ مجتمعي خاص عبر هيكل اجتماعي تقليدي يقوم على الزعامات العشائرية، والزراعة الموسمية، وتنقل الرعي، ولهم قدرات تحكم في منطقة واسعة تشمل الحدود والممرات التجارية.
وعلى مستوى النخب والمسؤولين الحكوميين، تبرز السيدة فوزية هاشم، وزيرة العدل منذ تأسيس الدولة الإريترية عام 1993 وحتى اليوم. وهي مسلمة من أصول تِغرية (Tigray)، وتتحكم في صياغة النظام القانوني والمراسيم، إضافة إلى تنظيم المحاكم المجتمعية.
لكن تواجدها على رأس وزارة العدل، والذي لا يمكن أن يخفي النفوذ المحدود للمسلمين في السلطة، لم يكن له تأثير إيجابي على المسلمين في البلاد الذين يتعرضون لأشكال متنوعة من التمييز من قبل أعلى هرم السلطة في البلاد.
وحسب تقرير نُشر في يونيو/حزيران 2024، فإن غالبية المسؤولين رفيعي المستوى، العسكريين والمدنيين، مسيحيون، بينما أربعة وزراء فقط في الحكومة المكونة من 17 عضواً، وقائد عسكري كبير واحد من المسلمين.
التمييز ضد المسلمين في إريتريا
رغم أن المسلمين يشكلون ثاني أكبر فئة دينية بعد المسيحيين في إريتريا، ورغم الاعتراف الرسمي بالإسلام، تعاني الجالية المسلمة من مظاهر تمييز متعددة، قانونياً واجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، وهو ما وثقته تقارير هيئات حقوقية تابعة للأمم المتحدة وأيضاً جمعيات مستقلة.
- التمييز الديني والقانوني
الحكومة الإريترية “تعترف” فقط بالأديان الأربع: الإسلام السني، الكنيسة الأرثوذكسية، الكنيسة الكاثوليكية واللوثرية، وأي جماعة دينية خارج هذه الإطارات تُعتبر غير قانونية، ويتعرض أفرادها للملاحقة والاعتقال وأحياناً التعذيب، ما يُجبر البعض على إنكار دينهم لمجرد الإفراج، وفق تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”. بل إن حتى قيادات الأديان المعترف بها تواجه تقييداً حكومياً صارماً، فقد استأثرت الدولة بتعيين مفتٍ للإسلام.
التمييز ضد المسلمين في إريتريا طال حتى أعيادهم الدينية. وكتب الشيخ عبد الله العلوي: “يفترض أن تكون الأعياد الدينية مناسبة للتعبير عن التعدد والعدالة والهوية، إلا أن واقع الحال يُظهر مفارقةً لافتة، حيث يشعر المسلمون بوجود تمييز منهجي في التعامل مع أعيادهم مقارنة بما يُمنح للأعياد المسيحية من اهتمام رسمي وإعلامي”.
في مقاله الذي نُشر بموقع رابطة علماء إريتريا في يونيو/حزيران 2025، اعتبر الشيخ العلوي أنه رغم هذا التعايش المجتمعي بين المسلمين والمسيحيين في إريتريا “يُلاحظ المسلمون بمرارة وجود تمييز واضح في تعامل الدولة ونظامها السياسي مع الأعياد الدينية”.
إذ تحظى الأعياد المسيحية الأرثوذكسية بتغطية واسعة في الإعلام الرسمي، في المقابل تمر الأعياد الإسلامية دون اهتمام يُذكر، وأحياناً دون حتى بيان تهنئة من الجهات العليا، مما يعكس خللاً في مبدأ العدالة الدينية والتمييز بين المسلمين والمسيحيين في البلاد.
فيما يشارك كبار المسؤولين، بمن فيهم رئيس الدولة، في أعياد الكنيسة، يغيب التمثيل الرسمي عن أعياد المسلمين، أو يقتصر على مستويات دنيا دون رمزية سياسية. ولا تُوجَّه برقيات التهاني للمسلمين بذات الاهتمام والحرارة التي تُخصّ بها الكنيسة.
- التمييز السياسي والاجتماعي
يغيب المسلمون عن مراكز القرار السياسي، ليس بسبب قانون يميز ضدهم رسمياً، بل بسبب غياب الحقوق المدنية وحرية التعبير: لا توجد أحزاب سياسية مستقلة، ولا مجال عام للمجتمع المدني أو وسائل الإعلام المستقلة في غياب أدنى شروط الممارسة الحرة للصحافة.
ويعاني المسلمون في مناطق متفرقة من العراقيل في ممارسة الشعائر، بما في ذلك المدارس الإسلامية. على سبيل المثال، أُعدم نقل نشاط مدرسة إسلامية خاصة (مدرسة “الضياء”) إلى الإدارة الحكومية بالقوة، وأُقيل رئيسها الذي وافته المنية في السجن لاحقاً.
ويواجه الطلاب المسلمون صعوبات في الحصول على تعليم ديني إسلامي، حيث تُهيمن المناهج المسيحية على النظام التعليمي.
ويبرز التمييز الاجتماعي في أعياد المسيحيين التي تعتبر عُطلاً وطنية معلنة وثابتة، بينما أعياد المسلمين تُعلن في بعض الأحيان وأحياناً تُهمل. وتُبرز الدولة، عبر خطابها الرسمي، الديانة المسيحية كجزء من “الهوية الوطنية”، بينما يُعامل الإسلام في أحيان كثيرة كعنصر خارجي أو وافد ثقافي.
- التمييز الاقتصادي
يشكو المسلمون من عدم المساواة في الضريبة والإعفاءات؛ فالجمعيات المسيحية الأرثوذكسية تحصل على مزايا ضريبية لا تُمنح للعديد من المساجد أو الكنائس الكاثوليكية، مما يعكس تفضيلاً ضمنياً لطائفة على أخرى.
كما أن الاقتصاد الإريتري يوجد بالكامل تحت سيطرة الدولة، التي تقمع القطاع الخاص، وهو ما يؤثر على أصحاب الأعمال من الأقليات المسلمة، خاصة في السواحل والمناطق الحدودية. وصلت هذه القيود إلى حد تهجير بعض رجال الأعمال إلى دول الجوار كجيوب بيئية للنجاة الاقتصادي.
اعتقال الأئمة وإغلاق المدارس الدينية
رغم الاعتراف بالإسلام (السني) كدين رسمي في البلاد، فإن السلطات في إريتريا تحجّم أي نشاط يصطدم بتوجهاتها. وكشفت تقارير حقوقية دولية أن الانتهاكات التي طالت المسلمين في البلاد تشمل الاعتقال، التعذيب، الاختفاء القسري، إضافة إلى إغلاق المدارس الدينية وصولاً إلى هدم المساجد.
مقرر الأمم المتحدة وصف حالة حقوق الإنسان في إريتريا بأنها “صورة قاتمة مستمرة من الإفلات من العقاب، تشمل سجناً تعسفياً واعتقالاً خارج نطاق القانون، تشمل رجال دين مسيحيين ومسلمين على حد سواء”، وفق ما جاء في تقرير نُشر في يونيو/حزيران 2024.
المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أوضحت في أحدث تقاريرها الصادرة في أغسطس/آب 2025 أن السلطات الإريترية “تمارس سياسة منهجية لإضعاف المؤسسات الدينية الإسلامية وإلغاء دورها المجتمعي، عبر إغلاق المعاهد والمدارس الدينية، ومصادرة الأوقاف، واعتقال العلماء والدعاة، وإخضاع المجتمع لرقابة مشددة”.
أحدث مظاهر الانتهاكات الدينية في إريتريا تمثّل في اعتقال مدير مركز تحفيظ القرآن الكريم في مدينة قندع (شمال غرب العاصمة أسمرة)، الشيخ آدم شعبان، والاستيلاء على المركز وتسليمه لوزارة التعليم، رغم أنه وقف إسلامي أُقيم قبل أكثر من خمسة وأربعين عاماً على قطعة أرض تبرع بها أحد المواطنين.
وكان هذا المركز في بدايته معهد قندع الإسلامي الذي تأسس عام 1969 وخرّج أجيالاً من العلماء والدعاة، قبل أن تغلقه السلطات عام 2000 في حملة شملت حينها اعتقال عدد من أساتذته.
وكشفت المنظمة عما وصفته بـ”سجل طويل من التضييق على المؤسسات الإسلامية”، شملت إغلاق معاهد عريقة يعود تاريخ تأسيسها إلى ستينيات القرن الماضي، مثل معهد الدين الإسلامي في كرن الذي أُسس عام 1961، ومعهد عنسبا وازنتت الذي افتتح عام 1963.
كما شمل الإغلاق التعسفي معهد أصحاب اليمين في كرن الذي أُسس عام 1969، والمعهد الإسلامي في قندع الذي يعود تاريخ افتتاحه إلى 1969، ومدرسة الضياء الإسلامية في أسمرة التي بدأت عملها عام 1967، إضافة إلى معاهد أخرى كمركز الضياء والبخاري، وذلك بين عامي 2000 و2020، إلى جانب هدم أربعة مساجد في مدينة مندفرا بين عامي 1995 و1996.
ولفتت المنظمة إلى أن هذه السياسات القمعية ترافقها حملة اعتقالات واسعة ضد الشيوخ والدعاة، شملت أكثر من 220 شخصية دينية وتعليمية، تعرض العديد منهم للاختفاء القسري، بينما توفي آخرون في ظروف غامضة داخل أماكن الاحتجاز، وسط رفض السلطات الكشف عن هويات المتوفين أو أسباب وفاتهم.

إريتريا وإسرائيل.. علاقات براغماتية
خلال يناير/كانون الثاني 2025، أصدرت الحكومة الإريترية بياناً عبّرت خلاله عن دعمها الثابت للشعب الفلسطيني، مع التأكيد على حقوقه في التحرر والاستقلال. هذا الموقف يعكس بروداً في العلاقات بين أسمرة وتل أبيب، خاصة إذا علمنا أن العلاقات بينهما تعود إلى أول أشهر فقط بعد استقلال إريتريا.
إذ إنه منذ استقلال إريتريا عن إثيوبيا عام 1993، بَنَت أسمرة وتل أبيب علاقة ثنائية ذات طابع “هادئ” وبراغماتي تغلب عليها حسابات الأمن والبحر الأحمر على العلنية الدبلوماسية. وظهر أن “أهمية البحر الأحمر” هي المُحرّك الأبرز: أمن الملاحة في مضيق باب المندب، مراقبة أنشطة إيران ووكلائها، وحدود اليمن والسودان.
تقارير صحفية إسرائيلية استندت إلى إحاطات بحثية مثل “ستراتفور” زعمت منذ 2012 وجود تعاون أمني يمنح إسرائيل موطئ قدم استخباراتي حول أرخبيل دهلك وميناءي مصوع وعَصَب الاستراتيجيين، على الرغم من النفي الرسمي الإريتري لوجود قواعد أجنبية دائمة.
على المستوى الدبلوماسي، فُتحت السفارة الإسرائيلية في أسمرة بعد الاستقلال، وظلت العلاقات تُدار بأدنى درجات الظهور العلني، لكن هذا “الهدوء” اهتز عام 2022 حين وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد على إغلاق السفارة في أسمرة بعد تعثر قبول السفير الإسرائيلي لعامين.
خطوة فسّرها الإعلام الإسرائيلي بأنها نتيجة عراقيل إريترية و”انعدام جدوى تشغيل بعثة خاوية”. القرار مثّل نهاية مرحلة التمثيل المباشر في أسمرة، وإن لم يقطع العلاقات تماماً.
اقتصادياً، لم تُسجل اتفاقات كبرى أو تدفقات تجارة ملحوظة بين الطرفين، وبقيت العلاقة محكومة أكثر باعتبارات الأمن والهجرة لا بالتجارة والاستثمار.
أحد أوجه التماس الاقتصادي-الاجتماعي كان ملف الجالية الإريترية في إسرائيل (لاجئون ومهاجرون)، والذي تحول إلى ملف داخلي في تل أبيب وأداة شد وجذب سياسي تؤثر تردداته على العلاقات الثنائية.
ذروة ذلك برزت في سبتمبر 2023 حين اندلعت صدامات عنيفة بين مؤيدين ومعارضين للنظام الإريتري في تل أبيب، لتكشف تغطيات صحفية لاحقة جوانب من “قنوات اتصال” قديمة بين مؤسسات رسمية إسرائيلية والبعثة الإريترية، وهي علاقات انتُقدت داخل إسرائيل بعد أحداث العنف.
أمنياً وعسكرياً، ظلت المعادلة الحاكمة: البحر الأحمر أولاً. تقارير صحفية إسرائيلية عدة من “هآرتس” و”يديعوت أحرونوت” و”جيروزالِم بوست”، تحدّثت عبر السنوات عن تعاون استخباراتي (مراقبة تحركات إيران والحوثيين) ووجود لفرق بحرية صغيرة أو نقاط إنذار مبكر.
بينما قدّم باحثون في مراكز فكر أوروبية قراءة أوسع لوضع “عسكرة” البحر الأحمر وتنافس القوى على عقدته البحرية، مع الإشارة إلى أن إريتريا من بين السواحل الحاسمة جغرافياً.
من زاوية إقليمية، تُظهر تحليلات “مجموعة الأزمات الدولية” و”المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية” و”المجلس الأطلسي” أن البحر الأحمر صار ساحة تنافس مركب (إيران، الحوثيون، قوى الخليج، إسرائيل، وفاعلون دوليون)، وأن علاقات إسرائيل مع دول القرن الإفريقي تتأثر مباشرة بمساراته.
علاقات إريتريا وإسرائيل وحرب غزة
ابتداء من 2020 فما بعده، ازدادت الأسئلة داخل إسرائيل عن جدوى استمرار الرهان على أسمرة أمنياً، وظهرت دعوات في الصحافة لخفض الانخراط وقطع الارتباط المؤسسي، خاصة بعد إغلاق السفارة وتكرّس الانكفاء الدبلوماسي.
هذا الموقف سجلته مقالات رأي وتحقيقات إسرائيلية اعتبرت أن إريتريا لم تعد “ضرورة استراتيجية” كما في العقدين الماضيين.
أما موقف نظام إسياس أفورقي من القضية الفلسطينية، فيمكن تلخيصه بأنه براغماتي-تحوّطي: تجنب التموضع العلني الحاد، والإيحاء برفض “الاستقطابات” الإقليمية.
في مقابلة متلفزة نادرة عام 2010، نفى أفورقي أي ارتهان لإيران أو إسرائيل أو الولايات المتحدة، وكرر فكرة أن بلاده “ليست للبيع” لأي محور، وهي صياغة تفسر لماذا نادراً ما تصدر من أسمرة مواقف مفصلة بشأن مسارات التسوية الفلسطينية، مع المحافظة على خطاب عام عن “الشرعية الدولية” دون اصطفاف عملي.
وزادت حدة ذلك بعد الحرب الإسرائيلية على غزة المستمرة منذ 2023 التي أثرت على العلاقات بين دول أفريقية وإسرائيل، لكن دون أن تُطيح أو تؤثر على شبكات المصالح القائمة، وهو ما يفسر لماذا ظلت قناة أسمرة-تل أبيب تُدار كـ”ملف أمن بحري” أكثر منها علاقة سياسية مكتملة الأركان.
وتحت وطأة الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة، تأثرت علاقة إسرائيل بأفريقيا عموماً، لكن لم تخرج من أسمرة إشارات انعطاف علني كبير أو مواقف تعلن صراحة دعمها للدولة الفلسطينية أو المقاومة، ما يبقي سياسة “خفض البصمة السياسية” قائمة.