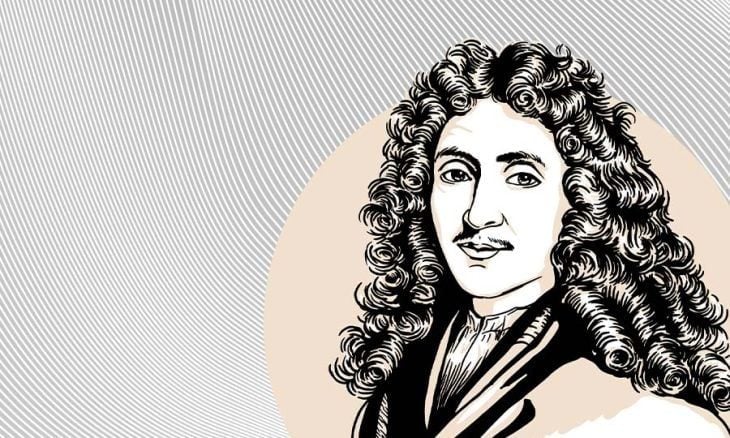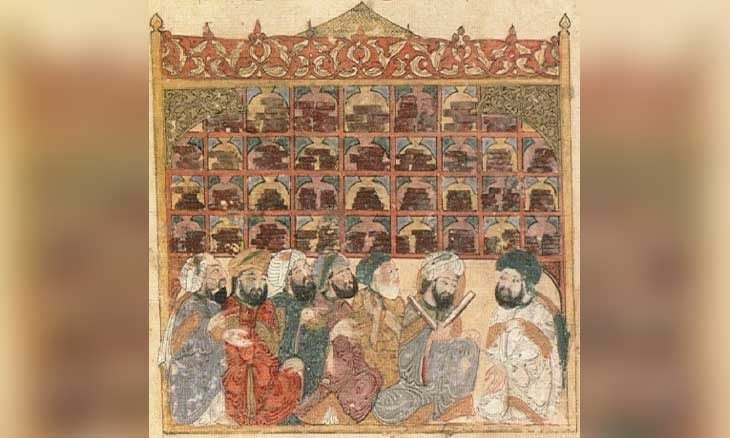مثقفون مصريون يرصدون إرث إلياس خوري: الأدب ضد النسيان
مثقفون مصريون يرصدون إرث إلياس خوري: الأدب ضد النسيان
محمد عبد الرحيم
كاتب مصري
القاهرة ـ : تحل في منتصف هذا الشهر ذكرى رحيل الكاتب اللبناني إلياس خوري (12 يوليو/تموز 1948 ــ 15 سبتمبر/أيلول 2024). خوري الذي حاول طوال مسيرته الإبداعية، سواء في مجال الرواية، أو المؤلفات الفكرية الأخرى أن يُصر ألا يرى إلا الإنسان وتفاصيل حياته البسيطة، التي ربما صاغتها الحروب والمآسي، إلا أن هذه التفاصيل وبساطتها جعلت من صوت الرجل، كباحث عن سردية أخرى تبتعد عن مباشرة الخطابة السياسية التي ضربت جيل الرجل والأجيال اللاحقة، والتي لا تفرّق بين الأدب والموقف، أو الرأي السياسي.
من جهة أخرى لا يفرّق إلياس خوري بين قضايا، أو أزمة وجد فيها بالمصادفة، حتى عام ميلاده فهو تاريخ لا يُنسى وسيظل في ذاكرة العرب، والمأساة الفلسطينية والأزمة اللبنانية، وكذا الوضع السوري مؤخراً، بل والمأزق العربي ككل، يصوغ خوري في أعماله حياة الشخوص التي ظلت وما زالت تعاني من احتلال ظاهر يمثله الكيان الصهيوني، وآخر مُستتر تمثله أنظمة الحُكم العربية المتواطئة غالباً. فتجربته الطويلة والمؤثرة في الأدب العربي، ستحتاج الكثير من القراءة والدرس والمراجعة. وبمناسبة الذكرى الأولى لرحيله نستعرض شهادات بعض من المثقفين المصريين، وتجربتهم مع أدبه وأفكاره..
اللجوء إلى سردية إلياس خوري
بداية يقول الشاعر والصحافي محمود خير الله في شهادته.. رغم أنني لستُ روائياً، ولم أكن يوماً كذلك، إلا أن لديّ مع رواية إلياس خوري حكاية تستحق أن تروى الآن، فقبل عشرين عاماً، أي في شتاء عام 2005 ابتُليت أنا وأسرتي بالوقوع ضحايا حادث مروري مروّع، أدى إلى وفاة ثلاثة من ركاب الباص الذي كنا نستقله، وأدى ـ والحمد لله ـ إلى إصابتنا فقط بكسور وجروح أبقتنا بحاجة إلى عدة عمليات جراحية (كاملة التخدير)، وخلال الأسبوع الأول من استعادتي القدرة على المشي، قررت أن يكون أول مشوار لي إلى الفن، أملاً في نسيان أحزاني ـ لبعض الوقت ـ حيث استطعت أن أحجل بقدم نصف مصابة لدخول فيلم سينمائي، ووقع اختياري على فيلم «باب الشمس» للمخرج يسري نصرالله الذي تصادف وجوده في سينما بالقرب من المستشفى. كنت أعرف قيمة يسري نصرالله كمخرج سينمائي من أفلامه السابقة «المدينة» و»سرقات صيفية»، على الأقل، لكن حالي تبدلت تماماً ـ كما يليق بالفن أن يفعل ـ بعد مشاهدة «باب الشمس»، لقد شعرت بأن الرسالة التي يقولها الفيلم تخصني أنا وحدي، وهي أن المقاومة في كل الظروف والملابسات حقٌ مكفولٌ للجميع، وأن من باب المقاومة يجب أن أعبر هذا المأزق الرهيب الذي وجدت نفسي فيه، وأن أرعى أسرتي (الجريحة) بكل ما أملك من قوة، مثلما عبَرَ الفلسطينيون مآزقهم كلها ورعوا جرحاهم، حتى آخر نفس عبر التاريخ الذي يرويه لنا إلياس بعين مبدعة ومنصفة.
فرحت جداً بالطاقة التي منحني إياها إلياس خوري، وذهبت بسرعة لقراءة الرواية لأكتشف المزيد من عوالم إلياس، الذي يعتبر واحداً من الأصوات الروائية القليلة، التي حاولت تقديم سردية واقعية منصفة للشأن الفلسطيني، بحيث يوفر عينا تأريخية وعينا سردية تجريبية على مستوى اللغة، وعلى مستوى البناء أيضاً في كل عمل أدبي يقدمه، وتلك ميزة جعلته مقروءاً ولافتاً للأنظار إلى جوار أدباء آخرين لا يعتمدون سرد الواقع سبيلاً لكشف غوامضه، ولا يورطون أنفسهم ـ أساساً ـ في أي قضايا ذات أبعاد وطنية.
لقد وظف إلياس خوري رؤيته التقدمية للفن والعالم من أجل صياغة سردية لحياة المخيمات الفلسطينية، فترة السبعينيات من القرن العشرين، ووقف عند أدق تفاصيل النضال، حينما كان الرجال يدبرون الهروب من السجن ليلة واحدة للنوم مع زوجاتهم، من أجل أن تستمر السلالة المقاومة، رغم أنف الاحتلال وجنوده وأسلحته وعتاده وقوانينه البشعة.
بعدها وبتأثير الفيلم ذهبت إلى مكتب يسري نصرالله وأجريت معه حواراً نشرته في (مجلة الإذاعة والتلفزيون) عبّرت فيه عن إعجابي بقدرة المخرج على أن يعكس رؤية كاتب عميق التأثير مثل إلياس خوري، وقلت إن السينما المصرية كانت تفتقر إلى مثل هذه الرؤية العميقة للقضية الفلسطينية، وأن اللجوء إلى سردية كاتب بحجم إلياس خوري كان حلاً ناجعاً لتقديم فيلم مصري جريء ومدهش عن القضية.
الصوت الذي لا يموت
من جانبه يقول الشاعر والفنان التشكيلي المصري سامح قاسم.. إلياس خوري هو واحد من أولئك الكتّاب الذين يصعب حصرهم في خانة بعينها، إذ أنّ مسيرته الأدبية والفكرية امتدت لتلامس أكثر من مستوى: من الروائي الذي يحاور الذاكرة والخراب، إلى الناقد الذي يتأمل البنية العميقة للنصوص، إلى المثقف الذي يضع صوته في مواجهة النسيان والقهر. وُلِد في بيروت عام 1948، في مدينة ستغدو لاحقاً مختبراً قاسياً لأفكاره وأحلامه، إذ حملت الحرب الأهلية اللبنانية معها جروحاً لا يمكن محوها، كما شكّلت القضية الفلسطينية خلفية إنسانية وأخلاقية لمشروعه الروائي. هكذا تشابك الخاص بالعام، والسيرة الفردية بالتاريخ الجماعي، لتصبح أعماله مساحة سردية، تستعيد ما حاولت السلطات والسياسات دفنه بعيدا. لقد أدرك خوري باكراً، أن الرواية أداة لفهم الذاكرة، ولتفكيك الأساطير الرسمية التي تحيط بالتاريخ. من هنا جاء انشغاله الكبير بفلسطين، باعتبارها موضوعاً سياسياً، وأيضا جرحا إنسانيا مفتوحا، ومأساة تتجاوز الحدود الضيقة إلى أن تصير رمزاً للخذلان العالمي. في عمله الأشهر «باب الشمس» 1998 يبلغ مشروعه الروائي ذروة خاصة، حيث يحاول عبر شخصيات فلسطينية ولبنانية، أن يستعيد سردية النكبة وما تلاها، كوقائع تاريخية سائلة من جهة، وكحيوات نابضة بالحب والخوف والضياع من جهة أخرى. في هذا العمل الملحمي، تصبح المخيمات مسرحاً للحكاية، وتغدو الذاكرة الفردية امتداداً للذاكرة الجماعية.
ويضيف قاسم .. ما يميز إلياس خوري أنه لا يكتب عن السياسة بالشعار، بل يكتبها بالحياة اليومية، بالحب والعائلة والجسد. شخصياته ليست أيقونات ولا رموزاً مجردة، بل إنهم بشر مهزومون، عاشقون، مقموعون، باحثون عن مكان في عالم ينهار من حولهم. يقول في أحد نصوصه: «الرواية ليست تاريخاً، إنها حياة الذين لا يملكون تاريخاً». ولهذا، فإن رواياته تحاول أن تمنح الصوت لمن تم تهميشهم: اللاجئ، الأسير، المرأة التي فقدت بيتها، العاشق الذي خسر محبوبته في مجزرة، الطفل الذي يكبر في مخيم بلا مستقبل. كل هؤلاء يصيرون أبطالاً في نصوصه، لا لأنهم منتصرون، بل لأن وجودهم نفسه فعل مقاومة. وإذا كانت الرواية عند خوري هي بيت الذاكرة، فإن لغته هي الأداة التي تمنح تلك الذاكرة قوة البقاء. فهو يكتب بلغة عربية مشبعة بالشعر، ولكنها في الوقت نفسه لغة قريبة من الحياة اليومية، تتسلل إليها اللهجة اللبنانية والفلسطينية، وتتماهى فيها السخرية مع الرثاء. هذه اللغة المزدوجة بين الفصيح والعامي، بين الغنائي والتقريري، تكشف عن حساسية خاصة تجعله قادراً على الإمساك بالتناقض: أن تكتب عن العنف بلغة تحفل بالجمال، وأن تستعيد الحكاية المفقودة بأسلوب يجعل القارئ يعيشها كما لو أنها تحدث أمامه. لقد كان لإلياس خوري دور بارز أيضاً في المشهد الثقافي العربي. عمل في الصحافة، وأدار ملحق «النهار الثقافي» الذي شكّل منصة للعديد من الأصوات الأدبية الشابة. كما كتب نصوصاً مسرحية، بعضها قدّم على خشبات بيروت، وكانت هي الأخرى جزءاً من انشغاله بالتاريخ والذاكرة. وفي مقالاته النقدية والفكرية، تأمل في الرواية العربية الحديثة، وكتب عن نجيب محفوظ وغسان كنفاني وغيرهما، مؤكداً أن الرواية ليست مجرد فن لكنها مرآة لأسئلة الحرية والعدالة. في إحدى مقالاته يقول: «الرواية هي المختبر الوحيد الذي نستطيع فيه أن نجرّب أشكالاً للحرية، في عالم مسوَّر بالقمع». ما يجعل خوري مختلفاً عن غيره من الروائيين العرب هو هذا التوتر الخلاق بين الالتزام الإنساني والجمالية الفنية. فهو لا يتخلى عن الجرح الفلسطيني، لكنه في الوقت ذاته يرفض أن تكون الرواية بياناً سياسياً مباشراً. لذلك نجد أن نصوصه تنبني على الحكاية وعلى تعدد الأصوات، وعلى تقنيات حديثة مثل تيار الوعي وكسر الزمن الخطي، بحيث تصبح الرواية فضاءً معقداً يشبه الواقع المتشظي الذي يعيشه أبطاله. إن تعدد الأصوات في رواياته ليس مجرد تقنية فنية، وإنما إعلان أن الحقيقة ليست واحدة، وأن التاريخ لا يمكن أن يُختصر في رواية رسمية واحدة، فهو مجموع الروايات الصغيرة التي يرويها الأفراد العاديون. إلياس خوري، بهذا المعنى، يكتب من موقع الشاهد، شاهد على زمن القسوة، على بيروت وهي تنهار، على فلسطين وهي تُمحى، على الإنسان وهو يتفتت. لكن شهادته ليست محايدة، إنها مشبعة بالانحياز للمظلوم، للمطرود من بيته، للمرأة التي تنتظر عودة حبيبها من السجن. ومن هنا فإن مشروعه لا يمكن فصله عن أخلاقيات الكتابة: أن تكتب كي تحفظ الذاكرة، وأن تروي كي لا يموت الصوت.
الأسئلة الأبدية والتاريخ الحي
وفي الأخير يؤكد هذه النظرة من وجهة أخرى الروائي والمسرحي وكاتب السيناريو أحمد نبيل فيقول.. رغم الطابع السياسي لمؤلفات إلياس خوري، يظل ما يميزه في اعتقادي ببساطة كونه «أديبا». بمعنى أن تاريخ الأدب والفن لا يخلو من أعمال لجأ أصحابها لاستغلال القضايا السياسية كتعويض عن فقر فني، والنتيجة ظهور أعمال ذات نبرة خطابية ودعائية، أقرب إلى المنشورات السياسية منها إلى الأدب، أعمال لا تحمل قيمة جمالية، بقدر ما تستعير القيمة من قشور قضية ما. وأظن أن ما يميز إلياس خوري هو قدرته على الانطلاق من الأسئلة السياسية إلى قلق وجودي أعمق، يشمل الحرب والمقاومة وتفاعلات الناس مع الحياة، لأن الظرف السياسي قد يزول وتبقى الأسئلة الأبدية هي غاية الأدب والفن، لذلك أتصور أن رواياته يمكن لأي قارئ أن يتفاعل معها، بصرف النظر عن مدى اهتمامه بالشأن السياسي. مثلا إذا نظرنا للعلاقة الأبوية بين خليل ويونس في «باب الشمس»، طبيب معتل يحاول بث الروح في جثمان بطله الميت، صحيح أن العلاقة تحمل بعدا سياسيا، ولكنها تتجلى في صورة إنسانية، ومشاعر يمكن لأي إنسان اختبارها. كذلك شخصية كريم في رواية «سينالكول»، الذي يفشل في ترجمة ذكرياته عن الوطن في منفاه الاختياري في فرنسا، عاجزا عن استعادة ووصف روائح البن والتفاح اللبناني عبر اللغة. وهذا في تصوري ما يجعلك تلمس فداحة أثر الحرب على حياة الناس، ولكن من خلال منطق ولغة نابعة من وجدانهم. شخصيات من لحم ودم، تتفاعل مع الواقع، انطلاقا من تجارب معيشة، تحمل صوتها الخاص، ولا تتوقف عند حدود الرواية الرسمية للتاريخ. وهناك أمثلة عديدة لكتاب كبار فعلوا الشيء نفسه بأساليب مختلفة، على سبيل المثال برتولد بريخت في قصصه القصيرة، حين يختار أن يروي عن مصرع يوليوس قيصر، من وجهة نظر جندي فقير يؤدي الخدمة العسكرية، أو قصة إعدام الفيلسوف الإيطالي جيردانو برونو من وجهة نظر زوجة الخياط، التي لم يسدد لها ثمن تفصيل معطفه. لأن الأدب الحقيقي باختصار لا يستمد قيمته من قضية أو موضوع مهما بلغت أهميته، بقدر ما يعتمد على كيفية معالجته وتناوله لتلك القضية.
«القدس العربي»