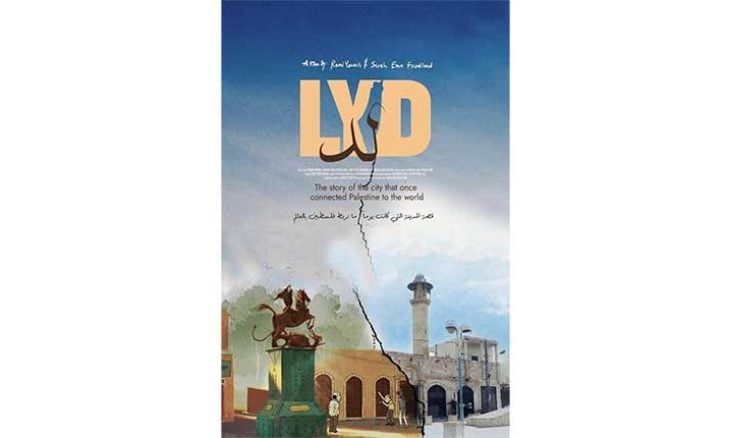بين كذبتين: أسير يخرج إلى الحياة وآخر يعود إلى الفقد

مريم مشتاوي
في آخر الممر، حيث الضوء ضعيف مثل نبض مرهق، كان الأسير يخطو خارج باب صدئ. الهواء بارد ولزج.. سنوات أمضاها في قيد طويل لا يقاس بالأيام، ثم فتحوا له الباب وألقوا في أذنه الجملة التي ظلّت تصاحبه كالظلال: كل أفراد عيلتك ماتوا! قيلت الجملة دون شهود، مثل قنّاص لا يراه أحد، واستقرّت في صدره كحجر في قاع بئر. ومنذ تلك اللحظة صار يمشي في الحلم واليقظة بقدمين من رماد.
كان يتدرب على الفقد كما يتدرب الجندي على الطاعة، يعلم نفسه أن يقف أمام المرآة فلا يرى سوى من تبقى منه. في الزنزانة كان يتخيل غرفة جلوس مقفلة بالتراب، وجه زوجته يبهت مثل صورة ظلت في الشمس طويلاً، يدا طفليه الصغيرتان ترتجفان في الضباب. كان يخاف النوم، لأن الأحلام كانت تستدعيهم إليه وهم يمشون فوق قبورهم. كان يكره اليقظة، لأن اليقظة تذكّره بما قاله الجلادون: كلهم ماتوا. كلهم!
وحين وقع الإطلاق وأُدرج اسمه في القوائم، لم يبتسم. لم يثق بالباب الذي انفتح فجأة. السجن يعرف كيف يفتح الأبواب كي يفترس. خرج وهو يضع كفه على قلبه. في الطريق إلى البيت، كان كل شيء يذكّره بكلمات مرصوصة مثل رصاص: لا تنتظر أحداً… قال لنفسه إن العودة ستكون زيارة لقبر جماعي.
لكن الباب انفتح على مفاجأة اسمها الحياة. زوجته هناك، تلهث من الدهشة، تصوب عينيها نحوه. طفلاه يركضان نحوه. لم يفهم ما يحدث. خبأوا عنه الحقيقة في السجن. تدفّق عليه البكاء مثل بحر يواصل هدم سواحله.. كان يريد أن يلمسهم واحداً واحداً، أن يتيقّن من حرارة جلودهم. هكذا أخذوه بين أذرعهم.
جلس بينهم وأخذ يحصي التفاصيل الصغيرة، التي لم يمتلكها داخل السجن: الكوب الذي يشرب فيه الجميع، طبق العدس برائحة الكمّون، قطعة قماش على حافة الشباك، حذاء لابنه الصغير. الآن فقط أدرك معنى أن يكون الكذب سلاحاً أكثر فتكاً من القيود، وأن الاحتلال لا يكتفي بجسده حين يسجنه، إنما يطارد روحه ليقنعها بأن الحب انتهى خارج الجدران. كل ما أراده في تلك اللحظة أن يرد الحياة إلى مكانها الطبيعي، أن يعلم طفليه الفرق بين السجن والبيت، بين الحارس والجار، بين صمت القهر وصمت العائلة قبل النوم.
في الليل، حين نامت الخيام، جلس قرب فرشة ابنه يتأمل قدماً صغيرة تتحرك في الحلم. تذكر كيف كانوا يجرونه إلى التحقيق ويقولون: لم يعد لك أحد. أي ضمير ينام مرتاحاً بعد أن يضع في صدر إنسان قنبلة يأس وعذاب هائلين؟
حين خرج الآخروجد الفقد ينتظره عند الباب
في السجن، تعلّم أسير ثان أن يربي صبراً طويلاً، سنوات وهو يطرق جدران الأيام ليمنع صداها من الأنين. كان يسأل عن زوجته وأطفاله، فيجيبه الصمت. الصمت في السجون سياج، الصمت مدرسة لترويض الألم.. لم يقولوا له شيئاً، تركوه يتخيلهم واقفين على باب البيت كل مساء، يشتاقون للصوت الذي يعرّف البيت بنفسه.
حين جاء يوم الإفراج، سار في الممر نفسه الذي سار فيه الأول، لكن الهواء هنا كان ثقيلاً كأنه يجر خلفه نعشاً، خرج وهو يحمل في صدره حلماً بسيطاً بأن يفتح الباب ويجد زوجته مبتسمة، وأن يركض صغاره كما تفعل السنونو حين يؤذن الربيع.
اقترب من الحي الذي حفظ أزقته من ذاكرة قديمة. لا شيء يشبه نفسه… لاحظ أن العيون تتجنب النظر في عينيه طويلاً. التصقت به يد أحد الجيران وهمس: اصبر… لم يفهم أي صبر يسبق العودة إلى البيت؟ وحين وصل، لم يجد الباب كما تركه. وجد ركاماً وصمت يسيج الأرض… اقتربت منه امرأة كبيرة في السن وضعت يدها على رأسه كما تفعل الأمهات حين لا يجدن الكلمات. عندها عرف أن الموت سبقه إلى المكان، وأنه جاء متأخراً ليحصد البقايا.
جلس على الأرض. الأرض أقرب مكان للذين سقطت منهم السماء. أخبروه: زوجتك رحلت، وأولادك الثلاثة أيضاً.. انحنى على ركبتيه كمن يجمع شظايا زجاجٍ تناثر من نافذة الذاكرة. تذكر الليل الذي كان فيه يحدث ابنه عن الطائرات الورقية، وكيف وعده أن يصنع واحدة كبيرة حين يعود. تذكر ضفيرة ابنته التي كان يراها في الأحلام مثل حبل ينجيه من الغرق. كل شيء صار الآن عدماً. كيف تلامس الغياب؟ كيف تضبط حرارة حضن لم يعد موجوداً؟
كان يشهق بصوت عميق يخرج من باطن الأرض، ثم يزفر كأنه يلفظ حياة سابقة.
عند القبور، جلس، الأرض هنا تعرف قصصاً كثيرة ولا تبوح بها. تخيّل كيف رحلوا… هل كانت لحظة الرحيل سريعة مثل رصاصة، أم بطيئة مثل جدار ينهار؟ تخيّل زوجته وهي تكتم الخوف كي لا ترتعب قلوب الأطفال. تخيل طفله الذي كان يشبهه حين يضحك، وابنته التي كانت تضع وردة في شعرها يوم العيد. كلهم الآن تحت هذا القرب من السماء. رفع يده كمن يطلب تأشيرة للعودة إلى زمن لم يعد له وجود.
في الأيام التالية، صار يخرج كل صباح ويعود مساء ومعه شيء من أثرهم: لعبة قديمة وجدها عند قريب لهم، حقيبة مدرسية عليها حرف تآكل نصفه، ورقة امتحان سقطت من دفتر في بيت الجيران. كان يجمع هذه الأشياء كما يجمع المزارع بذور موسم قادم.. تعلّم أن يحمل صورة صغيرة في جيبه، وأن يلعق المرارة مثل دواء. تعلّم أن يصبر حين يسمع ضحكات آخرين.
وفي مساء له رائحة المطر، التقى بالأسير الأول في مجلس صغير. تبادلا النظرات التي تفهم دون شرح. حكى الأول كيف خدعوه بالحكاية السوداء وحكى الثاني كيف فتح الباب فدخل على جنازة مؤجّلة. كان لكل واحد منهما وزن على كتفه. قال الأول: كذبهم كاد يقتلني. ردّ الثاني: صمتهم قتلني فعلاً.. ثم سكتا قليلاً. بعد فترة، قال الأول: تعال نزرع شجرة في الطريق بين بيتك والمقبرة.. وافق الثاني. زراعة شجرة لا تعيد الموتى، لكنها تربّي في الأرض عادة جديدة: كلما مرّ من هناك رأى ظلاً يتّسع.
الشجرة الصغيرة تحركت في الريح كأنها تقول لهما شيئاً. في عينيْ كليهما لمعت دمعة وحيدة.. دمعة من وجد عائلته في اللحظة الأخيرة، ودمعة من فقد عائلته في اللحظة نفسها. كان المشهد يشبه توازناً دقيقاً بين حدين: حد النعمة وحد المصيبة.
عند عتبة الليل، صرخت المدينة: هناك من خرج من قيد الحديد ليعانق قيد الحقيقة، وهناك من خرج ليكسرها. وبينهما امتدت غزة، مثل أم تشدّ أبناءها إلى حضنها، وتقبّل جباههم كي لا يتوهوا في متاهات الكذب والغياب.
كاتبة لبنانية