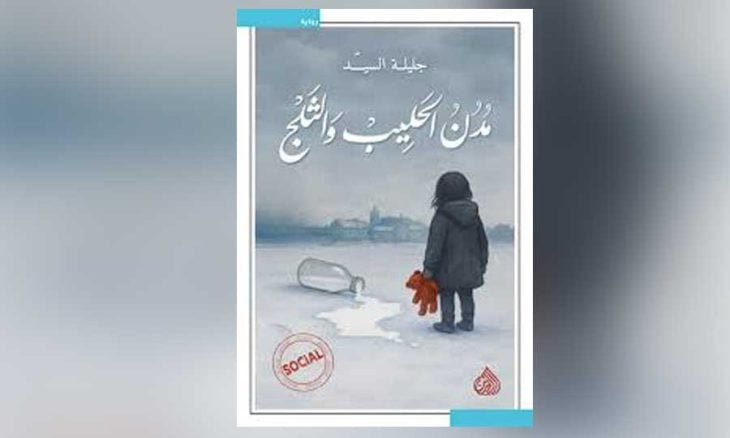الشِّعر والترهيب في الثقافة العراقية

مروان ياسين الدليمي
أصبح للمثقفين المُسيسين حزبيا، مِن شيوعيين وبعثيين وقوميين وناصريين وإسلامويين، مساحة أوسع داخل المؤسسات الثقافية، عندما سقط النظام الملكي في العراق عام 1958، وتمكن الشيوعيون والبعثيون على وجه خاص من أخذ الفعل الثقافي إلى مرحلة مفارقة في مسيرة الثقافة العراقية، حيث بدأ توظيف الأيديولوجيا يترك آثاره على جسد الثقافة، فاصطبغ الزمن بكل ما يعضد أواصر هذه العلاقة، بفعل تأثير سلطة الرقيب الأيديولوجي وما يفرزه ويقرره من نماذج نصيّة يمكن أن توضع في أي خانة من الكتابة إلاَّ أن تصنَّف في فضاء النتاج الإبداعي.
سلعة رخيصة
تلك الانعطافة التاريخية رسمت في ما بعد السياق العام للثقافة العراقية، رغم تغير القوى والأنظمة السياسية التي توالت على إدارة الحكم، فالمثقفون البعثيون بأيديولوجيتهم القومية، الذين كانوا في صراع دائم مع نظرائهم الشيوعيين، أعادوا إنتاج هذا المشهد الثقافي، عندما أمسك حزب البعث بزمام السلطة ولمرتين، الأولى من 8 شباط/فبراير 1963 ولغاية 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1963 ، والثانية من 17 تموز/يوليو 1968 ولغاية نيسان/أبريل 2003، فاتخذوا من تلك الأرصفة التي عبّدها المثقفون الشيوعيون، أيام حكم الزعيم عبد الكريم قاسم (1958 – 1963) مسارا لهم. من بين أقوس سلطة المثقفين الشيوعيين والبعثيين، لم يتشكل نص إبداعي يكرِّس سلطة الثقافة بفضاء حريتها الرحب، إلاَّ ما يخدم تمركز الحضور الأيديولوجي فيها، لأن كلا الاثنين دائما ما كانا يضعان حدودا صارمة أمام من يفكر بعيدا عن منظومتهما الأيديولوجية، فتساوى الاثنان في رؤيتهما للثقافة، وهي رؤية مصابة بقصر نظر شديد وفقر دم مزمن، فكان من المنطقي أن تؤخذ الثقافة إلى حيث تخضع طائعة لسلطة الأيديولوجيا، لترتق ما في ثوبها من ثقوب، وتمحو البثور البشعة من وجهها.
وقد استشعر الاثنان خطورة أن تشتغل ماكينة الثقافة خارج بوتقة الأيديولوجيا، فتحول النتاج الإبداعي، والشعر في المقدمة منه، إلى سلعة رخيصة تحت ضغط معاييرهما ومقاديرهما وأسيجتهما وخطوطهما الحمر، وبات من الصعب تسويقه وصموده إزاء الزمن، وما يحصل فيه من تحولات على مستوى الشكل والمضمون والرؤى الفنية، والنتيجة أن تكدَّست النصوص بعناوينها ومحمولاتها الطنانة، على رصيف الشعارات والوعود الوطنية البراقة، ولم تتمكن من الوصول بالوعي والوجدان إلى ضفة أخرى.
جوقة الشعراء
من بعد عام 1958 لم تعد هناك مساحة واضحة تفصل بين الثقافة والأيديولوجيا، وبات الخيط رفيعا جدا بينهما، بل انقطع في مواضع أخرى، بالتالي أمست الثقافة مطيَّة لفعل الترهيب الذي تنتجه الأيديولوجيا، وانحصر دورها في تمهيد ما سوف ترتكبه أدواتها الحزبية والميليشياوية من انتهاكات وجرائم، في إطار لعبة معتمة أثخنت الواقع بجراح عميقة، وقد انخرط فيها شعراء شيوعيون وبعثيون عبر قصائد كتبوها، ساعدهم على ذلك المناخ العام وطبيعة المرحلة الدولية في خمسينيات القرن الماضي، عندما كانت سلطة الأيديولوجيا تتوسع في بقاع العالم بتأثير التجربة السوفييتية، بالتالي تعلمت من تلك الجوقة الأممية بقية الأحزاب غير الشيوعية وفي مقدمتها حزب البعث.
ورطة الشعراء
الشعراء العراقيون كانوا الأكثر تورطا في اللهاث وراء سراب هذه اللعبة الدوغمائية، فاشتغلوا في عمق هذه الظاهرة، واستجابوا لدعواتها وأكلوا من وليمتها، ولم يتجل عن غيبوبتهم هذه أي استفاقات إبداعية مهمة تساهم في تنشيط الفعل الإبداعي، وتعيده إلى حاضنته الطبيعية، بعيدا عن ذائقة الأيديولوجيا بثرثراتها وهرطقتها، التي لا تفوح منها سوى روائح التبجيل والتعظيم والتزييف الوطنية. هذه التركيبة التي أمسى عليها سياق الثقافة العراقية خلال عقودها الماضية حتى عام 2003 تدعونا إلى التساؤل عن حقيقة مفهوم الشاعر، وطبيعة موقفه عندما يكتب قصائد يحتفي فيها بقتل الخصوم الأيديولوجيين، ويمجِّد ما شاع من صور العنف التي أرّخت حياة العراقيين منذ خمسينيات القرن الماضي وإلى الآن، وهذا السياق يقودنا إلى أن نطرح السؤال الآتي: هل يمكن تبرير اندفاع الشاعر وتأييده لعمليات التعذيب التي تمارس بحق المعارضين لسياسات النظام الحاكم، بغض النظر عن عقيدتهم؟
استبداد الشعر
اختيارنا لنموذج الشاعر دونا عن بقية المشتغلين في حقول الثقافة والإبداع، يأتي من وحي قناعتنا بأن الشعر كان مُستبِدا بحضوره على عموم المشهد الثقافي، أما بقية المشتغلين في الحقول الإبداعية الأخرى فكانوا شبه مغيبين عن واجهة المشهد، فالشعر العراقي المعاصر انتمى إلى سلطة الأيديولوجيا أكثر مما انتمى إلى الشعر ذاته، فكان أشبه برذاذ يتناثر من أبواق الأيديولوجيا بمختلف ألوانها، إلاّ قِلَّة قليلة من الشعراء، ربما لا يعدون حتى على أصابع اليد الواحدة، اختاروا الوقوف في شرفة منعزلة تطل على الشعر وحده، مثل الشاعر محمود البريكان (1931 – 2002) الذي بقي ينآى بشعره عما كان سائدا من أساليب التدجين والترهيب والتزييف والتعظيم، ومن السهولة بمكان التوصل إلى مثل هذا الاستنتاج إذا ما أعدنا النظر في كل المنتوج الشعري خلال النصف الثاني من القرن العشرين، بشرط أن تكون أدواتنا النقدية خاضعة للمناهج الأكاديمية.
انتهاكات شعرية
لنا أن نستذكر ما اقترفه الشعر العراقي المعاصر من تضليل وترهيب وتزييف للوعي، ابتدأً من خمسينيات القرن الماضي، ويمكن الإشارة إلى نقطة انطلاق هذا الدور من اللحظة التي ارتدى فيها الشعر قيافة الميليشيا بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي قادها العقيد عبدالوهاب الشواف في التاسع من آذار/مارس عام 1959، فالأحداث الدموية الشنيعة التي شهدتها شوارع مدينة الموصل شمال العراق، نتيجة فشل ذلك الانقلاب، كان قد راح ضحيتها عشرات المدنيين من القوميين والبعثيين والناصريين المدنيين، من المحسوبين على مؤيدي الانقلاب، والمثير هنا، أن تلك الأحداث التي شهدت عمليات سحل لجثث الضحايا على أسفلت الشوارع وتعليق بعضها الآخر عارية على أعمدة الكهرباء، أنها لاقت ترحيبا حارا من قبل شعراء معروفين، كان أغلبهم محسوبا على الحزب الشيوعي، أمثال: محمد مهدي الجواهري، طالب الحيدري، علي جليل الوردي ، محمد باقر سماكة، محمد صالح بحر العلوم، عبد الوهاب البياتي، هاشم الطعان، حسين مردان، عبد الأمير الحصيري، كاظم السماوي وآخرين، فالبياتي على سبيل المثال لم يتردد في إحدى قصائده أن يكتب»إنّا سنصنع من جماجمهم منافض للسجائر»! أما الشاعر محمد صالح بحر العلوم فكتب قصيدة احتفاء بحفلةِ تعليق جثث الضحاياعلى أعمدة الكهرباء وسحلهم في شوارع مدينة الموصل:
«شعبٌ تفنن في انتزاع حقوقه.. بحباله من رأسِ كل مغامر
وإذا الحبال تمكنت من ثائر .. طرحته وانتقلت لصيد آخر
وإذا بُليت بغارق في غيه .. فاترك هدايته لحبل حاضر»
أما الشاعر حسين مردان – الذي كان يعد في تلك الحقبة أيقونة قصيدة النثر والتمرد على الواقع الاجتماعي- فكتب يقول:
«فانصب المقصلة
لتتساقط الجماجم الدنسة
وبرأس حربة جديدة أغلق نوافذ الخطر
فمنذ شهور
والشعب يحمل بين يديه السفط
لاستقبال أول رأس»
لن نستعرض بقية النصوص التي كتبها بقية الشعراء الذين ذكرناهم، فهذه النتف تكفي للاستدلال على ما اقترفته الثقافة العراقية وفي مقدمتها الشعر، من صفحات معتمة في مسيرتها المعاصرة نتيجة خضوعها لسلطة الأيديولوجيا.
الماركسية والطائفية
السواد الأعظم من الشعراء والأدباء والمثقفين العراقيين منذ مطلع أربعينيات القرن الماضي كانت الماركسية تكاد أن تشكل مرجعيتهم الفلسفية في تحديد هويتهم الثقافية، سواء على صعيد الموقف السياسي أو الإبداعي، حتى إن البعض منهم كان بعثيا أو قوميا أو ناصريا، إلى أن سقط العراق تحت سلطة الاحتلال الأمريكي عام 2003 فإذا بالكثير من مثقفي العراق ينخرط تحت رداء الطائفية المذهبية، رغم انتمائهم للأفكار الماركسية واليسارية، ولن نغالي إذا ما وصفنا هذه المرحلة بأنها أشد بؤسا على بنية الثقافة، وليس مستبعدا أنها أفرزت نتائج استهدفت ما تبقى من قيم تعلي من شأن حرية التفكير بعيدا عن الخطوط التي ترسمها سلطة الأيديولوجيا. وبقدر ما يحمل الفكر الماركسي من حيوية في رؤيته للواقع والتاريخ إلاَّ أن رهطا واسعا من المثقفين الشيوعيين العراقيين تداخلت عندهم الخطوط ما بين الفضاء الثقافي والتخندق الأيديولوجي، والأمر هذا ينسحب على البعثيين أيضا بالدرجة والعمق نفسيهما، وهذا يعني أن الثقافة العراقية خلال مخاضها الطويل، خسرت حريتها لصالح الأيديولوجيا، وهذه النتيجة تنسجم اليوم مع موقف الجماعات الدينية الإسلاموية التي تهيمن على السلطة، في فهمها لطبيعة العلاقة التي تجمع الثقافة بالأيديولوجيا، وما يؤكد هذا السياق المنغلق في الوعي، أن النخب المبدعة من الشيوعيين العراقيين والبعثيين حتى هذه اللحظة لم تمارس نقدا ذاتيا «ثقافيا» لمواقفها التي وظفتها في مقارباتها الإبداعية، خاصة في النصوص الشعرية التي انتجتها خلال الفترات القلقة والمرعبة في النصف الثاني من القرن العشرين، ويتناقض هذا الصمت النقدي مع جوهر الفكر القائم على المراجعة والتقييم والنقد. يبدو أن فعل الترهيب الأيديولوجي عبر الشعر ما يزال يخترق المشهد الثقافي والوعي الجمعي بعد عام 2003، فبعد أن تمددت سلطة الميليشيات الطائفية وأحكمت قبضتها على الواقع طولا وعرضا، عملت على أن يكون لها مؤسساتها الثقافية، وانخرط في ماكنتها عديد الشعراء، فأخذوا على عاتقهم مهمة إنتاج النصوص التي كانت تتغنى بترهيب الخصوم خلال خمسينيات وستينيات وسبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، كما لو أن قدر الشعر في العراق أن يكون مقترنا بالدم والموت والرعب، مثلما هي حياة العراقي.
كاتب عراقي