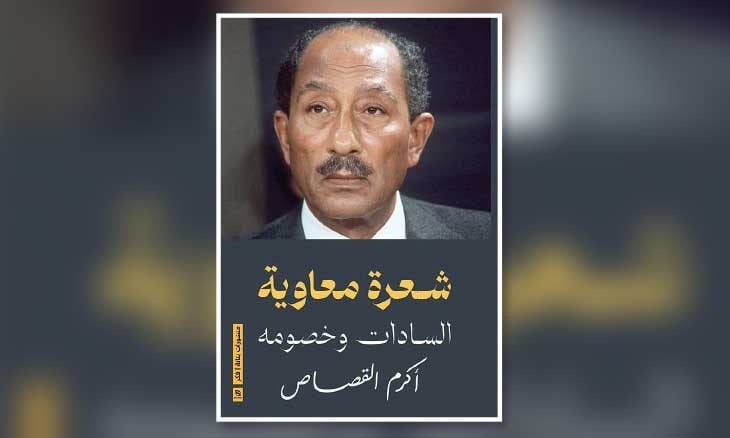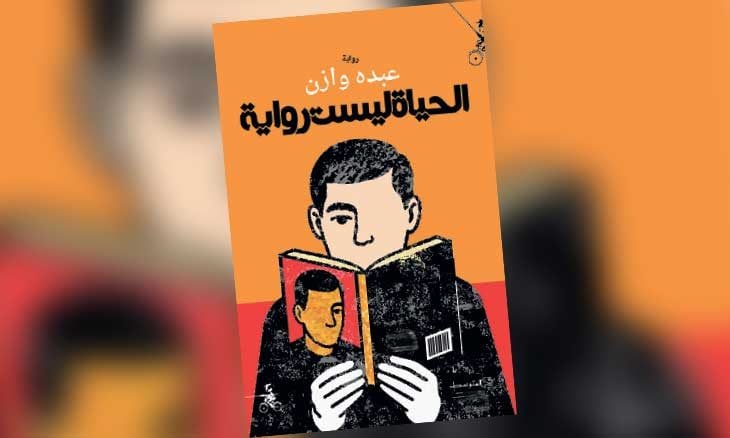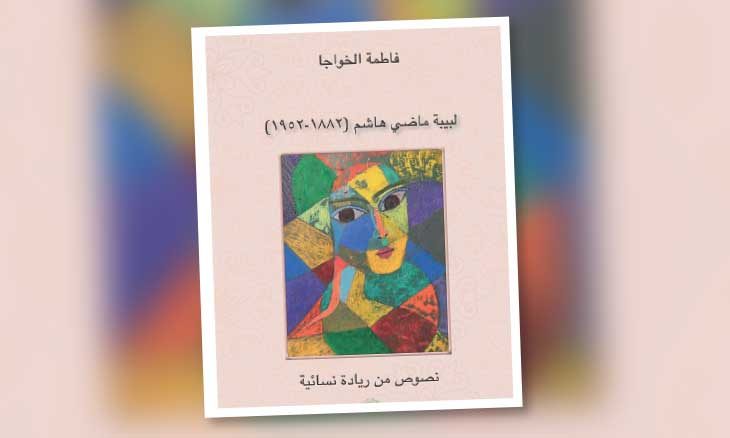الهيمنة الثقافية والتمييز العنصري: كيف صاغ الاستعمار خطابه عن الشعوب الأصلية؟

الهيمنة الثقافية والتمييز العنصري: كيف صاغ الاستعمار خطابه عن الشعوب الأصلية؟

مصطفى عطية جمعة
هيمن المستعمر الغربي عسكريا ونفسيا ولغويا على السكان الأصليين في المستعمرات، وسعى إلى محو خصوصيتهم الثقافية، وإماتة تاريخهم الحضاري، وترسيخ احتقارهم للغتهم. وقدّم لهم النموذج الغربي بوصفه النموذج الأوحد في النهضة والتقدم، الذي يعني قتل لغتهم وثقافتهم وتاريخهم، والتباهي بالتحدث بلغة المستعمِر، بوصفها لغة العصر والحضارة، بما يعني أن اللغة الأصلية هي قرينة للتخلف والهمجية والتراجع الحضاري، ولا مكان لها في حضارة العصر.
وقد صيغ خطاب الاستعمار عن السكان الأصليين، بلغة المستعمِر نفسه، مستخدما قاموسا من المفردات والتعبيرات شديد الدونية. يقول فانون في كتابه «معذبو الأرض»: «انظر إلى اللغة التي يتكلمها المستعمِر، حين يتكلم عن المستعمَر، تجد أنها اللغة المستعملة في وصف الحيوانات، إنهم يستعملون هذه التعابير: زحف العرق الأصفر، أرواث المدينة الأصلية، قطعان الأهالي، تفريخ السكان، تنمّل (من النمل) الجماهير، هؤلاء السكان الذين يدبّون على الأرض، هذه الجماهير المستهترة، هذه الوجوه التي فرّ منها كل معنى إنساني، هذا القطيع الذي لا رأس له ولا ذنب، هؤلاء الأطفال الذين لا يبدو أن لهم أهلاً، هذا الكسل المستلقي تحت الشمس».
ويتسع الأمر أكثر، كما يشير دافيد غونزاليز نيتو David Gonzalez Nieto، وهو يحلل علاقة اللغة بالاستعمار، مؤكدا أن اللغة لا يمكن أن تكون أداة محايدة، حيث تستخدم في عالم السياسة الغربية من أجل حث الشعب على المشاركة في الحياة الديمقراطية، بينما تستخدم مع سكان المستعمرات، من أجل ترسيخ تابعيتهم الثقافية، وربط هويتهم بهوية المستعمر الغربي. فالمعاني والدلالات في اللغة تتكون من خلال التفاعل بين نظامين للتمثيل؛ النظام الأول يتصل بالأشياء System Connects Things، حيث يشمل الناس والأحداث والموجودات والأفكار المجردة، أي التي يتعامل بها الناس مع بعضهم بعضا في الحياة اليومية. أما النظام الآخر، فهو معنيٌ بالخرائط المفاهيمية Conceptual Maps وعلاقتها باللغة والثقافة، وهي منظومة يتم تحديثها بشكل مستمر، وتقوم بإعادة تعريف العالم وتقديمه كواقع من منظور الاستعمار، بترسيخ خرافة تفوق المستعمر Colonizer’s Superiority في مختلف التمثيلات الثقافية في العالم. وتكون اللغة في هذه الحالة أداة من أجل ترسيخ هيمنة لغة المستعمر استخداما وإعلاما وتعلما. والأمر لا ينطبق على جميع البلدان التي سقطت تحت نير الاستعمار، فتأثيرات المستعمر متفاوتة من بلد إلى آخر، فهناك بلدان كادت أن تذوب هويتها الثقافية تحت الغزو الاستعماري، وهناك بلدان صمدت ثقافيا، وحافظت على لغتها الأصلية، وهناك درجات متفاوتة بين هذين النموذجين، ولا شك في أن اللغة العربية كانت لها خصوصيتها وعمقها الحضاري الذي حفظها وحفظته. وهذا ما ينبغي البناء عليه، إذا أردنا حضارة جديدة، فلا يمكن أن ننشئ حضارة، ونحن واقعون في أسر حضارة أخرى، نريد تقليدها: فكرا، وهوية، وقيما، وأخلاقا، ولغة، وعلوما، وفنونا.
ومن أوجه الصراع في عصرنا، ما سعت إليه القوى الكبرى في العالم، في محاولاتها لتغيير الطبيعة اللغوية، للمناطق التي تفرض عليها نفوذها، فاللغة البرتغالية تنتشر في البرازيل، واللغة الإسبانية في الأرجنتين، وكل هذا من نتائج الحقبة الاستعمارية في القرون السابقة، حيث سعت القوى الاستعمارية الكبرى إلى تثبيت نفوذها اللغوي بشكل تسلطي، وفرنسا نموذج على ذلك، حيث سوّقت اللغة الفرنسية بوصفها قناة مؤدية للحداثة، في الجزائر والهند الصينية، وكرّست الفرنسية بوصفها لغة رسمية في الإدارة الاستعمارية والتعليم والإعلام. أما اللغة الروسية، فقد عملت روسيا القيصرية على نشرها في الأقاليم حولها، فلما جاءت الثورة البلشفية، وسيطرت على أجزاء واسعة من وسط آسيا وشمالها، وشرق أوروبا؛ سوّقت اللغة الروسية بوصفها لغة الاشتراكية العلمية، وإن ظلت جاذبيتها محدودة وتقلصت أكثر، مع انهيار الاتحاد السوفييتي عام 1991، وما انتشار الإنكليزية الآن إلا لينهض ليكون مثالا جوهريا على علو شأن الولايات المتحدة، ومن قبلها الإمبراطورية البريطانية التي أفلت عنها الشمس. لكن الأمر اللافت للنظر، أن اللغات العالمية المنتشرة الآن، اتخذت رموزا لنشرها لدى شعوب الأرض، مصحوبة بأيديولوجيات وأفكار. فاليد الثقيلة دالة على مادية اللغة الروسية، في تعبيرها عن الماركسية، وارتباطها بالتقشف الاقتصادي والجهد الجماعي. أما اللمسة الخفيفة فترمز إلى عقلانية اللغة الفرنسية، وتشير اليد المفتوحة للنزعة الاستهلاكية الأمريكية، والابتكارات والمشروعات الفردية المحققة للإثراء السريع.
فكل لغة تحمل أيديولوجية تعبر عن دولها وشعوبها، فاللغة الروسية ارتبطت بحقبة الاتحاد السوفييتي، الذي احتل أقاليم شاسعة من جمهوريات وسط آسيا، ودول شرق أوروبا، واتخذ من الروسية سبيلا لنشر فكره وسلطته والدمج الثقافي والفكري لهذه الشعوب، ومحاربة هويتها، بنشر الفكر الماركسي، بشعارات تنتصر لحقوق العمال والمزارعين والفقراء، وعلى النقيض، فإن اللغة الإنكليزية عبّرت عن بريطانيا العظمى، حينما كانت تتمدد في العالم، وتتخذ الأسد شعارا، والشمس علامة على اتساع رقعتها. وكانت الإنكليزية محظوظة، فمع شيخوخة الأسد البريطاني، وانحسار مده الاستعماري، ومغيب شمس الإمبراطورية، صعدت الولايات المتحدة، خاصة بعد حقبة العولمة، مستفيدة من انهيار الاتحاد السوفييتي وارتفاع شعارات نهاية التاريخ بانتصار الرأسمالية والديمقراطية الغربية على حد قول صموئيل هنتنغتون: إن الحضارات كيانات ثقافية، وليست كيانات سياسية، فهي لا تحفظ النظام، ولا تقيم العدل، أو تجمع الضرائب، أو تخوض الحروب، أو تتفاوض على اتفاقيات، فكل هذا من مهام الدول، فالتركيب السياسي للحضارات يختلف من حضارة إلى أخرى، كما يختلف مع الزمن داخل الحضارة الواحدة. وبالتالي فإن الحضارة الواحدة قد تحتوي على وحدة سياسية أو أكثر، وهذه الوحدات قد تكون دولا قومية، أو اتحادات، أو إمبراطوريات، أو اتحادات فيدرالية، أو اتحادات كونفدرالية، أو دولا متعددة الجنسيات، وكل منها له شكل حكومة مختلف. ومع تطور الحضارة تحدث عادة تغيرات في عدد وحداتها السياسية وطبيعتها.
والصراعات التي تحدث بين الأمم في كثير من أوجهها تُنازِع على السيادة والسؤدد، وأيضا صراع حضاري، تتقاتل فيه الأفكار والعقائد واللغات، وهو ما يؤكده هنتنغتون، وهو يستشرف المستقبل، فالحضارات هي القبائل الإنسانية النهائية، وصدام الحضارات هو صراع قبَليّ على نطاق كوني، وإن كانت العلاقات بين الجماعات (الدول والشعوب) التي تنتمي إلى حضارات مختلفة؛ غالبا لن تكون وثيقة، بل عادة ما تكون باردة وعدائية في معظم الأحوال. ففي عالم مكون من حضارات متعددة، ستكون العلاقات متراوحة بين: سلام بارد، حرب باردة، حرب التجارة، شبه الحرب، السلام القلق، العلاقات المضطربة، التنافس الحاد، التعايش التنافسي، سياق التسلح، هذه العبارات كلها هي الوصف الأكثر احتمالا للعلاقات بين الكيانات المنتمية إلى حضارات مختلفة. وستتعدد ميادين الصراع، سياسيا وعسكريا واقتصاديا، وأيضا هناك أناس (دول ومجتمعات وأقليات) سيستخدمون جهود دولة من إحدى الحضارات لحماية أقارب لهم في حضارة أخرى، أو للتفرقة ضد أناس من حضارة أخرى، أو لطرد أناس ينتمون إلى حضارة مختلفة. وكذلك سيكون الصراع حول القيم والثقافة، عندما تحاول دولة ما أن تتبنى أو أن تفرض قيمها على شعب حضارة أخرى، وتحاول دول المركز حشد جماعاتها الحضارية لتناصرها.
إن الرؤية التي افترضها هنتنغتون وبنى عليها تصوراته نابعة من نظرة الغرب إلى العالم، حيث يرتكز النظام الدولي على الصراع بوصفه مرتكزا في السياسة العالمية، نظرا لتفاوت النظم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتفاوت الثروة، وتفاقم صراعات القوميات والعرقيات، والتهديد الدائم بالقوة، إلى جانب التفاوت والتناقض بين وحدات النظام الدولي أيديولوجيا وسلطويا، فالصراع هو محور رؤيته في التعامل مع بني البشر؛ صراع على الموارد، وعلى الأراضي في حقبة الاستعمار المباشر، ثم صراع حضاري، ناتج عن عدم إمكانية التعايش، بعكس الرؤية الإسلامية، التي تتخذ من العدالة مرجعا، والسلام والتعايش أساسا، وتجعل الحرب استثناء، وهو ما يجب أن نعيه جيدا ونحن نرى الحروب المشتعلة دوما في عالمنا. فالعدالة هي القيمة السياسية العليا في السياسة الشرعية الإسلامية، وتصاغ عليها القيم كافة التي تحدد دعائم العلاقات الإنسانية بين البشر: أفرادا وجماعات ودولا، في حالات السلم، وحتى إذا اضطروا إلى الحرب، بل إن العدالة الإسلامية هي حق للأعداء، مثل الأولياء، ولا تجوز أن تحمل العداوة على الظلم، بل إن العدل مع الأعداء أقرب للتقوى. ودعا الإسلام إلى السلم كافة، وعدّ الحرب إغواء من الشيطان. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾،(المائدة، 8)
كاتب مصري