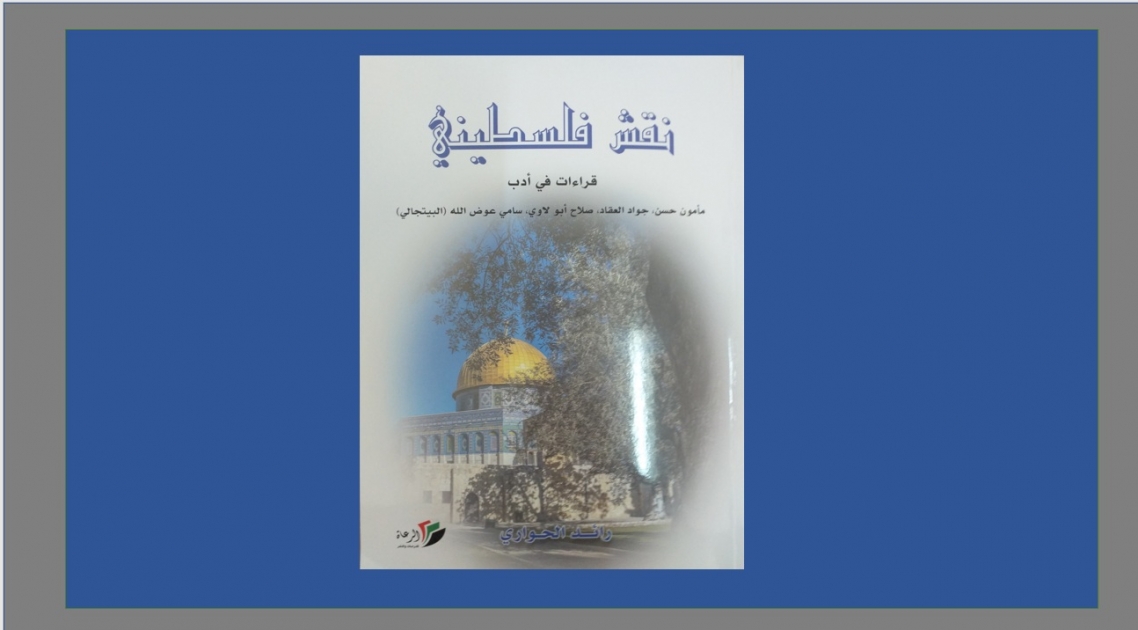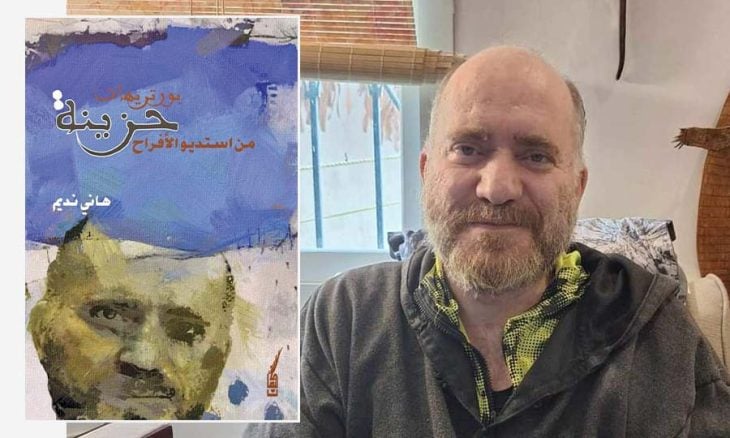محاولة في صناعة فوكو العربي

علي حسن الفواز
تبدو الحاجة إلى إعادة قراءة ميشيل فوكو مثيرة للفضول المعرفي، وللمساءلة عن أزمة هذا الفيلسوف مع العالم، الذي هو عالمنا أيضا، لكنه المختلف في الجوهر، وفي النظر إلى الحرية التي يملكها فوكو الفرنسي، ولا نملكها نحن..
مصطلحات مثل الخطاب والعصاب والعقاب والرقابة والجنوسة والسجن والعيادية تشكّل قاموسا غامضا، ومجالا لمعاينة الأفكار العميقة والمخفية التي تلامس المخفي في هذه المصطلحات، فتجعلها أكثر توترا وإثارة، وأكثر تهديدا للتاريخ، بما فيه تاريخ الأفكار ذاتها، فما يراه فوكو ليس بعيدا عن قلق الحداثة، وعن رهابات «الوعي الشقي» وعن أزمة السلطة مع الإنسان، وأزمة الإنسان مع الحرية والجسد والتاريخ، ومع المؤسسات والأيديولوجيات التي تصنع السجون والعنف، وتضع الجسد أمام تأويلات مفتوحة، تجعله مطاردا ومحصورا ومُهددا بالتدمير، وأن ما يصنعه من خطابات لا تعدو أن تكون جزءا من لعبته في التورية والاختفاء والشغف بالدفاع عن فرادته، وعن وعيه الصاخب بسؤال الحرية..
قد يصلح فوكو أنموذجا للدرس، ولتوظيفه في مقاربة موضوع المثقف العربي المتعالي، والرث في آن معا، الذي يجد نفسه تحت إيقاع قهري، وفي حرب مفتوحة، تخص السلطة، والجسد والهوية والعمل والحرية والتاريخ، وأن ما يمكن أن يكتبه سيكشف عن محنته وهو يرى الأنساق المضطربة لكائنه الفلسفي المعطوب والضحية المنتهك، الذي يعيش استحالة تحوّله إلى مواطن حر، قادر على الإباحة والاعتراف، ومراقبة السلطة التي كانت تراقبه، وأحسب أن إعادة صياغة الأدوار واحدة من أكثر الأزمات التي ستواجه فوكو الفرنسي، فرغم أنه خرج من معطف فلاسفة «ثورة باريس 1968» ومن أطروحات جماعة فرانكفورت، ومن ظاهراتية هوسرل وهيدغر وسارتر، إلا أنه ظل يناور في وعيه الماركسي المضطرب، فالصراع الطبقي الذي وضعه ماركس قاعدة ذهبية جعله فوكو تمثيلا لصراع داخلي ليس بين الطبقات، بل بين الذوات، والهيمنات، وهذا ما جعل كتبه «ألغاما ومتفجرات» كما وصف نفسه، وأن نظرته للسلطة، تعني نظرته للسياسة والإدارة البيروقراطية، مثلما تعني نظرته للرأسمالية التي فخخت العالم والأسواق، وجعلت من الإنسان كائنا يلتذ بالاستهلاك، مثلما يلتذ بالجنس والحرية، وهذا الاشتباك هو جزء من أزمة الكائن العولمي الذي يرهن الحرية واللذة بالاستهلاك، وأن «من المستحيل» الخروج عن ذلك إلى الحرية الفائقة، إذ سيخرج التاريخ شاهرا أسلحته المركزية الأيديولوجية والسياسية عبر مظاهر القمع الناعمة والصلبة، حيث الحروب والمدارس والمستشفيات والسجون والمكتبات والمؤتمرات والأيديولوجيات.
أحسب أن «فوكو العربي» الذي افترضه سيكون خيارا لمواجهة فوكو الفرنسي المتموضع في نسق تاريخي وفلسفي محدد، وفي تعالٍ ثقافي وأنثروبولوجي تجعله ينطلق من ذاكرة «المستعمر القديم» الذي يؤمن بثنائية هيغل عن «السيد والعبد» وهذا ما يعني وجود حاجة للبحث عن وسائل لتأهيل «فوكو العربي» ليكون جزءا من اللعبة، ومن الرهانات على المغايرة وعلى تقويض المركزية القديمة، فرغم أن ذلك سيجعله أكثر انتهازية وكراهية وقسوة، إلّا أنه قد يحرضنا على تقويض أساطيرنا عن الفحولة والقوة والتاريخ المنتصر دائما، والدعوة إلى شراء «فؤوس ثقافية» للحفر في تاريخنا وزمننا الصلب، وفي التعاطي النقدي مع محنة ذلك التاريخ، ومع الحريات المقموعة، والسجون المفتوحة، والمنافي الواسعة، وربما سيجعلنا أكثر حساسية إزاء قراءة ملفات تاريخ السجون ومستشفيات الأمراض العقلية ومؤسسات الأمن الوطني، وسير الحكام المستبدين، والفلاسفة الأشرار، والمثقفين الانتهازيين، وعلى نحوٍ تتبدى من خلاله سمات الخطاب العربي بوصفه جزءا من مركزية «العنف الصياني» الذي يفترض أن النقد عدوان على السلطة، وأن الرقابة ممارسة غير صالحة « للدراسات الثقافية» والحديث عن العصاب والجنوسة والسجن والمشفى سيكون حديثا خاصا، وجزءا من صلاحيات الجنرال، لأن هذه المفردات هي ذاتها جوهر فكرة الألغام التي وصف بها فوكو كتبه الغامضة والمثيرة للجدل..
فوكو والمثقف الهارب من الحرب
منذ عام 1967 ونحن في حروب وهزائم مفتوحة، ولم نجد أمامنا سوى الشعراء الذين يتوهمون ترميم خراب العالم باللغة، والروائيين الذين يصنعون لنا سرديات مضادة، لكننا لم نجد فلاسفة يمارسون النقد الحر، لكي يبرروا ظاهرة شراء الأسلحة الفاسدة، وهروب الجنود من ملاجئهم، وهروب المثقفين من التاريخ، فبقدر ما تحدث صادق جلال العظم عن «نقد العقل الديني» وهشام شرابي عن «النقد الحضاري للمجتمع العربي» ومحمد عابد الجابري عن «نقد العقل العربي» ومحمد أركون عن «نقد العقل الإسلامي» وغيرهم، فإن هذا النقد بدا مازوشيا ومُذِلا، ولم يفتح أي ممر في أعماق سراديب المحنة والهزيمة والهروب..
علاقة ذلك بأطروحات ميشيل فوكو تكمن في موضوعة «الحفر» وفي الأدوات التي يمكن أن يستخدمها للتعرّف على أزمة التاريخ والسلطة، وأزمة الجسد المقموع والسلطة، ومن منطلق توصيفي يُعيد النظر بالجسد الثقافي العربي، ليجعل القمع جزءا من فكرة الهزيمة، فالمهزوم التاريخي يبحث ويحفر عن أسباب هزيمته، لا أن يعمل على تحويل الهزائم القومية إلى برنامج للقمع الوطني، ولزيادة مساحات السجون، والبحث عن أدلجات باردة تسبغ على الاحتجاج والثورة توصيفات يجردها من إنسانيتها وطهرانيتها. كان فوكو الفرنسي حرا، ومغامرا، ومجنونا، صنع للأشياء كلمات، وجعل من دروس الجنسانية والعيادية ممارسات في وعي وظيفة الكائن الحر الخارج من أزمة الحرب العالمية، ومن جنون الأسواق الرأسمالية، ومن نرجسية الجنرال ديغول.. لكن «فوكو العربي» الذي افترضه كصانعٍ لـ»المتفجرات» سيبدو مرتبكا وشائها، أصابعه المرتعشة تتوه عند مسامير التفجير، وربما سيعاني من عسر اللغة، ومن سوء تصريف الأفكار، لأننا سنورثه الخوف من السلطة والرقيب والجنرال، فنُخفي معه هويته الأركيولوجية، ونكرّس اعترافه الساذج بأنه موظف وطني وعقلاني، ولديه حساسية مفرطة إزاء الجنس والسياسة والسجن والعيادة والمشفى.. حديث فوكو الفرنسي عن «الصياغات الخطابية» جعلته أكثر غموضا، وربما جعلته يملك وعيه بـ»إرثه الديكارتي» عن الذات المفكرة، وعن الطريقة التي يرصد بها الجسد المقموع سياسيا، فجعل ذلك الإرث فوكو أكثر شراسة، وأكثر جموحا في الذهاب إلى الجسد وحريته، والتغوّر في تاريخه وأزمته، وصولا إلى تورط في محرّماته وممنوعاته، حتى صار ضحية جنسانية لهوسه باكتشاف الحرية.
لكن حديث «فوكو العربي» عن الخطاب لن يكون بتلك الحيوية، ليس لأننا نكره «الذات المفكرة» ونُحرّم الفلسفة، وأن السلطة تنظر للفيلسوف بارتياب لأنه شكّاك، وقد يكون ملحدا، بل لأن التفكير والمغامرة بالكتابة عن الممنوع والمكبوت ستقود حتما إلى المعارضة، وإلى الاختلاف، وهذا ما يخشاه المثقف العربي فيلسوفا كان، أم روائيا أم شاعرا، لذا يجد للهروب من المواجهة أبوابا واسعة، وأقنعة كثيرة تجعله يُبرر هزيمته وهروبه، بوصفهما نوعا من السلامة والتقية والخلاص وإيثار النافل على الواجب، وما أخشاه حقا أن يشاطر فوكو العربي مثقفه السياقي الفكرة ذاتها عن الهروب والعطالة والتلذذ بالهزيمة..
فوكو السياسي.. فوكو الفلسفي
التنوع الذي جعل من فوكو الفرنسي حرا، لم يكن كذلك عند «فوكو العربي» إذ يبدو الثاني مصابا بفوبيا الجماعات، والحديث عن الهويات «القاتلة والمقتولة» والانخراط في وظيفة السياسي الأيديولوجي، والسياسي الطائفي والقومي، وبالتالي ستضيع وظيفة الفيلسوف التي يتوهمها نوعا من المباهاة، لكنها في القاموس الشعبي لا تعدو أن تكون صعلكة وجنونا وخروجا عن «النص» والسياق. وسط المحنة، والحروب المفتوحة، ما عاد النقد نافعا، ولا أظن أن أطروحات ناقدة كالتي تركها صادق العظم، وشرابي والجابري وأركون وجعيط وإدوارد سعيد وحتى جورج طرابيشي وفالح عبد الجبار، ستكون نافعة في إعادة إنتاج صورة ملونة لـ»فوكو العربي» وتسويقها على أساس الترويج لـ»الصناعات النقدية» لأن ما يجري وسط «العنف الصهيوني» و»الشقاوة الأمريكية» والرثاثة الغربية جعلنا نبحث مثل التجار الفاشلين عن ديون قديمة، وعن معاطف قديمة، فالصمت العربي، والخوف العربي وهيمنة تجار الأفكار والملابس المستعملة جعلني «شخصيا» أفكّر جديا بتوظيف الذكاء الاصطناعي لإنتاج مشروع «فوكو العربي» لكي أجعله ناقدا أو أركيولوجيا حقيقيا، يمكن توظيفه، واستعارة قناعه، وحتى جيناته، وعلى نحو يجعل تطبيق منهجه الأركيولوجي/ الحفري سهلا ومقبولا، وصالحا كأنموذج للكشف ولقراءة ما نعانيه من صلابة وخشونة من مظاهر بدت فاضحة في أفكارنا، وعلى قمصاننا المسكونة بميثولوجيا الشبق الذي تركته السيدة زليخا في تاريخ مقدسنا الغامض.
الهروب من التاريخ، سيعني الهروب إلى تاريخ آخر، وكل هروب سيعني الاتكاء على أجهزة أيديولوجية للسلطة كما يقول دولوز، أو للجماعات والطوائف، وربما لـ»الاستعمار ذاته» بوصفه عرابا أو حاميا، أو يملك سماء تحميها الطائرات وليس الخرافات، وهذا يجعل حديثنا مع فوكو العربي عن «ثورات الربيع العربي» حديثا عن الكوميديا السوداء، أو عن بعض حكايات الغموض في المغازي العربية، التي يتخذها بعض فقهاء الفضائيات مجالا للحديث عن الخلاص وعن النهايات السعيدة، وبالتالي نبذ الفلسفة، وطرد الفلاسفة، واتهام فوكو وغيره بأنهم ملوثون بعدوى الشك والكراهية، والعمل على العودة إلى التماهي مع شخصية «علي بابا» أو شخصية «السندباد البحري» أو «علي الزيبق» بعيدا عن ما نقترحه حول الاستعانة بـ»فوكو العربي» الذي يمكنه أن يكسر الإيقاع، وأن يشاطرنا المغامرة، وربما سيناور بلبس قناع «فوكو الفرنسي» لكي يكون أكثر صدقا في تمثيل أفكار التمرد على تاريخ هزائمنا.
كاتب عراقي