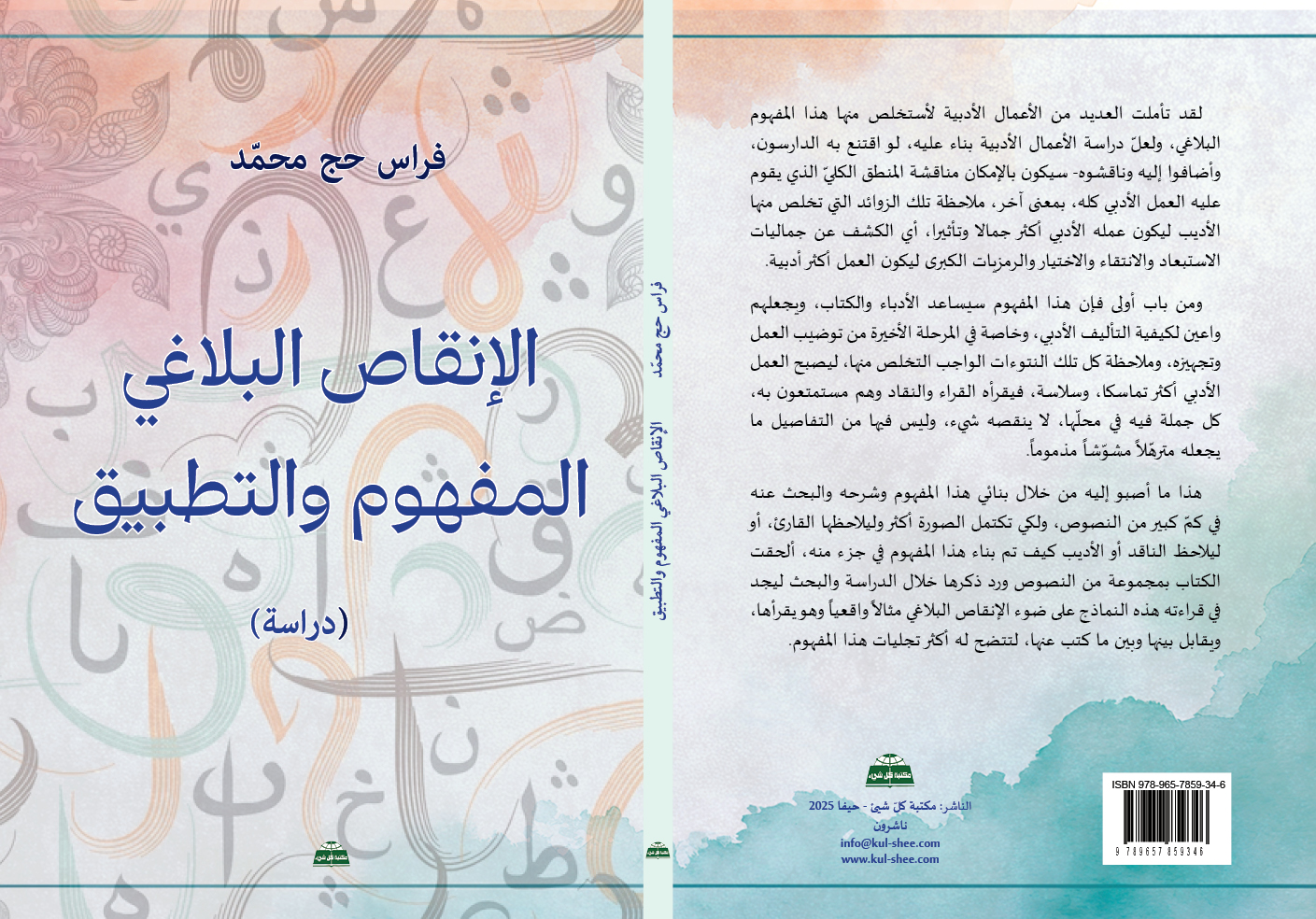الغرابة في الكتابة السردية وإغواءات اشتغالاتها

مروان ياسين الدليمي
لا يملك الروائي سوى اللغة، فهي أداته الوحيدة في تفكيك وصياغة العالم وفق رؤيته، اعتمادا على سلطة التخييل التي تمنحه حرية اللعب بالزمن ومجريات الأحداث، دون الانسياق خلف لغة تقريرية تنقل معرفة الكاتب المباشرة بالواقع، فاللغة في مشغل السرد تنزاح إلى نسيج معقد من تراكيب فنية، بالشكل الذي تصبح فيه لغة استشكالية ليست مطابقة للواقع، حسبما يصفها إدوارد الخراط.
وتعامل اللغة في السرد أقرب إلى عمل المُحترِف في مشغولات الأرابسك، حيث تتداخل منمنمات صغيرة جدا من مواد مختلفة، بعلاقة متعاشقة داخل القطعة الخشبية والمشغولة بعناية فائقة. والروائي لن ينقطع عن التفكير وهو يتعامل مع الشخوص والأحداث بقضية مزاوجة المعنى مع المبنى، فليس مُهما ما يقوله من أفكار، وما يطرحه من أسئلة، وما يقدمه من صراعات وأوجاع إنسانية، بل المهم الكيفية التي يقدم بها هذه العناصر إلى القارئ، هنا تكمن فرادة العمل الروائي، واختلاف اشتغالاته مع الحكاية الواقعية، أو الحكاية كما تُروى شفاهيا. والتاريخ من هذا المنظور مجرد حكاية لا أكثر، يمكن أن تحظى بقبول نسبي، أو كما يقول كريستوفر باتلر في كتابه «ما بعد الحداثة» ترجمة نيفين عبد الرؤوف، «التاريخ مجرد طريقة لوصف الأحداث، يعتمد بقاؤها من عدمه على عملية من النقاش والجدل، وعلاوة على ذلك فإن بنى التاريخ وتفسيراته السببية المفصلة جُمِعَت في الأساس على نحو يشبه القصص الروائية».
الرواية والسينما والحكاية الشفاهية
الأسئلة التي تُطرح هنا: ما قيمة التجربة الفنية؟ وأين هي التجربة إذا ما تطابقت تجربة قراءة الرواية مع تجربة سرد حكايتها شفاهيا؟ فالسرد الشفاهي ينفي عن الرواية خصوصيتها في طريقة سردها، بما يعني أنه يقفز فوق التقنيات التي اعتمدها المؤلف في نسج حبكة النص. من هنا يمكن ملاحظة الفشل، الذي رافق معظم الروايات عندما تم نقلها إلى الشاشة، فلا غرابة لمّا يتفاجأ المتلقي بأن الفيلم لا صلة تجمعه بالرواية، مع أنه قد التزم بالحكاية وشخوصها، وما بينهم من صراعات وما تنتهي إليه مصائرهم، كما جاءت في الرواية، ولهذا دائما ما نجد المتلقين يتساءلون بعد انتهاء الفيلم: هل من صلة تجمع بين الاثنين؟ لعل السبب في هذه الإشكالية يعود إلى أن لغة السرد مختلفة ما بين الرواية والسينما. ولن نبتعد كثيرا عن الموضوع إذا ما أشرنا إلى بعض الاختلافات الجوهرية بين هذين الوسيطين السرديين، فلغة الرواية تعتمد على النص المكتوب، حيث يستخدم الكاتب الكلمات لتشكيل الأفكار والمشاعر، ومن خلالها يتمكن القارئ من تخيل الشخصيات والأحداث، ما يتيح له مساحة واسعة للتفسير والتأويل الشخصي. بينما لغة السينما تعتمد على الصورة والصوت، ويتم استثمار تقنيات الإخراج، والتصوير والمونتاج والموسيقى في عملية البناء السردي، بذلك فإن المخرج يقوم بتحويل النص إلى مشاهد مرئية، فيتم التعبير عن المشاعر من خلال الوجه، والحركة، والإضاءة، وهذه العناصر تمنح السينما قدرتها وخاصيتها على تقديم تجربة حسية مباشرة. كما أن الرواية تمتاز بقدرتها على تقديم الزمن بشكل مرن، بالشكل الذي يمكن للكاتب أن يتنقل بين الحاضر والماضي والمستقبل، واستخدام الارتداد الزمني (Flash back) أو الاستباق الزمني (flash forward). أيضا الرواية لديها من الآليات ما تمكن المؤلف من الغوص في دواخل الشخصيات وتعرية أفكارهم الداخلية ومشاعرهم المعقدة، بالتالي فإن ذلك يساهم في بناء علاقة أعمق بين القارئ والشخصيات. في المقابل فإن السينما تستخدم وسائط بصرية وصوتية لنقل المشاعر، وقد يلعب الأداء المتميز للممثلين تأثيره الواضح في نقلها بشكل تعجز عنه الكلمات. أما من جانب التلقي فإن الرواية تكرس التفاعل الذاتي الفردي، حيث يستغرق القارئ وقتا للتفكير والتأمل في النص. وهذا النوع من التفاعل يسمح بتجارب شخصية فريدة. أما السينما فإنها تقدم تجربة جماعية في التلقي، حيث يتفاعل الجمهور مع الفيلم بشكل مباشر، ما يعني تحقق ردود أفعال عاطفية في وقت واحد، مما يخلق تجربة تلقي مشتركة. وعلى الرغم من أن لغة السينما ولغة الرواية تختلفان في أساليبهما ووسائطهما، إلاَّ أن كليهما تمتلكان القدرة على سرد القصص والمشاعر بطريقة مؤثرة. فلكل شكل فني خواصه، وفي النهاية، يتجلى الجمال في تنوع سبل وأدوات التعبير السردية من ناحية استحضار الأحاسيس والتجارب الإنسانية.
السرد وتهشيم الزمن
إن تجربة كتابة عمل روائي تمنح المؤلف مزيجا من مشاعر المتعة والنشوة والشغف ربما أكثر من أي حقل إبداعي آخر، بما في ذلك الفن السينمائي، لأنني سبق أن جربت الاشتغال في الحقلين، ومن ناحيتي وجدت في الكتابة الروائية مساحة للتخييل مفتوحة على آفاق واتجاهات مختلفة ومتنوعة، فالنص السردي يصبح متحركا في فضاء من الحرية التي يتلاعب بها التخييل، وعليه فإن «المعاني تصبح هي الأخرى ملكية خاصة لمن يفسرها»، حسبما يرى باتلر في كتابه الذي أشرت إليه سابقا. فالكتابة السردية منحتني ما كنت أبحث عنه من إطار فني خاص وخلاق، مكنني هذا الإطار بما يمتلكه من ذخيرة تقنية ثرية من تفكيك الوعي الجاهز داخل الفرد والجماعة، كما في روايتي السيرية الأولى (اكتشاف الحب) وأتاح لي أن أتوغل في مغاور الداخل، حيث يتقاطع الذاتي بالموضوعي، وهذا ما حاولت إيصاله في روايتي الثانية «ما تخيله الحفيد»، أيضا مكنتني الكتابة الروائية في عملي الثالث «اختفاء مذاق النبيذ» من تهشيم سلسلة الزمن السائر بخط مستقيم، بالشكل الذي أخذت تتراكب معا في بنية السرد أفعال المضارع والماضي وما يقع في خانة المحتمل.
الحدث والشخصية
في مشروعي الروائي المتواضع – مقارنة بآخرين – يشكل الحدث والشخصية أهمية مركزية، وما يشغلني في مرحلة تكوينه، البحث عن الكيفية التي أنظر من خلالها إلى هذين العنصرين، باعتبارهما واقعيين، واضعا في استراتيجيتي عدم التزامي بشرطي الصدق والأمانة في نقل الحدث، مثلما جاء في الواقع، لأن الحدث بذاته الواقعية يمكن سرده بطرق متعددة، وسيختلف كليا في ما لو انزاح بواقعيته إلى منطقة التخييل الروائي، بمعنى أن الأدب الأكثر ابتعادا واقترابا في الوقت نفسه عن التاريخ، وهذا ما اهتممت بالعمل عليه في كتابة نصوصي الثلاثة، لأن لغة السرد الروائي فيها من الإغواء ما يمنح الكاتب فرصة التحرك في فضاء شاسع، بعيدا عن محدودية التصور في الرَّوي التقليدي للفضاء، كما في حقول الكتابة الأخرى إذا ما تناولت الحدث الواقعي نفسه. وهنا أتفق تماما مع وجهة نظر الشكلانيين الروس، فهم يشيرون إلى أن «المتوالية الواقعية عندما يضعها الروائي في متوالية أدبية، يعني تغريبها، أي أن الشيء الواقعي لا يعود هو نفسه، إنما يصبح غريبا عنه»، فالغرابة جزء حيوي من بنية العمل الروائي، وأي عمل إبداعي، والمسألة تبقى محصورة في السؤال الآتي: أين نجد الغرابة في النص الأدبي، هل في بناء الشخصية، أم الأحداث، أم الزمن، أم اللغة؟ ربما في نص ما تتوفر في كل هذه العناصر، بينما في نص آخر يمكن أن تتوفر في واحد منها.
٭ كاتب عراقي