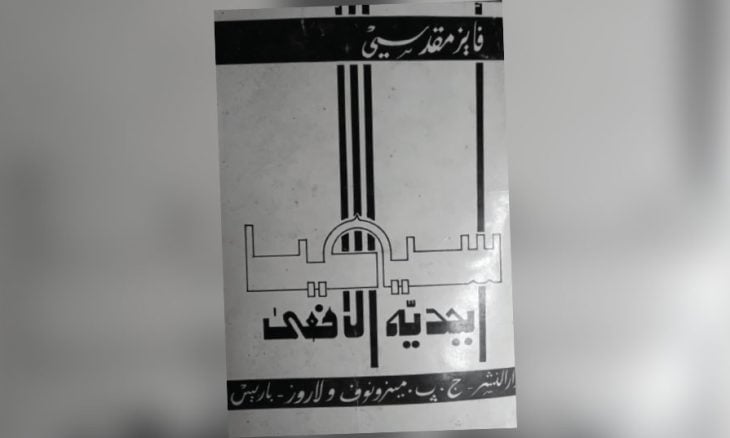
الحياة كمسرح والموت كفرجة في «سيميا أبجدية الأفعى»

عبدالحفيظ بن جلولي
تتداخل الأشياء في راهن العالم حتى تعتم الرؤية ويضمحل الإنسان، وينبثق سؤاله كظاهرة وجودية غامضة لا يمكن فهمها في ظاهرها، أبعادها الثقافية والاجتماعية والنفسية والتاريخية تجعلها في درجة من التعقيد لا ينفك سوى بتأويل الإنسان ذاته، والشعر يقدّم إمكانية لاختراق وعي الإنسان وهو يفكر من خلال «الخيال النشيط»، ولهذا كان غاستون باشلار الفيلسوف في تواصل مع الصور التي يقدّمها إليه الشعراء.
اللافهم عين فهم الشعر:
فايز مقدسي في كتابه الشعري «سيميا أبجدية الأفعى» الصادر عام 1973عن دار نشر فرنسية ج.ب ميزونوف ولاورز، يقدم الشّعر لا كدلالة للفهم، بل كمعطى لغوي للتعمية، والسّبب فيما يبدو لي أنّ الإنسان تجربة فردية في ذاته، والشاعر أعمق نموذج لهذه الحالة. قراءة مقدسي لا تحيل إلى المعنى، لقد ورد في مقدّمة الكتاب بقلم عابد عازرية «الحرف صوت إنّما الصوت ليس بمعنى إنّه حرية المعنى». إنّ الغموض في كل قصيدة يمنح القارئ شهوة طاغية في الاستزادة منه حتى نهاية الكتاب ليتأكد الباحث عن معنى للإنسان أنّ الكلام الشعري يقع ضمن شبكة «أفعوانية» لا تقود سوى إلى التركيز حد التشتت في الحركة اللامتناسقة للغة لتحيل النصوص برمتها إلى خارجها، إلى فايز مقدسي. التقى فايز مقدسي ضياء السكري، الموسيقي السوري العالمي، الذي كان يحنّ إلى العربية، فقد غادر سوريا صغيرا، وأبدى رغبة في عمل باللغة العربية، «فاستخرج أصواتاً موسيقية من العربية، وطلب مني أن أكتب له النصوص، وحينها اكتشفت العالم الموسيقي لضياء، وهو العالم الحافل بالغموض والألغاز، والسحر، فبحثت عن نصوص يمكن أن تتطابق مع عالمه ذاك، ووجدت أنّ نصوص المتصوفة المسلمين هي أفضل النصوص، كمحيي الدين بن عربي، والنفّري، والحلاج، والسهروردي». في هذا المنعرج الصوفي نعثر على الخلوة الإلهامية التي يستقي منها مقدسي جملته الغاصة بالغامض والمُلَغَّز، وبكل قلق وحيرة الصّوفي العابر دنيا الظاهر إلى مقام الباطن.
مع نص فايز مقدسي نعيش وعي اللافهم للقصيدة، ليس المهم فهم الشعر، المهم أن لا يعيقنا ذلك عن الوصول إلى فهم يتعلق بالذّات القارئة. «سيميا أبجدية الأفعى» تتشكل كقوة طاردة، «هذه اللغة ـ سيميا ـ هذه البراءة الأولى هي السّم الذي يتطلب الكثير من النبل حتى يشرب» كما يقول عابد عازرية.
يشكل الشاعر خلايا النص من أرخبيل مفهوماتي عصي على الإدراك، لأنّه توليفة من الكلمات التي نسج مقدسي القول فيها، وفق معطيات ممعنة في الذاتية والتجربة التي تتفهمها الذات وحيدة في تمرّدها الصعب والخطير، فـ»سيميا أبجدية الأفعى» تتشكل في الحقول الثلاثة للعلامة والكلمة والحركة، تلك هي حركة المعنى في حريته التي لا يمكن لأي تأويل أن يحدّ من سريان اندفاق المعنى فيها.
الحياة كمسرح والموت كفرجة:
التحق مقدسي بالسوربون ودرس «التاريخ القديم واللغات السامية»، و»انكب على التراث الشعري والملحمي السوري وترجم الأساطير السورية الكنعانية والآرامية». كان يدور في فلك الأسطورة والبحث عن الجذور في علاقتها بالراهن، وهو ما يفسر اللغة ذات الحمولة الكشفية، المنطوية على السر الوجودي المبهم والمحير، الموت الذي يتواطأ مع الحياة ليزيدا من حيرة الإنسان، أحيانا يزرع الإنسان الموت مجانا ليرضي شهوته بالحياة، ونسأل هل الحياة عبث؟
مفتتح الكتاب في نص «حصان»، «حصان يطوّح بالانقراض، يفترس خلاياه ويضمحل، يدوس عشبا ناريا، يلعنه الماء ويحلم به الهواء»، تطويح أيضا بالمتلقي في آفاق غير مرئية، استحضار للأسطورة وعشبة الخلود، نبتة جلجامش الذي تحوّل من الجبروت إلى العدالة في رحاب أنكيدو، تصارعا فتصادقا. الجبروت العبثي للإنسان ينذر بـ»الانقراض» و»الاضمحلال»، الإنسان يتآكل وينهار في ظل انحراق العشبة وتلوّث هواء الحياة.
«يتعب الموت بالموتى حتى تعرق القبور ويبتل تراب الأرض»، سؤال وجودي جوهري: هل ينتهي الموت؟ السيرورة الحياتية تتطلب النهايات، والأرض بالضرورة هي التي تكشف حقيقة الموت كوضع يؤول بالجسد فارغا من الحركة إلى عراقة التراب، باعتباره حالة السكون الشبيه بالموت، أو باعتباره الطين الشبيه بمادة الجسد، فللأرض أيضا ذاكرة تستدعي بلل الطين الأول الذي انفلت منها وتَشكّل كيانا إنسانيا غامضا فقد خصائص الطين البدئي.
في الطبيعة الإنسانية هناك توق إلى العودة إلى الأرض، «قبل موته، أشار إلى قبره، هناك توّج نفسه وامتشق حسامه»، هذه الإشارة فيها من اللا دلالة ما يكفي لأن تُفتضح حقيقة الإنسان العاشق للحياة، لكن المسار الوجودي لا يعبّر في واقعيته سوى على شهوة للموت تجعل الإنسان يقيم مراسيم الاحتفال بسلطة الموت كغريزة ونشوة تقابل بين القبر كنهاية والمكان كبداية، التتويج باعتباره حالة مكانية وما يستدعيه من جبروت للإعلان على عبث الإنسان بالحياة، وهو ما يكرّس عبثيته بالموت أيضا.
إنّ غياب أي دلالة تُرتجى من قراءة تتعجّل المعنى في نهوضه من الغموض، إنّما تؤكد على إنّ الشعر في حقيقته قراءة وانتظار، انتظار العالم يجيء مكسوا بالمعنى الذي في صوت الكلمات الذي هو «حرّية المعنى». فايز مقدسي وهو يرتّب هذه الشبكة الأفعوانية للمعنى، يفجّر نطاق الوجود بين حياة وموت، وبينهما يتساءل في حيرة عن ماهية العالم؟ («كأنّ في ضميره عذوبة وهو يبحث عن العدالة/ يسأل: «ما هو العالم» ويجيب «سماجة الزهور»). لا معنى لحركة الموت والحياة دون سؤال العالم. تقف الذّات على حافة حياة تؤول إلى الموت، وفي مستويات عبثية أيضا، لأنّ شهوة الإنسان للاستمرار تجعل الحياة ذاتها مسرحا هزليا لفرح يجتاح الذّات وهي تتخطى الجثث، كأنّ شيئا لم يحدث، وإلا كيف نفسّر الظلم والعدوان والموت الذي يدك الحياة مستهترا بمساراتها؟ سؤال العدالة، هو سؤال الحياة، هو المفقود الذي أخلّ بتوازن الرؤية للموت باعتباره وضعا وجوديا تستمر به الحياة في نظام نجهله لكنّه يختزن شيئا من المنطق. يحفر مقدسي في عبث الكينونة بمنطق عبث العالم، ويضيء معناه في «سماجة الزهور»، التي لا تحيل سوى إلى الموت، فجوليا كريستيفا في «علم النص» تبيّن الوحدة الدلالية في مقابلة بين المزهرية والتابوت، اللذين يحيلان إلى الموت، فالمزهرية موت للزّهرة من حيث إنّها تُستعمل لخلق حالة جمالية.
انفصال الإنسان والقيمة:
الوضع البشري في متاهة الحركة الوجودية يفقد نقاط ارتكازه، الوجود يتحوّل إلى عدم، لا شيء هناك ينبئ عن «حرية المعنى»، «هذا المكان بلا ارتكاز، كعالم يذوب – عماء يبصر»، اللاإرتكاز فقدان لهوية التوازن، فهل إشكالية مقدسي تكمن في لا توافقه مع العالم، مع الحياة، مع الموت، باعتبار ذلك قطيعة، أم باعتبار ذلك عبثا واستهانة بشرية بجوهر الوجود؟ أن يتحوّل العماء إلى إبصار، معناه تحوّل الكينونة إلى «خبط عشواء»، وتنحصر الوجودية في أثر الموت، على من يقع عليه أو يُفلته كما تكشف معلّقة زهير بن أبي سلمى:
رأيت المنايا خبط عشواء من تصب تمته ومن تخطئ يعمّر فيهرم
أو تتحدد خطوط العمى الوجودي بما صوّره خوسيه ساراماغو في رواية «العمى»، حيث تتحوّل المدينة إلى فوضى بعد أن فقد أهلها البصر، فالخبط عشواء هنا هو انعدام الأمن والأمان اللازمين للاستمرار الوجودي. تتكرّر دوما الصورة المنهكة بالمأساة، بل والتقزّز من الوجودية حين يُفعَّل الخيال النافر من كل انضباط وتنفلت اللغة من نظامها النّسقي لتساير حيرة الشاعر الوجودية فتخلق نسقها القلِق الذي يتعسّر على القارئ الانتظام في مساره، «كان عشقك يغتالني دونما هوادة، يغمس في مرق جسدي خبز الموتى، يقيّح في الحدائق الورود». فضاء الحب هو الجسد، ولكن الموت حبّا هو إرادة عاشقين بالحياة في انسجام التوادد. تنفر الوضعية التآلفية للحب وتنحدر نحو هوادة «الجسد» حين تنتهكه رائحة «الجثة»، فينقلب الوضع ليحل محل «التفتح» التقيّح، وتتعالق الوردة مع القيح، طبعا هذا المستوى من التصوّر ينتج في الإدراك حالة من الاشمئزاز، هو النفور ذاته من الوجودية العبثية التي قلبت موازين الكينونة وراحت تكشف عن اللادلالة في الأشياء. فراغ المسار الوجودي من الدلالة فَسَخَ الوصل بين الإنسان والقيمة.
التلاهي الوجودي ودوّامة اليقظة:
ماذا يمكن للغة أن تكتبه كي تفكك وضع شيفرات البؤس الوجودي، «ولعلّني قرّاء الزمان أفك الحرف. فانرمى العالم الغريب في صحراء اللفظ والكلام، صاح: الغوث الغوث/دخلت في علم المنام/فأين هو حال اليقظة؟» ينبني العالم نصّا مبدأه الوجود وينتهي في العدم، فأي الكلمات قادرة على احتواء المعنى في العالم مع كل تحوّلاته وانبثاقاته وعبثياته. تحتمل اللغة العديد من آفاق المعنى، وعبر العالم يمكن تأويل الإنسان، لكن يستحيل الوقوف عند المعنى القار في اللغة، ولذلك ربّما تتبادل المعاني المراكز، فيدنو المنام من اليقظة، ويغيب معيار الحركة في الوجود إذ يضطرب الزّمن الوجودي، ولكن الأعمق في رؤيا مقدسي هو تداخل الحلم والواقع فلا حدود، والإنسان بطبعه واقعي، فأين الواقع إذا كان العبث مستحكما في العبور بين «علم المنام» و»اليقظة»، تلك التي لا تكون سوى يقظة الإنسان في دوّامة تلاهيه الوجودي.
كاتب جزائري






