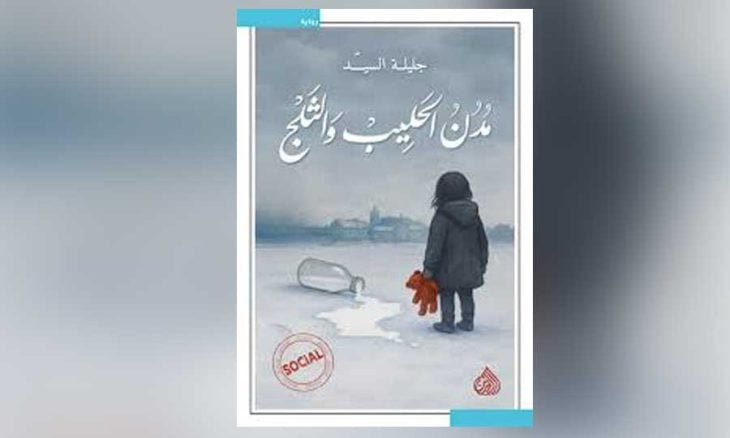طبقات النصوص

توفيق قريرة
قديما وحين كان الورق نادرا والكتابة سرا، كانت الورقة الواحدة تحوي أكثر من نص، فمن الممكن أن يكتب نصّ على رقّ، أو ورق ثم يكتب عليه نصا آخر. كان يستعمل هذا الوراقون والنساخ حين كانت تظلّ الأوراق عندهم ولا تباع فيضطرون لكتابة نصوص جديدة لها حظها في البيع والنشر. العبارة الأصلية التي تسمى هذه الظاهرة باليونانية Palimsestos (بالعربية الطرس) التي تعني حرفيا الحك من جديد، يعني حكّ الحرف القديم لإعادة الكتابة على الورق نفسه. استخدمت عبارة الطرس في أصل اللغة، للدلالة على الرق وتكون أكثر تحملا للخط والاستعمال من أوراق البردي الثمينة، التي لا تتحمل كثرة الاستعمال وكانت هذه الرقائق الجلدية تستعمل في الكتابة وفي التعاويذ وفي غيرها من الاستعمالات، ومن الممكن أن يشتري البائع رقا فيه نصّ فإذا فيه نصّ آخر مخفٍ يمكن أن يسعى إلى قراءته في أوقات فراغه، أو قلقه، أو تطلعاته.
يقال إن التطريس، أي الكتابة على خيالات كتابة أخرى كان اضطرارا حين منع المصريون تصدير أوراق البردي في القرن الثاني قبل للميلاد إلى برغامون في آسيا الصغرى، خوفا من أن تصبح مكتبتها أعظم من مكتبة الإسكندرية، فقرر أمير برغامون استخدام الأوراق القديمة في كتابات جديدة. كانت تلك الرقائق تعرف بجلد برغامون واستخدمت هذه الأوراق في النصوص الدينية والقانونية الشرعية. ويبدو أن العرب حين كانوا في الأندلس طوروا هذه الصناعة، صناعة الكتابة على الجلد وقد تطورت صناعة الكتب بواسطة هذا الضرب من الرقائق الجلدية، بعد أن كان البردي يطوى.
استعاد الناقد والجامعي الفرنسي جيرار جينيت هذه العبارة وسمّى بها كتابه الصادر سنة 1982 «الطروس: الأدب في الدرجة الثانية» في معنى ربط نصّ بآخر صريح، أو ضمني وهو ضمن ما يسمّى بتناقل النصوص Transtextualité، وهي ظواهر كثيرة اشتهرت منها ظاهرة التناص، وأن تكون النصوص متجاورة أو في طبقات وأن يذكرك نصّ بآخر في قصيدة أو بحكاية فذلك – عند جينيت ومن آمن بالتحاور بين النصوص من أمثال باختين- طبيعي في تعايش الكلام؛ لكنّا نريد أن نتحدّث عنه باعتباره موقفا نقديا بين العامة، ولاسيما في تلقيهم ثقافات أخرى. إن الحكم على التفاعل بين النصوص على أنّه ظاهرة شاذة أو استفادة غير مشروعة، أو سرقة هو ما يميز الرأي العام في تناول هذه الظاهرة. قد يحدث في بعض الأحيان أن تقرأ آية قرآنية قراءة لا يمكن الرجوع فيها عن معانيها التي قرئت بها، على الرغم من الادّعاء أن ذلك ممكن. في سورة (الصافات 48) «وعندهم قاصرات الطرف عين»، قال المفسرون إن المقصود بقاصرات الطرف نساء قصرن أطرافهن، فلا يرين سوى أزواجهن. في هذا السياق نقرأ في تفسير الطبري: حدثني يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: قال ابن زيد ، في قول الله (قاصرات الطرف) قال: لا ينظرن إلا إلى أزواجهن، قد قصرن أطرافهن على أزواجهن، ليس كما يكون نساء أهل الدنيا». وتسمية النسوة بالعين يردونه إلى كبر عيونهن قوله (عين) يعني بالعين: النجل العيون عظامها، وهي جمع عيناء، والعيناء: المرأة الواسعة العين عظيمتها، وهي أحسن ما تكون من العيون. إلاّ أن من يقرأ هذه الآية بما ورد في المصادر المسيحية التي ترى أنّه لا حديث هنا عن النسوة، بل هو حديث عن الثمرات وأنّ الطرف هو الثمر البكر (أنظر منظمة الفردوس للقديس أفرام) وما قيل في قاصرات الطرف يقال في البيض المكنون في الآية اللاحقة، وهو في الآداب المسيحية يعني العنب الأبيض.
إنّ القراءة المقارنية بالرجوع إلى النصوص المسيحية، هي قراءة لنصّ حديث مكتوب على بقايا نصّ قديم هو الآثار المسيحية، وهذا يعني أن كثيرا من نصوص القرآن الكريم ينظر إلى أصدائها في النصوص الأقدم منها، أي النصوص المسيحية. وهذا النظر ممكن لأنّه يرى النصوص ومن خلالها الأديان واقعة في طبقات بعضها فوق وبعضها يشف عن دلالات بعض.
إلاّ أن المفسرين لا يمكن لهم أن يعودوا ولو شبرا عن مواقعهم في توصيف الجنة من أن النبات فد تحول إلى بشر. ليس لنا في النصّ القرآني هذه الآلية التوليدية ولكنّ لنا أيضا أن نؤول الجنة تأويلا لا يعني معناها اللغوي، بل تعني معناها الذي انتقلت إليه بواسطة المجاز. فالجنة لا تعني الضيعة المخضرة اليانعة، بل تعني هنا اسما نقيضا للنار، فيها مقام الخلود البديع حيث الخمر والنسوة، ولذلك تصبح المغفرة إجازة لا بالغلال بل بالنساء. التوليد من ثمرة إلى امرأة حدث من خارج النصّ، أو من خارج المواضعة الاعتقادية، التي بناء عليها قرئ النصّ الجديد من غير انتباه أو مراعاة للكتابة القديمة.
التفسير الديني للنص القرآني وهو تفسير لغوي لا يعتقد في كثير من الأحيان في أن الكتابة التحتية (القراءات المسيحية) كتابة غير مفيدة للكتابة الفوقية (النص القرآني)؛ وأنّ الذاكرة التي في تلك الكتابة لا تفيد الإطار، ولا المواضعة التي صيغت فيه الدلالات الجديدة، لهذا فإنّ القول بوجود نوع من العدول أو التحريف للمعنى، لا يمكن أن يقنع المفسرين، فهم ليسوا على جهل بما كان، بل هم على دراية به، ولكنّ الأيديولوجيا القرائية الجديدة تطالبهم بأن يتناسوا القديم.
بنى المفسرون ذاكرتهم على مواضعاتهم التي تبنوها من أن في الجنة من اللذائذ ما يجعل النساء عنصرا إضافيا من العناصر: هي ثمرة بشحمها ولحمها، ولكنّها أيضا امرأة حييّة لا تنظر إلا لبعلها، مثلما كان الأمر عليه في مواضعات الدنيا؛ والقطوف في القرآن قطوف دانية من امرأة وفية. إنّ القراءة التي لا تنفي النص هي قراءة تعترف به وتعترف بما ورد فيه، وعليها أن تعترف بأن بينهما تجاورا وتقاطعا. لكن القراءة المتعالية هي قراءة تكتب على النص القديم، وتريد أن تمحوه محوا لا يظهر بعده وعندئذ تصبح التأويلات التي تكتب على النص مساهمة في محو أثار ذلك النص القديم، أو الذي مُحي لكي يُكتب على الرق نصّ جديد، لأن جزءا مهما من التعالي يكون على حساب محو النص القديم أو الثاوي وراء النص الجديد.
الحور العين نسوة ولسن ثمرات هكذا يستقر الأمر في الكتابة الجديدة ولو أراد الله أن يشتقهن من الثمرات لفعل، ولكنّ هذا التخليق سيكون مرتبطا بالخلق الأول للإنسان في نص آخر. ففي سورة (ص 52) يقول تعالى، «وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ أَتْرَابٌ» في الآية تأكيد على العبارة وتأكيد على أنها وملازمتها كالعبارة الواحدة. وفي هذا التأكيد ترسيخ لصورة بواسطة إعادة العبارة المركبة المسكوكة حتى لا يدخل شيء من دلالة القاصرات القديمة، على أنهن ثمرات شهيات. أعتقد أن قراءة النصّ الديني على أنّه كالطرس، التي تخفي الكتابة الأخرى يمكن أن يفيد شيئا حتى في تطوّر التصوّرات ومنها التصوّر لكائنات الجنة: من ثمرة إلى امرأة.
أستاذ اللسانيات بالجامعة التونسية.