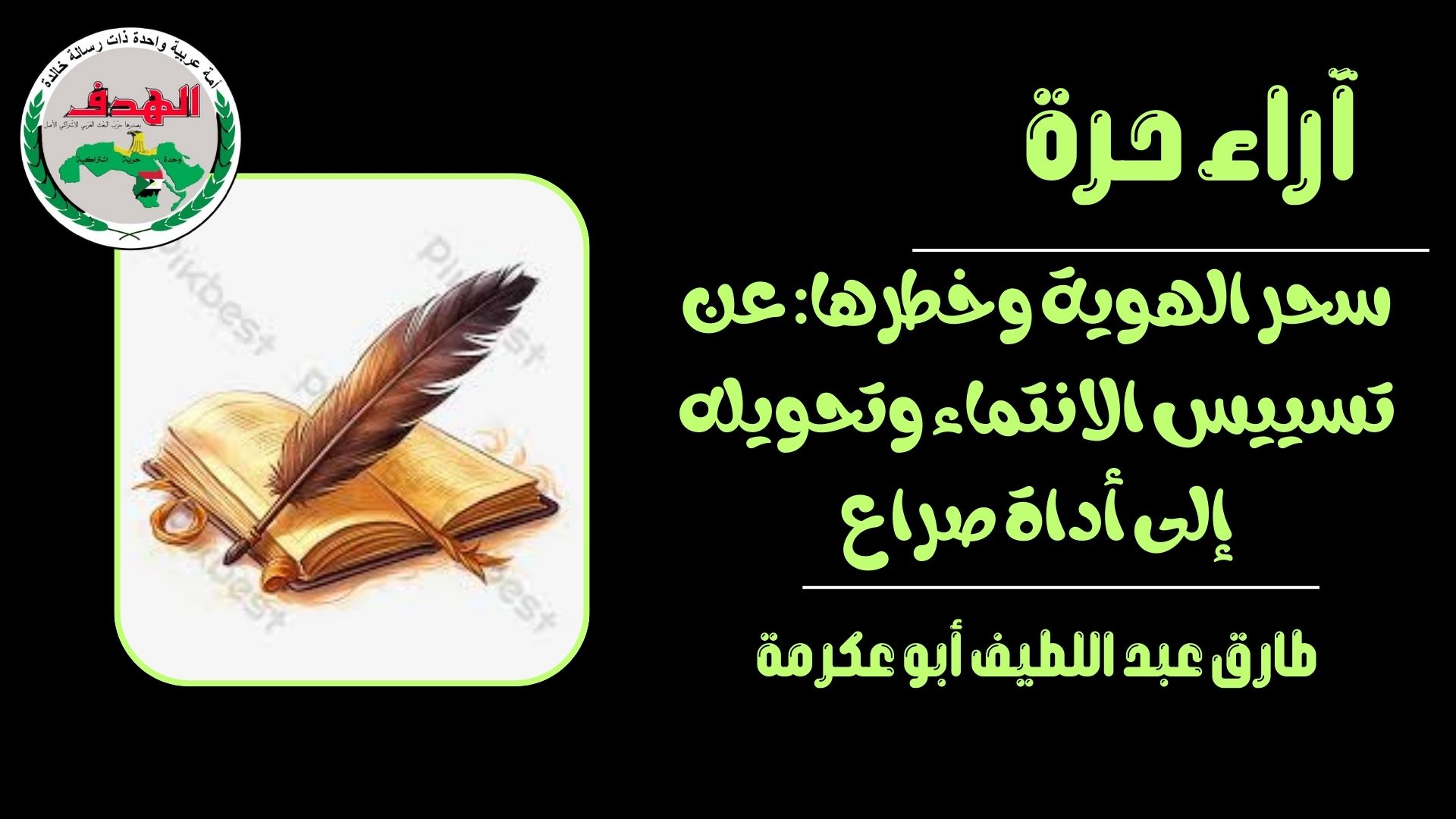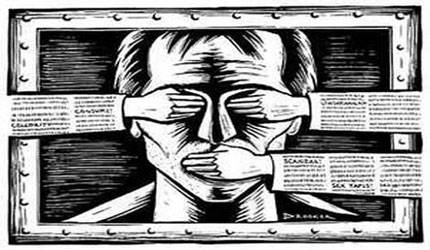في عالم الصورة ومؤثري المنصات.. لماذا نقرأ؟

في عالم الصورة ومؤثري المنصات.. لماذا نقرأ؟
محمد الشبراوي
مع بداية كل عام كالعادة، وبكل سعادة، درج أناس على رصد عدد الكتب التي طالعوها خلال العام المنقضي، يشاركون صورها عبر منصات التواصل مع أحبتهم، لعله من باب الفخر بإنجازهم، أو لتشجيع آخرين على خوض التجربة، لا بأس في ذلك إلى درجة ما، أو ربما من باب التباهي الخالص والبهرج الخداع.
تطالع كثيرين يتبعون هذه الموضة الثقافية -إن صح التعبير- فتشعر بالغربة، غربة الثقافة الحقيقية ومعالمها، صور تقول إنك ترى الجاحظ وألبرت مانغويل وأضرابهما، صور تحيلك إلى من عرفوا في العصر الحديث بـ»دودة كتب»، لكن الملموس في هذا السياق يشي بظاهرة ما، ظاهرة أشبه ما تكون بالماسح الضوئي (سكانر)، سمة ذات مظهر خارجي مجرد، آية من آي الترف السطحي والوجاهة الشكلية؛ لا تدري أهي قراءة عجلى؟ أم قراءة فهم وتدبر وتحليل وهضم واستيعاب؟ لا تجد انعكاسا لقراءات كثيرين على تفكيرهم، أو إنتاجهم الملفوظ أو المكتوب! وغاية المرء مما يقرأ أن يتغير للأفضل، أن يصبح أكثر قدرة على هضم الواقع والتعاطي معه، أن تتحسن قدرته على فك طلاسم الأمور من حوله فهما وليس بالضرورة تغييرا، إذ إن قضايا عدة عادلة وواضحة لكنها لم تحظَ بما تستحقه من الإنصاف، القضية الفلسطينية في صدارة تلك الأمثلة.
إذن المحك ليس في مئات الصفحات التي يلتهمها المرء يوميا، لينتهي به الحال بجبال من الصفحات سنويا، التعويل يكون على النتيجة، القيمة المضافة على المستوى الشخصي والمجتمعي لتلك القراءات، لئلا يجد الواحد نفسه يتباهى بقراءات لا حصر لها، وهو لا يُحسن معالجة فكرة أو إدارة موقف من مواقف الحياة!
يقول العميد أحمد أمين «هناك من يقرأ صفحة قراءة فنية فتدر عليه من الفائدة ما لا تدره ألف صفحة قراءة غير فنية»، ثم يضع للقراءة الصحيحة شروطا، أهمها من وجهة نظره «أن تكون قراءة في دقة وإمعان، يستطعم فيها القارئ الجملة من الفصل – أو الفصل من الكتاب – كما يستطعم الأكل اللذيذ، يجيد مضغه ويجيد هضمه»؛ ليتوصل من خلال ذلك إلى نتيجة مفادها أن «قراءة كتاب على هذا النهج خير من قراءة الكتب الكثيرة قراءة سطحية لا عمق فيها ولا تفكير». لن أكرر نفسي بالحديث عما سقته في كتاب (خطوب ودروب)، لكن ما يستأهل التأكيد أن شخصية مثل صامويل لانجهورن كليمنس، أو الذي تعرفه أنت باسم مارك توين، قادته قصاصة ورقية إلى دنيا الكتب قراءة وتأليفا، كان قبلها صبيا صعلوكا يكره المدرسة ويسعى جاهدا لقطع كل صلة له بالتعليم؛ فقادته قصاصة إلى سحر القراءة، ثم دخل دنيا الكتابة الساحرة الساخرة، وحقق شهرة طبقت الخافقيْن. صدفة وكتاب صغير الحجم غيرا مسار رجل ومعه ملايين في أصقاع الأرض، قبل ذلك الكتاب عمل صبي في غير مهنة مؤقتة؛ في أحد محلات البقالة تارة، مساعدا لسائق سيارة نقل كبيرة تارة أخرى، ثم شاءت الأقدار أن يعمل بمكتبة وهو ابن عشرة أعوام أو يزيد قليلا؛ فماذا كانت المحصلة؟! وقعت عيناه على كتاب يقال له (إظهار الحق) للشيخ رحمة الله الهندي، كان الكتاب بين أكداس الكتب، عليه من تراب الإهمال الشيء الكثير، غير أن الصبي أخِذ بهذا العنوان، قرر أن يعرف هذا الحق، فلما قرأه وقع في قلبه، وعزم أن يُسهم في إظهاره ونشره لخلق الله أجمعين ما وسعه ذلك؛ فكان أحمد ديدات.
وراء القضبان، اختلفت حياة مالكوم إكس وعرف عبر الكتب مسارا مغايرا لما كان عليه، الأمثلة على ذلك تفوق الحصر، الخيط الناظم لهذه الأمثلة أن أصحابها لم يفاخروا بأرتال الكتب التي التهموها أو طالعوها، إنما لمسنا تأثير ذلك فيهم وفينا على السواء، وصدق القائل (فما أحذو لك الأمثال إلا/ لتحذو إن حذوت على مثال). ولنا أن نعقد مقارنة سريعة بين تأثير الكتب في هؤلاء وأضرابهم، وطوابير من المعاصرين، لاسيما إذا علمت أننا نعيش عصر الصورة وما تحمله من البهرج الخداع، الصورة التي يطلق عليها ميشيل فوكو تسمية «إمبراطورية النظرة المحدقة»، فلم يسبق في تاريخ العرب أن اصطف الناس وتدافعوا بالأيدي والمناكب لشراء كتاب، لعل ذلك التدافع والزحام أليق في بلادنا على رغيف الخبر، وأساسيات الحياة، لكن العجب العاجب أننا شهدنا ذلك قبل أسابيع.
يتزاحم شباب في عمر الورود لشراء كتاب ما، لنا أن نفرح بعودة هذه الفئة العمرية إلى دنيا القراءة، ومع ذلك يقول العقلاء، إن التريث أمر لا بد منه، إذ إن فئة الكتب التي لا تبتعد كثيرا عن البرق الخلب، أو أنها سراب بقيعة، تدوزن على وتر السحر والماورائيات والجن، في عالم يشهد قفزات تكنولوجية متسارعة، لا تقدم فكرا يخرج أجيالا تجاري الأحداث والواقع المعيش، إنما يركن إلى قصص يغلب عليها طابع الفانتازيا.
هل نحن بذلك نرفض روايات الفانتازيا؟ بالطبع لا، لكن المقصود ألا تكون هذه الفئة هي الركيزة الأساسية والشغف الأوحد، فإن المتجمهرين لشراء رواية كيت وكيت، ضربوا مثالا لبيضة الديك، لم يتجمهر أحد لشراء أي من الروائع العربية مثل كتابات نجيب محفوظ، أو الروائع العالمية مثل كتابات تشارلز ديكنز، أنطون تشيخوف، فيودور دوستويفسكي، سنكلير لويس، ومن على شاكلتهم. التدافع الذي تحدثنا عنه كان حصرا لكتاب بعينه، وهذا استثناء لا يقاس عليه، استثناء يشكك في اتخاذه مثالا لعودة الروح القرائية بين الشباب، لعل بروباغندا التسويق لها يد في المسألة، هذا يفيد صاحب الكتاب ودار النشر، لكنه لا يعود بالنفع على غايات القراءة، التي تهدف إلى توعية الأجيال وخلق روح إيجابية تدفعهم للمشاركة في صناعة الأحداث.
الفرق بين التأثير والإيهام بالتأثير يتبدى مع توالي الأيام والأعوام، فلم يكن تولستوي وإدجار آلان بو وإرنست همنغواي وغارسيا ماركيز وإيزابيل الليندي ويوسا، في حاجة إلى الإيهام بقيمة أعمالهم، ولم يكن عباس محمود العقاد وطه حسين ومي زيادة وبنت الشاطئ ومحمد الماغوط، في حاجة إلى خداع الناس، ولم يتدافع الشباب ويتشاجروا في بلاد العرب قديما على ديوان أبي تمام والبحتري والمتنبي، أو المعري، ولم يتجمهروا حديثا للظفر بديوان محمد مهدي الجواهري، نزار قباني، محمود درويش، فاروق جويدة أو غازي القصيبي وأضرابهم، مما يجعل المرء يشعر بوجاهة ما قاله الأول.. «في الأمر إن».
لا نقصد التشاؤم أو تنفير الشباب من القراءة، إنما أن يكون التعويل على النصيحة النبوية الغالية «احرص على ما ينفعك»، وهذا لن يكون في مجرد تقليد آخرين، هذا لن يكون بأن «يسرح المرء مع الذئب ويعود مع الغنم»، أو ترسم خطى الإنفلونسرز ومؤثري منصات التواصل الاجتماعي، فلربما ذهب بعضهم – طلبا للشهرة وزيادة عدد الإعجابات (اللايكات)- إلى دخول حجر ضب خرب!
كاتب مصري