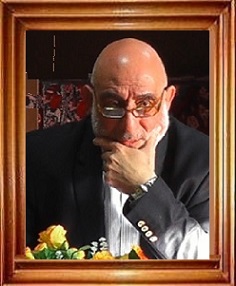قهر مزدوج وإنسانية محاصرة…

قهر مزدوج وإنسانية محاصرة…
بكر عواودة
بشكل طبيعي وفطري، يقاوم الإنسان الاستبداد من خلال الوعي والتمسك بهويته، ولكن التراجع والتراخي يؤديان إلى نشوء حالة هُلامية مشوهة مُستسلمة مع سيولة تبريرية فائقة…
يُعرّف باحث علم النفس الاجتماعي الدكتور مصطفى حجازي القهر بأنه حالة نفسية واجتماعية مُركّبة، يُنتجها النظام المستبدّ، ويَتشربّها الإنسان المقهور حتى تُصبح جُزءًا من بُنيّته الداخلية. هذا القهر لا يُمارَس فقط من خلال العنف، بل بالترهيب، والتهميش، والإقصاء، وأحيانًا بالتطبيع، والتشجيع، والقبول المشروط حتى الإذعان والتماهي.
بشكل طبيعي وفطري، يقاوم الإنسان الاستبداد من خلال الوعي والتمسك بهويته، ولكن التراجع والتراخي يؤديان إلى نشوء حالة هُلامية مشوهة مُستسلمة مع سيولة تبريرية فائقة. والتسليم تدريجيًا بأن الخلاص يمر عبر التماهي ومنافقة المنظومة القاهرة مؤسساتيًا وشعبيًا. إنها أشبه بحرب ثقافية على الوعي والرواية والهوية، على شكل جدار حديدي ثقافي اجتماعي يُهندس حدود المسموح، فلا يكتفي بإقصائك، بل يعبث بهويتك وتفكيرك وإحساسك وإنسانيتك ومصطلحات تعابيرك. ويتركك لعجزك وهلعك تبني وتطور منظومة الضبط والرقابة الذاتية، حتى تمتلك مهارة فائقة في التموضع بين البوح والصمت وفن إدراك المسموح والممنوع، وبين البكاء قهرًا وكبتًا، وبين خوفك من أن تطرق جدران الخزان.
وفي كل حرب أو أزمة، يسقط قناع “الديمقراطية” الإسرائيلية من جديد، وتنكشف القبيلة بأبشع تجلياتها العنصرية لتصادر بالقهر والعنف والجريمة إنسانيتنا وهوامش مواطنتنا، وتفرض أدواتها القمعية.
يعيش المواطن العربي في تجمعات سكانية مُكدّسة ومكتظة هي ليست أكثر من مأوى وملاذ للنوم، لا تصلح للعيش ولا تمتلك مقومات النهوض الذاتي. تتحكم بها منظومة سيطرة وسطوة معقدة وكبيرة، فمن الأسفل الإجرام المُنظّم، ومن الأعلى التمييز العنصري والقمع المُنظّم، مما ينتج قهرًا وإحباطًا يزيد من حالة الاغتراب بين المواطن وبيئته. ومن المثير للسخرية أن الإجرام المُنظّم والتمييز العنصري المُنظّم هما الحالتان النظاميتان الوحيدتان السائدتان في مجتمعنا واللتان تضبطان إيقاع مجتمعنا، كأدوات سيطرة وتفتيت، وهما نظامان متوازيان كمكابس ضخمة متناغمة: الأول يعمل على تفكيك البيئة المجتمعية الإنسانية الآمنة، والثاني على التفكيك الثقافي والسياسي وضرب العمل الجماعي. وما بين هذين المكبّسين، فوضى خلاقة يبحث فيها كل فرد عن طريقه ومسلكه هاربًا من إحداهما أو كليهما معًا. من الواضح أن عدم وجود سياسة أو خطة حكومية لمناهضة الجريمة هو بحد ذاته الخطة في تحويل مجمل أولويات الناس إلى الصراع على البقاء.
لم يعد القمع والحصار السياسي مقتصرًا على القوى السياسية الرافضة للفاشية والعنصرية، بل امتد، وبأدوات مختلفة شعبية وقضائية وأمنية وإعلامية متناغمة، إلى الفضاء الشخصي والمهني والأكاديمي والحقوقي والثقافي والاقتصادي والمجتمع المدني، حيث طالت حملات التحريض والملاحقة طلاب الجامعات، عمالًا وأطباء ومحاضرين وفنانين وصحافيين وكتاب مقالات وناشطين ومؤسسات أهلية وإغاثية. إنها أشبه بحرب سياسية ثقافية شاملة ضد المواطنين العرب.
ومؤخرًا، بدأت إسرائيل باستخدام أداة الاعتقال الإداري داخل الخط الأخضر، وهي ممارسة كانت محصورة غالبًا بالمناطق المحتلة منذ انتهاء الحكم العسكري في الداخل، لكنها طُبّقت مؤخرًا على أكثر من 25 ناشطًا، كان آخرهم المناضل رجا إغبارية، في مشهد يعكس انتقال أدوات القمع والضبط والترهيب من الاستثناء إلى القاعدة.
منع التظاهرات والاجتماعات والوقفات وحتى منع المسيرة الرمزية للعودة يأتي من هذا الباب بهدف تطويع المجتمع بأسره وكسر شوكته وقمع إنسانيته، عبر تجريم كل تعبير رأي سياسي أو حتى تعبير أخلاقي وإنساني لرفض المجزرة في غزة أو نداء لوقف الإبادة. فحتى الأغنيات والعروض المسرحية والكلمات والآيات القرآنية باتت ممنوعة. إنها مرحلة جديدة من البطش والقهر والتجبّر المكشوف تجاه الفلسطينيين.
تفكك الجماعة
أحد أبرز نتائج القهر البنيوي هو تفكيك الروابط الاجتماعية وتحويل الإنسان من كائن جماعي رافض ومناضل ضد الظلم إلى كيان اقتصادي منكفئ لا يثق بالمجتمع، يعيش هاجس النجاة والبقاء، باحثًا عن الخلاص الفردي. ولا شك أن ضرب القيادات السياسية الوطنية وتشويه عملها وتسخيفه وتجريمه وإخراجها عن القانون وإضعافها جماهيريًا هو أحد الوسائل التي تسهل تفتيت المجتمع.
من هذا الباب، فإن الهروب إلى الأمام نحو الاندماج والمشاركة كمجتمع وأحزاب ضمن هذه القواعد الخطيرة ليس حلًا أو إنجازًا، بل مقصلة سياسية ثقافية، أخلاقية وتجربة خطيرة بمصير شعب، لأنه يُثبّت قاعدة التفوق والقهر.
إن الطاقة النضالية المكبوتة في مجتمعنا جراء ما يحدث تتحول إلى صراعات داخلية للأسف، فتُوجَّه الغضب نحو الذات والجار، وابن البلد وابن العائلة الأخرى، بعيدًا عن البنية القامعة والقابضة على الأنفاس.
يتوجب أن ندرك كمجتمع أنه يتوجب مناهضة هذا الواقع بشكل مستمر، وتوجيه الغضب المكبوت نحو المسؤولين الحقيقيين عن هذا التردي والقهر، من خلال تحرك سياسي وجماهيري واسع حتى درجة العصيان المدني السلمي في سبيل تغيير قواعد اللعبة العنصرية.
آفاق الحل
هذه المرحلة تستوجب التفكير خارج الصندوق، بعيدًا عن مصطلحات وقوالب التحليل القديمة والمكررة. إن استعادة الفعل السياسي المجتمعي تبدأ باستعادة الوعي، وعي الذات، والوعي الجمعي، وفهم الرواية وصونها، ورفض المعادلات المشروطة التي تصوغ علاقة الفرد المقهور والمظلوم بمؤسساته من خلال مساومته على مواقفه وروايته وسلوكه.
وطرح البديل السياسي الأخلاقي بكل جرأة في إحلال الأمان والمساواة والديمقراطية وإنهاء الاحتلال. يبدأ التصدي من خلال تشخيص الواقع على حقيقته، فالتعريف الصحيح هو نصف الطريق للحل. فمن الطبيعي أن يكون أول فعل عدم تبرير الواقع وعدم قبول الحلول الجزئية، بل اعتباره جُرمًا مقصودًا ومخططًا.
إن نقطة التحول الحقيقية تبدأ حين يدرك الإنسان المقهور أنه مستهدف، وأن ما يُقدَّم له “كحالة طبيعية أو ثقافية” هو في جوهره نتاج تاريخ طويل من الإخضاع والظلم والقهر والخطط الخبيثة.
هناك من سيقول إننا نملك جزءًا من المفاتيح للحل، هذا صحيح، ولكن ليس من باب التهرب من المسؤولية، فإن أغلب المفاتيح الرئيسية موجودة بيد الدولة مثل: محاربة الجريمة المنظمة، القمع السياسي، حرية التعبير، الإفقار، أزمة المسكن والأراضي، التعليم، إلخ.
في هذا الإطار التشخيصي الذي يرى الإنسان نفسه مقهورًا ومظلومًا، يصبح مشروع التطور الإنساني والمدني والنهضة المطلوبة لمجتمعنا ليس فقط معركة سياسية، بل تحررًا نفسيًا وثقافيًا واجتماعيًا من القهر والخوف المستبطن والاستكانة.
إعادة بناء الثقة بالعمل الجماعي، ورفض الخطابات التي تروّض الواقع بدلاً من تغييره كلها خطوات أساسية للخروج من واقع قلة الحيلة إلى الفعل والمواجهة السياسية. وهذا يجسد حاجتنا إلى مشروع وطني ديمقراطي جامع، يحمل في جوهره أمرين أساسيين: الوعي بالهوية، لأن كل ما يحدث لنا هو انتقائي بسبب هويتنا، والأمر الثاني السعي نحو العدالة والديمقراطية الكاملة والمتساوية.
النفق ليس مظلمًا تمامًا، ما زالت هناك نوافذ للأمل في المبادرات الشبابية المحلية، حيث نجحت عدة تجارب في التصدي للعنف وفرض السلم الأهلي في مجتمعنا، كما حصل مؤخرًا في عدة قرى. فما قام به بعض الشباب من فرض رأي عام وحل نزاعات في عدة قرى هو عمل سياسي اجتماعي وتنظيمي بامتياز، لأنه يخلق رأيًا عامًا ويعيد للناس السيطرة على الحيز والفضاء العام الذي هو ملك لكل الناس وليس مشاعًا متاحًا.
وكذلك الأمر مع مسيرة العودة الأخيرة التي أصر فيها أهلنا على الرد بعنفوان وتحدٍّ على حظر المسيرة الموحدة في عشرات المسيرات، فهي أيضًا فعل تحدٍّ وفيه رمزية كبيرة.
وعلى الصعيد العام، لا بد أن أشير إلى مبادرة التجمع الوطني الديمقراطي التي خرجت من رحم هذه المعاناة للبحث في كيفية إعادة تنظيم عملنا السياسي والثقافي المستهدف، من خلال تصويب خطابنا السياسي والتعريف بالواقع بعيون المجتمع المهدد في حياته وأمنه ووجوده. هذه المبادرة تسعى إلى نقاش مجتمعي في نصوصها ومنطلقاتها وأهدافها لتشكل ميثاقًا مجتمعيًا نعيد فيه صياغة مشروعنا النهضوي والنضالي نحو حياة كريمة متساوية وهوية راسخة.
هذه المبادرة تتقاطع مع نشاطات فكرية تقوم بها بعض الهيئات والمجموعات الأكاديمية التي تضم ناشطين ومثقفين في محاولات لبناء أدوات فاعلة للخروج من هذا النفق. يجب الحرص ألا تبقى هذه المبادرات حبيسة مجموعات النخبة أو الفاعلين في الأحزاب السياسية، بل عليها مخاطبة ومحاورة الناس والمؤسسات والشباب والطلاب، وبناء تفاعل يشارك فيه الجميع.
مهما كانت التحديات، فنحن شعب قوي يملك الكثير من المقومات الإنسانية القادرة على خلق مناخ جديد. يجب أن ننظر إلى هذا الخطر كفرصة استراتيجية للنهوض من الكسل والخوف والانكفاء إلى حالة وعي سياسي تجوب قرانا ومدننا وإلى إعادة النقاش إلى الساحات والبيوت.