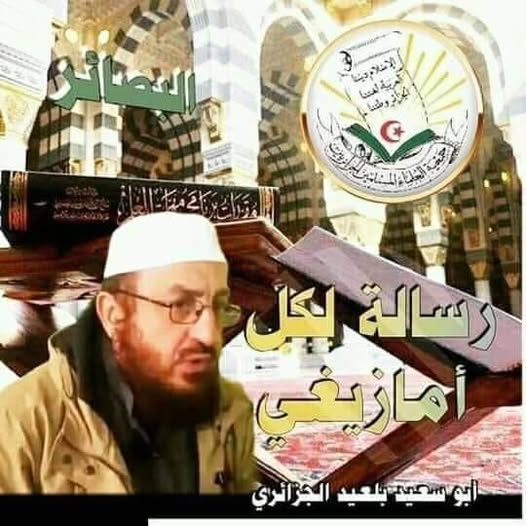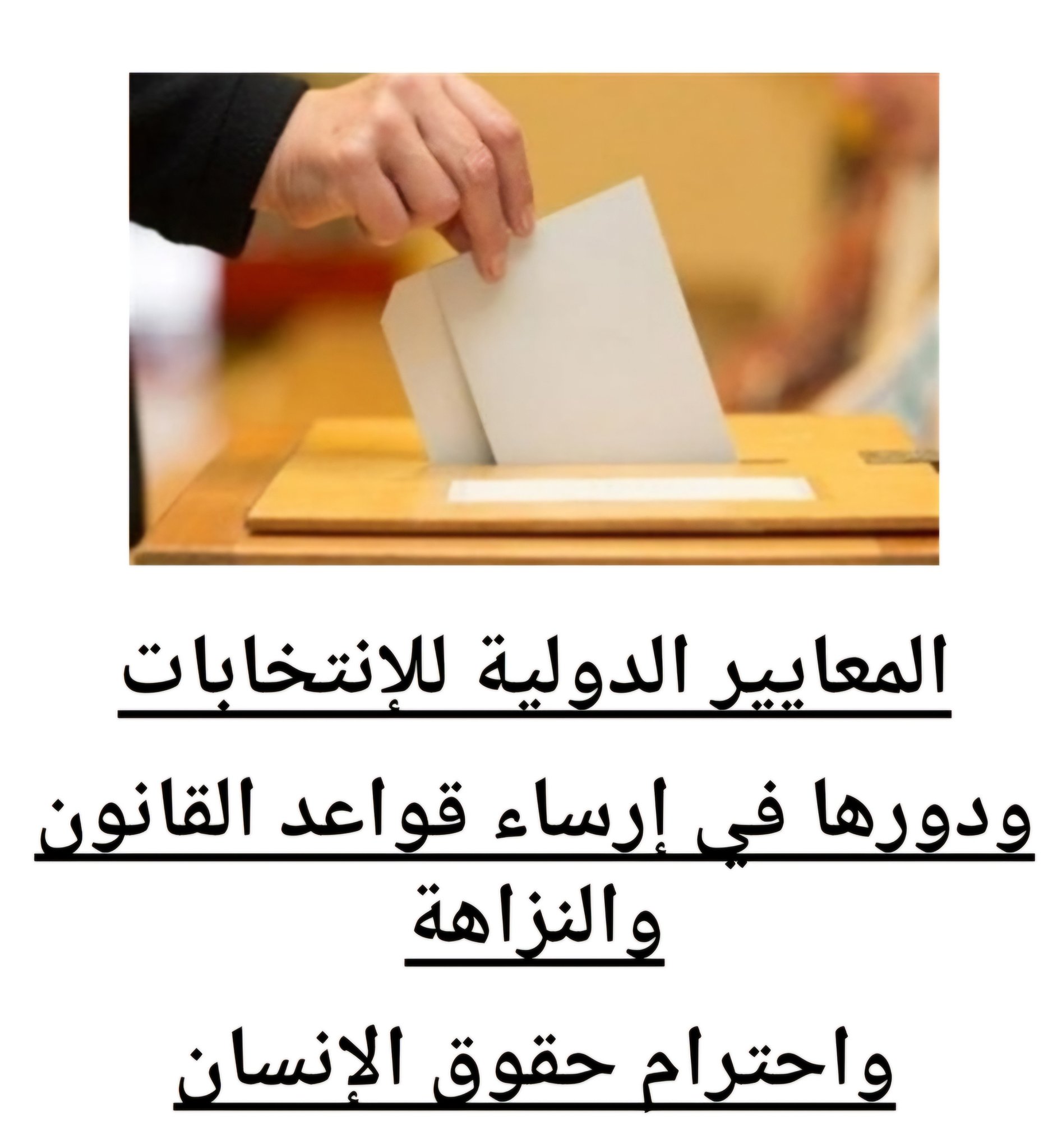مأزق سياسة الاحتراب الأهلي

مأزق سياسة الاحتراب الأهلي
ثمّة ما يتجاوز العودة عن الحداثة السياسية لدى السلطة الحالية في سوريا. فلو اقتصَرَ الأمر على أشكال محدّدة من الممارسات التي تنطوي على بعد أهلي أو ديني، وصولاً حتى إلى استعادة سياسات الأعيان والإقطاع القديم، لأمكن تجاوزهُ، ووضعه في خانة الممارسات النقيضة لـ«التحديث القسري»، الذي أتى به «البعث». لكن ما يتضح الآن، وبعد أشهرٍ خمسة على سقوط النظام السابق، أنّ ثمّة منهجية تضع سياسات الهويّة، ومن دون امتلاك أدواتها أو فهم فلسفتها حتى، في صُلب البنية السياسية للنظام الحالي.
غَلَبة البُنى الأهلية النابذة للسياسة
استبعاد الأحزاب كلّياً من الخريطة السياسية الجديدة، حتى تلك المعارِضة سابقاً منها، وتفضيل الوجاهات والأعيان والمرجعيات الدينية عليها، يوضح إلى أيّ حدّ تذهب السلطة الحالية في إخراج السياسة من منهجها لمصلحة الهويّة بمعناها الأوسع. أي تلك التي يمكن عبرها تبرير حصر الصراع السياسي، إذا صحّ وجوده أصلاً، بين أطراف لا تشبه بعضها فحسب، لجهة البعد الأهلي بمعناه الضيّق، بل أيضاً يحصل بينها تقاطعات وتخادُم، حتى حين تكون في حالة خصومة مُعلَنة.
ذلك أنّ البنية التجزيئية للسلطة، التي تتغذّى على تذرير الحداثة السياسية السابقة وتفكيكها، تستدعي، ليس فحسب ما يشبهها، في البيئات الأهلية الأخرى، بل أيضاً ما ينقل حالة الاستقطاب الأهلي، من البعد السياسي الذي يكون فيه الصراع سلمياً وتقدّمياً ونابذاً للعنف، إلى نظيرِه العسكري، الذي يقوم على الاحتراب الدائم.
العنف في مواجهة الجماعات الأهلية، كما يَظْهر حالياً، ليس منفلِتاً أو مستخدَماً على نطاق ضيّق بواسطة أفراد، بل هو نتاج منهجية الاحتكام إلى السلاح بدل السياسة في مقاربة الملفّات التي يعجز النظام عن إيجاد حلٍّ لها
حتى الاحتراب نفسه ــــــ الذي عادةً ما يخضع لدى اعتماده كمنهج من جانب النظم الشمولية لضوابط محدّدة تستبعد المساس بالروابط الاجتماعية التي تقي المجتمع خطر التفكّك ـــــ يتحوّل هنا إلى أداة سياسية لاستهداف هذه الروابط بالتحديد. فالعنف في مواجهة الجماعات الأهلية، كما يَظْهر حالياً، ليس منفلِتاً أو مستخدَماً على نطاق ضيّق بواسطة أفراد، بل هو نتاج منهجية الاحتكام إلى السلاح بدل السياسة في مقاربة الملفّات التي يعجز النظام عن إيجاد حلٍّ لها، ضمن الفضاء الحداثي المدني، بحكم افتقاده كسلطة أمر واقع إلى أدواته.
دور الفضاء المدني في كبح العنف السياسي
وهو ما يفسّر، من ضمن أمور أخرى، شيوع الجريمة عوضاً من ضبطها، واللجوء إلى «القصاص الميداني» الذي لا يستثني المدنيين، أثناء معالجة «حالات الإفلات من العقاب»، هذا إذا صحّ في التصفيات الحاصلة تسمية القصاص أصلاً.
ما يفعله الفضاء السياسي المدني، في المقابل، لو أُتيحت الفرصة لفاعليه من سياسيين وكُتّاب ومثقفين وحقوقيين وناشطين الفرصة، هو ليس فقط ضبط الصراع وعقلنته، إذ تُلجم نزعة العنف التي ينطوي عليها استخدام السلاح كيفما كان وفي مواجهة الجميع، بل أيضاً تزويده بأدوات القوّة الناعمة، المتقاطعة بشدّة مع الفضاء المدني السلمي، والمتداخلة مع الأشكال أو الأنماط السياسية، المعنيّة بدورها بنزع العنف من المجتمع نهائياً وعلى نحو كامل. حين يحصل ذلك بمقدارٍ معيّن، وعندما تصبح الفرصة متاحة بالتالي لإدارة الخصومات بمنطق يعلو فيه التسييس، حتى للهويّات الجزئية العصيّة عليه عادةً، فهذا يعني غالباً كبح منطق الاحتراب الدائم والانتهاء إلى مآلٍ أفضل بكثير من الوضع الحالي.
على اعتبار أنّ الوضع ينذِر، مع تصاعد وتيرة العنف الأهلي المسلّح واتضاح حجم الاشتباك التركي الإسرائيلي هنا، بتصدّعات أكبر وأكثر حدّة، على صعيد الجغرافيا الاجتماعية والسياسية للبلاد.
خاتمة
طبعاً، هذا لن يضعف الاستخدام الجيوسياسي للورقة السورية من جانب الأطراف المتدخّلة هنا، كون سوريا الآن ليست في موقع يسمح لها باستعادة أيّ دور إقليمي فاعل، فكيف بمواجهة من يحاول إضعافَها واستخدامَها كورقة للمساومة والصراع على النفوذ والدور في الإقليم والعالم. ومع ذلك، يمكن لتشريع الفضاء المدني، إذا ما حصَلَ توافقٌ أو إجماع على الاحتكام إليه داخلياً، أن يخفّف الاحتقان في الداخل، ويعطي الجميع مجالاً لالتقاط الأنفاس، بما يحقن الدماء، وينقذ حتى قاعدة السلطة الاجتماعية من تبعات خيار «الحسم العسكري». أي لجهة الفوضى الشاملة التي يقود إليها منطق الاحتراب انطلاقاً من الحلقة المفرغة لتناظُر المظلوميات السابقة واللاحقة أو تضادّها.
* كاتب سوري