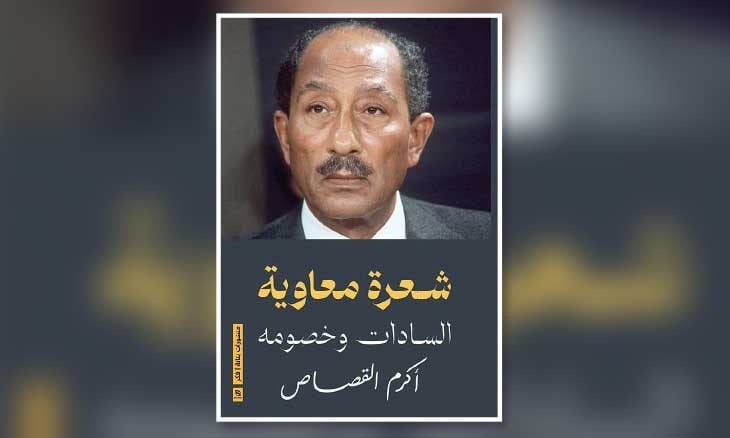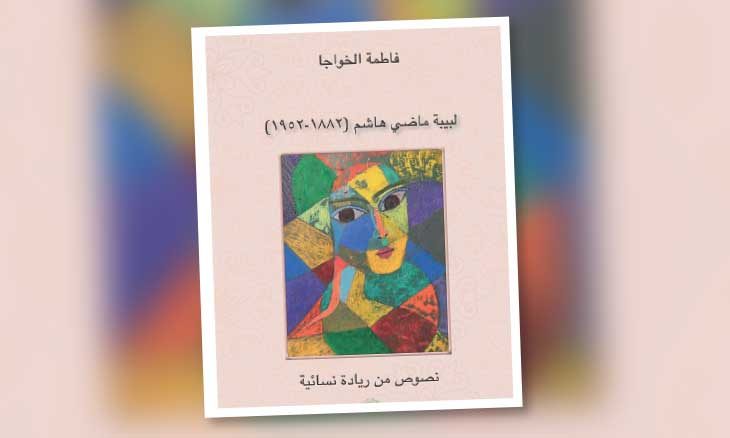أدنى من البشر!

شهباء شهاب
نشاهد أخبار العالم ولا نرى سوى الحروب التي غزته وملأته بالقتلى والمشردين، والمكلومين والثكالى والأيتام، وكأنّ هذه الحروب غدت كديدان الأرضة التي ما تلبث تنهش الأرض وتملأها بالحفر والثقوب والخراب هنا وهناك. نستعرض مشاهد القتل، والترويع، والتشريد، والتجويع، ونتعجب من قدرة الساسة على القيام بهذه الأفعال غير الإنسانية بدم بارد، ودون أن يرّف لهم جفن، ودون أن يشعروا بالخزي والعار. نتساءل هل الساسة بشر مثلنا، أم أنهم، كما يروّج البعض، من جنس غير بشري. هل للساسة أدمغة مثل أدمغتنا قادرة على المحبة والتعاطف، هل يملكون جهازا عصبيا يجعلهم يشعرون بالألم ويتوجعون مثلنا، نحن الناس العاديين البسطاء، بل هل يمكنهم النوم بسلام بعد أن يصدروا أوامرهم بشّن حرب، وإعدام شعب بأكمله وتشريده، وتجويعه حتى الموت.
هؤلاء الساسة الذين يرتكبون كل هذه الجرائم، من أين جاءوا بهذه القدرة على التخلي عن إنسانيتهم، هل هم حقا من سلالات غير بشرية، كما يؤكد بعض المشتغلين بعلم الطاقة وأصحاب نظرية المؤامرة.
الكثير منا يتساءل كيف يستطيع الساسة التوفيق بين ما تمليه عليهم ضمائرهم، ومغريات المصالح التي غالبا ما تتصادم مع القيم الأخلاقية. وللتخلص من هذه المعضلة يلجأ الساسة لإنكار أن من يتعاملون معهم هم بشر مثلهم. هذا الإنكار المخيف هو الذي يمكنّهم من الإفلات من الاعتبارات الأخلاقية عند التعامل مع الشعوب الاخرى. فهذا الفكر يقوم بابتداع آلية نفسية تسهّل إلحاق الأذى بالآخر المختلف، وتتيح استخدام العنف، وارتكاب الجريمة، وتقلل من أهمية معاناته، عن طريق تجريده من صفاته البشرية. فهذا الفكر يصوّر الآخر المختلف على أنه مخلوق من فصيلة أخرى أدنى من البشر، وأنه لا يملك مشاعر، أو أحاسيس، أو حاجات بشرية، ولا يتمتع بقدرات عقلية، وبالتالي فهو لا يستحق التعامل معه وفق الحدود الأخلاقية التي وضعها المجتمع البشري. هذا الإقصاء الأخلاقي يزيد من احتمال وقوع أنماط متطرفة من العنف، والاعتداء، والتهميش، وسوء المعاملة. كما أنه يعمل على إدامة التمييز وتعزيزه بين الأفراد والمجتمعات، ويرسّخ الطبقية الاجتماعية، ويشرعن استغلال البشر، وإخضاعهم، والاتجار بهم، أو إبادتهم، لأنه لا يتوقف عند الحدود الأخلاقية المعروفة.
لقد استخدمت اللغة ووسائل الإعلام كأداة أساسية في إرساء التصورات التي تنزع الصفة البشرية عن فئات معينة وجعلها تلقائية. ويتم ذلك عبر نشر الصور النمطية السلبية، والسرديات التي تصِم مجموعات معينة وتصوّرها على أنها حيوانية، أو إجرامية، أو غبية، أو سوقية، أو جاهلة، أو تفتقر إلى القدرة على التصرف الرشيد والعقلاني. وقد لا يدرك الكثير من الناس أنه يمارس هذا التجريد من الصفات البشرية بحق الآخرين أحيانا في حياته اليومية، عند وقوع الصدامات والنزاعات. فعندما يعرّض أحدهم الآخرين لإساءات لفظية، تتضمن أما استخدام لغة مهينة، أو عندما يستخدم الصراخ المفرط، أو يشبههم في العلن بالحيوانات، أو الكائنات الفضائية فهو في حقيقة الأمر لا ينظر لهم على أنهم بشر مثله، بل يعتبرهم من فصيلة أدنى من البشر. هذا الفكر قد يتجسد أيضا عندما تقوم بعض المجاميع المجتمعية بالتقليل من شأن مجاميع أخرى في المجتمع ذاته، وتعتبرهم أدنى من البشر، لأنهم لا يمتلكون التهذيب، أو اللياقة، أو العقلانية، أو لأنهم لا يتكلمون بلهجة أهل المدن، ولا يرتدون ملابسهم. هذا التجريد من الصفات البشرية قد تمارسه كذلك الدولة، أو المدرسة، أو مكان العمل، أو حتى العائلة، فقد تقوم الدولة بممارسته على شكل تمييز ضد الأقليات العرقية، أو القومية، أو الدينية.
كما تتعرض له المجاميع المهمشة المختلفة داخل المجتمع، مثل المعوقين، ومن لديهم ميول جنسية مغايرة للميول السائدة. فمثلا في العراق، أفراد كثيرون، ربما دون وعي، أو ربما عن جهل، أو قلّة كياسة وتهذيب، يصمون أفرادا من أبناء مجتمعهم بصفات، تبدو في معانيها الظاهرة حيادية، ولكن استعمالاتها قد حُرّفت لتشي بإيحاءات مهينة، تحمل أطيافا دلالية القصد منها تحقير الآخر، وتصغيره، وشتمه، والنظر له باعتباره أدنى بشرية. ومن هذا القبيل مفردات مثل شروكي، ومعيدي، وعربان، وكردي، ومصلاوي، وهندي، وكاولي، ويهودي، إلخ. وهكذا تتحول هذه المفردات من كلمات إلى رصاص يجرح، ويدمي، ويجترح الأزمات. كذلك فإن وسائل الإعلام الحكومية، سواء في الديمقراطيات أو الديكتاتوريات عادة ما تقوم هي الأخرى على تنفيذ حملات لا إنسانية في أوقات الصراعات والحروب، لتوجيه الرأي العام، وحثّه على تجريد الآخر المختلف من بشريته، ومعاملته على أنه من نوع أدنى من البشر. فكلنا يتذكر كيف قامت إدارة الرئيس الأمريكي بوش الأبن باستخدام خطاب لا إنساني لوصف العرب والمسلمين على أنهم إرهابيون ومتخلّفون، وأنهم يكرهون الحرية التي يتمتع بها الأمريكيون لتبرير غزو أفغانستان والعراق.
من المعروف أن الإنسان مخلوق اجتماعي، ويبحث عن هوية مما يجعله عضوا في مجموعات مختلفة. ولكنّ شدة تماهيه مع مجموعة معينة، قد يجعله يميل إلى تبني تصنيف للآخرين الذين لا ينتمون لمجموعته الخاصة، وتحصل عملية نزع الصفة البشرية عن الأفراد، خصوصا عندما يكون أفراد المجموعة الخارجية لمجموعة الفرد، مختلفين عن أفراد مجموعته اختلافا جوهريا. مجموعة الفرد هذه قد تكون مجموعة العرق الأبيض، أو مجموعة اليهود، أو مجموعة المسلمين، أو مجموعة الأثرياء، أو مجموعة أبناء المدن، أو مجموعة نخبة المجتمع من المثقفين، وغيرها. وتعزز الصور النمطية السلبية فكرة أن المجموعات الخارجية هي مجموعات أدنى بشرية، ما يبرر عدم التعاطف، والازدراء، أو العنف بمختلف أشكاله من تمييز، وتباعد، أو عزل اجتماعي، أو تهميش، وإقصاء، أو استغلال، واستعباد، أو تعذيب، وفتك، وإبادة وغيرها. ويحصل هذا نتيجة لعدة أسباب منها الخوف من المجموعات الخارجية، واعتبارها مُهدِدّة ومنافسة لمكانة المجموعة الداخلية، أو سلامتها، أو الرغبة في فرض الهيمنة على المجموعات الخارجية، كما يحصل مع المهاجرين في بلدان الهجرة، أو كما يحصل مع الأقليات العرقية والمجموعات والطوائف الدينية للمجتمع نفسه.
لقد تجسّد فكر نزع الإنسانية في العديد من الجرائم عبر التاريخ الحديث، بدءا من النازية، ومرورا بالاحتلال الأمريكي والإيراني للعراق وسوريا، ووصولًا إلى الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين. يقوم هذا الفكر على اعتبار «الآخر» كائنًا أدنى من البشر، مما يبرر ارتكاب الفظائع بحقه، من قتل وتشريد وتعذيب وتجويع. إنها العقيدة ذاتها التي بررت استعباد الأفارقة واستعمار الشعوب الأصلية في الأمريكيتين وأستراليا، تحت ذرائع «نشر الحضارة». وقد وظفت الأيديولوجيات الإمبريالية هذا التصور لشرعنة الاستغلال، دون خجل أو ندم.
الحركة الصهيونية مثال حي على هذا الفكر، حيث اعتُبر الفلسطينيون غير موجودين أصلاً، كما يظهر في شعار «أرض بلا شعب لشعب بلا أرض». وبهذا تم تجريدهم من إنسانيتهم في الخطاب السياسي، عبر نعوت كـ»جرذان» و»صراصير»، لتبرير الإبادة والتهجير والاعتداءات.
لذلك، لا بد من مواجهة هذا الفكر الخطير بدءًا من الأسرة والمدرسة، عبر ترسيخ قيم الإنسانية وتقبّل الاختلاف، ومرورا بمؤسسات الثقافة والتعليم التي يقع عليها دور تفكيك الصور النمطية، وترويج خطاب يحترم التنوع ويواجه التمييز. كما أن توخي اللغة الإنسانية وتحمّل المسؤولية الأخلاقية هما من أبرز أدوات التصدي لهذا الفكر اللا أخلاقي.
كاتبة عراقية