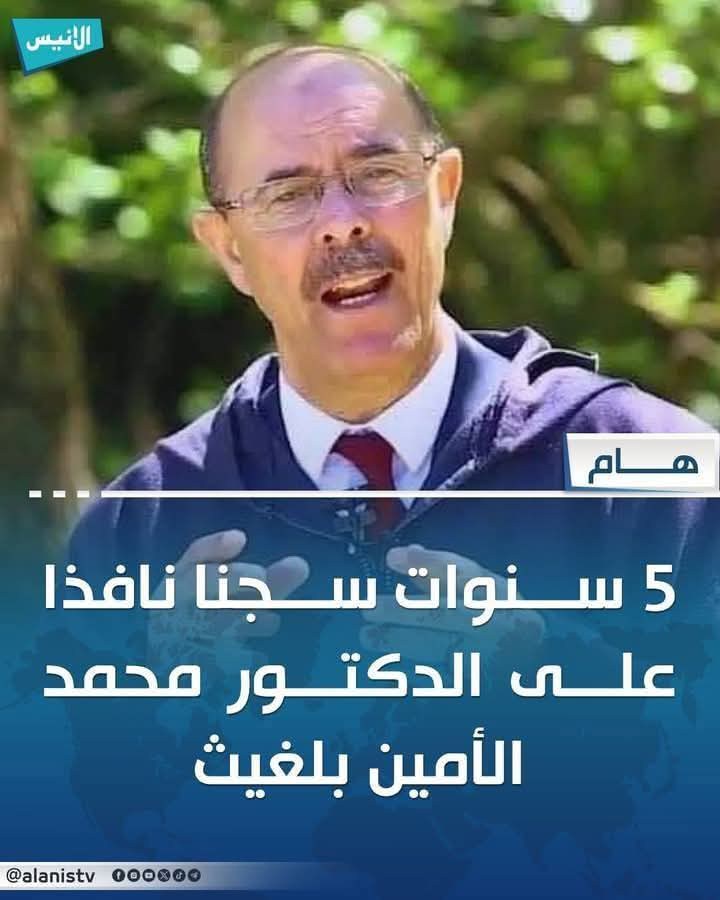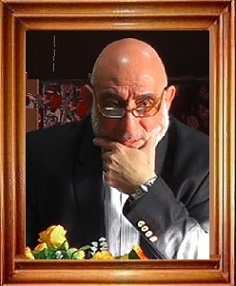وسام سعاده يكتب / التفاوت في التطور الإمبريالي بين الأمم!

التفاوت في التطور الإمبريالي بين الأمم!
وسام سعادة
كاتب وصحافي لبناني
أظهرت الحرب الروسية على أوكرانيا أنّ الإمبرياليّة لا يمكن أن تبقى محصورة كمفهوم بتلك الغربية. وأن المنطق الذي استبدّ بنهضة ميجي أواخر القرن التاسع عشر، ومختصره أن الأرخبيل الياباني إما أن يُستباح ويُستعمر، وإما أن يتحول بدوره إلى قوة استعمارية كاسحة في آسيا تزاحم الاستعمار الغربي عليها، ما زال يجد صداه في أسلوب تفكير الروس والصينيين، ولو بشروط وأشكال مختلفة.
في اليابان، اختلط الحابل بالنابل. تواشج التحديث والتصنيع السريعان مع صعود النزعة العسكرية، ورواج خطابية «إن كانت حرباً داروينية بين الأعراق فنحن لها». آسيويون في مواجهة الغزاة الأوروبيين. متأوربون حتى النخاع في مواجهة باقي الشعوب الآسيوية.
تمازجت نفحات «الجامعة الآسيوية» مع التشوق لبناء إمبراطورية مهيمنة على كل من المحيط الهادئ والبرّ الآسيوي، تمتد من كوريا ومنشوريا حتى الفيليبين. لم يكن هناك من خيار ثالث بالنسبة إلى النخب اليابانية التي أيدت في وقت واحد مبدأي وحدة آسيا وتفوق اليابانيين على سائر الآسيويين. فإما السقوط أمام الاستعمار الأوروبي كحال الهند ومصر، وإما تشكيل قوة إمبريالية في آسيا ضد آسيا.
بالتوازي، في وقت كان الكوريون يُقاسون الأمرين على يد اليابانيين، كانت النخب الهندية والإيرانية والعثمانية المتعطشة للتحرر من القهر أو التمدد الاستعماريين تحتفل بانتصار اليابانيين على الروس في تسوشيما، وتعدّها إيذاناً بخذلان «الرجل الأبيض» في كل مكان، وانتهاء عصر التفوق الأوروبي.
هذا النموذج قاد اليابان في نهاية المطاف إلى الهزيمة، وإلى ضربها بقنبلتين نوويتين، وإذلالها بالاحتلال الأمريكي. واليوم يظهر بوضوح أكبر لدى المؤرخين العسكريين أن اليابان ما كان لها منذ البدء أي حظ في مواجهة الأمريكيين في المحيط الهادئ، بخلاف ألمانيا التي لم تكن هزيمتها في الحرب حتمية منذ البدء.
وإذا كانت اليابان أقلعت في النهاية عن هذا النموذج التخييري بين أن تكون قوة إمبريالية وبين أن تكون مستعمرة، وشقت لنفسها مكانة أكثر تواضعاً، ضمن «الإجماع الغربي» (ولو أن التحذير من الصعود الياباني في شرق آسيا بقي نغمة أمريكية حتى التسعينيات) فإن المنطق الذي ولّدته نهضتها السريعة، وذات القالب السلطوي، عاد وانبعث بشكل مختلف في كل من روسيا ما بعد السوفياتية، والصين منذ تولاها شي جينبينغ.
هنا أيضاً «الخيار بلا ثالث»: فإما أن يؤدي التوسع الأطلسي إلى استتباع وشرذمة روسيا وتحويلها إلى قوة ثانوية ومستتبعة وغير متماسكة، إن لم يكن تقسيمها، وإما أن تكسر روسيا حركة التوسع الأطلسي في حدائقها الخلفية، ولو كان ذلك بممارسة الاضطهاد القومي، بدعوى أن الأوكران جزء من الشعب الروسي ولو كابروا على ذلك أو رفضوا.
طبعاً، مع فارق أن روسيا المنقادة إلى هذا الجنوح لا تحرّكها دينامية نهضوية داخلية كتلك التي قادت المشروع التحديث في اليابان وربطته ربطاً بالنزوع الكلي إلى الاقتدار والتغلب. بدلاً من النهضة تعكف روسيا على كوكتيل من النوستالجيا المزخرفة. شيء من القيصرية مع شيء من الستالينية، يضاف إليهما الاستئناس بالأوراسية الجنكيزخانية والتيمورية، إنما تحت قيادة السلاف الشرقيين الأرثوذكس، عملاً بمأثور إيفان الرهيب. إنما كل كوكتيل النوستالجيا التاريخية هذا، يحركه في الوقت نفسه الترهيب الذاتي: ماذا لو خسرنا؟ الخسارة ستكون مهولة لا آخر لها. إذاً الاستعداد للتضحية بكل شيء، وإحراق كل الجسور هو الأضمن. الخسارة لن تحصل لأنها ممنوعة!
النزوع الإمبريالي الصيني يبقى أقل جموحاً، بالمقارنة، أقل خضوعاً للترهيب الذاتي. فهو ما زال يدرج نفسه ضمن التصور الإمبراطوري المديد للصين، كعالم قائم بذاته لا يسعى لاجتياح عالم ما وراء البحار، وما زالت الصين تحسب لماو تسي تونغ، أنه رغم جميع أخطائه الجسيمة، انتشلها من قرن الإذلال الذي يبدأ بحرب الأفيون وينتهي بانتصار الحزب الشيوعي في برّها.
إنما هي «دولة – حضارة» أكثر من كونها «دولة أمة» وبالتالي لا يمكن أن تكون لها حدود خطية، بل دوائر من النفوذ المباشر فالأقل مباشرة «على التخوم».
أما العالم المتشكل من مئتي «دولة أمة» متساوية في الحقوق والواجبات في نطاق النظام والقانون الدوليين، والتي توازن بين مبدأي حق الشعوب في تقرير المصير وبين ثبوت الحدود الوطنية وعدم القابلية لتغييرها بالحرب والعدوان، فهذه ليست أكثر من أمنية يوتوبية
مع هذا، فالمنطق الذي حكم اليابان مطلع القرن الماضي يتسلل لمن في الحكم ببكين اليوم، ولو بشكل استشرافي مستقبلي. ففي عالم اليوم، إما أن تجهز نفسك لتكون قوة إمبريالية، وإما أن تتحول إلى مستعمرة أو شبه مستعمرة. ليس هناك خيارات أخرى. فإما عالم بأقطاب إمبريالية مختلفة، وإما عالم بقطب إمبريالي أمريكي أوحد.
أما العالم المتشكل من مئتي «دولة أمة» متساوية في الحقوق والواجبات في نطاق النظام والقانون الدوليين، والتي توازن بين مبدأي حق الشعوب في تقرير المصير وبين ثبوت الحدود الوطنية وعدم القابلية لتغييرها بالحرب والعدوان، فهذه ليست أكثر من أمنية يوتوبية. ضف إلى أن منطق الدولة – الأمة هذا أخفق اختبارياً في حل مسألة جزيرة تايوان. فإذا كان المجتمع الدولي يقرّ كله بمبدأ الصين الواحدة، وقضى ذلك بتحويل المقعد الدائم من «الصين الوطنية» إلى «الصين الشعبية» مطلع التسعينيات، فعلام يعترض الأمريكيون سبيل الصين لاستعادة جزء من ترابها الوطني؟
والحال أنه، على الرغم من أن الحرب الروسية على أوكرانيا قد أظهرت السمة الإمبريالية الواقعية أو المشتهاة، أو شيئاً من هذا ومن ذاك، لدى دولة بحجم روسيا، فإنها أظهرت أيضاً التباس الحرب نفسها على الضفة الأخرى.
فحكومة كييف لا تقاتل فقط انطلاقاً من منطق أنها تمثل شعباً يواجه آلة استتباع همجية له، بل كذلك وقبل كل شيء من موقع أنها تطمح للانتساب إلى الإمبراطورية الأطلسية. أن تكون أوكرانيا جزءاً من الإمبريالية الغربية، بل ذلك الواقف على خط النار، الركن الفدائي من الإمبراطورية.
وهذا بدوره انعكس تردداً داخل أروقة الحلف الأطلسي. فهو من جهة، ملتزم بالكلية بالدفاع عن أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي. في الوقت عينه، ليس سهلا على الإمبراطورية الغربية أن تحتسب أوكرانيا هذه «من صلبها» وللسبب نفسه: لأنها أرض النار، أرض وجدت لتُحرق في المواجهة، لأنها ساحة الحرب الطويلة بين الغربيين والروس. وهنا لا يعود من الممكن النظر الى حكومة كييف كنظام تحرر وطني في مواجهة العدوانية الروسية. العدوانية الروسية على الشعب الأوكراني قائمة، إنما الذي يقود الجانب الأوكراني يلحق الفكرة التحررية إلحاقاً غير عابر بحلم الانتساب إلى الإمبراطورية النقيض.
منذ انطلاقة الحرب الروسية على أوكرانيا وحكام كييف يشغلون أنفسهم بموقف إسرائيل من هذه الحرب. يعود ذلك إلى اجتماع عوامل. منها أن أوكرانيا وإسرائيل حصنان متقدمان للإمبراطورية الغربية. وفي الوقت نفسه حصنان من طبيعتين مختلفتين.
فإسرائيل هي جزء من هذه الإمبراطورية، وإن لم تكن عضوا في حلف شمالي الأطلسي.
وأوكرانيا حتى لو حازت يوماً ما على هذه العضوية فهي لن تكون في منتدى الهيمنة الغربية على باقي الشعوب، كحال إسرائيل، بل سيكون لها ما لبلغاريا أو لرومانيا ضمن هذا الحلف.
في الوقت نفسه تنظر كل من أوكرانيا إلى إسرائيل إلى تجربتهما بالمزج بين الغوغائية القومية وبين مقولة التحرر الوطني.
السردية الإسرائيلية حول التحرر الوطني من الاستعمار البريطاني والرجعية الإقطاعية العربية العميلة له بهتت للغاية وصارت نكتة سمجة. لكن استعيض عنها بسردية تحرر وطني خرافية بعد أكثر. متصلة بالتحرر الوطني من تداعيات التدمير الروماني لأورشليم، وعودة الحق ولو بعد ألفي عام. وهناك من يضيف عليها التحرر من الفتح العربي ورواسبه!
السردية الأوكرانية أقل خرافية. متصلة بضيم قومي حقيقي، لكنها مرتبطة بمنطق أن ما من خيار ثالث، إما أن تكون مع ألمانيا النازية وإما مع السوفيات، وإما أن تكون في حلف الأطلسي أو تخضع لروسيا. فكرة التحرر الوطني كما عرفناها في مرحلة جلاء الاستعمار كانت مختلفة تماماً: أن تخرج من إمبراطورية لا كي تقع في أخرى. مقولة التحرر الوطني ارتبطت بإمكانية بناء عالم متشكل من مئات الدول الوطنية. لكن يبدو أن المنطق الياباني، الذي هجرته اليابان مرغمة، شاع في الأرض خارجها. فالصهيونية باتت تقول إما اضطهاد الفلسطينيين وإما ترك اليهود فريسة لمعاداة سامية أخطر من تلك الماضية. لا حل وسط. كل من يسأل عن «حل وسط» بات يرمى في الغرب بمعاداة السامية! وقد جاء الالتزام الأمريكي والأوروبي اللامحدود بالحرب الإسرائيلية الراهنة ليظهر أن الاقتباس الإسرائيلي من المنطق الياباني السابق بات جزءاً من آلة اشتغال الإمبريالية نفسها!
رغم استعادة المنطق الياباني سابقا، لإنتاج إمبرياليات أنتي غربية، روسية أو صينية، فإن الحرب الحالية تنبهنا إلى ما أحببنا سابقا تغافله، وهو أن الامبريالية الأساسية ما زالت هي تلك الأمريكية وأن مفهوم الإمبريالية ما زال مفتاحياً لاستقراء العلاقات الدولية للقرن الثاني على التوالي، رغم كل ما لحق به من تمغيط، ومن تسويغ لكل استبداد وتوحش بحجة مواجهته.
مفهوم الإمبريالية أكثر من راهني. بشرط محاولة ربط تحولات الإمبريالية، مع استمرارية المنطق «الياباني سابقاً» (والذي كانت الإمبراطورية العثمانية أولى ضحاياه، حين قالت «تركيا الفتاة» بهذا المنطق) الذي يخير من هم خارج الغرب بين أن يرضوا بأن يُستعمَروا وبين أن يمارسوا الإمبريالية بدورهم، وهذا يمكن تسميتهم «التفاوت في التطور الإمبريالي» بين الأمم.
والحركية الإسلامية وان لم يكن لها ما للصين وروسيا من قدرات فهي أيضاً تستند إلى محاكاة المنطق الياباني السابق نفسه: فإما أن يمارس الإسلام إمبرياليته المضادة، وإما أن يستبيح الغربيون دياره ويستعمروها. لا طريق ثالث هنا أيضاً. وهذا بدوره يطرح السؤال المتمم: إن كان مفهوم الامبريالية ما زال كلي الراهنية، فماذا عن نقائض الإمبريالية، وهل من أمل بمداواتها من المنطق التي صدرته النهضة اليابانية إلى العالمين، وتحررت منه اليابان نفسها مجبرة، وبقي باقي العالم ينوء تحت ثقله وأكلافه؟
كاتب من لبنان