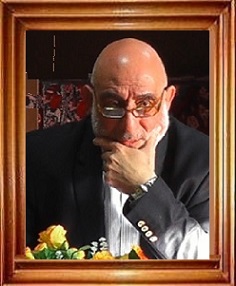التعذيب: عار الاحتلال

التعذيب: عار الاحتلال
منصف الوهايبي
«التعذيب؟ لقد ألفنا هذه الكلمة منذ زمن طويل، وقليلون جدّا هم أولئك الذين أفلتوا منه. فالأسئلة التي تطرح على «الداخلين» الذين يمكن توجيه الكلام إليهم هي على الترتيب: «هل أنت معتقل منذ وقت طويل؟ هل عذّبت؟ وهل معذّبوك مظلّيون أم هل هم ضبّاط؟» أمّا قضيّتي فقد كانت فريدة بما أحدثته من ضجيج. غير أنّها ليست فريدة في شيء. إنّ ما قلته في شكواي، وما سوف أقوله هنا، يمّثل بمثل واحد الأمور الجارية في هذه الحرب الفظيعة الدامية [حرب الجزائر] سمعت في الليل صراخ رجال كانوا يعذّبون، وستظلّ صيحاتهم تتردّد في ذاكرتي إلى الأبد. وقد رأيت معتقلين يضربون بالمطارق، ثمّ يلقى بهم من طبق إلى آخر، فيصيبهم من التعذيب والضرب الخبل؛ حتى أنّهم لا يعرفون إلاّ أن يتمتموا بالعربيّة الكلمات الأولى من دعاء أو صلاة قديمة». كما جاء في كتاب المناضل الشيوعي الفرنسي الجزائري هنري اليغ (أو علاّق على ما أرجّح) «الاستجواب» أو «الجلاّدون» ترجمة عايدة وسهيل إدريس (دار الآداب، ط.1/ 1958).
التعذيب ليس بالظاهرة الجديدة، فهو يسيطر على كلّ تاريخ البشريّة، ومعها بدأ. وبعض هذا التعذيب لا يزال لغزا غير قابل للاختزال، أو هو مظهر من مظاهر البدائيّة والمتوحّش في الإنسان وصورة من غرائبيّة البشر، أو هو تعبير عن السلطة عامّة. لكن ما يعتبره أحرار العالم عنفا وإبادة وانتهاكا صارخا لحقوق الآخر، تعده دولة الاحتلال من المآثر والمفاخر في هذه الحرب على غزّة، حيث نقف على الجسد الفلسطيني المقطّع المفكّك، الذي ليس بميسور العين أن تقيسه أو تستوعبه بيسر؛ وكأننا في فيلم «فرانكشتين» أو ما يشبه «مطبخا مأتميا» للأجساد المقطّعة، أو الإنسان وهو يُمسخ حجرا، في زمن مجرم مخزٍ كهذا الزمن، حيث تتحوّل الهمجيّة إلى فرجة في «الديمقراطيّات». وهذا بشهادة من المنظّمة الحقوقيّة الإسرائيليّة «بتسليم» فقد نشرت حديثا «شهادات مروعة» لأسرى فلسطينيين في سجون تل أبيب، وبينهم أطبّاء وأكاديميّات ومحامون من الضفّة وغزّة وفلسطين 48؛ وقد أثبتوا أنّهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب بما في ذلك الاعتداء الجسدي والجنسي والتجويع والحرمان من النوم ومنع ممارسة العبادة؛ منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023.
لم تنقطع ظاهرة التعذيب منذ غابر التاريخ إلى الأزمنة الحديثة بالرغم من حظره عالميّا فالتعذيب كما تقرّه المواثيق غير أخلاقي وغير قانوني، ويحظر حظرا باتّا على الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة، التسامح معه أو الإذن به أو تسهيله. والأمثلة كثيرة جدّا، ولكلّ قصّة لا تنتهي: محاكم التفتيش وحرب الجزائر، والاحتلال الأمريكي للعراق، وما صدر في «مذكّرات تعذيب» ــ صيغت على منوال النصوص القانونيّة وهي تصف الفظائع التي عانى منها معتقلو غوانتانامو، والتي قرّر الرئيس أوباما نشرها عام 2009 ـ وهي تقدّم دون أي وازع من ضمير، الحجج التي بموجبها يكون التعذيب «وسيلة مقبولة للاستجواب». ناهيك عن دكتاتوريي أمريكا اللاتينيّة، ومعتقلات السوفييت والصين وكمبوديا، وغيرهم مثل الأنظمة الشموليّة في العالم العربي في الخمسينات والستينات وما بعدها، وصولا إلى احتلال فلسطين، وحرب الإبادة وما يرافقها من تعذيب شنيع في حقّ الأسرى الفلسطينيّين؛ وثّقته وتوثّقه منظّمات حقوق الإنسان. فالقسوة الجسديّة أو العقليّة المستخدمة في خدمة الدولة لم تختف من عالمنا. بل إنّ التعذيب «يتكيّف» بشكل جيّد مع التقدم التكنولوجي والنفسي والطبّي. وقبل عدة سنوات، أشار موريس ميرلو بونتي، في كتابه «الإنسانية والرعب» إلى أنّ ما يجمع الطبّ والتعذيب، هو الفضاء الحميم فضاء الجسد الذي يستوطنانه: أحدهما لإنقاذه، والآخر لتدميره.
وهذه وغيرها من ثوابت الجانب المظلم في الانسانيّة أو «العقل المتوحّش»، بل هي» آلة حرب يديرها الإنسان ضدّ جوهره». ربّما هناك جدل قانوني وأخلاقي لا يزال قائما: هل يجوز تعذيب الإنسان؟ وهو جدل «عقيم» يعني الجلاّدين ورجال العصابات والمافيا وجنود جيوش الاحتلال والإرهاب، وعملاء الدول المارقة، دون غيرهم. وهم الذين يسوّغونه ويشرّعون له، باعتباره الوسيلة الفعّالة من أجل انتزاع الاعترافات والمعلومات والأسرار.
أقول إنّه جدل «عقيم» إذ لا فائدة من الاستئناس بالأخلاق أو الدين أو الفلسفة أو السياسة العامّة لتسويغ التعذيب وهو البغيض المنكر وتبريره. والأغرب هو كيف تبرّر الديمقراطيات ما لا يمكن تبريره. بل إنّ تفسير التعذيب أو تدبّره أو البحث في بنيته، في ما يشبه تناسق مشاهد مسرحيّة مجالها السياسي (التشريع والعدالة والجيش والشرطة)، ومجالها الأيديولوجي والثقافي (الفلسفة والفكر والأدب والثقافة) ومجال الفردي (الجلاد، المعذب، المتفرج)؛ قد يكون مدخلا لفهمه فتبريره.
في علم الأعصاب والطب النفسي العصبي وعلم النفس التجريبي وعلم وظائف الأعضاء، نقرأ أنّ عنف «أساليب الاستجواب القسري، مثل الضرب المبرح والحرمان من النوم، والحشر في صندوق تم وضع حشرة فيه، ومحاكاة الغرق، وما إلى ذلك ممّا أورده الأسرى الفلسطينيّون في سجون الاحتلال ومعتقلاته؛ لا تفلح أبدا في «سبر أنظمة الذاكرة لدى أولئك الذين يرفضون الكلام»، وأنه من المستحيل أيضًا وفقًا للبيانات العلميّة، تمثيل أي محتوى معرفي حقيقي لـ«الدماغ الكاذب». وعليه لا يمكن التذرع بأي شيء لصالح التعذيب: فهو غير إنساني، وعلاوة على ذلك «غير فعّال» ولا يمكن نعته إلاّ بكونه سلوكا ساديّا فظيعا. بل نكاد لا ندري من الذي ينسج على منوال الآخر: أمريكا أم إسرائيل؟
فمن 11 أيلول/سبتمبر 2001، أصبح التعذيب في الولايات المتّحدة شبه ممارسة حكوميّة مبرّرة سياسياً وقانونياً من أجل «الحرب العالميّة على الإرهاب»، ومن ثمّة إضفاء الشرعيّة الأخلاقيّة عليه؛ بل هو في نظر طائفة منهم شرّ لا بدّ منه، بل هو عند عتاة الصهاينة خير. إنّ التعذيب فصل من فصول الإبادة في فلسطين، وفضيحة أخلاقية وسياسيّة، بل يمثّل تحدّيا للضمير الإنساني عموماً وللفكر الفلسفي خصوصاً. وقد عالجه بمهارة لافتة فريديريك جروس، أستاذ الفلسفة الفرنسي؛ إذ ينطوي على مواجهة بين جلاّد قوي وضحيّة أعزل مقهور، في دولة أو دول تزعم أنّها تصون كرامة الإنسان ضدّ أي شكل من أشكال الوحشيّة. هل يوقظ الألم ذاكرة الإرهابيين المفترضين أم يطمسها؟ هل يكسر الصمت أم هل يدفع الناس إلى قول أيّ شيء؟
ما ينشده الاحتلال من هذه الهمجيّة وهذا «التعذيب المؤسّسي» هو زرع رعب الألم اللامتناهي، وتحويل الإنسان إلى وحش خائف مطارد، وليس الخوف من الموت وحسب؛ وإنّما من الاحتضار. هذا العذاب الذي لا ينتهي كما نشاهده ونعيشه في فلسطين حيث «يتعيّن عليك أن تموت أو تكابد الألم الذي لا نهاية له؛ لا لشيء، سوى أنّك من عرق أو دين أو مذهب آخر. أو لأنّك تنشد حقك في الحرّية والحياة الكريمة. في فلسطين اليوم، يواجه البشر انتشار الهمجيّة واستخدام وسائل الإعلام الأحدث حيث يتحوّل الرعب إلى مشهد، ويطعن الانسان في «حميميّته» وهو موكول إلى جلأّده، أعزل لا يعرف كيف يدافع عن نفسه؛ بل لا يشفي على موته وإنّما على الجنون: «لن أكون كما كنت بعد الآن… سأكون آخر… لا يمكن التعرّف إليه… هل سأتعرّف إلى نفسي؟».
ويكفي أن أشير في السياق الذي أنا به إلى بطل رواية أورويل «1984»، و«لاعب الشطرنج» لستيفان زفايغ، و«الاستجواب» الذي افتتحت به هذا المقال. وهو كتاب كان له شأن كبير أثناء حرب الجزائر، وشكّل نقلة نوعيّة في كشف جرائم فرنسا. وقد لا أجد في خاتمة هذا المقال أبلغ من القول إنّ هذه «الحقيقة مرعبة على بساطتها، فالأفراد الذين ربّما سوّلت لهم أنفسهم في ظلّ الظروف العادية، ارتكاب جرائم دون أن تكون لديهم نيّة لارتكابها، تقبّلوا في ظروف التسامح التامّ من القانون والمجتمع، أن يسلكوا سلوكا إجراميّا فاضحًا» كما تقول حنة أرندت في «أصول الشموليّة».
ولعلّ «موت الإله» صرخة فريديريك نيتشه ليست سوى نعي الإنسان نفسه وهو يرتكب هذه البشاعات، وكأنّه حيوان يعدّ حيّا للمسلخ. غير أنّ الكلام على التعذيب يعني لا شكّ الجلاّدين والضحايا أوّلا وأخيرا، مثلما يعنينا جميعا؛ إذ لا يمكننا الاستماع إلى المعذّب الضحيّة، ما لم نقف على طبيعة النظام القمعي الذي يدمّره وما لن ندنه؛ حتى لا يتحوّل التعذيب إلى جزء من تحقيق جنائي عادي كما في دولة الاحتلال وفي الأنظمة الشموليّة. ولعلّ مقالة لا برويير الشهيرة التي تقول إنّ «التعذيب هو اختراع رائع، بل آمن تمامًا لتدمير شخص بريء ذي بنية ضعيفة، وإنقاذ شخص مذنب ولد قويًا»، تعود اليوم في هذه الحرب على الفلسطينيّين.
إنّ التفكير في التعذيب يفضي حتما إلى التفكير في الدولة، وبشكل أعمّ، في أيّ نظام سياسي يمارس التعذيب باسم «الصالح العام».
شاعر وناقد تونسي